- المشهد الإنساني
- المقالات: ريما خلف، راشد الغنوشي، فادي غندور
- المشهد السياسي
- المقالات: سلام فياض، لينا عطا الله
- المشهد الجيوسياسي
- المقالات: محمد أبو رمّان، خليل المرزوق، بسمة قضماني
- خاتمة
- مقال: مروان المعشّر
تصدير
تنطوي الأزمات التاريخية التي يواجهها الشرق الأوسط الآن على نتائج طويلة الأمد لا حدود لها. ففي جميع أرجاء العالم العربي، تتعرض السلطة المركزية إلى ضغوط قاسية تكتنفها الصراعات في أطر مؤسسية يتفشى فيها الفساد. ويهدف مشروع "آفاق العالم العربي" الذي يُشرف عليه "برنامج الشرق الأوسط" في "مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي" وبدعم كريم من "مؤسسة الأصفري"، إلى إلقاء الضوء على التيارات العميقة التي تحدّد مسار هذه الأحداث الحافلة بالاضطراب.
ففي جميع أرجاء العالم العربي، تتعرض السلطة المركزية إلى ضغوط قاسية تكتنفها الصراعات في أطر مؤسسية يتفشى فيها الفساد.
ومن خلال مساهمات شبكة من الدارسين المتخصّصين في واشنطن، وبيروت، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، يُلقي المشروع نظرة فاحصة على الانتفاضات الاقتصادية الاجتماعية التي يواجهها المواطن العربي، والضغوط المؤسسية على الدولة العربية، والواقع الجيوسياسي في المنطقة العربية.
ويأمل المشروع، من خلال فحص التغيّرات المركبة المتداخلة التي تحدث على امتداد المشهد الإنساني والسياسي والجيوسياسي، أن يقدّم إلى صانعي السياسات – في العالم العربي وفي الأسرة الدولية الواسعة على السواء – فهما أكثر دقة للأسباب التي أدت إلى عدم الاستقرار العميق الجذور في المنطقة.
في شهر شباط/فبراير 2016، أصدر مشروع "آفاق" دراسة مسحية بعنوان "أصوات عربية حول تحديات الشرق الأوسط الجديد"، عُرضت فيها وجهات النظر التي طرحها أكثر من مئة من الخبراء والدارسين العرب من شتى أرجاء المنطقة.1 وقد وضعت الأغلبية الغالبة من هؤلاء الخبراء التحديات السياسية المحلية في مقدمة الأولويات (ومنها النزعة التسلطية، والفساد وغياب المساءلة)، وقبل التحديات الجيوسياسية (مثل النزاع الإقليمي، والمنافسات الطائفية، والتدخل الأجنبي). واعتبر البعض ذلك حصيلة لسلسلة طويلة من الإخفاقات الجوهرية في مجال الحوكمة.
لماذا فشلت الانتفاضات العربية، باستثناء الانتفاضة التونسية، في تحقيق الوعد بحكم أفضل حالاً، وبتوفير الفرص الاقتصادية، والتعددية السياسية؟
وهذه الفكرة النيّرة – وهي أن الركود السياسي، والنزعة التسلطية، والفساد، ترتبط ارتباطاً لا فكاك منه بالصراع والإرهاب في المنطقة العربية – تمثّل نقطة الانطلاق في هذا التقرير. وهي تسعى إلى التصدّي لعدد من المسائل الجوهرية المُستغلقة العسيرة التي تواجه الشرق الأوسط: لماذا فشلت الانتفاضات العربية، باستثناء الانتفاضة التونسية، في تحقيق الوعد بحكم أفضل حالاً، وبتوفير الفرص الاقتصادية، والتعددية السياسية؟ لماذا انتشر الصراع المحلي والإقليمي في المنطقة على نطاق واسع وبهذه الصورة الوحشية؟ وكيف ستكون مواصفات العقود الاجتماعية الأكثر تقبلاً لمبدأ المساءلة بين المواطنين والدول، وكيف تستطيع البلدان العربية الإفادة من رأس المال البشري؟
يبدو أن النظام العربي القديم – الذي يتّسم بأنساق التسلّط السياسي والاقتصادات المعتمدة على النفط آيلٌ إلى الأفول. وفي ما تستحيل العودة إلى مرحلة ما قبل العام 2011 من دون بديل واضح، فإن ثمة خطراً بقيام أنظمة أكثر قمعا من سابقاتها. إضافةً إلى ذلك، من المتعذر أن نشهد نهاية لهذا الوضع، ما لم تتبلور مقاربات سياسية كليّة شاملة تبدأ بمعالجة الأسباب الاقتصادية الاجتماعية والسياسية عميقة الجذور لأزمات الشرق الأوسط.
عندما توضع في الاعتبار ضخامة هذه التحديات، يميل السكان الذين استولى عليهم اليأس إلى الانسحاب من ميدان النشاط السياسي والتركيز على الأمن الشخصي، مثلما يميل صنّاع السياسات إلى التركيز المحدود على تهديدات الأمن ومكافحة الإرهاب. بالطبع، هذه المخاطر حقيقية وتستحق كل الاهتمام، بيد أن المظالم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية – والأهم من ذلك كله المطالبة بالكرامة الإنسانية والعدالة – لازالت ماثلة للعيان.
يرمي هذا التقرير إلى إثارة النقاش حول الحاجة إلى بروز اتجاهات جديدة في العالم العربي. ونحن نرحّب بالملاحظات النقدية المُتبصّرة حول ما يرد هنا من تحليلات، وقد ينعكس ذلك في إصدارات "آفاق العالم العربي" المقبلة.
مروان المعشّر
نائب الرئيس للدراسات
مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي
كانون الأول/ديسمبر 2016
ملخّص
إن أركان النظام العربي القائمة منذ أمد بعيد، وهي المساومات السلطوية وعائدات الموارد الهيدروكربونية، آخذة بالانهيار، فيما تواجه المؤسسات السياسية المطالب المتعاظمة لجماهير السكان المتزايدة. وكان من نتائج ذلك انتشار العجز والقصور والقمع على نطاق واسع في المجالات الاقتصادية الاجتماعية، ما أدى إلى تفكّك الدولة على نحو غير مسبوق، بخاصة في العراق، وليبيا، وسورية، واليمن. وأدت هذه العوامل، بدورها، إلى نزوح أعداد هائلة من البشر وإلى شيوع الألاعيب بين القوى الجيوسياسية. وإذا ما قُدّر للنظام أن يعود بعد انحسار النزاعات، سيتعيّن على المواطنين والدول صكّ عقود اجتماعية جديدة تؤسس المحاسبة والمساءلة وتنشّط عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي.
جذور الانهيار الإقليمي
- تنشغل المجتمعات في جميع أنحاء العالم بالتحوّلات التكنولوجية، والاقتصادية، والثقافية. ومع ذلك، فإن الضغوط المتأصلة كانت قابلة للاشتعال والانفجار بصورة خاصة في العالم العربي، جرّاء القصور المؤسسي وانتشار الصراع والنزعات الطائفية والراديكالية.
- ثمة أزمة بين الحكومات والمواطنين. كما تداعت المساومات السلطوية التي تقوم بموجبها الأنظمة بتقديم الخدمات الاجتماعية والوظائف الحكومية على سبيل المقايضة، لاسترضاء المواطنين. وقد أخذت هذه العقود الاجتماعية بالتآكل، في الوقت الذي لم تعد فيه الميزانيات المتضخمة والإدارات البيروقراطية المنتفخة قادرة على تلبية احتياجات التكاثر السكاني.
- فقدت الدول سيطرتها على مساحات واسعة من الأراضي لصالح لاعبين من خارج الدولة، بمن فيهم تنظيم الدولة الإسلامية. كما أن المراكز المؤثّرة سابقاً، مثل مصر والعراق، تتعرّض الآن إلى تقييدات حادّة جرّاء انتشار مواطن الضعف المحلية. والدول القوية تتدخّل على نحو متزايد في شؤون الدول الضعيفة، مايزيد من حدّة الصراع الداخلي في المنطقة.
- وإلى جانب الدول المجاورة المصدرة للنفط، فإن البلدان المستوردة للنفط، التي تعتمد منذ أمد بعيد على التحويلات النقدية، والمساعدات والاستثمارات الخارجية، ستواجه ضغوطاً متزايدة جرّاء انهيار أسعار النفط. وقد أعاق الاعتماد على عائدات النفط عملية التنمية الاقتصادية والسياسية في العديد من الدول، وجعلها غير مهيأة للتعامل مع الاضطرابات الناجمة عن ذلك.
تجاذب بين التخندّق والتغيير
- تلجأ أنظمة الحكم العربية، باستثناء قلّة منها، بصورة متزايدة، إلى استخدام الوسائل القسرية لإعادة تأكيد قدرتها على السيطرة. غير أن المواطنين لن يتخلّوا عن مطالبتهم بالمزيد من المساءلة والمحاسبة، والشفافية، والفعالية السياسة، بينما تتناقص خدمات الرفاه الاجتماعي، مما يرجّح تصاعد التوتر بين المواطنين والدولة.
- ترتبط السيطرة السياسية بالسيطرة الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً لا ينفصم عراه في أرجاء العالم العربي، ويؤدي ذلك إلى انتشار المحسوبية والفساد ويتطلب وضع الأسس لتنمية اقتصادية مستدامة يتولاها القطاع الخاص لفك هذا الترابط.
- قد يبدو استمرار الفوضى في الشرق الأوسط أمراً لا محيد عنه، غير أن مناطق أخرى شهدت انهيارات مماثلة واستدركت الأمر قبل أن تهوي إلى الهوة السحيقة. غير أن هذه المحاولات لتدارك الوضع في الشرق الأوسط ستبوء بالفشل، إلا إذا أبرمت المجتمعات العربية عقوداً اجتماعية جديدة تقوم على نماذج أكثر استدامة في المجال السياسي والاجتماعي الاقتصادي.
مقدّمة
مينا، وهي مُدرّسة سورية في السادسة والعشرين، في حيرة من أمرها: بين ماضٍ مضى وانقضى، وحاضر أوروبي غير مألوف، ومستقبل ملتبس. تمتعت بحياتها في مدينة حمص، حين كانت تعمل في مؤسسة للأطفال المصابين بالتوحّد وتواصل تحصيلها العلمي في الوقت نفسه. لم تكن تمارس أي نشاط سياسي، لكنها حرصت على التزام الحياد عندما تحوّلت الاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة التي بدأت في العام 2011 إلى حرب أهلية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2015، هربت من منزلها ومن بلادها.
تعيش مينا اليوم في مخيم للاجئين في برلين. ومع أنها وجدت عملاً في إحدى المدارس التمهيدية المحلية فإنها تقول، "مايرهقني إلى درجة لا تصدّق أن عليّ أن أبدأ حياتي من جديد". ويساورها القلق حول المعاناة النفسية التي يحملها أولئك الذين بقوا في سورية: "إنهم على قيد الحياة فقط. يأكلون، ويشربون، وينامون".
مع ذلك، فهي تأمل أن تطوّر مهاراتها التعليمية خلال وجودها في ألمانيا، ليتسنى لها المساهمة في إعادة بناء سورية عندما يتحقق حلمها بالعودة إلى بلادها.
وكما حدث لمينا، دخل الكثيرون في العالم العربي مرحلة الاقتلاع العميق تلك. لقد انقرض النظام القديم، فيما النظام الذي سيحل محله لايزال غير واضح المعالم. وتواجه الأنظمة العربية عاصفة عاتية تفتّت العلاقة بين المواطن والدولة، وتتصاعد معها الصراعات المحلية والإقليمية، وتنهار أسعار النفط، وترتفع معدّلات الحرارة ويلوح في الأفق احتمال حدوث نقص حادّ في المياه، ويتهافت الإحساس بالهدف المشترك بين الزعامات السلطوية في المنطقة. وهي عاصفة لم تكن تلك الأنظمة، عدا قلة قليلة منها، مستعدة لمواجهتها. وكانت الحصيلة هي الفترة الأكثر دماراً في الشرق الأوسط منذ تأسيس الدول العربية الحديثة بعد الحرب العالمية الأولى.
لقد انقرض النظام القديم، فيما النظام الذي سيحل محله لايزال غير واضح المعالم.
درجت الأنظمة العربية، على مدى عقود عدة، على توفير الخدمات الاجتماعية ودعم المواد الاستهلاكية والوظائف الحكومية، مقابل مشاركة ضئيلة، أو عدم المشاركة على الإطلاق، من جانب المواطنين في اتخاذ القرار – بما معناه عقود اجتماعية تقوم على أساس المساومات السلطوية. وقد اختلفت البلدان العربية اختلافاً بيّناً في الطريقة التي تدير بها شؤونها الداخلية. لكنها كانت كلها تقريباً تخضع لأنظمة حكم أوتوقراطية استبدادية، سواء في أساليب السيطرة أو استخدام القمع. فقد أنشأت أجهزة استخبارية وأمنية قوية وبذلت جهوداً ضخمة للإيهام بشرعيتها السياسية، ما يمثّل تحدياً صعباً في جمهوريات عربية عُرفت بكراهيتها للمؤسسات الديمقراطية. ومع تزايد الروابط بين القوتين السياسية والاقتصادية في كثير من البلدان العربية، تنامت شبكات المحسوبية القوية. كما أن النزاع العربي الإسرائيلي والحرب الباردة كانا حجر عثرة كذلك في طريق التنمية المؤسسية، مثلما كانا ذريعة لغيابها.
أدّى تركيز تلك الأنظمة على أدوات الاجتذاب والوسائل القسرية إلى خلق ثقافة التبعية وإلى وضع عقبات كبيرة في وجه المحاولات الرامية إلى تنمية مؤسسات قد تشجّع على تطبيق حوكمة شاملة. والأدهى من ذلك أن الأنظمة الفاسدة القمعية الجشعة أصلاً التي برزت في كثير من البلدان، قاومت بعنف جميع جهود الإصلاح وحرمت تلك البلدان من الأدوات اللازمة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية الجديدة.
في تلك الأثناء، كانت خلطة من القوى المحلية والعالمية تمر في حالة اختمار بطيء، ومنها: طفرة شبابية بارزة في البنية السكانية في العالم العربي؛ وطفرة حادة للإرهاب والتطرف الديني بعد الآثار التي خلّفها غزو الولايات المتحدة للعراق في العام 2003 والحرب الأهلية السورية المستمرة؛ والمنافسة الاقتصادية الدولية المتسارعة؛ وتكنولوجيا المعلومات التحويلية. وما من خريطة طريق ثقافية أو سياسية لعثرات اقتصادية اجتماعية بهذا الحجم. وإذا كانت المؤسسات السياسية المرنة نسبياً، مثل تلك القائمة في أميركا الشمالية وأوروبا، قد جهدت للتكيّف مع تلك التغيرات الزلزالية، فليس من المستغرب أن الأنظمة العربية الخامدة قد فوجئت ولم تكن مستعدة عندما بدأت الانتفاضات في العام 2011.
إن انهيار النظام الإقليمي، إذاً، مثّل في جوهره أزمة ثقة بين الحكومات والمواطنين.
إن انهيار النظام الإقليمي، إذاً، مثّل في جوهره أزمة ثقة بين الحكومات والمواطنين. ففي العام 2011، اتضح أن مايسمى عقوداً اجتماعية إنما كان من طرف واحد، لأن المواطنين في المنطقة رفضوا بشكل صريح الأسس التي أقيمت عليها المساومات السلطوية.
بعد النفي المفاجئ وغير المتوقع للرئيس التونسي زين العابدين بن علي، لجأت بعض الأنظمة إلى دليل إرشادي مألوف لاحتواء مضاعفات ماحدث في تونس، حين ردّت باستخدام مزيج من المعونات الاجتماعية والسياسية القمعية، مع درجات متفاوتة من الوحشية والحنكة. وكان من نتائج ذلك أن بعض الأنظمة الأكثر قمعاً في المنطقة، وهي العراق وليبيا وسورية واليمن، بدأت تتشرذم على أسس إثنية وإيديولوجية وطائفية وقبلية، بينما شهد بعضها الآخر قلاقل داخلية مهمة. إذ تجلّت أكثر هذه المظاهر تطرّفاً في سورية التي وجد مواطنوها أنفسهم آنذاك بين شقّي رحى: نظامٌ مستعدٌّ لتدمير مدنه حجراً على حجر، والعنف المبيد الذي يمثّله تنظيم الدولة الإسلامية، وقد فاقمت الضغوط الخارجية أزمات الدولة. وعلى الرغم من أن أسعار البترول قد استقرّت بعد أن فقدت 70 في المئة من قيمتها، من المتوقّع أن تبقى على انخفاضها في المستقبل المنظور، فتطرح بذلك تحديات مالية مهولة أمام العالم العربي. وفي جميع دول المنطقة، بما فيها تلك الأكثر ثراءً، ستفتقر الأنظمة الاقتصادية الريعية، التي كانت عائدات بيع النفط تموّل أنظمة وطنية واسعة للرعاية والمحسوبية والإعالة، بصورة متزايدة، إلى الاستدامة مع مرور الوقت، بل إن البلدان شحيحة الموارد في المنطقة ستتأثر من ذلك، لأن معظم الدول العربية غدت تعتمد، بصورة أو بأخرى، على عائدات النفط في المنطقة.
لن يكون بمقدور الدول العربية تنمية مجتمعات مزدهرة إلا إذا اقتدت بنماذج سياسية واقتصادية جديدة.
لن يكون بمقدور الدول العربية تنمية مجتمعات مزدهرة إلا إذا اقتدت بنماذج سياسية واقتصادية جديدة. وبما أنه يُطلب من المواطنين أن يُضحّوا بمزايا المعونة الاجتماعية التي اعتادوا عليها منذ عهد بعيد بدعوى التقشف المالي، فإن قبولهم بالأنظمة القديمة التي ستوجّه فيها السلطة أوامرها من القمة إلى القاعدة سيتوقف، وسيطالبون بالمساءلة، والعدل، وبدور أكبر في القرارات المتعلقة بالقضايا الوطنية. وبالنسبة إلى الزعماء الذين اعتادوا منذ أمد بعيد على ممارسة السلطة المطلقة، سيمثّل مصيدة خطرة – من صنعهم هم أساساً - وهم لن يجانبوا الصواب إذا اعتقدوا أن طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي سيؤدي إلى فقدان جانب من السلطة والنفوذ. وبذلك، ستواصل هذه الأنظمة، باستثناء قلة منها، التشبث بالوضع الراهن المتهافت، حتى لو أسفر ذلك عن نتائج كارثية.
في غمرة البلبلة التي اكتنفت الأوضاع القديمة، يشوب الغموض الوجهة التي ستتجّه إليها المنطقة. وقد لاحظ الفيلسوف الماركسي أنطونيو غرامشي في السجن في إيطاليا الفاشيّة في ثلاثينيات القرن الماضي أن "الأزمة تتجلّى تحديداً في أن القديم آيلٌ إلى الزوال، بينما لا يستطيع الجديد أن يولد؛ وفي فترة التريث هذه، يبرز عدد كبير من الأعراض المَرَضية". وهذا هو الواقع الذي يواجهه اليوم الشرق الأوسط، وهو منطقة تظل ذات أهمية حاسمة للسلام والأمن العالميين.
يحاول هذا التقرير استقصاء الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وهو يتفحّص التيارات العابرة للحدود التي تفعل مفعولها أفقياً وعمودياً، في الميادين الإنسانية والسياسية والجيوسياسية في المنطقة، أي العلاقات المتداخلة بين هذه التيارات في داخل البلدان وفي ما بينها على السواء. وبصورة أكثر تحديدا فإن التحليل يتناول:
- المشهد الإنساني – تجارب المواطنين العرب المتغيّرة في سياق الضغوط الديمغرافية والهجرة البشرية، والاستقطاب السياسي، والحراك الاجتماعي.
- المشهد السياسي- أزمة الحوكمة في أرجاء المنطقة، والضغوط على الأنظمة الريعية، وتأثير القطاع الأمني ووسائل الإعلام على السياسات العربية.
- المشهد الجيوسياسي- النظام الإقليمي الآيل للانهيار في سياق حافل بالعديد من الصراعات الداخلية والنزاعات بين الدول، ومضاعفات انخفاض أسعار النفط، وآثار التغيرات المناخية وشحّ الموارد المائية في المدى البعيد.
وستشكّل نتائج الاستقصاء، إطاراً لفهم كيف تتفاعل هذه الانهيارات مع بعضها البعض داخل كل مشهد، وكيف يمكن أن تبدأ مختلف البلدان في معالجتها. ولتوضيح الكيفية التي تفعل بها هذه الأعطال والتيارات مفعولها في سياقات متباينة، يطرح التقرير ثماني دراسات عن ثماني حالات: مصر، والعراق، والأردن، وليبيا، وفلسطين، والمملكة العربية السعودية، وسورية، وتونس. وكان من الممكن اختيار أقطار أخرى، غير أن هذه البلدان هي الأبرز في تبيان التيارات الأساسية في العالم العربي، وفي إيضاح الأساليب المتباينة التي تلجأ إليها الحكومات لمواجهتها. ويمثّل فهم التجارب التي تمر بها هذه البلدان عنصراً حيوياً لفهم ما ينتظر العالم العربي.
المشهد الإنساني
كان لانهيار النظام الإقليمي وتآكل العقود الاجتماعية في كثير من البلدان العربية تداعيات مهمة في ما يتعلق بعلاقة المواطنين العرب بحكوماتهم وعلاقاتهم مع بعضهم البعض. ومع أن المجتمعات في جميع أنحاء المعمورة منشغلة بالتكيّف مع التحوّلات التكنولوجية والثقافية، فإن هذه الضغوط الاجتماعية تطرح مزيجاً قابلاً للاحتراق بصورة خاصة في الشرق الأوسط في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وانتشار الصراع، والنزاعات الطائفية والراديكالية. فالتحوّلات الاجتماعية المركبة تحدث في أربعة ميادين متداخلة هي: الجانب الديمغرافي والتنمية الإنسانية، والهجرة، والاستقطاب، والحراك الاجتماعي.
الجانب الديمغرافي والتنمية الإنسانية
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
يعتمد الاستقرار والازدهار في البلدان العربية في المستقبل على تسارع معدلات التنمية الإنسانية، لأن التعويل على الموارد الهيدروكربونية لم يعد أمراً يُركن إليه بسبب التكاثر السكاني من جهة، والتغيرات في أسواق الطاقة العالمية من جهة أخرى. وفي حين حققت البلدان العربية بعض التقدّم في مجال معرفة القراءة والكتابة والتعليم العالي بالنسبة إلى النساء، فإن ثمة تخلّفاً في جوانب أخرى من التنمية الإنسانية تعيق النقلة المطلوبة من النمو الذي يسيّره القطاع العام إلى نمو يوجّهه القطاع الخاص. وتتعلق إحدى العقبات الرئيسية بالمدركات والمواقف. فمع تزايد البطالة والتململ في أوساط الشباب، مالت بعض الحكومات إلى التعامل مع الجيل الجديد من المواطنين بوصفهم تهديداً أمنياً لا ركناً ركيناً من أركان الاقتصاد، فعرقلت بذلك أنشطتهم في المجال العام. وهذه المواقف، في التحليل الأخير، هي التي تحرم المنطقة من ربحية ومنفعة مُضْمرة تتمثّل في النمو الاقتصادي المتسارع نتيجةً لتوسّع القطاع السكاني القادر على العمل، وهذا ماشجّع وعزّز في الماضي اقتصادات شرق آسيا ومناطق أخرى.2
في العام 2002، أحدث التقرير الأول من سلسلة تقارير "التنمية الإنسانية العربية" هزة مؤثرة في المنطقة. وقد تضمنت هذه التقارير، التي أعدّتها مجموعة من الدارسين والباحثين العرب المستقلين المرموقين، تحقيقات صريحة ومؤلمة عن أوضاع التنمية البشرية في البلدان العربية. وخلُص تقرير العام 2002 إلى أن العالم العربي يعاني العجز والقصور في ميادين الحريات السياسية، والتعليم، وتمكين المرأة.3 وبعد مايقرب من خمس عشرة سنة، لازالت هذه التحديات ماثلة للعيان وانضمّت إليها تحديات جديدة.
وخلُص تقرير العام 2002 [AHDR] إلى أن العالم العربي يعاني العجز والقصور في ميادين الحريات السياسية، والتعليم، وتمكين المرأة.
تعرِّف تقارير التنمية الإنسانية الحرية بأنها "الحوكمة التشاركية". وبحسب تقديرات منظمة "بيت الحرية" (Freedom House)، لم تنضم إلى قائمة الدول "الحرّة" منذ العام 2002 حتى الآن غير دولة عربية واحدة هي تونس. وهناك دولتان أخريان، هما لبنان والمغرب، تُعتبر كل منهما "حرّة جزئياً"؛ أما بقية البلدان فقد صُنّفت باعتبارها "غير حرّة".
خلال العقود الأخيرة، حققت البلدان العربية نجاحاً في مجالات الالتحاق بالمدارس ومعرفة القراءة والكتابة، غير أن نوعية التعليم - أي توفير المهارات المطلوبة لأغراض الاستخدام، والتدرّب التكنولوجي والبحث الأكاديمي والعلمي- لازالت تمثّل تحدياً رئيسياً. ويبرز التفاوت في هذه الناحية بين البلدان العربية الأكثر ثراء وتلك الأكثر فقراً. وقد جاء في مؤشر التنافسية العالمية 2014-2015 الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" أن الإمارات العربية المتحدة تحتل المرتبة 12 بين 144 دولة شملها المسح حول نوعية التعليم في الدراسات العليا، بينما كانت مرتبة مصر، وليبيا، واليمن، 119، و126، و142 على التوالي.4
بالنسبة إلى تمكين النساء، شهدنا تقدّماً في مجال معرفة القراءة والكتابة والالتحاق بالمدارس والجامعات في صفوف الإناث منذ العام 2002. وارتفع معدّل معرفة القراءة والكتابة في صفوف النساء البالغات في العالم العربي من نحو 41 في المئة في العام 1990 إلى 69 في المئة العام 2010.5 وفي أغلب البلدان العربية، تتفوّق الإناث على الذكور عددياً في مجال الالتحاق بالجامعات.6 ومع ذلك، لازالت مشاركة النساء في القوى العاملة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأدنى بين جميع بقاع العالم، إذ لا تتجاوز نسبة 22 في المئة، مقارنةً مع المعدل العالمي الذي يبلغ 50 في المئة.7 وبالمثل، تُعدّ المشاركة السياسية في البلدان العربية أدنى من معظم مناطق العالم، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة التي تبيّن نسب النساء الوزيرات والبرلمانيات في العالم.8
يُضاف إلى ذلك أن تحديات التنمية الإنسانية، ولاسيما البطالة، ازدادت حدّة مع التكاثر السكاني. ويحتل معدل التزايد السكاني في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المرتبة الثانية عالمياً بعد منطقة جنوب الصحراء الأفريقية. ومع أن معدل الخصوبة قد انخفض بين العامين 1990 و2014 من 5.2 طفلاً إلى 3.4 لكل امرأة، فإنه ما زال أدنى بكثير من نسبة الاستبدال، وهي 2.1. بل إن المعدل في بلدان عدة، أبرزها العراق، وفلسطين، والسودان، واليمن، يزيد على أربعة أطفال لكل أنثى.9 أما مصر، وهي الأكثر اكتظاظاً بالسكان في المنطقة، فقد شهدت تزايداً سريعاً في حجم سكانها الذين ارتفع عددهم من 68 مليوناً العام 2000 إلى 92 مليوناً العام 2015، بينما ارتفعت معدلات الخصوبة (التي تناقصت إلى حدٍّ كبير خلال العقود الأخيرة) مرة أخرى بين العامين 2007 و2014 لتبلغ 3.3 أطفال للمرأة.10
ونتيجةً لمعدلات الخصوبة المرتفعة تاريخياً، شهدت الدول العربية طفرة شبابية، أي قطاعاً من الشباب البالغين أكبر مما شهدته الفئات العمرية الأخرى. ويبيّن الشّكل (1) أدناه، الذي يوضح التوزيع حسب الجنس والعمر في الدول الاثنين والعشرين الأعضاء في جامعة الدول العربية، طفرة شبابية تقليدية، مقارنةً مع الشكل (2) الذي يظهر المعدّل المتقلّص للفئة الشبابية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.11


يعني توزيع المراهقين والشباب البالغين في سن الخامسة عشرة والخامسة والثلاثين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أعداد من يطالبون بفرص العمل وبمستويات أعلى من التحصيل العلمي أو التدريب المهني العالي ستكون عالية بصورة غير عادية. وقد ارتبطت الطفرات الشبابية تاريخياً بالصراعات الأهلية،12 ما يضاعف حاجة الدول التي تبرز فيها الطفرات الشبابية إلى تحقيق نمو اقتصادي سريع لمواكبة تزايد أعداد الشباب في سن العمل. وعندما تخيب تطلّعات هؤلاء الشباب، تنحو البلدان إلى حالة من عدم الاستقرار. وفي العالم العربي، الذي لازال يعاني من أعلى معدلات البطالة في العالم،13 ترتفع مستويات الإحباط.14 وتبرز هنا كذلك نتائج الفجوة بين الأجيال في المجالات الاجتماعية والسياسية: فبينما تنتشر فئة الأعمار الوسيطة دون الحادية والعشرين في بلدان عربية عدة، يتركّز النفوذ السياسي والاقتصادي بصورة محكمة في صفوف الجيل الأكبر سناً.15
وعندما تخيب تطلّعات هؤلاء الشباب، تنحو البلدان إلى حالة من عدم الاستقرار.
تبتعد بعض البلدان العربية، مثل تونس، تدريجياً عن الطفرة الشبابية مع انخفاض معدلات الخصوبة.16 غير أن السكان في البلدان العربية الأخرى لازالوا يتكاثرون بمعدلات سريعة، كما يُتوقّع أن تشهد بعض الدول الأكثر اكتظاظاً بالسكان، مثل مصر، طفرة شبابية أضخم خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة المقبلة.17
إن هذه الضغوط السكانية تزيد من الحاجة الملحّة في البلدان العربية لمعالجة الفجوات في التنمية البشرية، ولتفكيك شبكات المحسوبية. وتساوي قوة عمل مدربّة مع تنمية قطاع خاص يؤمّن فرص العمل. وتبيّن التجربة في سياقات أخرى أن تلك الطفرات الشبابية قد تتحوّل إلى مزايا تنموية عند توخي السياسات الاستثمارية والخيارات السياسية السليمة، ولاسيما في مجالات التعليم. وإذا لم تتحقق النقلة في البلدان العربية إلى مرتبة أعلى في تصنيفات التنمية البشرية، قد تستمر الاتجاهات الديمغرافية بوصفها إحدى أسباب المشكلات، بدلاً من أن تفضي في سنوات مقبلة إلى الازدهار.
الهجرة البشرية
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
تعاظمت تحديات الديمغرافيا والتنمية البشرية جرّاء تحركات السكان الهائلة التي أشعلتها النزاعات في جميع أرجاء المنطقة في مرحلة ما بعد العام 2011. وقد شهدت بعض البلدان، ولاسيما العراق وسورية نزوح أعداد ضخمة من المواطنين، هرباً من جحيم الصراع إلى دول مجاورة أو بقاع أخرى في مختلف أرجاء أوروبا. وكان من نتائج ذلك، أن عانت هذه البلدان من انخفاض حاد في جوانب من التنمية البشرية ومن تراجع مثير في أعداد وتخصصات من بقي من العاملين، مثل المستخدمين في مجالي الطب والهندسة. وهناك بلدان أخرى، مثل لبنان والأردن، التي استقبلت موجات متدفقة من اللاجئين، تعاني ضغوطاً قاسية بسبب ما تقدّمه من خدمات مثل التعليم، والضمان الاجتماعي والأجهزة الأمنية. يُضاف إلى ذلك أن الأنظمة السياسية القائمة على سياسات الهوية غدت أكثر تعقيداً بسبب التغيّرات السريعة في النسيج الاجتماعي في تلك البلدان.
من الصعب أن نبالغ في تقدير حجم الكارثة. ففي العام 2015، أشارت التقديرات إلى أن نحو 143 مليون عربي يعيشون في بلدان تعاني ويلات الحرب أو الاحتلال،18 كما أن نحو17 مليوناً طُردوا قسراً من منازلهم.19 وبينما يشكّل العرب 5 في المئة فقط من سكان العالم،20 إلا أنهم يشكّلون أكثر من 50 في المئة من لاجئيه.21
ومع وجود أكثر من 4.8 ملايين شخص أرغموا على الهرب من بلادهم ونحو 6.6 ملايين أرغموا على النزوح الداخلي،22 فإن واحداً من بين كل خمسة لاجئين عالميين يكون سوريّا.23 كما أن العراق، الذي عانى من موجات من النزوح تعود إلى ثمانينيات القرن العشرين، شهد كذلك حركات نزوح داخلية ملموسة نتيجة لاستمرار النزاع، حيث فرّ مايزيد عن 3.3 ملايين نسمة من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية.24 ويواجه سكان ليبيا والسودان واليمن التهجير القسري كذلك. علاوةً على ذلك، استضاف العالم العربي أعداداً كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين، وهم جالية اللاجئين الأقدم والأضخم في العالم ويبلغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، منذ الحربين العربية الإسرائيلية في العام 1948 والعام 1967.25
كانت الصراعات في المنطقة، ومانجم عنها من تحركات سكانية واسعة النطاق، قد أفضت إلى تغييرات اجتماعية كبيرة، وإلى خطر سقوط السكان اللاجئين في مصيدة دوائر الفقر المتوارثة من جيل إلى جيل. فالسكان الذين هربوا من العنف قد التحقوا بالمحاربين، أو أنهم أصبحوا لاجئين، ومنهم من يتمتع بالوضع الأفضل للمساهمة في عملية الإعمار بعد الحرب، ويمثّلون، أساساً، الشباب والطبقة الوسطى. وتشير دراسة حديثة، على سبيل المثال، إلى أن 86 في المئة ممن هربوا من سورية إلى اليونان بين نيسان/أبريل وأيلول/سبتمبر 2015، يحملون شهادات الدراسة الثانوية أو التعليم الجامعي.26 يضاف إلى ذلك أن أكثر من 2.8 مليون طفل سوري لا يرتادون المدارس،27 وقد يؤدي ذلك إلى نتائج وخيمة على المدى الطويل.
فالسكان الذين هربوا من العنف قد التحقوا بالمحاربين، أو أنهم أصبحوا لاجئين، ومنهم من يتمتع بالوضع الأفضل للمساهمة في عملية الإعمار بعد الحرب، ويمثّلون، أساساً، الشباب والطبقة الوسطى.
قُدّرت نسبة الفقر الكلية في سورية العام 2014 بنسبة 83 في المئة، بمن فيهم نسبة 35 يعيشون دون خط الفقر المدقع، ولايستطيعون تلبية الاحتياجات الأساسية لأسرهم،28 وفي أماكن أخرى، يعيش نحو 11 مليون شخص في اليمن في ظل ظروف في غاية القسوة من الناحية الغذائية.29 وفي العراق وليبيا، تقدّر الأمم المتحدة عدد الأشخاص الذين يحتاجون إلى شكل من أشكال المعونة الغذائية بنحو 2.4 مليون و210000 على التوالي.30
يستضيف الأردن ولبنان أكبر عدد من اللاجئين في العالم العربي، ومنهم نحو 655000 لاجئ سوري مسجّل في الأردن،31 ونحو 1.01 مليون في لبنان،32 إضافةً إلى جماعات اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان منذ عهد بعيد، وتتألف من نحو 2.1 مليون،33 و450000 لاجئ مسجل.34 وهذا يؤثّر تأثيراً بالغاً على المجتمع وعلى البنى الأمنية في كل من البلدين ويهدّد بتقويض العقود الاجتماعية القائمة. وقد أفضى استقرار أعداد ضخمة من اللاجئين في الأراضي الأفقر في كل من الأردن ولبنان إلى تسريع عملية الزحف الحضري إلى مناطق تفتقر إلى البنى الضرورية اللازمة، مثل مخيّمي المفرق والزعتري اللذين يؤويان 158683 لاجئاً سورياً، أو نحو 24 في المئة من جميع أولئك المسجّلين في الأردن.35
تعرّضت أجهزة الضمان الاجتماعي، التي أظهرت مستوى عالياً من القدرة على التكيّف والكرم في استضافة اللاجئين هي أيضاً إلى ضغط هائل. فقد شهد الأردن ولبنان كلاهما تراجعاً في مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل التعليم والصحة، وانخفاضاً في الأجور، وتزايداً في معدلات البطالة في قطاع الشباب والقطاع غير الرسمي، وارتفاعاً في معدل عمالة الأطفال.36 وفي لبنان، على سبيل المثال، يزاول العمل 10 في المئة من الأطفال السوريين اللاجئين، بمن فيهم 18 في المئة من الأطفال اللاجئين في سهل البقاع. ويُعتقد أن 26 في المئة من الأطفال اللاجئين السوريين سُحبوا من المدارس.37
فاقمت أزمات اللاجئين سياسات الهُويّة التي غيّرت التكوين الثقافي لكل منطقة وعقّدت، إلى حد كبير، الجهود التي بُذلت بعد الحرب للمصالحة. وعلى سبيل المثال، أُخليت وأفرغت الموصل من أهلها المسيحيين للمرة الأولى منذ قرون، غير أن المسيحيين كانوا أفضل حالاً من الأيزيدين والشبك، والمندائيين، والشيعة والتركمان، الذين تعقّبهم تنظيم الدولة الإسلامية وقتلهم. كما أن عمليات نقل السكان لم تعد مجرّد آثار جانبية للصراع على السلطة السياسية في الاتفاقات السياسية المحلية في بعض المواقع. وعلى سبيل المثال، نصّت الاتفاقات لإنهاء الحصار على الزبداني في العام 2015 وداريّا العام 2016 في سورية على نقل السكان.38
لم تؤدِّ هذه التركيبة الديمغرافية العربية إلى إضعاف الدول والمجتمعات العربية وحسب، بل قوّضت، ربما بدون أمل في الإصلاح، منظومة قيم التعايش والتعددية.
لم تؤدِّ هذه التركيبة الديمغرافية العربية إلى إضعاف الدول والمجتمعات العربية وحسب، بل قوّضت، ربما بدون أمل في الإصلاح، منظومة قيم التعايش والتعددية. ولا شك أن خلق الكيانات الإثنية والطائفية، سيفضي إلى زرع واستنبات بذور الصراع لعقود عدّة مقبلة، مع طرح مطالبات جديدة لاستخدام حق العودة.
وأخيراً، قد يؤدي ظهور لاعبين واقتصادات جديدة في مناطق النزاع، إلى إعطاء، دفعة للتهجير القسري، ويؤثر على مستقبل السلام. فقد غدا تهريب المهاجرين، على سبيل المثال، صناعة مترامية الأطراف للجريمة المنظّمة في أوروبا، يتراوح ريعها السنوي بين خمسة وستة مليارات دولار.39 وقد برز في سورية اقتصاد ضخم، مرتبط بالصراع، ويشمل بيع الأسلحة، وتهريب الأغذية والمنتجات الأساسية، وأنشطة إجرامية أخرى. وتشير بعض التقديرات إلى أن مايقرب من 17 في المئة من سكان سورية النشطين يعملون في الاقتصاد المرتبط بالنزاع، ما أسفر عن خلق طبقة جديدة تنامت ثرواتها بفعل الحرب.40 ويستطيع كثير من هؤلاء اللاعبين، ومعهم أعداد كبيرة من المليشيات التي شُكّلت إبّان الحرب، أن يفسد أية فرصة في المستقبل للوصول إلى تسوية سلمية. ونتلمس اتجاهات مماثلة، ولكن إلى حد أقل، في العراق، وليبيا واليمن، كما نلمح آثارها على البلدان المجاورة. وقد غدت مدن تونس الحدودية، على سبيل المثال، متورطة بصورة وثيقة في اقتصاد ليبيا المرتبط بالحرب.
مع ارتفاع حدّة الصراع، قد يتواصل تدفق السكان النازحين على جانبي الحدود في البلدان العربية، دخولاً وخروجاً. وسيولّد هذا التوسع تحوّلات أكثر إثارة في النسيج الاجتماعي والنظرة الاقتصادية للمنطقة. وعودة هذه الأعداد الضخمة من اللاجئين ستعتمد، إلى حد بعيد، على شكل تسويات السلام التي ستضع حدّاً للنزاعات الحالية، وعلى قدرتها على ضمان السلامة والأمن لمن استطاع أن ينجو من أهوالها. وسيسهم توفير بنية تحتية نشطة اقتصادياً وموجّهة نحو قطاع الخدمات، وأوضاع إعادة الإعمار، واحتمال مشاركتهم في حكم أنفسهم بأنفسهم، في تسهيل عودة اللاجئين إلى أوطانهم بصورة آمنة.
الاستقطاب
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
يساهم التكوين الاجتماعي للسكان في نشوء الاستقطاب الاجتماعي وتراكبه. وفيما يبدو الاستقطاب ظاهرة عالمية، يمكن القول إنه ليس في العالم منذ العام 2011 منطقة مجزأة ومبعثرة كالشرق الأوسط. ومع أن التفاصيل المحددة تختلف من بلد إلى آخر، فإن الفضاءات المتاحة للأصوات المعتدلة انحسرت بصورة عامة. وقد مكّن إغلاق الزعماء العرب للفضاء العام وتجنّب أصوات الانشقاق الجانبية من تكريس ممارسات النظم الحاكمة السلطوية، وأجهزة المحسوبية والمحاباة والاستدراج، وفاقم الضعف العام الذي تشكو منه تيارات المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، والفضاءات العامة ذات الطبيعة المنقسمة على ذاتها إيديولوجياً. ونتيجةً لذلك، لم يبق للفاعلين السياسيين والمواطنين على السواء سوى مجال ضيّق لإجراء التفاهمات والمصالحات، واضطر هؤلاء إلى الاختيار بين دعم الحكومة أو معارضتها أو الذهاب إلى نقطة أكثر خطراً، وهي تبنّي أو رفض قبول هُويّة طائفية أو إثنية أو قبلية محدّدة.
ومع أن التفاصيل المحددة تختلف من بلد إلى آخر، فإن الفضاءات المتاحة للأصوات المعتدلة انحسرت بصورة عامة [منذ العام 2011].
يمكن تقسيم الاستقطاب في المجتمعات العربية إلى فئتين عريضتين. الأولى إيديولوجية تتجلى في القوى الدينية والعَلمانية، وتتمثّل في التجارب المختلفة التي تعرضت إليها مصر وتونس بعد العام 2011. ففي مصر، حاولت القلة الأوتوقراطية العسكرية إقناع الجماهير بقبول الاستقرار والأمن عوضاً عن التعددية السياسية والحريات الشخصية. غير أن الإجراءات القمعية، مثل الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان، وسن قوانين جريئة بطريقة غير ديمقراطية، ومنح المؤسسات الدينية والعسكرية صلاحيات لا رقيب عليها، ضاعفت من الانقسامات الاجتماعية الطويلة العهد وأفضت إلى المزيد من العنف.
في المقابل، وعلى الرغم من أن الانتفاضة الشعبية التونسية لم تُترجم تماماً إلى ثقة جماهيرية بالمؤسسات السياسية، فقد حققت البلاد نجاحاً مهمّاً في خلق الإطار اللازم لوضع نظام دستوري جديد يوحّد بين القوى العلمانية والدينية ويؤمن للمواطنين النفاذ إلى فضاء عام مليء بالحيوية يمكن فيه النظر إلى التظلّمات الاقتصادية، والتوترات الاجتماعية، وقضايا الهوية، والأهداف السياسية. وستُظهر الأيام ما إذا كان من المستطاع تعميق مأسسة روح المصالحة النادرة الي أبدتها النخبة السياسية التونسية خلال الفترة الانتقالية بعد العام 2011، أم أن تزايد الخوف من الإرهاب والعنف السياسي، والغوغائية الإيديولوجية قد حقنتا جرعة من العوامل المدمّرة في السياسة التونسية.
أما الفئة الثانية الأكثر عنفاً فتتمثل في الاستقطاب السياسي، الذي صاحب الاضطراب السياسي في المُجتمعات المُنقسمة إثنياً أو دينياً. ويمكن استغلال هذا الاستقطاب، بوصفه أداة سياسية مؤثرة، لتوفير كبش فداء، أو مَشجب تُعلَّق عليه السقطات الاقتصادية الاجتماعية، وتؤلّب عليه القواعد الشعبية الأساسية. وفي بلدان مثل العراق وسورية، تمّ في بعض الأحيان ضخّ جرعات من التطرُّف في الخطاب التحزّبي لدرجة إضفاء الشرعية على العنف السياسي أو المذهبي، ما شكّل أرضاً خصبة للتطرّف والإرهاب. وقد تباينت النتائج بين تصاعد وتائر التوتر الطائفي في البحرين ولبنان، وبين نشوب حروب أهلية وانهيار الدولة في العراق وسورية.
ففي العراق، أسفرت السياسات الطائفية عن بروز فراغ أهلي وخلل في السياق الاجتماعي الذي كان يفضي إلى العنف والإرهاب. وقد أدت النزاعات المستمرة للاستحواذ على الموارد الاقتصادية والتمثيل السياسي بين المجتمعات الكردية، والشيعية، والسنّية إلى خلق ملاذات آمنة لتنظيم الدولة الإسلامية، ودفعت جماعات اجتماعية أخرى تسعى إلى استغلال الانقسامات الطائفية، ومنها قوات الحشد الشعبي، إلى تبنّي استراتيجيات عنيفة مماثلة.
أما في سورية، أسفر نظام المحسوبية القائم على أساس طائفي، وطبيعة نظام بشار الأسد القمعي، عن انعدام الثقة الشعبية تقريباً بمؤسسات الدولة وحيادها. فقد انهارت فكرة وجود هوية وطنية سورية ومعها مفاهيم المواطنة الحديثة القائمة على المساواة في الحقوق والاستحقاقات للسوريين كافة. وقد أدّى تدمير النسيج الاجتماعي للبلاد والشرذمة الظاهرة في ما كان دولة سورية موحّدة، إلى توليد واقع جديد يضم إقطاعيات قامت على أنقاضها.
أما البحرين فهي اليوم أهدأ مما كانت عليه في العام 2011، عندما تظاهر عشرات آلاف المواطنين (وهو عدد ضخم في بلد يضم 1.3 مليون نسمة)،41 قبل أن تتصدّى لهم وتقمعهم قوى الأمن، بدعم قوي من المملكة العربية السعودية وبلدان الخليج الأخرى. بيد أن الفجوة لازالت آخذة بالاتساع بين الأقلية السّنية الحاكمة والأغلبية الشيعية المحرومة، ويبدو أن استقرار البحرين المعهود منذ أمد بعيد بدأت تظلله الشكوك إلى حد ما. وفي لبنان، غالباً ما يحتدم الصراع بين جماعات طائفية أو بين ممثليها السياسيين تحديداً، حول توزيع الموارد المحدودة والانتماءات الإقليمية المتنافسة. وأدّى الاستقطاب الناجم عن ذلك إلى إضعاف مؤسسات الدولة، وولّد الشك السياسي، ووسّع الفجوة بين السكان اللبنانيين والطبقة السياسية التي تحكمهم.
ومع قلة المداخل المؤدية إلى التعبير السياسي، تفسح أنظمة الحكم الاستقطابية المجال أمام هيمنة الأصوات الرافضة، ويصبح الخطاب السياسي المتطرّف مدخلاً محتملاً إلى تجذّر التطرف الديني.
ومع قلة المداخل المؤدية إلى التعبير السياسي، تفسح أنظمة الحكم الاستقطابية المجال أمام هيمنة الأصوات الرافضة، ويصبح الخطاب السياسي المتطرّف مدخلاً محتملاً إلى تجذّر التطرف الديني. وما لم تعتبر عمليات الانتقال الديمقراطي عقوداً اجتماعية جديدة مبرمة بين المؤسسات الحاكمة والمواطنين للتغلب على التظلّمات الاقتصادية ونواحي العجز في منهج الحكم، فإن التطرّف والإرهاب قد يصبحان أكثر استهواء للجماعات المهمشة والمحرومة.
دراسة حالة 1
فلسطين – فُرقةٌ فسقوط
أدّت عشر سنوات من الاستقطاب الاجتماعي والسياسي في فلسطين، إلى تآكل تدريجي في المؤسسات الحاكمة وإلى تقويض المطامح الوطنية.
يُعتقد على نطاق واسع الآن أن عملية التفاوض بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية قد انتهت. فالسلطة الفلسطينية – التي أُقيمت في العام 1994 كهيئة مؤقتة لمدة خمس سنوات للإشراف الإداري (مع دور في ضمان الأمن الداخلي) بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة – قد فات موعدها قبل سبعة عشر عاماً، كما أنها جُرّدت من كل هدف.
وبدلاً من أن تتطور الأوضاع السياسية إلى كيان دولة، أُصيبت بالخمود. وتجهد السلطة الفلسطينية لتوفير الخدمات العامة للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة. ولايزال التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل قوياً، غير أنه يثير الاستياء الشديد؛ كما أن الانشقاق بين السلطة الفلسطينية التي تسيطر عليها "فتح"ٍ في الضفة الغربية وبين غزة التي تسيطر "حماس" على الحكم فيها، حرم الفلسطينيين من وجود قيادة موحّدة: وما فتئت القيود التي تفرضها إسرائيل على الحركة إلى داخل الضفة الغربية وفي أرجائها، تعيق التنمية الاقتصادية والضبط الإداري، وتواصل إسرائيل ومصر فرض قيود قاسية وشبه كاملة على حركة البضائع والناس، داخل غزة وخارجها.
غير أن هذا الخمود، في غمرة المحاولات المتكررة من جانب الولايات المتحدة لإحياء مسيرة المفاوضات التي تبدو أقرب إلى الموت منها إلى الحياة، حَجَبَ عن العيان حالة من التدهور السياسي التدريجي في مجتمع بلغ درجة عالية من الاستقطاب. ومع أن الفلسطينيين تجنبوا انهيار السلطة السياسية المركزية، على نحو ما حدث في سورية واليمن، فإن التطلعات الوطنية الفلسطينية تضرّرت أيّما ضرر، كما أن احتمالات قيام كيان دولة حقيقية آخذة، على ما يبدو، بالانحسار.
يشمل الاستقطاب السياسي في فلسطين، ويتقاطع مع، أبعاد عدة. فقد تعمّقت الفجوة بين الكيانات السياسية في غزة والضفة الغربية. وعلى الرغم من تكرار المفاوضات لإعادة توحيد نصفَيْ فلسطين، لم يُظهر أيٌّ من الطرفين، وهما قيادة حماس في غزة وقيادة فتح في رام الله، أي حماسة حقيقية للمصالحة، بل يستخدم كلٌّ منهما الانشقاق كأداة دعائية لتعزيز موقفه وتسفيه الطرف المنافس. ومن المهم أن نلاحظ كذلك أن الحصار المُحكم الذي فرضته إسرائيل على غزة منذ انتفاضة الأقصى في العام 2001 سيبلغ عمره قريباً نصف عمر السكان المقيمين في المنطقة، أي أن الروابط الإنسانية بين غزة والضفة الغربية بدأت بالضمور.
الإزاحات الجغرافية في المجتمع الفلسطيني لاتقل عمقاً عن ذلك. فقد توزّع الفلسطينيون بين من يقيمون في القدس تحت مظلة الحكم الإسرائيلي (بحكم حقوق الإقامة على العموم وليس الجنسية)، ومن هم في إسرائيل قبل العام 1967 (وهم مواطنون يتعرّضون إلى الاغتراب المطّرد في دولة يهودية)، ومن يعيشون في الشتات، وتتراوح معاملة الحكومات العربية لهم بين الإهمال والارتياب. وقد ترسّخت هذه الانقسامات وأفضت إلى تبنّي وجهات نظر وبروز مصالح مختلفة. كما أن الاتصالات الاجتماعية والاقتصادية بين هذه الشرائح السكانية المتباينة تراخت لانشغال كل منها بأعبائها الخاصة.
في تلك الأثناء، لم تنحسر كينونة الدولة الفلسطينية بالمعنى المؤسسي وحسب، بل هي آخذة بالانسحاب كذلك من الأجندة السياسية الفلسطينية. ذلك أن الجيل الذي أقام منظومة من المؤسسات الوطنية – مثل منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية، والحركات السياسية، والنقابات والأجهزة البيروقراطية – بدأ بمغادرة مسرح الأحداث. ولايبدو أن رؤيته السياسية قابلة للحياة أو مهمة بالنسبة إلى الفلسطينيين الشباب الذين لايعتقدون أن من الممكن التوصل إلى تسوية شاملة مع إسرائيل. فقد وُلِد أكثر من 20 في المئة من الفلسطينيين بعد اندلاع انتفاضة الأقصى العام 2000، كما وُلِد 10 في المئة منهم في وقت متأخر ولا يتذكّرون ماجرى قبل ذلك التاريخ. وتختلف المواقف السياسية في أوساط الجيل الأكثر شباباً اختلافاً بيّناً عن مواقف أقرانهم الأكبر سنّاً، حيث يطالب واحد من كل ثلاثة من الفلسطينيين بحل السلطة الفلسطينية، ويرى واحد من كل سبعة منهم بأن انتفاضة مسلّحة ستساعد الفلسطينيين على نيل حقوقهم الوطنية.1
يُمثّل الاستقطاب الفلسطيني سبباً وحصيلة في آن. فقد ظلّ الأمن الخارجي وجوانب مهمة من الأمن الداخلي في الضفة الغربية بيد الإسرائيليين. كما أن المؤسسات السياسية التي أُقيمت في تسعينيات القرن العشرين تُشكّل الأسس الديمقراطية اللازمة لدولة فلسطينية مستقلة، قد انهارت بشكل واضح، وأخلت السبيل للفصائل الفلسطينية لتتمسك بما تستطيع السيطرة عليه، بدلاً من أن يتعامل بعضها مع بعض. ولم تجرِ انتخابات السلطة الوطنية لمنصب الرئيس وللبرلمان إلا في العام 1996 ثم في العام 2005 (للرئاسة) والعام 2006 (للبرلمان). ومن المستبعد أن تجري الانتخابات الوطنية في وقت قريب. أما التفويض الذي مُنِح للرئيس الفلسطيني محمود عباس عن طريق الانتخاب فقد انتهى منذ ثماني سنوات، لكن عجزه عن التصدي للتوسّع في بناء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية أدى إلى تآكل شرعيته السياسية ومكانته الشعبية الشخصية بشكل لالبس فيه. وإذا ما خلا منصب الرئاسة، فقد يتم إشغاله باتخاذ خطوة مرتجلة تنتقص من شرعية شاغل المنصب، ماسيجعل الوضع أبعد مايكون عن الوحدة الوطنية.
بالمثل، غدا الارتجال هو الصفة المُميّزة للعملية التشريعية بإصدار سلسلة من المراسيم عبر إجراءات ملتبسة من جانب عباس في الضفة الغربية، وفي غزة من جانب برلمان ميّت مجرّد من روح المبادرة والمساندة الشعبية. وتبدي المحاكم مؤشرات واضحة على خضوعها إلى السلطة التنفيذية في كلتا المنطقتين الفلسطينيتين. أما الانتخابات البلدية التي كان من المتوقّع إجراؤها في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2016، فقد أُرجئت بسبب تعذّر التنسيق إلى أجل غير مسمى، لأن الأجهزة القضائية المتناحرة في الضفة الغربية وغزة حالت دون ذلك. وتواجه منظمة التحرير الفلسطينية، التي لاتزال تمثّل الفلسطينيين والمصالح الفلسطينية في العالم، حالة من التفسّخ المؤسسي، إذ تحولت إلى مجموعة من الهيئات التي يديرها مكتب عباس (لأن رئيس السلطة الفلسطينية هو رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية كذلك). وفي مثل هذه الظروف، لم يكن من المستغرب أن تبلغ حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية هذا المستوى الحاد من الفساد.
تُرى، كيف لجهاز سياسي مُنقسم على نفسه ومختلّ وظيفيا أن يستمر؟
مع أن فلسطين تفتقر إلى الموارد الهيدروكربونية المهمة الموجودة في كثير من البلدان العربية، يُظهر الاقتصاد السياسي الفلسطيني أعراضاً مميّزة لنزعة ريعية تسهم في زيادة الاستقطاب الاقتصادي. ومن المؤسف أن الأسرة الدولية المانحة قد فاقمت، بصورة غير متعمّدة، هذه النزعات في كل خطوة تقريباً من عملية أوسلو على مدى عقدين من الزمن. فقد تلقّت السلطة الفلسطينية منذ قيامها سبعة عشر مليار دولار على هيئة مساعدات أجنبية.2 كما من الملاحَظ أن بروتوكول باريس حول العلاقات الاقتصادية، الموقَّع في العام 1994، خلق سلسلة من الاحتكارات على واردات السلطة الفلسطينية التي تولّد موارد ريعية ضخمة، مثلما تفسح المجال للفساد.
ومنذ تقسيم فلسطين إلى جزئين: الضفة الغربية و قطاع غزة، أدّت القيود الإسرائيلية إلى إفراغ اقتصاد غزة وتجويفه: 80 في المئة من السكان يعتمدون، جزئيا على الأقل، على المعونات. ويعاني من البطالة نحو 41 في المئة من الرجال و61 في المئة من النساء.3 وتبلغ رواتب القطاع العام في الضفة الغربية ملياراً وتسعمئة مليون دولار، أي خمسين في المئة من نفقات الحكومة.4 وبالطبع، النزعة الريعية ليست من الشروط الضرورية لقيام الدول الأكثر ثراء في المنطقة.
من هنا، فإن النسق السياسي الفلسطيني، الذي يُظهر الكثير من الميول المؤسفة التي تتجلّى في بلدان عربية أخرى، قد فقد وحدته وأهدافه، كما بدأ يفقد الدعم الدولي.
ومع أن فلسطين لم تستطع أن تؤسس كيان الدولة إلا بصورة إسمية، فإن الروح الوطنية الفلسطينية أظهرت قدراً كبيراً من المرونة والصمود في مواجهة الكثير من النكسات والعراقيل التي تعرضت إليها. وربما سيخضع هذا الصمود للمزيد من الاختبارات في السنوات المُقبلة.
1 Survey Research Unit, “Palestinian Public Opinion Poll No. 58,” Palestinian Center for Policy and Survey, December 14, 2015, http://www.pcpsr.org/sites/default/files/poll%2058%20full%20English.pdf.
2 "د. اشتية: 17 مليار دولار حجم المساعدات التي وصلت الى السلطة الوطنية منذ عام 1993"، سوات فلسطين، 20 حزيران/يونيو 2016، http://www.swot.ps/atemplate.php?id=1561.
3 “UNRWA: Unemployment in Gaza Is the Highest in the World,” Palestine Chronicle, August 9, 2016, http://www.palestinechronicle.com/unrwa-unemployment-gaza-highest-world/.
4 International Bank for Reconstruction and Development, “Public Expenditure Review of the Palestinian Authority: Towards Enhanced Public Finance Management and Improved Fiscal Sustainability,” World Bank, September 2016, http://documents.worldbank.org/curated/en/320891473688227759/pdf/ACS18454-REVISED-FINAL-PER-SEPTEMBER-2016-FOR-PUBLIC-DISCLOSURE-PDF.pdf.
الحراك الاجتماعي
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
لم يستطع المواطنون العرب، منذ عقود، النفاذ إلى عمليات صنع القرار العام، والفضاءات السياسية الرسمية، وآليات الكشف الفعال عن نواحي القصور في العمل الحكومي. ومع ذلك، لم يقف المواطنون موقف المتفرج السلبي من التطورات التي تمس بلدانهم، واستخدموا الأنشطة السلمية للتعبير عن همومهم. والواقع أن المواطنين الشباب وجماعات من نشطاء المجتمع المدني والحركات العمالية كانوا يتصدرون حركات الاحتجاج السلمية المعارضة لاستمرار الوضع القائم، والتي بلغت ذروتها في الانتفاضات العربية العام 2011. كما شدّدوا على المطالبة بتحسين الأحوال المعيشية المتدهورة ومحاربة الفساد والمحسوبية، وإلزام الحكومة باحترام حقوق الإنسان.
لم يقف المواطنون [العرب] موقف المتفرج السلبي من التطورات التي تمس بلدانهم، واستخدموا الأنشطة السلمية للتعبير عن همومهم.
كانت الاحتجاجات واسعة الانتشار قبل العام 2011. فقد كانت من تشكيلة الأدوات التي استخدمها الناشطون الشباب للتنديد بما مُنيت به حكومتهم من إخفاقات. وكانت التظاهرات الاحتجاجية التي تتمحور حول المطالب السياسية أقل تواتراً، غير أنها كانت تحدث في جميع الحالات، مؤذنةً بولادة نوع جديد من الحراك والمشاركة الجماهيريّين. وحرص الناشطون الشباب والأكثر رسوخاً في المجتمع المدني وفي الأوساط العمالية، والروابط المهنية، والجماعات الطلابية على تجاوز الفجوة الدينية والعلمانية وانضموا إلى هؤلاء ليؤسسوا شبكات غير رسمية للاحتجاج. وقد قطعوا صلتهم بالسياسات الرسمية، داخل النظام والمعارضة على السواء، وكرّسوا طاقاتهم للعمل من خلال الجمعيات والمنتديات العربية واستخدام الاحتجاجات السلمية وتكنولوجيا الاتصالات. وشملت هذه الفئات: "حركة شباب 6 أبريل"، حركة "كفاية"، و"الحركة المصرية من أجل التغيير"؛ والحملة الوطنية للدفاع عن حقوق الطلاب واتحاد الطلبة الديمقراطيين في الأردن؛ و"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين" (Diplômés Chômeurs) في المغرب؛ ومجموعة "السياج الخامس" (Fifth Fence) في الكويت؛ و"جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان".
لعبت الانتفاضة المصرية الدور الأبرز في تبيان أهمية الحراك الجديد في أوساط المواطنين العرب. فقد استلهمت دعوة المصريين للاشتراك في الاحتجاج السلمي في 25 كانون الثاني/يناير 2011، الأحداث التي وقعت في تونس، وتداعت لنصرتها شبكات الاحتجاج غير الرسمية. ومع أن أكثر تيارات المعارضة السياسية الرئيسة رفضت المشاركة أول الأمر، إلا أن الناشطين الشباب تمكّنوا تدريجياً من حشد شرائح سكانية للانخراط في حركات الاحتجاج السلمية.42
فيما شكّلت استقالة الرئيس السابق حسني مبارك في شباط/فبراير 2011 ذروة نجاح الحراك الاجتماعي العربي، ووجِهت الانتفاضات الشعبية ضد الأنظمة الدكتاتورية في دول أخرى بقوة وحشية، كما في ليبيا وسورية. فقد تبدّد زخم الاحتجاجات، واستعادت قوى الأمن قدراتها في مختلف أرجاء المنطقة. وسيُصار لاحقاً إلى حل القضايا المتصلة بالاضطرابات.
وعلى الرغم من الاختلاف والتناقض بين الاتجاهات التي اتخذتها البلدان العربية بعد الانتفاضات الديمقراطية في العام 2011، لايزال الحراك الاجتماعي يرسم معالم الوقائع على الأرض. ففي تونس، دخل الشباب التونسيون حلبة النشاط السياسي النظامي وحافظوا على حضورهم القوي في الفضاءات غير النظامية وفي ساحات الاحتجاج على حدٍّ سواء، يدفعهم إلى ذلك، أساساً، الإحساس بالإحباط الاقتصادي والسياسي.43
وفي البلدان التي استنفذ الصراع طاقاتها، تركّز منظمات المجتمع المدني اليوم على إيجاد ملاذات آمنة لضمان بقاءها على قيد الحياة. ومع استمرار القمع الوحشي، سيكون من الصعب على السكان العرب المشاركة في أية مناقشات مفيدة أو ذات دلالة حول العناصر الرئيسية في عقود اجتماعية جديدة. ففي مصر، قامت الحكومة التي تخضع لإمرة العسكريين بتضييق الخناق على التعددية السياسية، وفرضت قيوداً مشدّدة على منظمات المجتمع المدني.44 غير أن ذلك لم يحل دون مواصلة الشباب المصريين المشاركة في فضاءات الاحتجاج غير النظامية، كما لم يؤثر على الطابع متعدّد الإيديولوجيات لحراك المواطنين الاجتماعي. وهكذا تابعت شبكات التواصل غير النظامية تجسير الفجوة الدينية العلمانية، ولجأت إما إلى توسيع أدوارها في فضاءات عامة جديدة كالمجالات الفنية45 أو الأدبية، أو أعادت اكتشاف معاقلها التقليدية في الجامعات والمدارس الثانوية.46 لازالت شبكات منتجي الأفلام السينمائية، والروائيين، والطلاب الجامعيين هي التي تشكّل السرديات التي لاتقتصر على المطالبة بإصلاحات ديمقراطية جذرية وحسب، بل تدعو كذلك إلى بلورة رؤية لمصر المستقبل العلمانية الحديثة.
وفي سورية واليمن، استمرت مبادرات المواطنين في هذا الميدان، على الرغم من الحروب الأهلية الوحشية، واستأنفت المنظمات المحلية غير الحكومية وجماعات الناشطين في الإعراب عن الاحتجاج الشعبي، وسهّلت تقديم المساعدات الإنسانية للسكان الذين حاصرتهم الحرب.47
وعلى الرغم مما تتّسم به القوى الرافضة للوضع الراهن من مرونة وقدرة على التكيّف، إلا أن قوى الأمر الواقع قد استعادت الزخم القديم. ذلك أن الرغبة في الاستقرار وغلبة التيار المعاكس للنشاط الديني السياسي في مصر، ناهيك عن الفوضى في سورية واليمن، دفعا شرائح مهمة من السكان العرب إلى تبني موقف الأنظمة الأوتوقراطية التي تعارض المطالبة بالتغيير. وكان من نتائج الرعب الذي هيمن على البلدان التي اندلعت فيها تلك الحروب إقناع الكثير من العرب بالحاجة الماسّة إلى الاستقرار. وقد استغل الحكام هذا الشعور فانبروا للدفاع عن الأوضاع الراهنة باعتبارها الأسلوب الوحيد لتحاشي البلبلة والفوضى.
غير أن الفاعلين المدنيين يواصلون المشاركة باستخدام مختلف المنتجات التكنولوجية الحديثة ووسائل الإعلام الاجتماعي، حتى في هذه الأوضاع العصيبة. وحتى بعد إغلاق منافذ الإصلاح السياسي، تعاظمت أهمية الدفاع عن الحريات الشخصية عبر إطلاق حملات مطلبية ومبادرات من جانب المواطنين. وما زالت الفرص المتاحة لتحقيق التقدّم مجديةً ومجزية في مجالات عدّة من بينها، على سبيل المثال، النضال لتمكين النساء، وتحسين الأوضاع في مواقع العمل، وتحديث المناهج التعليمية، وتشجيع المساءلة المالية.
وفي حين أن القوى المساندة للوضع الراهن أصبحت لها اليد العليا، على ما يبدو، في أغلب البلدان العربية، من المستبعد أن يستكين المواطنون العرب لهذا الوضع، فيما تتصاعد الضغوط الاقتصادية الاجتماعية وتتحجم المعونات الاجتماعية خلال السنوات المقبلة. وهم لا يتوقّعون من الحكومات، والمؤسسات الحاكمة، ومؤسسات الدولة، أن تؤمن لهم احتياجاتهم الأساسية، أو أن تنقذ المجتمعات من أزماتها المستمرة. ومن هنا، سيلجأ المواطنون باطّراد إلى الحراك الاجتماعي، ولو بأشكال مختلفة عن تلك التي ارتبطت بالربيع العربي، للتأثير في مصير بلدانهم.
دراسة حالة 2
تونس – حفّاز على التغيير
لم يكن الحراك الاجتماعي التونسي وحسب إحدى خصائص الانتفاضات العربية عام 2011؛ فقد لعب كذلك دوراً إيجابياً في إقامة المؤسسات الديمقراطية منذ ذلك الحين.
تعاني تونس كثيراً من الأمراض التي تعانيها بلدان عربية أخرى: الحوكمة الفاسدة، والفساد، والظلم، وبطالة الشباب، والتطرّف. غير أن نظام تونس الديمقراطي الوليد، والعقد الاجتماعي الجديد، والمجتمع المدني الذي أعيد إحياؤه، توفّر كلها أدوات غير موجودة في بلدان عربية أخرى، مع أنها لا تقدّم حلولاً سحرية لجميع المشاكل.
في السنوات التي أعقبت الانتفاضة الشعبية المثيرة في كانون الأول/ديسمبر 2010، حقّق التونسيون تقدّماً مشهوداً في بلوغ إجماع ناظم جديد، في أجواء حيوية مُفعمة بروح الحراك الاجتماعي لمرحلة ما بعد الثورة. وعلى الرغم من الاختلافات الأساسية بين القوى العلمانية والدينية في تونس، استطاع التونسيون الاتفاق على دستور يؤمّن موقعاً لجميع الفئات في المجتمع – مع دعم التداول السلمي للسلطة، ومنح كامل الحقوق للمرأة، وضمان حماية حرية الرأي والتعبير والمعتقد. وتمثّل تونس نموذجاً فريداً للمصالحة والتداول السلمي للسلطة في المنطقة.
غير أن النضال السياسي يتواصل، مع أن كثيرين يُعربون عن القلق من أن إدارة الرئيس الباجي قائد السبسي، الذي بلغ التسعين، استعادت بعض السمات التي كانت خصيصة لنظام زين العابدين بن علي. ويتعيّن على النظام السياسي الجديد أن يفي بالوعد الذي قطعه على نفسه بإيجاد الحلول لمشاكل تونس الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. من بين الأولويات العاجلة وضع رؤية اقتصادية للبلاد، والتصدي للفساد المتواصل، وتنمية القدرة على اتخاذ القرار على الصعيد المحلّي.
وفي حين لم تعد تهيمن على مقدرات تونس أسرة حاكمة تُصرّ على احتكار ثروة البلاد، لاتزال القوانين والسياسات الرامية إلى ديمومة لعبة اقتصادية مُغلقة، هي والفساد، تنهش البنية الاقتصادية. كذلك، وعلى الرغم من التحوّلات السياسية المثيرة في تونس، انخفض الترتيب على مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من 43 (من مئة، أي "نظيف جدّاً") في العام 2010، إلى 38 في العام 2015.1
لقد كافح التونسيون للبدء بالإصلاحات الاقتصادية عن طريق ردم الفجوات القائمة بين المصالح المتضاربة التي يمثّلها جهاز إداري بيروقراطي ضخم، وبين تنظيم نقابي عمالي (هو الاتحاد العام التونسي للشغل)، وأصحاب الأعمال التجارية المرتبطون بالنظام القديم، والمبادرون الرياديون الشباب، والشباب المتعطّلون المطالبون بوظائف في القطاع العام.
القضايا الأصعب حلّاً هي المشاكل التي دفعت محمد البوعزيزي إلى التضحية بنفسه على هذا النحو المهيب في كانون الأول/ديسمبر 2010، حين انطلقت شرارة الانتفاضة التونسية: وهي تشمل التهميش الاقتصادي لسكان الأرياف، واعتمادهم على الاقتصاد غير النظامي الذي يشمل التهريب وبيع التجوّل، وتعرضهم إلى الابتزاز والمضايقة من جانب المسؤولين المحليين. ويعترف المسؤولون بالحاجة إلى تنمية الأحياء الداخلية الفقيرة في المناطق الحضرية، لكن لم يُنجَز في هذا المجال إلا القليل.2
أما توفير الخدمات في المناطق الساحلية والداخلية فيختلف اختلافا بيّناً، وقد أدى ذلك إلى استقطاب التونسيين – أي من يقيمون في المناطق التي تتمتع بالامتيازات وتتوفّر فيها العمالة الرسمية أو التوظيف في القطاع العام، مقابل المقيمين في المناطق المهمّشة الأقل انتفاعاً من فرص الاستخدام النظامي والخدمات الحكومية.3 ولم يؤدِّ هذا الإجحاف الاقتصادي الاجتماعي إلى تعاظم الاحتجاج السياسي وحسب، بل أسفر كذلك عن مفاقمة نزعات التطرف العنيفة.
يعود جزء من أسباب التباطؤ في تنمية الاقتصاد والحوكمة خارج المناطق الساحلية إلى التأجيل المتكرّر لبدء الإجراءات الرامية إلى استحداث اللامركزية، حيث إن ذلك يستوجب تحويل صلاحية اتخاذ القرار والإشراف على المخصصات المالية من المركز إلى المناطق المحلية. ولايزال تعيين المسؤولين المحليين يتم بقرار من الحكومة المركزية، وليس في متناولهم غير الموارد الشحيحة، إلا إذا استطاعوا اجتذاب معونات أجنبية.4 كان من المقرر إجراء انتخابات محلية للمرة الأولى في العام 2016، غير أنها أُرجئت أكثر من مرة لأن غالبية الأحزاب السياسية لاتزال تشعر بأنها عاجزة عن التعبئة الشعبية في جميع أرجاء البلاد.
كما أن تونس معرَّضة إلى المخاطر الوافدة من الجارة ليبيا. فقد كان للتونسيين الذين دبّروا في العام 2015 الهجمات الإرهابية الثلاث التي ألحقت أبلغ الضرر بقطاع السياحة في تونس روابط مع معسكرات للتدريب في ليبيا، بل إن المسلحين الليبيين من تنظيم الدولة الإسلامية حاولوا السيطرة على بلدة بنقردان الحدودية التونسية في آذار/مارس 2016.5 ومع ذلك، يشكّ الليبيون أنفسهم بأن الحركات الجهادية التونسية قد أسهمت في إفشال الدولة في ليبيا.
على الرغم من هذه المشاكل، تتمتع تونس بأصول ومصادر قوة عدّة مهمة. فقد كان التونسيون في وضع ممتاز للاستفادة، جزئياً على الأقل، من الانفراج السياسي في العام 2011، جرّاء استثمار الدولة التاريخي الكبير في التنمية البشرية، مقارنةً مع البلدان العربية الأخرى والأفريقية.6 ويصدق ذلك بصورة خاصة على نواحي التعليم وتمكين المرأة، وهي المجالات التي تمتّعت باهتمام خاص خلال حكم الرئيس السابق الحبيب بورقيبة الذي استمر ثلاثين سنة، قبل الإطاحة به في العام 1987.7 ومع أن بورقيبة وخليفته بن علي لم يكونا ديمقراطيين بأي حال من الأحوال، فإنهما سمحا بتنمية رأس المال البشري، بل سانداه إلى حد ما، الأمر الذي أسفر عن توليد حراك اجتماعي مهم. وقبل العام 2011، كان التونسيون قد أقاموا مؤسسات مستقلة على نحو ما عن الحكومة، مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، ونقابة المحامين، وجمعيات المجتمع المدني، بما فيها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي أصبحت في العام 1976 الأولى من نوعها في الدول العربية.
منذ الثورة التونسية، تنامت وازدهرت الحريات، مثل حرية الرأي والتعبير، وحرية التجمّع، وحرية التنظيم السياسي، وأسفر ذلك عن تأسيس منظمات مجتمع مدني جديدة وقوية، وانتعاش منظمات قديمة، ما يؤكد الطابع التعددي الديناميكيّ للمشهد السياسي في البلاد. وكان المثال الأكثر إثارة على دور المجتمع المدني، هو التوصل في العام 2013 إلى التسوية والمصالحة التي أنقذت الانتقال الديمقراطي الوليد في البلاد، واستحقت بعض منظمات المجتمع المدني التونسية على أساسها جائزة نوبل للسلام في العام 2015.8
كما تقوم منظمات المجتمع المدني تلك بتوليد أفكار سياسية تضيّق الفجوات بين المواقف الاجتماعية والسياسة، وتؤكد على أهمية الشفافية في أنشطة الحياة اليومية التي لاتلقى الاهتمام الكافي على الصعيد العملي. وبصورة عامة، يتجاوب المشرّعون المُنتخبون وبعض الوزراء المعنيين مع مداخلات تلك المنظمات، وهو وضع يختلف كل الاختلاف عما كان سائدا من قبل. ويعود ذلك، في جانب منه، إلى أن كثيراً من هؤلاء المسؤولين أتوا من منظمات المجتمع المدني نفسها أو أنهم، على الأقل، يثمّنون ما يمكن أن تقدّمه من مساهمات. وقد تضافرت زيادة قدرات المجتمع المدني مع ظهور أوجه جديدة لمساهمته في اتخاذ القرارات الحكومية، وتنمية الآليات الخاصة بالمحاسبة والمساءلة أمام المواطنين، وشقّت كلّها دروباً مُمكنة قد تسلكها تونس لمواجهة التحديات في مجالات الاقتصاد والحوكمة.
1 Transparency International, Corruption Perceptions Index 2015, February 1, 2016, https://www.transparency.org/cpi2015/%20-%20results-table; and Transparency International, Corruption Perceptions Index 2010, http://files.transparency.org/content/download/132/531/2010_CPI_EN.pdf.
2 Amy Hawthorne, “POMED Backgrounder: A Trip to Tunisia’s Dark Regions,” POMED, December 2015, http://pomed.org/pomed-publications/backgrounder-a-trip-report-from-tunisias-dark-regions/.
3 Hernando de Soto, “The Verdict Is In: The Arab Spring Is a Massive Economic Revolution,” February 9, 2013, http://ild.org.pe/images/books/facts_in/2013_02_09_TheFactsAreInTheArabSpringIsAMassiveEconmicRevolution.pdf.
4 Fadil Aliriza, “Crisis of Governance: Local Edition,” Foreign Policy, August 9, 2016, http://oreignpolicy.com/2016/08/09/crisis-of-governance-local-edition/.
5 Haim Malka and Margot Balboni, “Libya: Tunisia’s Jihadi Nightmare,” CSIS, June 2016, http://foreignfighters.csis.org/tunisia/libya.html.
6 Tunisia’s Human Development Index rating as of 2015 was one of the highest among the non-oil exporting Arab countries, similar to that of Lebanon and Jordan and significantly higher than that of Morocco or Egypt. See United Nations Development Program, Human Development Report 2015 (New York: United Nations, 2015), http://hdr.undp.org/sites/default/files/2015_human_development_report.pdf.
7 Eric Pace, “Habib Bourguiba, Independence Champion and President of Tunisia, Dies at 96,” New York Times, April 7, 2000, http://www.nytimes.com/2000/04/07/world/habib-bourguiba-independence-champion-and-president-of-tunisia-dies-at-96.html.
8 Norwegian Nobel Committee, “The Nobel Peace Prize for 2015,” press release, Nobelprize.org, October 10, 2015, https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/peace/laureates/2015/press.html.
مقالثقافة التعاون والمصالحة في تونس
راشد الغنوشي
ما زالت تونس التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي تناضل ضد الطغيان والقمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعود ذلك إلى حد كبير إلى ثقافة التعاون والمصالحة بين الأحزاب الإسلامية والعَلْمانية التي بُنيت وطُوِّرت بوعي وثبات على مدى السنوات، بل العقود الماضية.
ما زالت تونس التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي تناضل ضد الطغيان والقمع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
لم تكن الرحلة الصعبة من الدكتاتورية إلى الديمقراطية لتبدأ في تونس بغير الشراكات الحزبية. وفي عملية الانتقال تلك، تمكّنت تونس من أن تتغلّب على مخاطر الاستقطاب الإيديولوجي واحتكار العملية من جانب هذا الطرف أو ذاك. وتمكنت البلاد من تحقيق ذلك عن طريق بناء الائتلافات بين أحزاب مختلفة تتنوع منطلقاتها الفكرية، وتنمي في ما بينها التزاماً مشتركاً بالديمقراطية والتعددية وحقوق الإنسان، وتحقيق المطالب الرئيسية للثورة.
وقبل وقت طويل من ظهور نتائج أول انتخابات حرة وعادلة في تونس في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011، كان الحزب الذي أقوده – حزب النهضة – وعدد من الأحزاب الأخرى قد توصل إلى قناعة بأن إقامة الأسس لتونس الديمقراطية تتطلّب تشكيل حكومة ائتلافية. كان علينا أن نُبلور ثقافة ديمقراطية سياسية جديدة تقوم على الاحترام المتبادل والتعايش بين الأحزاب، وعلى الأخص بين التيارين الفكريين المحوريين في المجتمع التونسي: العلمانيين المعتدلين والإسلاميين المعتدلين. مع العلم أن هذين التيارين كانا منذ زمن طويل بمثابة الجناحين الرئيسيين للحركة الوطنية، والعنصرين الحاسمين للمشروع الديمقراطي.
منذ أكثر من عقد، أطلقت أحزاب المعارضة والناشطون في تونس مبادرة جمعت الناشطين السياسيين من شتى الأحزاب، والصحفيين ودعاة حقوق الإنسان والمستقلين في هيئة سُمِّيتَ في ما بعد "لجنة 18 تشرين الأول/أكتوبر". وقد بدأت المبادرة نشاطها بإضراب مشترك عن الطعام في العام 2005 لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان وما يعانيه السجناء السياسيون في السجون والمعتقلات.
ثم تحولت هذه المبادرة إلى منتدى للحوار بين ممثلي المعارضة لوضع رؤية مشتركة لنظام سياسي ديمقراطي جديد في تونس. وبعد مداولات تفصيلية مطولة وعميقة، أصدرت اللجنة أوراق موقف مشترك حول المبادئ الأساسية لنظام سياسي جديد، بما في ذلك الآليات الخاصة بالتداول السلمي للسلطة، والمساواة بين الرجل والمرأة، وحرية الاعتقاد والرأي، والعلاقة بين الدين والدولة.
لم تكن هذه العملية بالأمر الهيّن. فقد هاجمها من يعارضون الحوار بين العلمانيين والإسلاميين. وواجه المشاركون حملات تخويف مُكثَّفة وهجمات شخصية من نظام زين العابدين بن علي، الذي استمات في محاولة الحيلولة دون حدوث أي تقارب بين جماعات المعارضة. وكثيراً ما شُغلت أحزاب المعارضة العربية بحرب ضروس في ما بينها بدلاً من التركيز على المجرم الحقيقي: ألا وهو الأنظمة الدكتاتورية الجائرة.
وعندما سمحت أحزاب المعارضة لنفسها بالانجراف مع أصحاب السلطة على أمل استئصال منافسيها الإيديولوجيين، فقد تحوّلت أحياناً إلى ألعوبة بأيدي زعماء السلطة الدكتاتورية الذين تلاعبوا بالانقسامات الإيديولوجية ببراعة وحوّلوها لصالحهم بتأليف معسكر إيديولوجي ضد آخر قبل الانقضاض عليهما معاً.
لقد استطاع الانتقال الديمقراطي في تونس تحاشي جميع السياسات الإقصائية والمغالية في التطرف، وذلك بإقامة الشراكات بين أحزاب ذات خلفيات فكرية مختلفة. ضمّت الحكومة الائتلافية الأولى (2011-2014) حزب النهضة وحزبَيْن عَلْمانيَيْن من يسار الوسط (حزب التكتل وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية). وقد أثبت ذلك أنه نموذج رائد للتعايش بين الأحزاب العَلْمانية والإسلامية. وتضم الحكومة الائتلافية الحالية خمسة أحزاب، بما فيها العلمانيون واليساريون والنقابيون، وشخصيات من يمين المركز، والديمقراطيون الإسلاميون.
ولا يمكن إعادة بناء ديمقراطية مستقرة شاملة تعكس إرادة الشعب وتنأى بنفسها عن الاستقطاب، وعن القضاء على الرأي المخالف وعن الدكتاتورية، إلا بالتخلّي عن جميع المواقف تجاه الخصوم السياسيين.
إن إنجاح هذه الشراكات يتطلّب التزاماً مبدئياً بالتعددية واستعداداً لتحقيق الإجماع عبر الحوار والمصالحة. ولا يمكن إعادة بناء ديمقراطية مستقرة شاملة تعكس إرادة الشعب وتنأى بنفسها عن الاستقطاب، وعن القضاء على الرأي المخالف وعن الدكتاتورية، إلا بالتخلّي عن جميع المواقف تجاه الخصوم السياسيين، من أجل الوصول إلى المنافسة السياسية السليمة، والتعددية والتعاون.
راشد الغنوشي سياسي ومفكر تونسي، ورئيس حزب النهضة: له مؤلفات عديدة عن الإسلام والديمقراطية وحقوق الإنسان، وهو من أبرز دعاة الديمقراطية في العالم الإسلامي.
مقالالعصر الرقمي أساسٌ لنموذج تنموي عربي جدّي
فادي غندور
في أنحاء الشرق الأوسط، نشهد الآن ظاهرة من التغيرات الجذرية في أنظمتنا الاجتماعية والاقتصادية، وتجرى إعادة تعريف صناعات ونماذج أعمال بالكامل. يحرّك عناصر هذا المشهد الثورة الرقمية الناتجة عن تسارع ظهور الابتكارات الرقمية، والتي قد تكون من أكثر التحوّلات حسماً ولكن من أقلها نقاشاً في المنطقة. فقد أدت هذه التكنولوجيا الرقمية إلى إحداث تغيرات جوهرية في مجتمعاتنا العربية؛ في كيفية تواصلنا، في طريقة التعبير عن أفكارنا، كيف نتعلم، أين نبحث عن التسلية، من أين نتسوق وكيف نعمل.
ورغم أن تأثير التحوّل الناتج عن التكنولوجيا الرقمية قد يتجلّى في مجالات وصناعات أكثر من أخرى، إلا أن انتشاره سيصل إلى كل شيء، مؤثراً في المقام الأول على صياغة مستقبل الشباب، ليس فقط في تمكينهم من التواصل مع العالم بطرق غير مسبوقة، ولكن في تشكيل مستقبل عملهم، ليلغي وظائف ويخلق وظائف أخرى بمهارات جديدة لا تشبه سوق العمل الحالي.
وبالنظر إلى مدى سرعة تبني التكنولوجيا الرقمية في الشرق الأوسط، نجد أنها من أعلى المعدلات في العالم. فقد أدت معدلات النمو القوي والمتواصل للتجارة الإلكترونية بأرقام مزدوجة سنوياً، إلى تعاظم حجم هذا القطاع ليبلغ ما يزيد عن 5 مليارات دولار في العام 2015.1 أما عن المؤشرات الأخرى على أهمية الحياة الرقمية في العالم العربي، يكفي أن ننظر إلى استخدام الفرد للإنترنت، لنجد أن الفرد في العالم العربي يمضي أكثر من خمس ساعات يومياً على الإنترنت، أغلبها على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي بحسب إحصاءات العام 2014، التي تشير أيضاً إلى أن الأفراد في السعودية يشاهدون نحو 90 مليون فيديو يومياً على يوتيوب، وهي النسبة الأعلى للفرد في العالم.2 كما أدى غياب منافذ ديمقراطية حقيقية وفاعلة للتعبير عن الرأي في أغلب النماذج العربية الحالية إلى عزوف الشباب عن المشاركة في الحياة السياسية بمنظومتها التقليدية، والتوجّه لشبكات التواصل الاجتماعي كمنصة أساسية للتعبير عن مواقفهم في مختلف القضايا وللمشاركة في الجدل العام، ويظهر هذا التفاعل من خلال 17 مليون تغريدة على تويتر يطلقها العالم العربي يومياً بحسب نفس الإحصاءات.3 ومرة أخرى، تتصدَّر السعودية القائمة بأعلى انتشار لتويتر عالمياً بمعدل 33 في المئة.
يفرض اندماج التكنولوجيا الرقمية في النظام الاجتماعي والاقتصادي في العالم العربي واقعاً جديداً، ويتطلب أن يعمل أصحاب المصلحة جميعاً، من حكومات وقطاع خاص ومجتمعات مدنية، لإعادة تعريف علاقتهم مع مواطنيهم. فقد أفاد 68 في المئة من المشاركين في دراسة ميدانية أخيرة في المنطقة أن شبكات التواصل الاجتماعي أدت إلى زيادة انتشار وتأثير آرائهم السياسية، كما أبدى 70 في المئة ارتياحهم لقدرتهم على التعبير عن آرائهم السياسية على الفايسبوك.4
ولدى فيسبوك قاعدة كبيرة في المنطقة، حيث بلغ عدد مشتركيه في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في العالم العربي 114 مليون شخص، مما يجعله منبراً في غاية الأهمية يتعيّن على الحكومات أن تتبنّاه كقناة فاعلة للتواصل المباشر مع مواطنيها.5
وبالمثل، بدأنا نشهد نتائج الاقتحام السريع للحلول والصناعات المبنيّة على الإبداعات الرقمية في مجالات كانت بمنأى عن التغيير حتى الآن، من خلال إعادة تصميم الكثير من الصناعات وتقديم نماذج أعمال جديدة بالكامل. فعلى سبيل المثال، نجد أن "كريم"، وهي شركة إقليمية ناجحة ومنافسة لشركة "أوبر" قد غيّرت النظام التقليدي لعمل شركات سيارات الأجرة المبني على الاحتكار، بينما أتاحت الفرصة لعشرات الآلاف من العاطلين عن العمل، كليّاً أو جزئياً، للمشاركة في سوق كانوا مستثنين من المشاركة فيه سابقاً. كما أن "جملون"، وهو أكبر متجر إلكتروني للكتب العربية في المنطقة، بدأ بإحداث ثورة في مجال النشر بتوفير طباعة الكتب عند الطلب – الأمر الذي سيفتح الأبواب أمام جيل جديد من المؤلفين والناشرين لم يكن لديهم القدرات لدخول سوق النشر.
وسيؤدي نمو التكنولوجيا المالية FinTech إلى تعميم الخدمات المالية وإتاحتها لـ86 في المئة من البالغين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ممن لا يوجد لديهم حساب بنكي.6 حيث توفّر هذه الحلول التكنولوجية المالية رأس المال والخدمات المالية للمواطنين وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة الذين لم يمكّنهم نموذج السوق المالي الحالي من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات المالية. حيث تقوم مواقع إلكترونية مثل Liwwa وBeehive بتوفير حلول الإقراض والتمويل "الند للند" للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال جمع أكبر عدد من المستثمرين للتمويل. كما استطاع عدد كبير من النساء العربيات اللاتي لا يملكن إلا هواتفهن الذكية المبادرة بفتح متاجر إلكترونية على إنستغرام لبيع السلع والمشاركة في الاقتصاد من بيوتهن.
بدأت المنطقة تشهد مؤخراً ظهور الطلائع من رواد الأعمال ممن أنشأوا شركات مبنية على نماذج أعمال جديدة تماماً، والذين بنوا أعمالهم وحصدوا ثرواتهم بعيداً عن المجالات التقليدية كالعمل في القطاع العام أو الشركات العائلية، أو الاعتماد على مزايا الميراث وإيرادات العقارات. وسُجّلت أول قصة نجاح ضخمة لشركة رقمية في العالم العربي عندما استحوذت شركة Yahoo على منصة "مكتوب"، المُنشأة من سميح طوقان وشريكه حسام الخوري. ثم قام الشريكان مع رونالدو مشحور ببناء وإطلاق Souq.com، الذي أصبح أول وأكبر متجر إلكتروني في المنطقة تصل قيمته السوقية إلى مليار دولار.
إن الاقتصاد الرقمي الذي يعيشه العالم العربي يعمل على تمكين جيل جديد من الرواد ممن يتَحدّون النظم الاجتماعية والاقتصادية التقليدية القائمة، ليرسموا خريطة اجتماعية جديدة تتمحور حول إشراك المجتمع بسائر أطرافه في التنمية الاقتصادية المبنية على الشفافية.
إن الاقتصاد الرقمي الذي يعيشه العالم العربي يعمل على تمكين جيل جديد من الرواد ممن يتَحدّون النظم الاجتماعية والاقتصادية التقليدية القائمة، ليرسموا خريطة اجتماعية جديدة تتمحور حول إشراك المجتمع بسائر أطرافه في التنمية الاقتصادية المبنية على الشفافية وحق الجميع في تبادل المعرفة والوصول إلى المعلومات.
وأين كان الاتجاه الذي قد يتخذه الاقتصاد الرقمي، فنحن على يقين أن على جميع أصحاب المصلحة من حكومة وقطاع أعمال ومجتمع مدني على السواء، التعاون الوثيق لتصميم إطار مفاهيمي جديد للتكيف مع التغيرات التكنولوجية المضطردة بسرعة وفاعلية عالية، وإلا فإن العالم العربي سيتخلّف عن مواكبة العالم الرقمي وسيخسر فرصة ثمينة للتنمية وإعادة صياغة المجتمع.
يشغل فادي غندور منصب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي والمدير العام التنفيذي لمؤسسة "ومضة كابيتال"، وهي صندوق للمشروعات التكنولوجية يتمركز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ كما أنه مؤسس الشركة اللوجستية "أرامكس"، ومؤسس ورئيس مجلس إدارة المؤسسة التنموية "الرواد للتنمية".
1 T. Kearney, Inc., Getting in on the GCC E-Commerce Game (Chicago: A. T. Kearney, Inc., 2016), http://www.middle-east.atkearney.com/documents/787838/8908433/Getting+in+on+the+GCC+E-Commerce+Game.pdf/f06b44f0-4fdc-44d3-b9b3-1e273e4eeb36.
2 Fouzia Khan, “90 Million Videos Viewed Daily on YouTube in KSA,” Arab News, March 7, 2014, http://www.arabnews.com/news/536196.
3 Racha Mourtada, Fadi Salem, and Sarah Alshaer, “Citizen Engagement and Public Services in the Arab World: The Potential of Social Media,” 6th ed., Governance and Innovation Program, Mohamed Bin Rashid School of Governance, June 2014, http://www.arabsocialmediareport.com/UserManagement/PDF/ASMR6_En_Final.pdf.
4 Everette E. Dennis, Justin D. Martin, and Robb Wood, “Social Media,” in “Media Use in the Middle East, 2015,” Northwestern University in Qatar, 2015, http://www.mideastmedia.org/survey/2015/chapter/social-media.html#.
5 “Facebook Now Has 114m Monthly Active Users in MENA,” Arabian Gazette, November 11, 2015, http:// www.arabiangazette.com/facebook-114m-monthly-active-users-mena-20151111/.
6 Asli Demirguc-Kunt et al., “The Global Findex Database 2014: Measuring Financial Inclusion Around the World” (World Bank Policy Research Working Paper 7255), World Bank Group, April 2015, http://documents.worldbank.org/curated/en/187761468179367706/pdf/WPS7255.pdf#page=3.
المشهد السياسي
في الوقت الذي أدركت فيه الأنظمة الملكية العربية، وحكومات تونس بعد الثورة بالتأكيد، الحاجة إلى التغيير، إلا أن معظم الأنظمة تنخرط في سلسلة من الألاعيب الخطرة للحفاظ على البقاء. ومن المفارقات أن ردودها القسرية على الانتفاضات فاقمت التحديات عميقة الجذور في المجالات الاقتصادية الاجتماعية، والسياسية، والأمنية، والثقافية، ما يجعل استعادتها للسيطرة مهمة أكثر صعوبة. إذ لم يعد السؤال هو العودة إلى الأوضاع السابقة، بل كيفية الصمود في وجه تفكّك، أو انهيار، أنظمتها السياسية ومساوماتها السلطوية. وتكافح الدول العربية عمليات التحول المتسارعة في أربعة مجالات رئيسة: الحوكمة، والنزعة الريعية، والأمن، وتكنولوجيا الإعلام والمعلومات.
الحوكمة
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
لازالت أغلب البلدان العربية تواجه أزمة في مجال الحوكمة، على الرغم من تعدد استجاباتها في هذه الناحية. ويصر الكثير من البلدان التي لم تشهد مثل هذه الانتفاضات على أن الاضطراب الراهن في المنطقة نجم عن هذه الانتفاضات، وهي تحاول بالتالي العودة إلى الاستقرار الذي كان ينعم به النظام العربي عشية العام 2011، وتبذل الجهود لخلق أنظمة حكم أكثر إدماجاً للجميع واستجابةً لمطالبهم. كما أن بلداناً أخرى قد دهمتها الحروب الأهلية، أو تتّجه، على غرار مصر، نحو المزيد من القمع وإرساء نوع جديد من الحكم السلطوي.
لازالت أغلب البلدان العربية تواجه أزمة في مجال الحوكمة، على الرغم من تعدد استجاباتها في هذه الناحية.
لقد بدأت العقود الاجتماعية العربية بالتآكل في مطلع القرن الواحد والعشرين؛ إذ لم تعد الميزانيات المتضخمة قادرة على تغطية نفقات المستويات المناسبة من التحصيل العلمي، والرعاية الصحية والخدمات الأخرى، كما أخفقت في خلق بيئة سليمة لنمو القطاع الخاص واستحداث فرص العمل48 وعندما تتوقف العقود الاجتماعية عن أداء تلك الأدوار بشكل سليم، ينزل الناس إلى الشوارع.
كثيراً ما تميل أنظمة الحكم، في الاستراتيجيات التي تتبعها للمحافظة على السلطة، إلى إعطاء الأفضلية لفئة دون أخرى، أو خفض مرتبة النساء إلى مستوى الدرجة الثانية، إما من خلال الدساتير أو القوانين التي تحد من التطبيقات العملية لهذه الدساتير. ويوضح ذلك الأسباب التي لم يُعتبر فيها التنوّع الثقافي والإثني والديني مصدراً للقوة، بل على العكس مظهراً من مظاهر الضعف السياسي.
من هنا، كانت الحاجة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية أحد المطالب المشتركة التي طرحتها الانتفاضات العربية. ذلك أن افتقار المواطنين إلى المساواة في مجال الحماية أمام القانون قد دفعهم تدريجياً إلى تبنّي أطر ضيقة لتعريف الهوية، ترتكز أساساً على الدين، أو القبيلة، أو الجغرافيا، بوصف هذه المكونات وسائط أكثر فعالية لمعالجة مظالمهم. وفي بلدان مثل العراق، ولبنان، وليبيا، وسورية، تكون الانتماءات القبلية أو الطائفية في أغلب الأحيان أقوى من علاقاتهم بالدولة.
إن عدو الحكم السيّئ هو، في العادة، جمهور متعلّم ومثقّف وقادر على التفكير النقدي والتسامح تجاه وجهات النظر الأخرى. ولهذا السبب، إن أحد المجالات التي تستلزم إصلاحات جدية هو التعليم، في الدرجة الأولى نوعية التعليم. أما العنصر الغائب في كثير من البرامج التعليمية العربية فهو المناهج الدراسية التي تشجع على نمو مفهوم المواطنة، وتفضي إلى بناء الدولة على نحو سليم عن طريق تعليم القيم، بما فيها التسامح واحترام التنوّع.49
بدلاً من ذلك، يُطالَب الأطفال العرب اليوم في سنٍّ مبكرة بأن يكبتوا الفوارق الشخصية لصالح الأهداف العامة الكبرى، ويُشجَّعون على أن يفكروا في بعد واحد. أما التفكير النقدي فلا يلقى التقدير ولا التشجيع. وتجري تربية أجيال كاملة على الاعتقاد بأن الولاء للبلاد يعني الولاء للحزب، أو النظام أو الزعيم الذي يتولى الحكم فيه. وتؤدي ردود الفعل هذه إلى إحباط المساعي الرامية إلى تحقيق الحوكمة الرشيدة.50
إن عدو الحكم السيّئ هو، في العادة، جمهور متعلّم ومثقّف وقادر على التفكير النقدي والتسامح تجاه وجهات النظر الأخرى.
كانت الدعوة إلى المساءلة والشفافية من الموضوعات المشتركة الأخرى في الانتفاضات. ففي الدراسة الاستقصائية "أصوات عربية"، التي أجرتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في العام 2016، أفاد الخبراء الذين استُطلعت آراؤهم أن النزعة السلطوية والفساد يمثلان اثنتين من القضايا الثلاث الأهم التي تواجه المنطقة: فمن أصل 103 خبراء أشار 65 خبيراً إلى النزعة السلطوية و48 منهم إلى الفساد باعتبارهما القضيتين الأكثر إلحاحاً.51
تمثّل تونس نموذجاً فريداً لدولة استجابت لهذه التحديات، عبر الإقدام على صوغ عقد اجتماعي مستقبلي شامل – يمنح المرأة حقوقاً متساوية، ويضمن الحقوق لجميع المكونات المجتمعية، ويرسي الدعائم لدولة ديمقراطية – حتى ولو لم تتغلب الدولة على مشاكلها الاقتصادية والأمنية. وقد اتخذت قطر والإمارات العربية المتحدة، اللتان تقاومان الّلبْرَلَة السياسية، خطوات لتحسين البيئات التنظيمية الاقتصادية فيهما.52 غير أن أكثر البلدان العربية قد تمكنت من إجراء إصلاحات تجميلية، أو تبنّت سياسات تضع القضية الأمنية فوق كل اعتبار.
إن فشل الأحزاب الإسلامية، الذي تجلّى في أبرز صوره في مصر، من خلال طرح نماذج حوكمية بديلة جديرة بالثقة، وانتشار الخوف من الحركات العنيفة والتقاطع بين هاتين الناحيتين، سهّلا قيام ثورة مضادة مماثلة لما حدث في أوروبا العام 1848، والأرجح أن المحاولات لإعادة عقارب الساعة إلى ما قبل العام 2011 ستبوء بالفشل لأن مشاعر الإحباط التي أدت إلى الانتفاضات لازالت ماثلة للعيان. وتُعتبر المنطقة بحاجة ماسة إلى عقود اجتماعية جديدة مُتفق عليها لتلبية مطالب المواطنين السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية. لكننا لم نشهد حتى الآن دليلاً على أن أغلب البلدان العربية، باستثناء تونس، تخطط للتحرك في هذا الاتجاه.
دراسة حالة 3
العراق- سلطة في الظل
أدّت إخفاقات الحكم المتواصلة في العراق إلى كبح الشرعية السياسية بصورة بالغة، وأفسحت المجال أمام لاعبين خارج نطاق الدولة لممارسة نفوذ سياسي مهم.
سيمضي بعض الوقت قبل أن يتحوّل العراق بصورة كليّة من دولة مركزية واحدة إلى ديمقراطية فيدرالية فاعلة. عوضاً عن ذلك، أسفرت الجهود المبذولة لبناء الدولة منذ الغزو الأميركي في العام 2003 عن نسق للحكم يعتمد على سياسات الهوية. ولذا، عجزت الحكومات العراقية عن تمثيل المواطنين بصورة شرعية أو تزويدهم بالخدمات الأساسية، أو حمايتهم من النزعات الطائفية العنيفة.
أسّست الطبقة السياسية، التي تضم مسؤولين من جميع الجماعات الإثنية والطائفية الرئيسة، نظاماً من الكراسي الموسيقية. فقد تولّى السياسي الشيعي ابراهيم الجعفري مناصب رئيس الوزراء، ونائب رئيس الجمهورية، ووزير الخارجية. كما أن السياسي السنّي أسامة النجيفي شغل مناصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ووزير الصناعة. وشغل السياسي الكردي هوشيار الزيباري منصب وزير الخارجية، ثم وزير المالية، ونائب رئيس الوزراء.
ويجد القادة العراقيون بصورة متزايدة أن من الصعب عليهم التحدث بالنيابة عن جانب مهم من الفئات التي يمثّلون. ذلك أن معظم هؤلاء القادة، الذين عادوا إلى العراق بعد العام 2003، إنما يستمدّون شرعيتهم من حلفاء خارجيين.
تكمن السلطة الحقيقية في العراق خارج مؤسسات الحكم الوطنية. وجماعات المجتمع المدني والجماعات شبه العسكرية هي التي تجهد، أساساً، للسيطرة على الدولة. وهناك تحركات تنطلق من القاعدة إلى القمة في صفوف المجتمع المدني مطالبة بالإصلاح وبالحوكمة الرشيدة في المقام الأول. كما برزت مجموعة جديدة من القادة المستقلين ممن لايمثّلون جزءاً من النخبة القديمة ولاينتمون إلى الأحزاب السياسية. وتطرح هذه الحركة نفسها بصفة غير طائفية، ويتزعم موجة الاحتجاج فيها رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر. وقد بدأ قادة قوات الحشد الشعبي، التي تضم نحو خمسين من الفصائل شبه العسكرية الشيعية أساساً، يؤدون بشكل متزايد أدواراً سياسية ويحاولون استغلال عجز الدولة عن حماية المواطنين.1 وهم يعملون خارج نطاق الدولة بالفعل من أجل زيادة نفوذهم على حساب الدولة. وأبرز قادة الحشد الشعبي رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي الذي أسّس هذه الحركة، ويتمتع بالنفوذ في أقوى الجماعات فيها. ويتحدد النشاط السياسي في العراق بصورة مطردة في ضوء المنافسة بين أنصار الصدر والمالكي.
في العامين 2015 و2016، تصاعدت احتجاجات العراقيين على الوضع القائم. وانصبّ غضبهم أساساً على الطبقة السياسية التي انتفعت من المحاصصة الطائفية عبر وضع حلفائها في مراكز النفوذ وممارسة الفساد. وعلى حدّ تعبير إحدى النائبات في البرلمان، ليس ثمة مسؤول واحد، حتى هي نفسها، لم ينتفع من ممارسة الفساد.2 وقد سمح ذلك لمقتدى الصدر أن يعزز موقفه في أوساط المجتمع المدني والجمهور بصفة عامة. كان رجل الدين هذا يتصرّف فوق القانون إلى حد ما. وتجلّى ذلك بأوضح صوره في نيسان/أبريل 2016، عندما نظّم مع قلة من أنصاره حملة احتجاج داخل المنطقة الخضراء في بغداد، وشجّع مئات من المحتجين بعدها على اقتحام البرلمان مطالبين بالتغيير.3 ومع أنه الزعيم الأبرز في الحركة، فإن حركات علمانية أصغر حجماً بدأت نشاطها منذ تموز/يوليو 2015، عندما تولّى المواطنين الإحباط بعد عجز الحكومة عن توفير الماء، والكهرباء، والخدمات الأساسية الأخرى خلال أشهر الصيف الحارة.
ويهدف أنصار الصدر إلى تقويض العلاقات المريحة في صفوف الطبقة السياسية. وتنطوي جهودهم على الرغبة في النأي بأنفسهم بعيداً عن سياسات الهوية والتحرّك باتجاه السياسات التي تستهدف التصدي للقضايا. وهم يسعون إلى معالجة المشاكل المنتشرة على نطاق واسع، بما فيها الفساد، والخدمات الحكومية المتردّية، والمحسوبية. وما يدل على أن هذه الحركات قد تتجاوز الانتماءات الطائفية أو الإثنية أن بعض الشيعة يحتجّون على مفاسد القادة الشيعة مثلما يفعل بعض الكرد ضد قادتهم.
في المقابل، ترتكز قاعدة الدعم المناصرة لقادة قوات الحشد الشعبي الموالية للمالكي على سياسات الهُوّية. ويتمتع هؤلاء بدعم الملايين من الشيعة العراقيين، وحصلوا على أكثرية ما لديهم من الأسلحة والموارد المالية من إيران التي وظّفت الحشد الشعبي مُمثِّلاً ووكيلاً لها في العراق. وعزّز المالكي من شعبيته ونفوذه في المؤسسات الحكومية والدعم الذي يتلقاه من إيران بإعلان نيته العودة إلى الحكم. ولتحقيق هذا الهدف، عمل على تشويه سمعة الحكومة الحالية التي يرأسها حيدر العبادي.
من القادة الآخرين في قوات الحشد الشعبي هادي العامري، وزير المواصلات السابق الذي يتزعم "منظمة بدر" القوية؛ وأبو مهدي المهندس، الذي يتولى الإدارة في قوات الحشد وكان ذات يوم رئيسا ﻟ"كتائب حزب الله"؛ وقيس الخزعلي، الذي يرأس "عصائب أهل الحق". وللاستفادة من الدولة الآخذة بالانهيار، مارس هؤلاء المسؤولون ضغوطاً كبيرة على حكومة العبادي، وأعلنوا في الآونة الأخيرة عن نيتهم المنافسة في قائمة موحّدة للحشد الشعبي في انتخابات المحافظات العام 2017، فيتحوّلون بذلك إلى قوة سياسية.
ينبع عداء هؤلاء للحركة التي يتزعمها الصدر من رغبة الأخير في انتزاع السلطة من أيدي النخبة القديمة – بمن فيها المالكي، والعامري وآخرين. والكراهية متبادلة بين الطرفين. فخلال تظاهرة الاحتجاج الصدرية في نيسان/أبريل 2016، هتف المحتجون ما مفاده "أخرجي يا إيران!"4 وكان ذلك موجّهاً، في جانب منه، إلى جماعات الحشد الشعبي المتحالفة مع المالكي والمقرّبة من إيران. يُضاف إلى ذلك أن الصدر ركّز في أكثر من مناسبة على مسألة فقدان المالكي للشرعية، وذلك عندما تزعم، على سبيل المثال، محاولة في البرلمان لحجب الثقة عن رئيس الوزراء آنذاك في العام 2012.
جهد العبادي لاسترضاء كُلٍّ من الصدر وقيادة الحشد الشعبي على السواء، وعيّن في حكومته مجموعة من التكنوقراط. ومع أنه لم يحصل أول الأمر على ثقة البرلمان ثلاث مرات في نيسان/أبريل العام 2016، فقد حقق بعض التقدّم عندما حصل على الموافقة على خمسة مناصب وزارية في شهر آب/أغسطس. كما أن العبادي تفاهم مع قادة الحشد الشعبي الذين كانوا، بحكم موقفهم، يمثّلون خطراً على رئاسته للحكومة. فأصبح مكتب رئيس الوزراء هو الذي يدفع الآن رواتب الفصائل شبه العسكرية ويعترف بهم كجماعات تابعة للدولة. ولا بد أن يلجأ العبادي في المستقبل إلى المناورة بين النفوذين السياسيين للصدر والمالكي، ماسيعني مواصلة الضغط على كيان الدولة الضعيف.
هذه التحركات الديناميكيّة في أوساط النخبة السياسية، والحالات التي فشلت فيها الحكومة عموما في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، ستنعكس آثارها على الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية وعلى الترتيبات السياسية المُقبلة في البلدات والمدن التي طُرِدَ منها أعضاء التنظيم. فمع أن الحركات الاحتجاجية اقتصرت على المناطق الشيعية والكردية، فإن المواطنين في مناطق الأغلبية السنية سيطالبون كذلك بتغييرات تضع حدّاً لهيمنة الطبقة السياسية الحالية، وتُنهي مايعانونه من تهميش. وقد كان السبب الوحيد الذي حال دون تعبير السنّة عن مواقفهم خلال السنوات الأخيرة هو الوضع الأمني المتعلّق بوجود تنظيم الدولة الإسلامية. غير أن السنّة هم الذين بدأوا الاحتجاجات في العام 2011، حين طالبوا بنسبة تمثيل أعلى عندما زاد المالكي من تمركز السلطة بين يديه.
سيواصل الصراع السياسي في العراق التركيز على أزمة الحوكمة التي تفاقمت بشيوع المحاباة والمحسوبية وتعثّر القطاع الأمني. وستبرز بوادر المؤشرات على ماسيترتب على ذلك في انتخابات المحافظات المُقبلة في العام 2017 والانتخابات البرلمانية في العام 2018، عندما يواصل أنصار الصدر والمالكي التنافس على السلطة السياسية. وبالنسبة إلى مجموعة المالكي، ستستلزم العودة إلى سدة الحكم بروز زعيم قدير وبالتالي حكومة مركزية قوية.
ومع أنه من المستبعد أن تتسلّم جماعة الصدر السلطة، فإن سياساتها لابدّ أن تتضمّن استخدام مؤسسات الدولة، مثل البرلمان، وتنظيم الاحتجاجات التي تستهدف القادة السابقين من أحزاب المعارضة. وفي هذا السياق، فإن اللاعبين الوطنيين – أي المرجعيات الدينية في مدينة النجف التي تعمل في ظل آية الله العظمى علي السيستاني، وما يتبقى من أجهزة الدولة تحت إمرة العبادي – ستُتاح لهم الفرصة لممارسة نفوذهم من أجل ترجيح الاحتمال بأن يُسهم تيارا المالكي والصدر في تعزيز سلطة الدولة، بدلاً من تقويضها.
1 Norman Cigar, Iraq’s Shia Warlords and Their Militias: Political and Security Challenges and Options (Carlisle, PA: United States Army War College, June 2015), http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB1272.pdf.
2 "فضيحة.. حنان الفتلاوي تعترف بالحصول على عقود ومناقصات ونسبة الكوميشن"، مقطع فيديو على موقع يوتيوب، نُشر بواسطة: علي الطائي، 9 نيسان/أبريل 2014، https://www.youtube.com/watch?v=AYkkBJtljCw.
3 Renad Mansour and Michael David Clark, “Is Muqtada al-Sadr Good for Iraq?,” War on the Rocks, May 2, 2016, http://warontherocks.com/2016/05/is-muqtada-al-sadr-good-for-iraq/.
4 "الجماهير في ساحة الاحتفالات تردد إيران ..بره بره /يا قاسم سليماني ..هذا الصدر رباني"، مقطع فيديو على موقع يوتيوب، نُشر بواسطة: Iraqi Media، 30 نيسان/أبريل 2016، https://www.youtube.com/watch?v=ERt7xe8KLM8.
النزعة الريعية
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
خلال العقود الأخيرة، أفادت معظم البلدان العربية على نحو ما، من الموارد الوفيرة في المنطقة. ولا يشمل ذلك منتجي المواد الهيدروكربونية وحسب، الذين استطاعوا استخدام الأرباح لشراء الولاء وتأسيس ما اعتُبر دول رفاه بالفعل، بل شمل كذلك البلدان غير المنتجة للنفط، التي انتفعت من تدفّق المعونات أو رؤوس الأموال من البلدان المنتجة للنفط، أو من التحويلات النقدية التي يرسلها مواطنوها العاملون في الدول المنتجة إلى بلدانهم.
بيد أن احتياطيات النفط الضخمة في الشرق الأوسط أثبتت أنها كانت نقمة بقدر ما كانت نعمة.53 فبالإضافة إلى التحسّن الواضح الذي أدخله النفط على نوعية الحياة المادية في المنطقة، إلا أنه خلق كذلك دولاً ريعية تستمد ثروتها في الأساس من بيع مواردها الهيدروكربونية إلى أطراف خارجية. ويقال إن أحمد زكي اليماني، الذي كان وزيراً للنفط في المملكة العربية السعودية قد صرّح ذات يوم: "في المحصلة، ليتنا اكتشفنا الماء".54
استخدمت حكومات البدان المنتجة للنفط دخلها كمورد ومزوّد عام لاحتياجات الشعب، بدلاً من تشجيع الاعتماد على النفس أو على النمو الذي يوجّهه القطاع الخاص. فأصبح المواطنون بالتالي عالة على الحكام في مجالات التوظيف، والخدمات، والمكرمات. وحيث أن الحكومات لم تكن بحاجة إلى فرض الضرائب على مواطنيها لتعزيز الدخل الوطني، فقد غدت مواجهة نزعة الدولة السلطوية أكثر صعوبة.
كان من نتائج ذلك أن الحكومات العربية في الدول غير المنتجة للنفط أصبحت تعتمد كل الاعتماد على المعونات ورؤوس الأموال الوافدة من البلدان المنتجة، بما في ذلك التحويلات النقدية المُرسلة من مواطنيها العاملين هناك، للتعويض عن عدم قدرتها على توفير الخدمات الاجتماعية لسكانها. وأسفر ذلك عن قيام نظام من الريعية الإقليمية غدت بوجبه أغلب البلدان العربية مرتبطة بشبكة من الثروة التي تصنعها الاقتصادات في البلدان المنتجة للنفط. كما أن النخب السياسية والاقتصادية في البلدان المنتجة للنفط وغيرها، مثل مصر والأردن وتونس، أفادت من الامتيازات التي قدمتها الأنظمة لقاء ما تقدمه من مشاعر الولاء. ومع مرور الوقت، أسفرت مظاهر الترف التي تتمتع بها تلك النخب ودلائل الجور والفساد في توزيع الموارد إلى تعاظم الإحساس بالاغتراب في أوساط الجماهير.
وما أن بدأ التفسّخ في العقود الاجتماعية العربية، حتى أخذت دول عدة، من بينها مصر والأردن وتونس بإجراء اصطلاحات اقتصادية. كان من المعتقد آنذاك أن الإصلاح الاقتصادي ينبغي أن يسبق الإصلاح السياسي إذا ما أُريد لهذه الدول أن تتجنب عدم الاستقرار الاجتماعي.55 غير أن عمليات الإصلاح الاقتصادي قصرت عن بلوغ الأهداف المرجوة لسببين:
الأول، هو أنه ما لم يُطبَّق الإصلاح السياسي الضروري لضمان الرقابة المشددة والإشراف البرلماني، فإن برامج الإصلاح الاقتصادي غير المُدققة بها كانت تميل إلى تحقيق منفعة نخبة صغيرة وليس السكان بصورة عامة. وقد جرت خصخصة العديد من الصناعات في الدولة، على الرغم من ضرورتها، بمعزل عن الشفافية التامة، الأمر الذي ولّد الانطباع، المُبرّر غالباً، بتفشي الفساد.56 وأظهر مسح البارومتر العربي العام 2016 أن غالبية كبيرة من العينة التي شملتها الدراسة في كلٍّ من الدول - وهي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وفلسطين وتونس - تعتقد أن الفساد منتشر في أجهزة الدولة ومؤسساتها إلى حد "كبير" أو "معتدل".57
وقد جرت خصخصة العديد من الصناعات في الدولة، على الرغم من ضرورتها، بمعزل عن الشفافية التامة، الأمر الذي ولّد الانطباع، المُبرّر غالباً، بتفشي الفساد.
أما السبب الثاني فهو أن غالبية برامج الإصلاح الاقتصادي لم تولِ اهتماماً كافياً للاختلال الاجتماعي الناجم عن ذلك. فمع أن المدركات عن الرفاه الاقتصادي ترتبط في العادة بصورة إيجابية بالتوسع في الناتج المحلي الإجمالي، فإن استطلاعاً أجرته مؤسسة Gallup عشية الانتفاضة المصرية وجد أن العكس هو الصحيح: فبينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5 في المئة العام 2010، فإن واحداً من كل خمسة من المصريين لاحظوا تحسّناً في الأوضاع الاقتصادية.58 ونتيجةً لذلك، بدأ الجمهور يربط الإصلاح الاقتصادي، لا بالازدهار والتحسّن في مستوى معيشهم، بل بالفساد والتعسّف الاقتصادي.
إذا استمر الانخفاض الحالي في أسعار النفط لعدة سنوات مقبلة، كما هو متوقع، فإن ذلك سيطرح تحديات كبيرة أمام الأنظمة الريعية في المنطقة. فقد بدأت المملكة العربية السعودية بتغيير أنموذج المساعدات التي تقدّمها من مقاربة تقوم على تقديم المنح إلى أخرى تستند إلى الاستثمار.59 وسيزيد ذلك من الضغوط المفروضة على الحكومات التي تتلقى المساعدات لتحسين أدائها الاقتصادي، وتبتعد عن نظام الرفاه الاجتماعي إلى نظام يعتمد على الجدارة والاستحقاق والتوسّع الذي يوجّهه القطاع الخاص.
لقد وصل النموذج الريعي، الذي انتشر على نطاق واسع في المنطقة حتى الآن، إلى مرحلة التشبّع. كما بلغت الحكومات الحدود القصوى من قدرتها على المحافظة على فرص العمل في القطاع العام، وعلى زيادة مديونيتها العامة، والمحافظة على القروض الخارجية. غير أن المحاولات الرامية إلى تغيير هذه الأنظمة ستواجه مقاومة كبيرة من النخب السياسية والاقتصادية التي لاتريد أن تخسر ماتتمتع به من امتيازات. ومن المتوقع أن تبرز المعارضة في أوساط أجهزة الدولة البيروقراطية التي تفتقر إلى رؤية لكيفية الانتقال إلى نظام من النمو الشامل المُستدام.
لايمكن للعالم العربي أن يسعى إلى تنمية اقتصادات مزدهرة بغير التخلّي عن الأنظمة الريعية. غير أن الانتقال سيكون عسيراً جدّاً، بسبب اعتماد الحكومات الكلّي لعقود عدة على الموارد الريعية. وبما أن المجتمعات العربية مُطالبة بالتضحية عن طريق تخفيض دعم المواد الاستهلاكية، والقبول بعدد أقل من الوظائف الحكومية، واختصار الخدمات وأنواع الدعم بصورة عامة، فسيصبح أصعب على قادة هذه المجتمعات أن يحولوا دون إشراك المواطنين في عملية صنع القرار. ولن تكلَّل مساعي الإصلاح الاقتصادي في العالم العربي بالنجاح إلا إذا صاحبتها عملية إصلاح سياسي تمنح الناس أدواراً مؤثرة وتسهم في بناء الضوابط والتوازنات.
دراسة حالة 4
الأردن – بين الوضع الراهن والإصلاح
لايزال اعتماد الأردن، بصورة غير مستدامة، على المعونات الأجنبية وتضخُّم القطاع العام فيه يقفان حجر عثرة في طريق تنميته المؤسسية والاقتصادية.
مع أن الأردن شهد تظاهرات صغيرة في الأيام الأولى من الانتفاضات العربية، فإن المملكة سلمت من وطأة الفوضى التي أعقبت ذلك. ويُعتبر العرش الهاشمي مؤسسة شرعية من جانب أغلبية كبيرة من الأردنيين، مثلما يعتبر قوة تجمع وتوحّد الجماعات الإثنية في البلاد. وكان من نتائج ذلك أن معظم المطالب تركزت على إحداث تغييرات داخل النظام، لا على تغيير النظام نفسه.
يُضاف إلى ذلك أن النظام الملكي اتّبع سياسة عملية براغماتية أقل ميلاً إلى القمع من كثير من نظائره في المنطقة في تعامله مع المعارضة. غير أن ذلك لاٍيعني أن كل شيء على ما يرام. فقد عمل الأردن في ظل نسخة ناعمة حميدة من المقايضة السلطوية التي يوفّر فيها النظام الخدمات الأساسية للمواطنين بينما يُنكر حقهم في أن يكون لهم دور ملموس في معالجة القضايا الوطنية. وعلى الرغم من وجود مؤسسات سياسية، فقد قُلِّص نفوذ الهيئتين التشريعية والقضائية في نظام الحكم لصالح سلطة تنفيذية تمارس درجة أعلى من الهيمنة. ومع مرور الوقت، اكتسب القطاع الأمني قدراً من النفوذ في اتخاذ القرارات أعلى مما لدى الحكومات المعنيٍة. وفي تلك الأثناء، يواصل الديوان الملكي دوره الغالب في إدارة الأمور في البلاد.
عانت مؤسسات الدولة خلال السنين من فجوة أساسية في مجال المصداقية. فقد أظهر استطلاع وطني في نيسان/أبريل 2016 أن 87 في المئة من الأردنيين لم يذكروا إنجازاً واحداً يستحق مجلس النواب السالف عليه الشكر.1 وتبلورت هذه المشاعر بصورة أوضح في أيار/مايو 2016 عندما أقرّ البرلمان، على عجل، سلسلة من التعديلات الدستورية التي تمنح الملك صلاحيات جديدة غير مسبوقة.2 علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من أن الانتخابات التشريعية جرت عامّي 2013 و2016، فإن قوانين الانتخاب قد صيغت لتوليد برلمانات غير فعالة. وعلى هذا الأساس، فإن نظام الحكم لم يكن معنيّاً بممارسة البرلمان لأي سلطة حقيقية.
وعلى الرغم من عدم ثقة الأردنيين بحكومتهم، دفعتهم النتائج التي أسفرت عنها الانتفاضات العربية في سورية ومصر إلى العدول عن النزول إلى الشوارع بعد العام 2013، خشية أن يواجه الأردن جيشاناً مماثلاً. غير أن هذا الهيجان الإقليمي زاد من جرأة النظام للانقضاض على جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن، فتغيرت بذلك السياسة التي كان قد التزم بها منذ أمد بعيد، باسترضاء تلك الحركة التي كانت تحرص على الدوام على تحقيق أهدافها بالوسائل السلمية. وأكد ذلك على قدرة النظام على استغلال جميع الفرص لتشديد قبضته على التطورات السياسية، حتى وإن تم ذلك بتعزيز الموقف الشعبي الذي تشوبه الشكوك حول مؤسسات الدولة.
يواجه الأردن كذلك مشاكل اقتصادية حادة. فالنظام شبه الريعي العامل في المملكة منذ نشوئه قد وصل إلى حدوده القصوى. ولم يعد من الممكن ضمان اعتماد الأردن على المعونات الخارجية لتمويل جهازه الإداري البيروقراطي المتضخّم. مع أن المساعدات من الولايات المتحدة قد زادت إلى حد كبير جرّاء الأزمة السورية – من 850 مليون دولار في العام 2013 إلى مايقرب من مليار ونصف المليار دولار – لايمكن إدامة هذه المستويات إلى ما لا نهاية.3 وفي هذه الأثناء، دفع انخفاض أسعار النفط العالمية المملكة العربية السعودية، وهي السند المالي الإقليمي الرئيس للأردن، إلى تضييق مجال المساعدة والاستعاضة عن ذلك بمقاربة تركّز على الاستثمار.4
على الصعيد المحلي، توظّف الحكومة 42 في المئة من القوى العاملة، وهي من أعلى النسب في العالم.5 ويتعاظم الدين العام بشكلٍ حادّ، بحيث بلغ اليوم مستويات خطيرة تعادل 93 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي.6 وعلى الرغم من تدابير الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة،7 فقد بلغت معدلات البطالة الرسمية خلال العقدين الماضيين نحو 14 في المئة. والأخطر من ذلك أن البطالة في أوساط الشباب الأردنيين (الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والتاسعة والعشرين) تقارب نسبة 30 في المئة.8
يدرك نظام الحكم أن النسق الاقتصادي الذي تعمل بموجبه الدولة لايتمتع بالاستدامة. غير أن المحاولات السابقة لتغييره وُوجِهت بمقاومة عنيفة من نخبة سياسية لاتريد التحرّك باتجاه نسق يعتمد أكثر على الجدارة، ويبتعد عن نظام بيروقراطي في القطاع العام يتميّز إما بالعجز أو بعدم الرغبة في الانتقال إلى اقتصاد أكثر اعتماداً على القطاع الخاص في تشجيع التوسّع وتوليد الوظائف.
وعندما بلور الأردن أجندته الوطنية العام 2005 لوضع خطة شاملة قائمة على معايير أداء تحقيق النتائج للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، واجهت هذه الأجندة، على الفور، محاولات لتقويضها عبر حملة إعلامية وسياسية عدائية توجهها النخبة السياسية. وإذا أخذنا في الاعتبار أن خطوات الإصلاح الاقتصادي المبكّرة قد أسفرت عن تزايد الفساد وأخفقت في معالجة البطالة المنتشرة على نطاق واسع، وتحديات النمو والدين العام، يمكن القول إن الأردن لايزال يراوح مكانه اليوم: فهو عاجز عن تعزيز النظام الراهن، مثلما هو عاجز عن المضي قدماً إلى الأمام.9 ولا يمثّل إغلاق الفضاءات السياسية والاقتصادية وصفة صحيحة لضمان الاستقرار والازدهار.
أسفرت الهجرة الجماعية إلى الأردن عن تفاقم المشاكل الاقتصادية في البلاد. فقد دفع الصراع في سورية مليوناً ومئتي ألف من السوريين، وفقاً للبيانات الإحصائية الأخيرة العام 2015، إلى الانتقال إلى الأردن حيث يقيمون إما كلاجئين أو كمقيمين من غير المواطنين.10 والاحتمالات ضئيلة في عودتهم إلى بلادهم في مستقبل منظور. ويمثّل السوريون عبئاً رئيساً على البنية التحتية الهشّة في الأردن، ولاسيما في مجال ندرة الموارد المائية، وهم ينافسون الأردنيين على فرص العمل المحدودة. ومع تضاؤل فرص العمل والتعليم في المستقبل، فإن إحباط السوريين قد يتعاظم على نحو متزايد فيميلون بالتالي إلى مواقف إيديولوجية راديكالية.
وأخيراً، يواجه الأردن هموماً أمنية نظراً إلى وجود فصائل من تنظيم الدولة الإسلامية على حدوده مع سورية والعراق، إضافةً إلى عدد قليل ولكنه آخذٌ بالتزايد من أنصار هذه الجماعة الجهادية داخل الأردن.11 ومع أن الحكومة قد اتخذت موقفاً صلباً من الناحية العسكرية، فإن الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية لا بد أن تتعزّز بالجهود الرامية إلى مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، التي دفعت ببعض الشباب الأردنيين إلى الانضمام إلى صفوف ذلك التنظيم.
يواجه الأردن مشاكل حقيقية، لكنها ليست من النوع الكؤؤد الذي لايمكن تذليله. وستُحدَّد ملامح المملكة في المستقبل بقدرتها على أن تخوض، بنجاح، غمار التحديات المتعددة التي تجابهها. إلا أن الأردن لايزالٍ حتى الآن يفتقر إلى الإرادة السياسية اللازمة للانتقال إلى أنساق سياسية واقتصادية أكثر انفراجا. ولن يتحقق ذلك إلا بإعطاء الشعب دوراً سياسياً أبرز في تدبير أموره، وبتمكين القطاع الخاص من أن يحل محل الحكومة بوصفه المولّد الرئيس لفرص العمل. وستُظهر الأيام ما إذا كانت نهاية العصر الرَّيْعي في المنطقة ستدفع الأردن في هذا الاتجاه.
1 Center for Insights in Survey Research, “Survey of Jordan Public Opinion, National Poll #13,” International Republican Institute, April 19, 2016, http://www.iri.org/sites/default/files/wysiwyg/2016_iri_poll_presentation_public_1.pdf.
2 المصدر السابق.
3 Jeremy M. Sharp, “Jordan: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Service, January 27, 2016, https://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL33546.pdf.
4 David Schenker, “Promised Saudi Support to Jordan: At What Price,” Washington Institute for Near East Policy, May 9, 2016, http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/promised-saudi-support-to-jordan-at-what-price.
5 Aaron Magid, “Political, Economic Alarm Bells Ringing in Jordan,” Al-Monitor, March 14, 2016, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/03/jordan-economy-crisis-government-officials.html.
6 “IMF Executive Board Approves US$723 Million Extended Arrangement Under the Extended Fund Facility for Jordan,” International Monetary Fund, August 25, 2016, https://www.imf.org/en/News/Articles/2016/08/25/PR16381-Jordan-IMF-Executive-Board-Approves-US-723-million-Extended-Arrangement.
7 “14.6% The Unemployment Rate During the First Quarter of 2016,” press release, Jordanian Department of Statistics, April 26, 2016, http://dos.gov.jo/dos_home_e/main/archive/Unemp/2016/Emp_2016-q1.pdf.
8 “Unemployment, Youth Total (% of total labor force ages 15-24) (modeled ILO estimate),” World Bank, http://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.1524.ZS?locations=JO.
9 “Corruption Perceptions Index 2015,” Transparency International, 2015, https://www.transparency.org/cpi2015/..
10 “Jordan Census Counts 1.2 Million Syrians,” January 31, 2016, Voice of America, http://www.voanews.com/a/jordan-census-counts-1-point-2-million-syrians/3170432.html.
11 "أبو رمان يناقش سر داعش ومدى خطر التنظيم على الأردن"، صحيفة الغد، 4 أيلول/سبتمبر 2014، http://www.alghad.com/articles/823799-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4-%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88%D9%85%D8%AF%D9%89-%D8%AE%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86.
القطاع الأمني
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
أسهمت هيمنة القطاعات الأمنية والعسكرية في الدول العربية إلى حدٍّ كبير في الأزمات السياسية والحوكمية الراهنة. ففي البلدان التي شهدت انتفاضات شعبية، تعاظمت غضبة الجماهير وتزايد سخطها جرّاء انتهاكات الشرطة. لكن حتى عندما حققت تلك الثورات النجاح، فشلت الحكومات المؤقتة الضعيفة والهيئات التمثيلية التي تفتقر إلى الخبرة، في وضع إصلاح القطاع الأمني على الأجندة العامة.
أسهمت هيمنة القطاعات الأمنية والعسكرية في الدول العربية إلى حدٍّ كبير في الأزمات السياسية والحوكمية الراهنة.
كان مثل هذا الإصلاح كان سيطبق على الجهات المولَجة إنفاذ القانون، وأجهزة الأمن، وأجهزة الدولة شبه العسكرية أو القسرية الأخرى. كما كان سيشمل نقلة موازية في العلاقات المدنية-العسكرية لوضع القوات المسلحة الوطنية تحت السيطرة الواضحة للسلطات المدنية المُنتخبة ديمقراطياً. لكن، بدلاً من ذلك، لجأت الفصائل السياسية المتزاحمة إما إلى التنافس للسيطرة على القطاع الأمني والقوات المسلحة أو إلى السعي لاسترضائها.60 كما أن العجز عن المشاركة في الإصلاح قد كشف النقاب عن البقية الباقية من مخلفات النظام السابق المتمثّلة في الشخصيات والشبكات الكامنة في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
نتيجةً لذلك، انهارت المؤسسات الأمنية والعسكرية في ليبيا واليمن، على سبيل المثال، انهياراً تامّاً، الأمر الذي فتَّ من عضد الدولة وعمّق الخلافات فيها. وقد أدت بعثرة المجتمعات الليبية واليمنية وتجزئتها على أسس مناطقية، وقبلية وطائفية-إثنية إلى مآزق أمنية متعددة. وبالتالي، أصبحت إعادة بناء القطاعات الأمنية المركزية جزءاً لا يتجزأ من إعادة تعريف شخصية الدولة وتحديد أهدافها وإعادة التفاوض حول العلاقات بين الدولة والمجتمع، مع زيادة التعقيد إلى حد كبير في كلتا المهمتين.61 وظهرت هذه المآزق نفسها في سورية منذ العام 2011، وفي العراق منذ العام 2009. فعندما أصبح نوري المالكي رئيساً لوزراء العراق، انهار الجيش العراقي إلى حدٍّ بعيد، وأدى ذلك إلى نشوء قوات الحشد الشعبي التي يسيطر عليها الشيعة.
في بلدان أخرى، سمحت مغادرة الزعماء الأقوياء الأوتوقراطيين الساحة السياسية للقطاعات الأمنية والقوات المسلحة بتعزيز استقلالها الذاتي. واتضح ذلك بأجلى صوره في مصر، عندما تواطأت قوى الأمن والجيش في شهر تموز/يوليو 2013 لإطاحة أول رئيس مدني مُنتخب. غير أنها فشلت في تحويل السلطة القسرية إلى قوة ضبط سياسية واجتماعية مستقرة، ناهيك عن حل المشاكل البنيوية العميقة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، الذي تغلغلت فيه قوى الأمن والجيش بصورة مكثفة.
على العكس من ذلك، حققت الأحزاب السياسية في تونس إنجازاً ديمقراطياً بحلّ الخلافات القائمة بينها من خلال الحوار واحترام نتائج الانتخابات. إلا أنها فشلت في تأكيد سيطرتها على وزارة الداخلية، التي لاتزال تمثّل صندوقاً أسود تسيطر عليه شبكات غير نظامية اخترقت القطاع الأمني.62
برزت تيارت مماثلة في أنظمة الحكم الجمهورية العربية التي كانت تشهد انتقالاً سياسياً أو انتقالاً بعد مرحلة الصراع، غير أنها لم تبلغ الدرجة نفسها من التأزم التنظيمي أو الانهيار المؤسسي. وقد أسفر تآكل الأطر المؤسسية والتوافقات السياسية حول صلاحيات دوائر الدولة ومسؤولياتها إلى تردّي الأداء الإداري في القطاعات الأمنية في الجزائر ولبنان وفلسطين والسودان. وفي بعض الحالات، أدّى التوزيع الفضفاض للسلطات بين الأحزاب السياسية وتجمعات النخب والفصائل المؤسسية، إلى شلل القطاع الأمني والانتقاص من فعاليته وتقويض شرعية الحكومة. وفي بلدان أخرى، مكّنت هذه العوامل القطاع الأمني من العمل باستقلالية متزايدة بعد أن وضع سياساته وأولوياته الخاصة في غياب خطوط إرشادية متماسكة أو أهداف مرسومة من جانب الحكومة.
وما زاد من ضخامة التحدي الذي يمثّله ضعف الحوكمة أو غيابها عن القطاع الأمني، الانهيار الحاد أو الشلل الكامل الذي أصاب قطاع القانون الجنائي. فعندما تهاوى القطاع الأمني، كما حدث في ليبيا واليمن، تعرّض القضاة إلى الاغتيال أو اضطروا إلى الهرب، بعد أن تركوا مجتمعات محلية كاملة بدون محاكم قضائية رسمية؛ بل إن مسؤولي المحاكم تعرّضوا إلى الهجوم حتى في تونس، من موظفي القطاع الأمني الذين طالبوا بإطلاق سراح زملائهم الذين كانوا يحاكمون لإقدامهم على قتل مواطنين بغير مسوّغ قانوني.63
أما السلالات الملكية العربية فكانت، على العموم، أفضل حالاً. إذ أن النخب الحاكمة في مجلس التعاون الخليجي والأردن والمغرب تلتف، نسبياً على الأقل، حول منظومة من الأهداف والسياسات المحورية، كما أن عمليات رسم السياسات فيها تتميّز بقدرٍ أكبر من التماسك والترابط الوثيق بين الأسر الحاكمة. ثم أن تحالف تجمّعات النخب مع القطاعات الأمنية والقوات المسلحة يعزز الولاء بين الأمن والجيش، بفعل الإنفاق الحكومي الكبير على الرواتب والمشتريات. وكان التقشف المالي يفاقم من صعوبة هذه العلاقة، كما حدث في الأردن العام 2010.64 كما أن الإصلاحات السياسية قد تكتسب في بعض الأحيان، وبدعم من الديوان الملكي، نفوذاً سياسياً جزئياً أعلى مما يمارسه القطاع الأمني، كما يحدث في المغرب منذ العام 2010.65 غير أن الأسر الحاكمة حافظت على علاقات الاعتماد المتبادل مع القطاعات الأمنية والقوات المسلحة في بلدانها. مع ذلك، يعني غياب الإصلاحات السياسية المُجدية أو المشاركة في السلطة، إلا في المغرب،66 أن السياسات المحلية في الأنظمة الملكية العربية بدأت تتحرك وفق ما يريده القطاع الأمني. والواقع أن القمع البوليسي، لايزال يمثل أحد العناصر الجوهرية لأنظمتها السياسية.67
اعتماد النفوذ السياسي على القدرة على بناء الوسائل القسرية والمحافظة عليها، غدا اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى.
من هنا، ثمة ثلاثة تحديات أساسية تعترض الطريق. الأول هو أن اعتماد النفوذ السياسي على القدرة على بناء الوسائل القسرية والمحافظة عليها، غدا اليوم أكثر وضوحاً من أي وقت مضى، على الرغم من التفاوت الكبير بين الأقطار العربية. وهذا مايدفع الجهود المعاكسة التي تبذلها دوائر الدولة إلى إضفاء الطابع المركزي على تنظيم القطاعات الأمنية والقوات المسلحة والسيطرة عليها من جهة، وما تبذله الدوائر غير الحكومية لإقامة الكيانات الأمنية والعسكرية الموازية الخاصة بها، من جهة أخرى. وقد غدت الازدواجية المؤسسية الناجمة عن ذلك من حقائق الحياة في العراق ولبنان وفلسطين والسودان وسورية واليمن. وهذا ما يعنيه أيضا التفاوت المتزايد بين القوات الخاصة ووحدات مكافحة الإرهاب الأفضل تدريباً وتسليحاً من جهة، والوحدات ذات التدريب المتدني، والتجهيز المتواضع، والأجور الشحيحة التي تشكّل الجانب الأكبر من القوات المسلحة في بلدان مثل الجزائر والأردن والمملكة العربية السعودية، من جهة أخرى.
ويكمن التحدي الثاني في أن تآكل كلٍّ من السلطة السياسية للحكومات وقدرة مؤسسات الدولة الأساسية، وما رافق ذلك من الأزمات المالية والمحسوبية الاقتصادية، قد وسّع نطاق الفساد في قطاعي الدفاع والأمن في أكثر البلدان العربية إن لم يكن فيها كلها. وترك ذلك آثاره على وظائف الدولة بجميع جوانبها، بدءاً من القبول في أكاديميات الشرطة والجيش، مروراً بالترقيات والتعيينات، وجميع جوانب عمليات الشراء، وانتهاءً بأداء المهام التشغيلية وتوفير الخدمات.
يُضاف إلى ذلك أن ضعف قدرات الدولة وانتشار النزاع المسلح تسبّبا في نشوء اقتصادات مكثفة قوامها التهريب على جانبي الحدود المشتركة. وقد اخترقتها وتغلغلت فيها القطاعات الأمنية إلى درجة غدا معها تفكيك الأسواق السوداء أكثر صعوبة. وأصبحت القوات المسلحة كذلك لاعباً اقتصادياً في دول عربية عدة، وانخرطت، بدرجات متفاوتة، في أعمال مسجّلة رسمياً أو في أنشطة الأسواق السوداء، أو عملت كوسيط في المضاربات الاستثمارية وتقاضي العمولات مع أفراد الأسر الحاكمة والنخب ذات النفوذ.
أما التحدي الثالث، فهو أن التوظيف في قطاعي الدفاع والأمن، الذي كان في أغلب الأحيان منجماً لفرص العمل ومشروعاً للضمان الاجتماعي، يتعرض الآن إلى الضغوط جرّاء التقشف المالي في كثير من الدول العربية. كما أن التوظيف في العديد من الدول يؤدي إلى إعادة تصنيف القطاعات الأمنية والقوات المسلحة على أسس مناطقية، أو قبلية أو ريفية-حضرية، أو سياسية-إيديولوجية، حسب السياق المحدّد في كل دولة.
ومن أجل تحقيق تقدّم حقيقي، على الدول أن تضع إصلاح وحوكمة القطاع الأمني والقوات المسلحة على الأجندة العامة.
تزيد هذه التحديات من مقاومة القطاع الأمني للإصلاح ولإعادة تحديد العلاقات المدنية–العسكرية في سياق الحوكمة الديمقراطية. وهي تعيق أيضاً إضفاء الصفة الاحترافية على القطاع الأمني والقوات المسلحة، وإعادة بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودمج الميلشيات غير الحكومية في مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وجسر الانقسامات الجهوية والجماعاتية في صفوف المجندين في القطاعات الأمنية والعسكرية. ومن أجل تحقيق تقدّم حقيقي، على الدول أن تضع إصلاح وحوكمة القطاع الأمني والقوات المسلحة على الأجندة العامة، كما أن على اللاعبين الدوليين أن يتجنّبوا إعطاء الأولوية لمكافحة الإرهاب بصوره تنتقص من الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح. وتدعو الحاجة إلى قيام ثقافة للتشاور والحوار، من أجل بناء ائتلافات سياسية حول أهداف متّفق عليها تم متابعيها بصورة حثيثة عبر سياسات متماسكة ومقاربات منهجية ملموسة.
دراسة حالة 5
مصر – حدود الأمن الفوضوي
ترسّخت هيمنة المؤسسة العسكرية في مصر الآن بدرجة لامثيل لها على مدى العقود الأخيرة، ما سيؤدي إلى خنق النشاط السياسي المدني وتهديد النمو الاقتصادي.
منذ استيلاء المؤسسة العسكرية على السلطة في العام 2013، تعاظمت التحديات التي تُواجه مصر في مجال الإرهاب، بينما لم يطرأ تحسّن ملموس إلا في نواحٍ قليلة على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لأغلب المواطنين. ومن هنا، ففي الوقت الذي يعلي فيه غالبية المصريين من شأن العسكريين، تواجه الحكومة العسكرية صعوبة متزايدة في استمداد الشرعية من الوعد الذي قطعته على نفسها باستعادة الأمن والقضاء على الإرهاب، ناهيك عن تحقيق الازدهار الاقتصادي.
في 26 تموز/يوليو 2013، وبعد أن أمر عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المصرية آنذاك، بعزل الرئيس آنذاك محمد مرسي، استجاب كثير من المصريين لدعوته بالتجمهر في الشوارع لمنحه تفويضاً شعبياً بمحاربة الإرهاب، لاقتناعهم بأنه هو المُنقذ الجديد لبلادهم مما تعانيه.1 غير أن شعبية الرئيس السيسي أخذت منذئذ بالانحسار جرّاء الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان - بما في ذلك مقتل أعداد من أنصار "الإخوان المسلمين" في مذبحة ميدان رابعة العدوية في 14 آب/أغسطس 2013 – وتدهور الأوضاع الأمنية، والأداء الاقتصادي والاجتماعي للحكم العسكري. كما بدأ كثير من المصريين باعتبار الحكومة نظاماً تسلّطياً يتركّز اهتمامه على حماية الامتيازات التي تتمتع بها الزعامات العسكرية والأمنية، والنخب المالية والاقتصادية المرتبطة بها.
يعيش أكثر من 22 مليون مصري دون خط الفقر،2 بينما يزيد معدل البطالة عن 13 في المئة ويرتفع إلى 34 في المئة في أوساط الشباب.3 وحسب مصادر حكومية، ارتفع معدل التضخّم إلى 15 في المئة في العام 2016.4 وبقي معدل النمو الاقتصادي في حدود 4 في المئة،5 بينما بلغ إجمالي الدين المحلي والخارجي لمصر 331 مليار دولار للعام 2015، أي ما يربو على 90 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.6
ومع أن حكومة السيسي حققت أول الأمر بعض النجاح في دعم المواد التموينية ومعالجة القصور في إمدادات الطاقة، يبدو أن هذه الجهود قد تباطأت في ما بعد. وليس من الواضح إن كانت الحكومة تمتلك رؤية اقتصادية. وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من عمليات مكافحة الإرهاب المستمرة في شبه جزيرة سيناء، لازالت نسبة القتلى في صفوف الجيش والشرطة مرتفعة. وبحسب المصادر الصحافية المحلية، لقي نحو 125 من أفراد القوات المسلحة والشرطة مصرعهم في العام 2015، مقابل 150 خلال السنتين السابقتين.7 كما أن ثمة تصاعداً متواصلاً في أعمال العنف التي يمارسها رجال الأمن، ومنها القتل من دون محاكمة والتعذيب وأعمال العنف التي ترتكبها الجماعات المتطرفة في الطيف الإسلامي.8
نتيجةً لذلك، بدأت الهواجس تساور الدول المساندة لمصر في الإقليم، بما فيها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على نحو متزايد تجاه أداء الوضع الاقتصادي والاجتماعي، في الوقت الذي تتراجع فيه واردات النفط. ومع أن مصر تُعتبر على نطاق واسع شريكاً مهمّاً في محاربة الإرهاب، إلا أن القلق يزداد حول انتهاكات حقوق الإنسان التي شوّهت صورتها على الصعيد العالمي.
على الرغم من تعاظم مشاعر الريبة والنفور في المجال العام تجاه سجل النظام في مايتعلق بحقوق الإنسان، فإنه لازال يمضي قدماً على المسار نفسه، تسانده في ذلك على مايبدو عناصر مهمة في المجتمع المصري. فقد واصل سياسة القمع وتشويه سمعة حركات المعارضة. وفي صيف العام 2013، اعتُبرت جماعة "الإخوان المسلمين" مسؤولة عن تصاعد الأعمال الإرهابية وعن الفشل في تحسين الأوضاع المعيشية في مصر. وبعد ثلاث سنوات، اتُّهم طلبة جامعيون وناشطون من الشباب، وعمّال في القطاع الصناعي، وموظفون مدنيون بالتآمر ضد الأمة، إما عن طريق مطالبتهم بوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان أو بالاحتجاج السلمي على فقدانهم حقوقهم الاقتصادية والمدنية.
أما الأطباء، الذين نظّمت نقابتهم احتجاجاً سلمياً بعد سقوط عدد منهم ضحايا لوحشية الشرطة في العام 2015، فاتهمتهم وسائل الإعلام الحكومية بالخيانة الوطنية.9 كما جرى التنديد بالغضب الشعبي الموجّه ضدّ انتهاكات حقوق الإنسان المتراكمة – والذي تجلّى في الأقصر العام 2015 والقاهرة العام 2016 – باعتباره من تدبير عملاء أجانب. كما اتُّهِمتْ حكومات قطر، وتركيا، والولايات المتحدة، وكذلك حركة حماس،10 بإثارة موجات الاحتجاج بهدف تقويض الأمن الوطني وتحويل مصر إلى دولة فاشلة.11
كذلك، بذل النظام العسكري جهوداً حثيثة لتقويض أركان المؤسسات المدنية وتطويعها. ففي العام 2015، أقرّ قانوناً للانتخابات البرلمانية يعطي الأفضلية للمرشحين المستقلين على قوائم الأحزاب السياسية، ما أضعف الأحزاب وحيّد المناقشات حول السياسة العامة. يُضاف إلى ذلك أن مسؤولي الحكومة وممثليها عكفوا، بإيعاز من المنافذ الإعلامية المحلية، وبصورة منهجية، على الانتقاص من شرعية المعارضة السياسية، والتشكيك بالسياسيين المدنيين، والإيحاء بأن الجنرالات – سواء كانوا من الجيش، أو الشرطة أو المخابرات – هم وحدهم الذين يصلحون للحكم في البلاد. كما جرى التركيز على أن المؤسسات المدنية داخل جهاز الدولة، ولاسيما الهيكل البيروقراطي للدولة وهيئات الإدارة المحلية، تعتمد على النواة العسكرية والأمنية المحورية للدولة المصرية.
على الرغم من القمع المنهجي، تستمر الفعاليات النشطة ضد النظام. ومع أن أعداد الاحتجاجات التي يجري الإبلاغ عنها آخذة بالتناقص منذ العام 2014، فإنها لاتزال مرتفعة، إذ إن العام 2015 قد شهد 3691 احتجاجاً.12 كما تنوّعت الشرائح السكانية المشاركة في الاحتجاجات لتشمل الطلاب، والعمّال، والموظفين المدنيين، والأطباء، وضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، و"الإخوان المسلمين"، والمفكرين المستقلين، ونشطاء المجتمع المدني.
إن التحديات الاقتصادية والأمنية والسياسية التي تواجهها مصر مُثبطة، ويتطلب تذليلها تحولاً جوهرياً في سياسات النظام. لابدّ أن يغيّر النظام استراتيجياته الأمنية لاستحداث سياسات فعّالة لمكافحة الإرهاب وضمان حكم القانون. كما ينبغي وضع حد للقمع ولانتهاك حقوق الإنسان واسع الانتشار كوسيلة لمواجهة التيارات المتطرفة الخطيرة في سيناء وأماكن أخرى. علاوةً على ذلك، يتعيّن على النظام أن يبتعد عن هدر موارد البلاد المحدودة في مشروعات إنشائية ضخمة – مثل "قناة السويس الجديدة" والعاصمة الإدارية الجديدة - وعن تمكين المؤسسة العسكرية من التوسّع الذي لامبرّر له في المجالين الاقتصادي والمالي. بدلاً من ذلك، يجب أن تُعطى الأولوية لتمكين القطاع الخاص وخلق بيئة تُعلي من شأن الشفافية وحكم القانون. وما لم يحدث هذا التحوّل، سيغدو التصدي لهذه التحديات أكثر صعوبة، ويفضي إلى المزيد من عدم الاستقرار.
1 Haroon Siddique and Ben Quinn, “Egypt: Death as Rival Rallies Clash–As It Happened,” Guardian, July 26, 2013, https://www.theguardian.com/world/2013/jul/26/egypt-showdown-army-supporters-muslim-brotherhood-live.
2 “More Than 22 Million Egyptians Live in Poverty: Report,” Egyptian Streets, July 13, 2014, http://egyptianstreets.com/2014/07/13/more-than-22-million-egyptians-live-in-poverty-report/. Aswat Masriya, “27.8 Percent of Egyptian Population Lives Below Poverty Line: CAPMAS,” Egypt Independent, July 27, 2016, http://www.egyptindependent.com/news/278-percent-egyptian-population-lives-below-poverty-line-capmas.
3 “Egypt,” in Human Development Report 2015, Selim Jahan (NewYork: United Nations Development Program, December 14, 2015), http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/EGY.pdf.
4 الكتاب الإحصائي السنوي"، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المركزي، http://www.capmas.gov.eg/Pages/StaticPages.aspx?page_id=5034.
5 “Egypt,” World Bank, 2016, http://www.worldbank.org/en/country/egypt.
6 “Egypt’s Budget Deficit Rises 18pct in Jul-Apr on High Debt Service,” Ahram Online, June 21, 2016, http://english.ahram.org.eg/NewsContent/3/12/223551/Business/Economy/Egypts-budget-deficit-rises-pct-in-JulApr-on-high-.aspx.
7 Data provided during personal communications with local journalist; “Islamic State Claims Deadly Attack on Egyptian Soldiers in Sinai,” Reuters, November 26, 2016, http://news.trust.org/item/20161124220556-8rrcd/.
8 “Egypt: Events of 2015,” in World Report 2016, ed. Human Rights Watch (New York: Human Rights Watch, 2016), https://www.hrw.org/world-report/2016/country-chapters/egypt.
9 Hani Hodaib, “The Struggle in the Egyptian Medical Syndicate,” Tahrir Institute for Middle East Policy, March 2, 2016, https://timep.org/commentary/struggle-in-egyptian-medical-syndicate/.
10 Kareem Fahim, “Egyptian Officials on Defensive Amid Uproar Over Policy Brutality Case,” New York Times, December 3, 2015, http://www.nytimes.com/2015/12/04/world/middleeast/egypt-police-brutality.html?_r=0; “Egypt Protest After Tea Vendor ‘Killed by Police,’” BBC, April 19, 2016, http://www.bbc.com/news/world-middle-east-36084846; Zeinobia, “Protest in Luxor Over Police Brutality: Back to the Old Times,” Egyptian Chronicle (blog), November 28, 2015, http://egyptianchronicles.blogspot.com/2015/11/protest-in-luxor-over-police-brutality.html.
11 في حالتين على الأقل، وهما مقتل مواطن كان في عهدة الشرطة مدينة الأقصر الواقعة جنوبي البلاد في العام 2015 ومقتل مواطن آخر على يد شرطي في حي الدرب الأحمر في القاهرة في 2016، اندلعت احتجاجات شعبية عارمة ضد وحشية الشرطة ودفعت وزارة الداخلية إلى الشروع في تحقيقات قانونية ضد أفراد الشرطة المتورطين في هذه الانتهاكات فضلاً عن الوعد بالمساءلة وإحداث تحسينات في أداء الشرطة. للحصول على تغطية للحادثين، انظر: محمد حمامة، "ما حدث في اﻷقصر قد لا يبقى في اﻷقصر"، موقع مدى مصر، 14 كانون الأول/ديسمبر 2015، http://www.madamasr.com/ar/2015/12/14/feature/سياسة/ما-حدث-في-اﻷقصر-قد-لا-يبقى-في-اﻷقصر.
12 "مؤشر الديمقراطية: 3691 احتجاجاً فى مصر خلال عام 2015"، مؤسسة مؤشر الديمقراطية، http://demometer.blogspot.com/2016/01/3691-2015.html; وأيضاً: "مؤشر الديمقراطية: 3691 احتجاجا في 2015.. والمصريون يتحدون قانون التظاهر بـ32 طريقة بينها الحملات الإليكترونية والمعارض، موقع البداية، 24 كانون الثاني/يناير 2016، http://albedaiah.com/news/2016/01/24/105400.
وسائل الإعلام وتكنولوجيا المعلومات
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
يشكّل المواطنون العرب مواقفهم اليوم في سياق تغيّر جوهري لا عودة عنه في طبيعة التواصل السياسي. فقد استخدمت البلدان العربية وسائل الإعلام لعقود عدة كأدوات للتعبئة والسيطرة السياسية. وأسهمت الرقابة الخانقة والبث الإذاعي ثقيل الوطأة الصادر عن الدولة في التحكّم بدفق المعلومات المُتاحة للمواطنين العرب. غير أن سيطرة الدولة بدأت بالتآكل في تسعينيات القرن الماضي مع ظهور محطات التلفزيون الفضائية مثل قناة الجزيرة. وأتاح انتشار الإنترنت السريع للمواطنين فرصاً غير مسبوقة للنفاذ إلى المعلومات والتعبير عن آرائهم. من هنا، حدثت الانتفاضات العربية العام 2011 في منطقة مشبّعة بالإعلام، إذ كان أغلب مواطنيها يحصلون بصورة منتظمة على المعلومات من طيف محيّر من محطات التلفزيون، والصحف، والمواقع الإلكترونية، ومنافذ التواصل الاجتماعي.
يشكّل المواطنون العرب مواقفهم اليوم في سياق تغيّر جوهري لا عودة عنه في طبيعة التواصل السياسي.
إن النفاذ إلى الإنترنت، الذي كان ذات يوم محدوداً بالمقاييس الدولية، انتشر على نطاق واسع بسرعة بالغة، مثلما شاع استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بما فيها فايسبوك وإنستغرام وتويتر. وكان لانتشار وسائل الإعلام المباشرة والإذاعية أثر بالغ خلال الانتفاضات العربية، عندما أدّت دوراً حاسماً في الربط بين الحركات الاجتماعية في المنطقة ونشر ديناميكيات الكفاح السياسي في تونس إلى البلدان. وأتاحت الانتفاضات، بدورها، لشخصيات كانت مهمّشة في الماضي فرصة النفاذ إلى القنوات الإعلامية الرئيسة، في الوقت الذي شجّعت فيه على بروز العديد من المنابر الإعلامية المباشرة الجديدة.
غير أن الآمال التي عُقدت أول الأمر على هذه البيئة الإعلامية المفتوحة، سرعان ما خفّفت منها العقبات نفسها التي تعترض التطلعات إلى التغيير في المنطقة. فبدأت الأنظمة العربية باستغلال الأشكال الإعلامية الجديدة، وسخّرت الموارد لاستخدامها كأدوات للقمع، والتعبئة، والرصد والسيطرة. وبالمثل، بدأ مراقبو الدولة بفرض الضغوط على محطات التلفزيون الفضائية العابرة للحدود، واستخدامها كأدوات سياسية لتشجيع الانتفاضات ضد خصومها في المنطقة، مع مواصلة دعم أنظمة الحكم الصديقة. وقد أبدت مؤسسات الإعلام الوطنية، حتى في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، مقاومتها لهذا التغيير الرئيسي وظلت خاضعة إلى هيمنة الموالين للنظام القديم. وبرزت المنابر الإعلامية الأحدث عهداً لتمثّل في غالب الأحيان مصالح الأحزاب السياسية أو الممولين الأثرياء.
لايمكن أن نحمّل الأنظمة مسؤولية جميع العلل التي أصابت هذه البيئة الإعلامية الجديدة. فقد تفاقم الاستقطاب السياسي على أسس طائفية وإيديولوجية جرّاء التوجه العالمي نحو الإعلام الجهوي، ونزوع مستهلكي الإعلام الاجتماعي إلى تصنيف أنفسهم في جماعات مُغلقة متشابهة فكرياً. وأسهمت هذه التوجهات في حالة الاستقطاب والارتياب على أسس إثنية وطائفية وإيديولوجية، ما أدى إلى تقويض عمليات الانتقال السياسي.68 وعلى سبيل المثال، كان الإعلام الاجتماعي جزءاً لا يتجزأ من ممارسات تنظيم الدولة الإسلامية والفئات المتطرفة الأخرى، التي طوّرت منظمات إعلامية متقدّمة لتنسيق الجهود عبر الحدود، ونشر الدعاية، واجتذاب المجنّدين على الصعيد العالمي.
اتّضحت هذه التأثيرات الإعلامية بأجلى صورها في البلدان الانتقالية، بما فيها مصر وتونس، حيث فاقمت وسائل الإعلام المخاوف المتبادلة ومن انهيار الوحدة الثورية بين الإسلاميين وخصومهم. وقد أثبتت وسائل الإعلام أنها أداة مؤثرة لحشد التأييد للانقلاب في مصر العام 2013 وللحيلولة دون بروز الخلافات السياسية في بلدان أخرى.69 وقد سعت الدول العربية إلى استعادة سيطرتها على الوسائل الإعلامية وحشد جهودها من أجل المحافظة على استئثارها بالحكم.
ويوفّر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين فرصاً جمّة للاتصال بالآخرين عبر المسافات الاجتماعية والفيزيقية.
ومع أن لدى الدول والأنظمة موارد هائلة تسخّرها للسيطرة على وسائل الإعلام واستغلالها، فإنها مع ذلك ستبذل قصارى جهدها للهيمنة على تدفّق المعلومات. وقد غدا الشرق الأوسط إحدى أكثر مناطق العالم تبنّياً للإنترنت، حيث تطرح التغيّرات التكنولوجية على الدوام أساليب جديدة للتواصل، بحيث أصبح المواطنون العرب يعتبرون النفاذ إلى المعلومات وحرية التعبير من حقوقهم الأساسية.70 وحتى بعد سنوات من انبعاث الاستبداد الأوتوقراطي، أعرب ثلثا المستجيبين في مسح البارومتر العربي العام 2016 عن اعتقادهم بأن بوسعهم توجيه النقد للحكومة من دون خوف.71 ويوفّر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للمواطنين فرصاً جمّة للاتصال بالآخرين عبر المسافات الاجتماعية والفيزيقية. ولهذا السبب، فإن جهود الدولة لإعادة فرض الرقابة والهيمنة على السكان ستواجه في المستقبل مقاومة أكثر صلابة.
مقال
"البارومتر العربي" و"أصوات عربية"
يمثّل "البارومتر العربي" شراكة بحثية تساهم فيها مبادرة الإصلاح العربي، وجامعة برنستون وجامعة ميشيغان. وقد أجرت منذ العام 2006 استطلاعات علمية مكثّفة حول التوجهات السياسية والاجتماعية.1
وفي نطاق الموجة الرابعة من البارومتر العربي، حدّد المستجيبون في الجزائر، ومصر، والأردن، والمغرب، وفلسطين، وتونس، وبنسب عالية، قضيّتي الاقتصاد والفساد باعتبارهما، حسب تصورهم، التحدِّيين الأكثر خطورة. والأهم من ذلك هو نسبة المواطنين العرب الذين أكدوا انتشار الفساد وتعاظم مخاطره على نطاق واسع. فقد ذكر خمسة وأربعون في المئة ممّن شملهم المسح أن الفساد يمثل واحداً من أبرز خطرين يتهددّان بلدانهم. ويرى تسعون في المئة من التونسيين أن ثمة قدراً من الفساد، أو كثيراً منه في أوساط الحكومة. وهذا ما يراه كذلك 84 في المئة من الجزائريين والمصريين، و83 في المئة من الفلسطينيين، و76 في المئة من المغاربة، و63 في المئة من الأردنيين.
ولاتزال الديمقراطية تتمتع، مبدئياً، بنسبة عالية من المؤازرة، حيث أبدى أكثر من 70 في المئة من المستجيبين في كل دولة موافقتهم على عبارة مؤداها أن "الديمقراطية قد تواجه المشاكل، لكنها أفضل من الأنظمة الأخرى". بيد أن حدة الحماس خفّت، ربما جرّاء الإخفاق الذي مُنيت به مراحل الانتقال العربية. ومن البلدان الستة التي شملها المسح، اعتبر عشرة في المئة من المستجيبين في الجزائر وحدها ترويج الديمقراطية إحدى القضيتين اللتين تتصدران قائمة التحديات التي تواجهها البلاد.
وفي شباط/فبراير 2016، نشر مشروع "آفاق العالم العربي" الذي تُشرف عليه مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي نتائج المسح المُسمّى "أصوات عربية"، الذي استعرض وجهات النظر التفصيلية لأكثر من مئة خبير من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن فيهم عدد من أبرز المفكرين السياسيين في المنطقة.2 ومع أن هذا المسح لم يكن ذا طابع علمي مثل البارومتر العربي، فإنه تضمّن عدداً من الأسئلة التحليلية المفتوحة التي تلقي بعض الضوء على المآزق السياسية التي تواجهها المنطقة.
ومع أن الخبراء لم يحدّدوا بالإجماع الأسباب الكامنة وراء اضطرابات الشرق الأوسط، فإن أغلبيتهم الكاسحة أعطت الأولوية للتحديات المحلية والسياسية، مثل النزعة التسلطية والفساد، وليس للتحديات الجيوسياسية، مثل النزاعات الإقليمية، والمنافسات الطائفية والتدخل الأجنبي. كما أعرب هؤلاء، بما يشبه الإجماع، عن استيائهم البالغ من قصور استجابة حكوماتهم لما يواجهونه من تحديات.
وبينما أعرب نحو 80 في المئة من الخبراء عن اعتقادهم بأن الديمقراطية نظام مناسب للبلدان العربية، فإنهم، على العموم، رأوا أن الحوكمة الديمقراطية ليست غاية بحد ذاتها، بل هي وسيلة للارتقاء بمبدأ المحاسبة والمساءلة والتصدي للفساد. وعندما طُلب منهم تسمية ثلاث من الدول العربية التي تتوافر فيها الحوكمة الأكثر فعالية، استشهد اثنان من كل ثلاثة منهم بتونس، وأشار الآخرون مراراً وتكراراً إلى المغرب والإمارات العربية المتحدة. ومن جهة أخرى، قال واحد من كل خمسة من هؤلاء الخبراء إن الحوكمة الرشيدة لا تتوفّر في أي بلد عربي.
1 Data for Algeria, Egypt, Jordan, Morocco, Palestine, and Tunisia in “Arab Barometer IV,” Arab Barometer, publication forthcoming 2017, http://www.arabbarometer.org/.
2 Perry Cammack and Marwan Muasher, “Arab Voices on the Challenges of the New Middle East,” Carnegie Endowment for International Peace, February 3, 2016, http://carnegieendowment.org/2016/02/12/arab-voices-on-challenges-of-new-middle-east-pub-62721.
مقالالمؤسسات أولاً
سلام فياض
لا شك في أن بدء الإصلاح السياسي عملية صعبة، غير أن استمراره واستدامته أكثر صعوبة. ولا تقتصر هذه الصعوبة على المجتمعات العربية وحدها، وتشهد على ذلك التحديات والاضطرابات التي غالباً ما كان على الديمقراطيات الفعالة أن تواجهها في مراحل تكوينها الأولى. ويتطلّب التعامل مع التحدي المتصل بصعوبة تحقيق الاستدامة المنشودة، الانخراط في عملية تدرّجية ذكيّة تسهم في إقامة مؤسسات الدولة وتوفّر لها الحماية، فيما تمهّد السبيل للمزيد من الإصلاحات في المستقبل.
إن محاولة الانتقال من نظام تسلطي إلى نظام ديمقراطي متقدّم عن طريق الانتخابات وحدها، محكومة بالفشل.
إن محاولة الانتقال من نظام تسلطي إلى نظام ديمقراطي متقدّم عن طريق الانتخابات وحدها، محكومة بالفشل. وعليه، لا بدّ في مرحلة ما من التمعّن وإدراك أن الانتخابات ليست أساس الديمقراطية، بل أحد مظاهرها، وأن استدامة الاصلاح السياسي بعد الشروع فيه، تتطلّب الاسترشاد بمبدأ أساسي موجِّه يقوم على اتّباع مقاربة التدرّج الذكي المُشار إليها.
لطالما تبنّت قوى دولية مؤثّرة فكرة مؤداها أن المبادئ الديمقراطية لا بدّ أن تتكرّس في حال إجراء انتخابات حرّة وعادلة، أو بعبارة أبسط، الفكرة القائلة إن الانتخابات تأتي أولاً لتليها الحرية الفردية في وقت لاحق. غير أننا شهدنا، مراراً وتكراراً، سرعة وقوع ديمقراطيات حديثة العهد في الشرك نفسه الذي وقعت فيه سابقاتها: إذ يتم قمع حركات الاحتجاج، وتُشدَّد الرقابة على الصحافة ، بل حتى يُفرَض الحظر على النقد الساخر.
في الكثير من الأحيان، يشعر الزعماء المنتخَبون ممن يفتقرون إلى الخبرة بالضعف، عندما يتولون الحكم في بلدان يسودها الاضطراب، الأمر الذي غالباً ما يدفعهم إلى اللجوء إلى الأساليب التي يمارسها القادة السلطويون، بدلاً من العمل على إرساء تقاليد القيادة الرشيدة. ونتيجةً لذلك، تسقط المُثُل الديمقراطية والحقوق المدنية ويضرب بها عرض الحائط بحجة الحرص على تحقيق الاستقرار.
إذا كانت استدامة الإصلاح السياسي هي الهدف الأساس، فلا بدّ من توفّر قاعدة من المؤسسات القوية التي تصون المبادئ الديمقراطية الأساسية، حتى في غياب الانتخابات. كما أن حرية التعبير وشفافية الإدارة عنصران جوهريان لنظام أكثر ديمقراطية، لأنهما يُمثّلان مدخلاً لتحقيق إصلاحات إضافية. وإذا بدا نظام الحكم التسلطي وذلك المكرّس لخدمة الشعب مفهومين متناقضين، بيد أنهما ليسا كذلك تماماً. إذ قد يتعايشان سويّاً إلى أن يطغى أحدهما على الآخر. فعلى سبيل المثال، إذا تمكّن المواطنون من النقاش بصراحة بشأن نفقات حكومتهم، وحصلوا على قدر معيّن من التجاوب، فإنهم لن يشعروا بالتمكين فحسب، بل إنهم سيلاحظون الفرق إذا ما جُرِّدوا من هذه الحقوق. وهكذا، بشكل أو بآخر، يبدأ الشعب في فرض الضوابط والمساءلة على الحكومة. وشيئاً فشيئاً، وعلى نحو متدرج، يتطوّر واقع ممارسة الحكم الرشيد بما يؤسس للتحوّل من نظام حكم مكرّس لخدمة الشعب إلى نظام يقوم بذلك كونه مستمداً من الشعب، وصولاً في نهاية المطاف إلى نظام مختار من قِبله.
ولا يعني ما سبق أن على المرء أن يكتفي بالنتائج المتواضعة. إنه يعني أن الأهداف المتواضعة قد تكون في كثير من الحالات جزءاً مما سيتكشف بعد حين بوصفه الطريق الطويل المؤدي إلى الديمقراطية. ولا بدّ للمساعي الرامية إلى تحقيق أفضل النتائج من أن تقيم، على نحو متدرج، مؤسسات ترسخ المبادئ والحقوق الديمقراطية الأساسية وتصونها– بدءاً من حق النفاذ إلى المعلومات، وحرية الرأي والصحافة.
وإذا بدا أن هذا التوجه ينطوي على دعوة للقبول بما هو دون المستوى المطلوب، فسيكون ذلك، وعلى درب الطريق الطويل المؤدي إلى أنظمة ديمقراطية كفؤة، كلفة زهيدة بالمقارنة مع الكلفة الباهظة لإخفاق عملية الإصلاح السياسي، أو، ما هو أكثر كلفة، التخلّي عنها لصالح نقيضها.
سلام فياض اقتصادي ورئيس وزراء سابق في السلطة الوطنية الفلسطينية.
مقالالإنترنت، ووسائل الإعلام والدولة في مصر
لينا عطا الله
في صيف عام 2016، انتشرت في مصر أنباء عن أن قانوناً للإعلام يوشك على الصدور. وقد بدأ إعداد المسوَّدة منذ عام 2014، عندما شكّل رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب لجنة لوضع القانون الجديد. كان الدافع لإعداد هذه المسوّدة، التي ما زالت مثاراً للخلاف، الرغبة في السيطرة على ما تعتبره مؤسسات الدولة فضاءات إعلامية يعوزها التنظيم، ولا سيما تلك التي يمكن النفاذ إليها عبر الإنترنت.
وتحتوي المسوّدة على عدد من الإجراءات التحريمية مثل فرض الرقابة رسمياً إبّان الحرب - حتى ولو طُبِّقَت بموجب أمر قضائي - وحظر انتشار ما تنقله وسائل الإعلام الأجنبية، إذا رأى المسؤولون أن مضمونها سيلحق الضرر بالأمن القومي. وتُفرض غرامات قد تصل إلى مليون جنيه (نحو 113000 دولار) إذا أقدمت الوسيلة الإعلامية على النشر بدون ترخيص.1 وتحتوي المسوّدة على عدد من الإجراءات التحريمية مثل فرض الرقابة رسمياً إبّان الحرب - حتى ولو طُبِّقَت بموجب أمر قضائي - وحظر انتشار ما تنقله وسائل الإعلام الأجنبية، إذا رأى المسؤولون أن مضمونها سيلحق الضرر بالأمن القومي. وتُفرض غرامات قد تصل إلى مليون جنيه (نحو 113000 دولار) إذا أقدمت الوسيلة الإعلامية على النشر بدون ترخيص.
منذ أمد بعيد، يمثّل الإنترنت للمصريين فضاءً سياسياً بديلاً استطاعت المنافذ الإعلامية الشابّة تشغيله وتقديم نوع من الصحافة يختلف عن تلك التي تدعمها أساساً أموال الدولة أو ثروة الشركات الكبرى. وقد رضخت وسائل الإعلام بالدولة لمستويات جديدة من التقييد غير المسبوق، إما بأوامر صادرة عن مؤسسات الدولة، أو بوسائل التخويف غير المباشر أو الآثار المزعجة التي تخلّفها مشاهدة اعتقال الصحافيين، أو، ببساطة، جرّاء الضغوط التي يمارسها الأثرياء الذين يدعمون هذه الوسائل الإعلامية.
ومع أن الأصوات الجديدة عبر الإنترنت، مثل "أصوات مصرية"، و"قُلْ"، و"زائد 18"، و"زحمة"، و"ولاد البلد"، و"مدى مصر" . . . ستحدّد مستقبل الصحافة في البلاد، إذا قُدِّر لها البقاء والاستمرار.
ومع أن الأصوات الجديدة عبر الإنترنت، مثل "أصوات مصرية"، و"قُلْ"، و"زائد 18"، و"زحمة"، و"ولاد البلد"، و"مدى مصر" - التي أسهمتُ في تأسيسها – ما زالت هامشية في قدرتها على اجتذاب قطاع واسع من الأنصار، فإنها ستحدّد مستقبل الصحافة في البلاد، إذا قُدِّر لها البقاء والاستمرار. فهي المنافذ التي ما فتئت تجرّب الصحافة التفسيرية ذات الدلالة، وتفسح المجال لكتّاب يحملون أفكاراً جديدة حول كيفية التعامل مع حالة مصر، وتنشر كتابات ذكية حول الاقتصاد (وهو قضية مصر الأكثر إلحاحاً)، كما أنها خلقت حيّزاً للثقافات الفرعية اللافتة في مجال التحرير الصحافي.
إن الأصوات الجديدة عبر الإنترنت تلفت الانتباه – وأحيانا بدرجة أعلى من اللازم – على الرغم من موقعها في هوامش المشهد الإعلامي الرئيس الذي يستأثر به، على نحو متزايد، الأثرياء المتحالفون مع الدولة. وقد اعتُقلت في الآونة الأخيرة فرقة من الشباب لأنها كانت تنتج عبر الإنترنت، بدون أي كلفة، أشرطة فيديو سياسية ساخرة.
وبصرف النظر عما يمكن أن يحدث لقانون الإعلام الجديد، فإن الجميع يعلمون أن الدولة قد عقدت العزم على السيطرة على هذه الهوامش. وسيمارس النظام المصري عن طريق ذلك كامل السيطرة على وسائل الإعلام، من خلال قنوات الاتصال المباشرة غير الرسمية وسياسة التخويف في غرفة الأخبار- بدءاً من فرض الرقابة الذاتية وتحويل الثروة الخاصة باتجاه تعزيز وسائل الإعلام – وانتهاءً باللجوء إلى الأدوات الفظّة المتمثلة في إيداع الصحافيين السجن، وإغلاق منافذ الأخبار، وتكميم الأفواه، وبطبيعة الحال، سن التشريعات التحريمية.
وستبدي الأيام الكيفية التي ستقاوم بها هذه الوسائل الإعلامية الوليدة وتحافظ على ديمومتها ويتعاظم نفوذها. غير أن من المؤكد أنها قد تكون في طليعة الممارسات الإعلامية حالما يتحرّر الفضاء السياسي وتعود ملكيته إلى الشعب التوّاق الحريص كل الحرص على معرفة الحقيقة في غمرة المتاهات الإعلامية.
لينا عطا الله صحافية تقيم في القاهرة، وهي المؤسس المشارك والمدير للموقع الإلكتروني "مدى مصر".
1 Mohamed Shuman, “A Critical Eye on the Law for Organising Media,” Ahram Online, June 11, 2016, http://english.ahram.org.eg/NewsContentP/4/222497/Opinion/A-critical-eye-on-the-law-for-organising-media.aspx.
المشهد الجيوسياسي
مع أن الشرق الأوسط شهد مستوى عالياً من التوتر الجيوسياسي ونزاعات متواترة بين الدول خلال فترة الحرب الباردة، اتّسم هذا الاضطراب عموماً بالمبادئ المتصلة بسيادة الدولة، وبالاستقرار البنيوي النسبي بعد العام 1967. أما الآن، فقد انهار النظام الإقليمي وحلّت محلّه الفوضى، التي وصفها الفيلسوف البريطاني توماس هوبز في القرن التاسع عشر بأنها الوضع الطبيعي للإنسان: أي "حرب الجميع ضد الجميع". وفي ظل هذا اللانظام في الشرق الأوسط الجديد، ما من دليل على أن الدول القوية تُحجم عن التدخل في شؤون الدول الضعيفة. إذ تتنافس دول عديدة، بما فيها إيران وإسرائيل والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، على السيطرة الإقليمية، وتلعب أدواراً أكبر مما ينبغي في الدول المجاورة مثل ليبيا وسورية واليمن. وفي تلك الأثناء، تنوء القوى المركزية السابقة في المنطقة، مثل مصر والعراق، تحت وطأة أعبائها المحلية. ويمكن فهم انهيار النظام الإقليمي العربي من زوايا أربع: تهافت الدولة والنزاع الداخلي، والصراع الإقليمي، والجغرافيا السياسية للطاقة، والبيئة.
تهافت الدولة والنزاع الداخلي
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
تبيّن أن الخلل الذي أصاب الكثير من الدول العربية كان أعمق بكثير مما تصوّره غالب المراقبين، ذلك أنه زاد من حدة العجز الاجتماعي والاقتصادي عميق الغور في المنطقة، وفاقم الاستقطاب في مجتمعاتها، وضيّق احتمالات الوصول إلى التسويات أو المصالحات السياسية. وأدّى ذلك إلى انهيار مؤسّسي، وانهيار اجتماعي، وانهيار النظام الأوسع للدولة العربية.
تبيّن أن الخلل الذي أصاب الكثير من الدول العربية كان أعمق بكثير مما تصوّره غالب المراقبين.
وربما كان الانهيار المؤسسي هو الأكثر وضوحاً، حيث عجزت بنى الحوكمة عن تلبية المطالب المتعاظمة للسكان الساخطين. فطالما أمكن ترجمة عائدات المواد الهيدروكربونية إلى عدد كافٍ من الوظائف في القطاع العام لمواكبة التكاثر السكاني، كان في وسع الزعامات العربية التركيز على أمن نظام الحكم وإسباغ الشرعية المفروضة من الدولة عليه (والانخراط في عمليات النهب الاقتصادي في الكثير من الحالات) على حساب التنمية السياسية والاقتصادية الحقيقية. ونتيجةً لذلك، لم يكن مستغرباً أن تضم أغلب الدول العربية التي ضعضعتها الحرب الأهلية الدول الأكثر قمعاً – وهي العراق وليبيا وسورية – والأقل من حيث النمو المؤسسي – وهي ليبيا واليمن.
في المقابل، كان الانهيار الاجتماعي أكثر بروزاً في الدول التي تجزّأت على أسس طائفية وإثنية وحتى قبلية. ففيما كانت مؤسسات الدولة تواجه التفكك والتجزئة، ارتدّ الأفراد إلى هويّاتهم الأولية، الأمر الذي عجّل تفسّخَ الدولة. ويعني ذلك، من الناحية العملية، أنه حتى مع انتهاء القتال في دول مثل ليبيا وسورية واليمن، سيكون من المُستبعد أن يُعاد تشكيلها ككيانات سياسية موحّدة وخاضعة إلى سيطرة مركزية. إذن، لا بد من التفكير بترتيبات جديدة، بما فيها آليات دستورية تتيح للمناطق والجماعات المحلية مزيداً من الحرية لتتدبّر أمورها بنفسها وتوفّر الحماية المادية الملموسة للأقليات.
لقد أسهمت تلك الانهيارات المؤسسية والاجتماعية في تهافت نظام الدولة العربية على نطاق أوسع وغير مسبوق: فقد انقضى عهد التماسك النسبي والإحساس المشترك بالهدف الذي كان يميّز الأعمال الجماعية التي تقوم بها الدول العربية. ففي حين كانت للنزاعات في ليبيا وسورية واليمن جذور محلّية تحديداً، فإن اندلاع الصراعات في الوقت نفسه يقدّم دليلاً قويّاً على التفاعل الديناميكي بين الروابط الإقليمية التي تتسبّب في عدم الاستقرار.
يمثّل انهيار نظام الدولة العربية مفارقة محيّرة. ففي العام 2016 بلغت اتفاقية سايكس–بيكو، وهي المخطط البريطاني الفرنسي لتقسيم الامبراطورية العثمانية السابقة إلى مجالات للهيمنة، عامها المئة. وارتبطت هذه الاتفاقية في المخيّلة الشعبية بالحدود الاصطناعية المفترَضة للشرق الأوسط، والتي رأى القوميون العرب أنها صُمِّمَت لتقسيم ما كان يُعتبر شعباً عربياً واحداً موحّداً. لكن على الرغم من هذا التراث الاستعماري المدمّر، أثبتت الحدود العربية أنها أكثر ثباتاً وديمومة من كثيرٍ غيرها في البلقان، وشرق أفريقيا، أو جنوب شرق آسيا، التي شهدت ولادة دول جديدة، أو تحوّل دول أخرى من حال إلى حال.
وفي الوقت نفسه، فإن الافتراض بأن ثمة حدوداً "طبيعية" في الشرق الأوسط هو مفهوم ينطوي على مخاطر محتملة، إذ يعني أن المؤسسات السياسية الأكثر استقراراً قد تتبلور فقط عندما تُرسم هذه الحدود. وينطلق التفكير هنا من أن هذه الحدود الطبيعية يمكن تحديدها ورسمها بغرض التجانس الإثني والطائفي، وفتح الأبواب على مصاريعها لعنف وتدمير أكثر مما يزلزل المنطقة الآن. وباستثناء النزاع العربي الإسرائيلي والمواجهات العربية الكردية في سورية والعراق، فإن جوهر الاضطراب في الشرق الأوسط لا يتمحور حول الأرض، بل يدور حول طبيعة الدول الواقعة داخل الحدود، لا حول الحدود بين الدول. وفي كلٍّ من الدول الأربع التي تعاني ما يبدو أنه نزاع مستعصٍ على الحل، وهي العراق وليبيا وسورية واليمن، قطعت التجزئة السياسية أشواطاً بعيدة، وفي أفضل الحالات، يبدو أن نظام الحكم اللامركزي سيكون الاحتمال الأرجح.
[هذه النزاعات] تدور حول طبيعة الدول الواقعة داخل الحدود، لا حول الحدود بين الدول.
كانت لحروب الشرق الأوسط نتائج كارثية زادت من وطأة المشاكل العويصة التي تواجه المنطقة، ومنها الإزاحات وموجات النزوح البشرية الهائلة، وعدم الاستقرار السياسي (ليس في الدول المجاورة وحسب، بل أيضاً في دول أوروبية وغيرها)، والتدخل الإقليمي. ولم يكن الإرهاب غائباً تماماً عن المنطقة في العقود الماضية، بيد أن غزو الولايات المتحدة للعراق العام 2003 والانهيار الإقليمي منذ العام 2011، أطلقا موجة إرهاب مهولة من عقالها في دول المنطقة الفاشلة. وقد شهد العراق أكثر من 2000 هجوم انتحاري بين عامَي 2003 و2015، شكّلت 41 في المئة من جميع الهجمات الانتحارية في العالم منذ العام 1982.72 وفي ليبيا، وسورية، واليمن، ومصر التي تشهد عصياناً أضيق نطاقاً في سيناء، تصاعدت الهجمات بصورة كبيرة منذ العام 2011.73
نظراً إلى الروابط القائمة بين النزاع الداخلي، والإرهاب العالمي، وتدفق اللاجئين، والكوارث الإنسانية، يُعدّ إنهاء حروب الشرق الأوسط العديدة التحدّي الأكثر إلحاحاً الذي يواجه قادة العالم. وما لم يتم احتواء هذه الصراعات، والحدّ منها، وحلّها في نهاية المطاف، ستغلب على جميع التحديات الإقليمية الأخرى.
في هذه الأثناء، ولأن درهم وقاية خير من قنطار علاج، على السياسات والجهات المانحة الدولية أن تركّز اهتمامها على مساندة الدول الضعيفة، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاع. وينبغي على الدعم الدولي أن يعطي الأولوية بصفة خاصة للدول التي لديها حكومات مسؤولة نسبياً أو مجتمعات مدنية على الأقل، مثل تونس والمغرب والأردن ولبنان.
قد يبدو الوضع في الشرق الأوسط ميؤوساً منه، غير أن فشل الدولة ليس حالة دائمة. فمع أن الانهيار التام للدولة، كما هي الحال في سورية، يغيّر مسار البلاد بصورة دائمة، فإن دولاً عديدة قد استعادت عافيتها بشكل جزئي أو نشط خلال العقود الأخيرة، ومنها دول عدة في أفريقيا، والبلقان، وجنوب شرق آسيا. بل إن الصومال، وهي النموذج الأعلى للدولة الفاشلة، أظهرت مؤشرات معقولة على ولادتها من جديد منذ نشر قوات الاتحاد الأفريقي فيها العام 2007.74 وتجنّبت بلدان عربية أخرى السقوط في وهدة الهوة السحيقة. فعلى الرغم من هشاشة الوضع في لبنان، أفلح في التعافي جزئياً من نزاع أهلي مدمّر، مثلما تعافت اليمن من النزاعات المبكرة في ستينيات وسبعينيات وتسعينيات القرن الماضي، مع أنها انتكست وسادها الاضطراب منذ ذلك الحين. لذا، فإن عودة الاستقرار في سورية في المستقبل ليست محتملة وحسب، بل هي ممكنة أيضاً.
دراسة حالة 6
ليبيا – الدولة المجوّفة
ليبيا اليوم دولة فاشلة، ابتُليت بمؤسسات جوفاء أو غير موجودة، واقتصاد منهار، وعنف وبائي مُستوطن، وبتشكُّل هُويّات محليّة دون وطنية.
يصعب على المرء، بعد خمس سنوات من الإطاحة برجل ليبيا القوي معمر القذافي، أن يتذكّر موجة التفاؤل، بل الاستبشار، التي استقبلت بها الثورة الليبية أول الأمر في العام 2011. وصحيح أنها كانت عنيفة، غير أنها لم تستغرق وقتاً طويلا. كانت ليبيا آنذاك تُعتبر المثال "الأفضل": فهي بلد غني بثروته النفطية، وقليل السكان الذين يغلب عليهم الطابع الحضري. يُسهل الوصول إليه جغرافياً، كما أنه، نسبياً، متجانس من الناحية الإثنية والتكوين الطائفي.
وخلال النصف الأول من العام 2012، كانت الدلائل تؤيد هذه الحجج. فقد كانت الدولة تتسم بالهشاشة، لكنها كانت مستقرة نسبياً. وعادت السفارات والمصالح التجارية الغربية إلى ليبيا، ونشط المجتمع المدني، وقفز إنتاج النفط بأسرع مما كان متوقعاً ليقارب مستويات ما قبل الحرب، التي بلغت مليوناً وستمئة ألف برميل يومياً.1 غير أن الدليل الأوضح على النجاح كان يتمثّل في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم 7 تموز/يوليو 2012، واعتبرها المراقبون الأجانب شفافة، وعادلة، وخالية من العنف، عدا بعض الاستثناءات المتفرقة.
أما الآن، فقد باءت الدولة الليبية بالفشل. إذ تقاسمت البلاد مجموعتان متنافستان تدين كل منهما بالفضل لمنظومة محيّرة من المليشيات المرتبطة بالبلدات والقبائل وسماسرة السلطة المحليين. وقد ولّت السفارات والشركات الأجنبية أدبارها. كما هرب نشطاء المجتمع المدني، أو قُتلوا، أو أُرغموا على الصمت. كما انخفض إنتاج النفط في تشرين الأول/أكتوبر 2016 إلى 300 ألف برميل في اليوم.2 وانهار الدينار الليبي وتَرك الليبيين العاديين تحت رحمة السوق السوداء لشراء الدواء والمواد الغذائية الأساسية، وكلاهما شحيح إلى درجة خطيرة.3
وقد أدّت الحرب بين الفئات المنشقة إلى تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في بنغازي، مهد الثورة، وأرغمت آلاف الناس على الهجرة. وفي طرابلس العاصمة، حيث تتمسك بالسلطة حكومة وحدوية تدعمها الأمم المتحدة، تَوقَف جمع النفايات، وغدت أحياء كاملة تعاني من فترات تعتيم تمتد كلٌّ منها عشر ساعات يومياً. وارتفعت معدلات الجريمة في أقصى الجنوب، حيث يقوم ممارسو الإتجار بالبشر بنقل عشرات الآلاف من المهاجرين الأفريقيين عبر الصحراء ثم إلى أوروبا.4 وفي غضون ذلك، ترسّخ تنظيم الدولة الإسلامية وغدا جزءاً لايتجزأ من مدينة سِرْت، مسقط رأس القذافي، المجاورة لمنطقة "الهلال النفطي" الاستراتيجية، وفي جيوب أخرى في الأجزاء الشرقية والغربية من البلاد.
كيف حدث ذلك؟ يتندّر الليبيون في ما بينهم بالقول إن ليبيا لايمكن اعتبارها دولة فاشلة لأنها لم تكن دولة أصلاً لتتعرض للفشل. فقد أورثهم القذافي بلداً أجوفَ مجرّداً من أية مؤسسات حاكمة. وخلّف هذا الفراغ المؤسسي أخطر نتائجه في القطاع الأمني. فقد عمل القذافي منذ عهد بعيد على تهميش القطاع العسكري النظامي خشية أن ينقلب عليه، وبالتالي ركّز السلطة في أيدي نخبة من الفصائل الأمنية التي يتولّى قيادتها أبناؤه. وبعد الثورة، تبخّرت الفصائل والأجهزة الأمنية الموالية له وحل محلها عدد ضخم من المليشيات.
في السنوات اللاحقة، تضخمت أعداد المنتسبين إلى تلك المليشيات وتزايد نفوذها، فاستولت على الوزارات، والمطارات، ومستودعات السلاح، وحقول النفط، والمراكز الجمركية بوصفها جميعا من الغنائم الاقتصادية ومن الوسائل المستخدمة لتأكيد ثقلها السياسي. وبما أن الحكومة الانتقالية لم يكن لديها الوسائل الكفيلة بضمان الأمن في البلاد، فإنها أخذت بتحويل الرواتب إلى المليشيات التي وُضعت تحت الإشراف غير المُحكم لوزارتَي الدفاع والداخلية. غير أن الفصائل المتنافسة استولت على هاتين الوزارتين.
والواقع أن الانتفاضة ضد القذافي كانت دائماً أكثر شرذمة مما يعتقد كثيرون، وأكثر انتشاراً بين أطراف عدّة: بين المناطق الشرقية المُهملة منذ أمد بعيد والغربية الأكثر نمواً؛ والقبائل والبلدات التي تمتّعت بحظوة القذافي والأماكن الأخرى التي حُرمت منها؛ وبين المنشقّين، ولاسيما الإسلاميين، الذين تعرضوا للسجن أو النفي، والتكنوقراط الذين تكيّفوا مع النظام وحاولوا إصلاحه؛ وبين طبقة الضباط الأكبر سنّاً ممن حاولوا المحافظة على بنية الجيش، والثوار الشباب الذين عقدوا العزم على إعادة تكوينه. وفي حواشي هذا المشهد، كانت الجماعات الإثنية التي تعرّضت إلى القمع منذ أمد بعيد، مثل الأمازيغ، والتبَّو، والطوارق، تطالب بحقوق أكثر في النظام الجديد.
بحلول منتصف العام 2013، كانت ظهرت أشكال جديدة من السياسات الإقصائية وتمثّلت في إصرار بعض الفصائل الإسلامية والثورية على إصدار قانون شامل للعزل السياسي، يحظّر على موظفي النظام السابق تولّي مناصب في القطاع العام في المستقبل. وبعد عام واحد، شهدت ليبيا اندلاع حرب أهلية شاملة بين جناحين يتسمان بالهشاشة والضعف، لكن لكلٍّ منهما حكومته الخاصة وهما: "فجر ليبيا" الذي يمثّل معاقل الإسلاميين والثوريين في غرب البلاد، مثل المحطة التجارية لتوليد الطاقة الكهربائية في مصراتة؛ وجناح "عملية الكرامة" الذي يمثل بقايا العسكريين، والقبائل الشرقية، والاتحاديين، وكذلك بعض البلدات القليلة في الغرب مثل الزنتان.
وقد أدّى التدخل الإقليمي، الذي بدأ منذ الثورة، إلى تأجيج الصراع. فقد قدّمت مصر والإمارات العربية المتحدة السلاح والمستشارين إلى قائد جناح "الكرامة" خليفة حفتر، وهو عدو لدود للاتجاه الإسلامي وضابط عسكري من عهد القذافي، هرب من النظام في ثمانينيات القرن الماضي.5 أما فصيل "الفجر"، فقد كانت قطر والسودان وتركيا تزوّده بالسلاح والمال.6
وبحلول شهر كانون الأول/ديسمبر 2015، عُقدت، برعاية الأمم المتحدة، اتفاقية أوقفت الحرب المكشوفة بين الطرفين وأسفرت عن قيام حكومة وحدوية جديدة هي "حكومة التوافق الوطني" التي اتخذ أعضاؤها من طرابلس مقرّاً لهم في آذار/مارس 2016. غير أن البرلمان المُعترف به في الغرب، وهو مجلس النواب، حجب الثقة عن حكومة التوافق الوطني،7 ولازالت شرائح من السكان في شرقي البلاد، وإلى حدّ ما في المناطق الغربية، تناصب هذه الحكومة العداء؛ وقد خاض الطرفان الحرب للسيطرة على البنك المركزي وواردات النفط.8
كانت الحكومات الغربية تأمل في أن تؤدي الأخطار التي يمثّلها تنظيم الدولة الإسلامية إلى الجمع بين الطرفين، لكن ذلك لم يحدث. فقد تحمّلت المليشيات في مصراتة، وبعضها إسلامي النزعة، وطأة القتال في معقل تنظيم الدولة الإسلامية في سِرتْ، بينما يواصل حفتر الحرب ضد مليشيات تنظيم الدولة الإسلامية التي تقاتل جنباً إلى جنب مع المليشيات الإسلامية الأخرى في بنغازي. وقد ساندت قوات العمليات الخاصة الغربية جميع الفصائل التي تواجه تنظيم الدولة الإسلامية. وأدّى ذلك، على نحو غير مقصود، إلى مضاعفة الشكوك لدى كل طرف تجاه الأطراف الأخرى.
تواجه حكومة التوافق الوطني سريعة العطب مخاطر جسيمة تهدّد بقاءها. فهي عاجزة، حتى في طرابلس، عن حماية نفسها تماماً من الميليشيات واسعة النفوذ، ناهيك عن تقديم ضمانات كافية للدبلوماسيين الأجانب لإغرائهم بالعودة. إضافةً إلى ذلك، عليها أن تجد آلية منصفة لتوزيع واردات النفط والسلطات السياسية مع الشرق والجنوب، والارتقاء بمستوى الحكم في المجالس البلدية، والسيطرة على حدودها. والأهم من ذلك كلّه أن من واجبها وضع خطة مستقبلية لإقامة بنية متماسكة لقوات الجيش والشرطة. ويشمل ذلك عملية تسريح الشباب من الميليشيات وتوفير الوظائف أو البعثات الدراسية لهم، أو ضمّهم إلى قطاع الأمن في الدولة.
يتضمّن توفير الفرص للشباب الليبي عملية إصلاح اقتصادي ضخمة، قد تستغرق جيلاً كاملاً، لتعزيز القطاع الخاص، مع تخفيف الاعتماد على الموارد الهيدروكربونية التي تمثّل أكثر من 90 في المئة من ريع الحكومة.9 وعلى الرغم من الانخفاض في إنتاج النفط الليبي وتراجع أسعار النفط عالمياً، فإن نفقات القطاع العام – وهو مصدر الدخل الأول لأكثر الليبيين – لازالت عالية. وتستنزف البلاد أرصدتها من احتياطي العملات الأجنبية بمعدلات تثير الخوف.
ويبدو أن ليبيا مُقدِمة على فترة مطوّلة من التحوّل إلى النظام اللامركزي في إطار دولة موحّدة وفضفاضة للغاية. وستُترك البلدات والبلديات لتدبّر أمورها بنفسها. وقد استطاع عدد قليل منها، مثل مصراتة، وطبرق، وزوارة، أن يستعيد جانباً من الحياة الطبيعية من خلال ترتيبات توصلت إليها القبائل، والمليشيات، والمسؤولون المنتخبون، وأصحاب الأعمال، وحتى شبكات الجريمة المنظمة. لكن المستقبل قد يتكشّف عن احتدام الصراع في أغلب المناطق، ولاسيما تلك التي يقيم فيها خليط من السكان، أو التي تتمتع بموارد استراتيجية، ومنها على سبيل المثال: بنغازي، وطرابلس، وجبال نفوسة، وحوض سِرْت.
لكن، على الرغم من هذه التوترات، من المستبعد أن تؤول الأمور في ليبيا إلى التقسيم التام. فالصراع يتموضع إلى درجة كبيرة محلياً في غالب الأحيان، ويدور بين البلدات والجماعات في مناطق محدّدة تاريخياً (منها على سبيل المثال: برقة، وفزان، وإقليم طرابلس/تريبوليتانا). أما التحدي الأكبر فهو إصلاح الحكم واختلال التوازن في الصلاحيات بين هذه المناطق، لا عزل بعضها عن بعض. وتلك مهمات مهولة بحد ذاتها، لكنها لا تستعصي على الحل. فقد أظهر الليبيون الآن قدرتهم على التصدي بصورة فعالة للدولة الإسلامية، وكسروا شوكتها في سِرْت وفي مواقعها الأخرى. وإذا ماتعزّز هذا الصمود بالتزام غربي وإقليمي بتقديم العون، قد يساعد على بدء عودة البلاد بصورة تدريجية إلى وضع سويّ.
1 Robert Tuttle and Saleh Sarrar, “Libya Oil Flow Rebounds From 10-Month Slide; Field Starts,” Bloomberg, January 6, 2014, http://www.bloomberg.com/news/articles/2014-01-06/libya-oil-flow-rebounds-from-10-month-slide-field-starts.
2 Benoit Faucon and Hassan Morajea, “Libya Plans to Load Oil at Long-Closed Port,” Wall Street Journal, September 14, 2016, http://www.wsj.com/articles/libya-plans-to-load-oil-at-long-closed-port-1473877615.
3 Alessandria Masi, “Libya’s Black Market Foreign Currency Exchange: From Healthcare to What’s on the Table, When the Exchange Rate Dictates Every Area of Your Life,” International Business Times, November 10, 2015, http://www.ibtimes.com/libyas-black-market-foreign-currency-exchange-healthcare-whats-table-when-exchange-2177104.
4 United Nations Security Council, Resolution 2312 (2016), October 6, 2016, http://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_res_2312.pdf.
5 “Libya’s Haftar Confirms Military Support for Operation Dignity From Egypt and UAE,” Middle East Eye, January 30, 2015, http://www.middleeasteye.net/news/libyas-haftar-confirms-support-operation-dignity-egypt-and-uae-1265705213.
6 Fehim Taştekin, “Turkey’s War in Libya,” Al-Monitor, December 4, 2014, http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/turkey-libya-muslim-brotherhood.html.
7 “Libya’s UN-Backed Government Gets ‘No Confidence’ Vote,” Al Jazeera, August 23, 2011, http://www.aljazeera.com/news/2016/08/libya-backed-government-confidence-vote-160822150247789.html.
8 Suliman Ali Zway and Declan Walsh, “Militia Seizes Libyan Oil Terminals in Challenge to Government,” New York Times, September 11, 2016, http://www.nytimes.com/2016/09/12/world/middleeast/militia-seizes-libyan-oil-terminals-in-challenge-to-government.html.
9 “Economic Diversification in Oil-Exporting Arab Countries,” International Monetary Fund, April 2016, http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2016/042916.pdf.
النزاع الإقليمي
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
ربما لم يتجسّد التفاعل المتشابك بين الصراعات التي تعيد تشكيل الشرق الأوسط في حدث ما في الآونة الأخيرة مثلما تجسّد في تدخّل روسيا في سورية في خريف العام 2015. فموسكو لم تضمن صمود نظام الأسد وحسب، بل كشفت أيضاً بما لا يقبل الشك عن عجز واشنطن، وخلقت اللحظة الأكثر تعقيداً على الصعيد الجيوسياسي منذ عقود.
وما زاد من المخاطر التي تنطوي عليها هذه النزاعات، أن الجهود المبذولة لتحقيق الإصلاح المحلّي ظهرت للعيان في السياق متزايد الالتباس الذي تتلاعب فيه المؤثرات الإقليمية والدولية، ولاسيما في الجزء الشرقي من العالم العربي. فقد قلبت الانتفاضات العربية الأوضاع السياسية الإقليمية رأساً على عقب، كما أن الوَهَن العميق الذي أصاب القوى المركزية العربية سابقاً بصورة خاصة، مثل مصر والعراق وسورية، أخلّ بميزان القوى. لذا، تعاظمت أدوار القوى الإقليمية غير العربية، وهي إيران وإسرائيل وتركيا، وأنظمة الحكم الملكية في الخليج. وقد تركت الحروب الكارثية المتعاقبة في العراق، والحرب في سورية في الآونة الأخيرة، فراغات مؤسسية في الشرق الأوسط، أدّت إلى تدخّل الأطراف المتنافسة في الدولتين، وإلى زعزعة الاستقرار في الأقطار المجاورة. وأسفر انهيار سلطة الدولة في ليبيا واليمن عن آثار مماثلة.
رسمت الحروب السياسية التي دارت عبر الحدود المسار المقبل، لا للبلدان المنشطرة فقط، بل كذلك لتلك التي تمر بمراحل انتقالية بعد انتفاضات العام 2011. ومن هنا، فإن بلدان الخليج التي تتوجّس خيفة من الديمقراطية وتحرص كل الحرص على المحافظة على الاستقرار الإقليمي، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، قدّمت الدعم للأنظمة الملكية المماثلة لها. كما ساندت الانقلاب العسكري في مصر العام 2013 مالياً وسياسياً، وأيّدت في تونس ائتلاف "نداء تونس" الذي عارض "النهضة"، الحزب الإسلامي الأبرز المرتبط بالحركات الإسلامية في مصر وتونس، وبذلك حوّلت السياسات المحلّية إلى منافسة واسعة النطاق لتعزيز النفوذ الإقليمي.75 عَنَت هذه المشاركة الخارجية الموسّعة أن المراحل الانتقالية، سواء تكلّلت بالنجاح أو باءت بالفشل، كانت مجردّ شأن محلّي في كل دولة.
عَنَت هذه المشاركة الخارجية الموسّعة أن المراحل الانتقالية، سواء تكلّلت بالنجاح أو باءت بالفشل، كانت مجردّ شأن محلّي في كل دولة.
لقد أتاح تفكّك العديد من الدول العربية لكثيرٍ من البلدان فرصاً جديدة لخدمة مصالحها الخاصة من خلال مساندة حلفاء محليين. وشملت هذا التدخل التمويل المُعلَن والخفي، وتسليح الحلفاء المحليين، والحملات الإعلامية من خلال المنافذ الإعلامية المحلية والعابرة للحدود، وفي بعض الحالات المتطرفة للغاية، من خلال العمل العسكري. أدّت هذه التصرفات، بشكل جوهري، إلى خلق "حروب بالوكالة"، ورسمت معالم السياسات المحلية. وقد وُضعت الصراعات المحلية على السلطة في إطار الانقسامات الإقليمية الأوسع، باعتبارها، على سبيل المثال، نزاعاً بين المسلمين السنّة والشيعة أو بين الإسلاميين وخصومهم. ولهذا السبب، فإن أية محاولة لمعالجة المشاكل المحلّية ستُمنى بالفشل ما لم تؤخذ هذه العناصر الديناميكية في الاعتبار.
ليس ثمة خط وحيد واضح للنزاع الإقليمي، بل خطوط عدة متقاطعة ومتداخلة تربط بين دول المنطقة، التي تفاوتت فترات قوتها ودوام نفوذها على مر الزمن:
إيران مقابل المملكة العربية السعودية
إن النزاع بين جناح "المعتدلين" الذي تدعمه الولايات المتحدة، ومعسكر "المقاومة" الذي حدّد معالم النشاط السياسي خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، قد أخلى السبيل لحرب بالوكالة ذات نزعة طائفية متعاظمة، تدور رحاها في حلبة إقليمية واسعة. وتنظر الرياض وطهران إلى النزاعات الدائرة في البحرين والعراق وسورية واليمن باعتبارها منافسة إقليمية بينهما، حتى وإن كانت تلك الروابط، في أحسن حالاتها، غير واضحة المعالم. وقد أضاف التوتر بين الدولتين بعداً جيوسياسياً إلى نزاعات كانت محلية أول الأمر، ما فاقم تعقيد الجهود المبذولة للتخفيف منها أو حلّها.
قطر وتركيا مقابل الإمارات العربية المتحدة والسعودية
يتمحور هذا النزاع الإقليمي حول التيار الإسلامي، ولاسيما "الإخوان المسلمين" والحركات المماثلة لهم فكرياً. وقد حدثت التدخلات الإقليمية بالوكالة في بلدان انتقالية مثل مصر وليبيا وتونس. إلا أن خط النزاع هذا قد انحسر نوعاً ما منذ أن تسلّم أمير قطر الشاب مقاليد الحكم في حزيران/يونيو 2013، وأدّى الانقلاب العسكري في مصر بعد ذلك بقليل إلى تصاعد حدة المعركة بين هذه البلدان إلى الذروة. ومنذ ذلك الحين، تعاون هذان الطرفان المتنافسان في الحربين السورية واليمنية، غير أن احتمال تجدّد الاستقطاب لايزال قاب قوسين أو أدنى.
إسرائيل مقابل فلسطين
لم يعد الصراع الفلسطيني محور الخلاف الإقليمي، بعد أن حلّ مكانه النزاع السوري. ولاتزال الأنظمة العربية تعلن تأييدها لحل الدولتين، غير أنها، على ما يبدو، تشعر بارتياح أكبر لتعاونها مع إسرائيل ضد إيران، حتى إن لم يتحقق أي تقدّم ملموس في القضية الفلسطينية. وليس هناك ما يدل على أن الجماهير العربية فقدت اهتمامها بفلسطين، غير أن التعاون بين إسرائيل والأنظمة العربية قد يبرز كقضية إشكالية وخلافية إذا ما استؤنفت المواجهة العنيفة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
السلفية الجهادية مقابل الأنظمة العربية:
أعاد تنظيما "الدولة الإسلامية" و"القاعدة" تشكيل التحدّي الجهادي الذي تواجهه الأنظمة العربية منذ أمد بعيد. وما من دولة تؤيّد الجهاديين علناً، غير أن لكل دولة إدراكاً خاصّاً مختلفاً لما يمثله هؤلاء من مخاطر، وما إذا كان عليها أن تعطي الأولوية لمحاربة الجماعات السلفية الجهادية، مثل تنظيم الدولة الإسلامية، أو التصدي لإيران، خصوصاً في العراق وسورية. وحتى لو انهار تنظيم الدولة الإسلامية في كلا البلدين، فإن ضروباً جديدة من التمرّد الجهادي قد تبرز على الأرجح، عندما يفسح فشل الدولة له المجال. ومن المؤكد أن تهديد الإرهاب يزيد من التحديات الأمنية والمجتمعية التي تواجه الأنظمة العربية، لكن البلدان العربية تذرّعت بهذا الخطر لتضييق الخناق على مجالات التعبير السياسي، والتجمّع الحر، والاحتجاج السلمي، باعتبار أن هذه الأنشطة تهدّد الأمن.
تجلّت صراعات القوى الإقليمية تلك في غمرة أوضاع دولية متقلبة. فقد اضطربت هيمنة الولايات المتحدة الإقليمية جرّاء الخلافات الحادة مع حلفاء رئيسين مثل مصر وإسرائيل والمملكة العربية السعودية وتركيا حول السياسة الأميركية في سورية، والاتفاق النووي مع إيران، والترويج للديمقراطية. كما تحرّكت روسيا، بطريقة انتهازية، تجاه المنطقة بصورة مباشرة عن طريق تدخلها العسكري في سورية، لاسترضاء حلفاء الولايات المتحدة المستائين ولتأكيد دورها كوسيط قوي لا يمكن الاستغناء عنه في الصراعات الاستراتيجية في المنطقة.
وفي دول الاستبداد الأوتوقراطي، أدّت حروب الوكالة هذه إلى تقويض مراحل الانتقال الديمقراطي، ودفعت الدول الهشّة إلى غمار الحرب الأهلية، وفاقمت النزعة الطائفية والتطرف العنيف.
وفي دول الاستبداد الأوتوقراطي، أدّت حروب الوكالة هذه إلى تقويض مراحل الانتقال الديمقراطي، ودفعت الدول الهشّة إلى غمار الحرب الأهلية، وفاقمت النزعة الطائفية والتطرف العنيف. ولم تقتصر آثار هذه النزاعات على الدول التي تدور فيها رحى الحرب، إذ أن تدفق اللاجئين من العراق وليبيا وسورية واليمن يفرض على البلدان المجاورة أعباء هائلة ومتزايدة. وعندما مدّت القوى الإقليمية يد التعاون، أسفر ذلك، عموماً عن تعزيز الحكم الأوتوقراطي أو استعادته على حساب الإصلاحات التي تبرز الحاجة إليها بصورة عاجلة. ومن هنا، تضافرت القوى الإقليمية والأجواء الدولية غير المستقرة لتكثيف مشاكل المنطقة بدلاً من تذليلها. وستغدو معالجة هذه التحديات المتعدّدة التي تواجه الحوكمة العربية أقرب منالاً عندما تنسحب هذه القوى من تلك المنافسات بالوكالة، التي لاتؤدي إلا إلى المزيد من عدم الاستقرار.
دراسة حالة 7
سورية – شبكة من الصراعات
تقع سورية في مركز الصراعات المتداخلة والمصالح الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
مع أن القصف الوحشي الذي قام به النظام السوري أسفر عن تدمير البلاد بصورة كاملة تقريباً، فإن التيارات التي أفضت إلى انتفاضة العام 2011 كانت تُشبه تلك التي شهدتها البلدان العربية الأخرى.
كثيراً ما نتناسى أن رئاستَيْ حافظ الأسد وبشار الأسد، مجتمعتين، قد جسّدتا أطول مثال على السلالات الجمهورية في العالم. فقد تسلّم حافظ الأسد السلطة في العام 1970 وبدأ، تحت شعار القومية العربية، ببناء دولة تعظّم المصالح الخاصة، سلطوية تتمحور حول نواة عشائرية طائفية، وتعزّزها المحسوبية. وجعل ذلك من سورية نموذجاً مثالياً لصيغة نشهدها في بلدان عربية أخرى.
بدأ كلٌّ من الأسدين الأب والابن، عهده بجولات منتظمة من عمليات القمع المحلّي (التي بلغت ذروتها عند القضاء على "الإخوان المسلمون" في حماة العام 1982) ومن المخططات المتواصلة للهيمنة الإقليمية (على الحركة الوطنية الفلسطينية وكذلك على لبنان). وكان الدافع إلى أنماط السلوك المحلّي والإقليمي تلك هو الحافز الحاسم التالي: الإبقاء على النظام والعصبة التي تتربّع على قمته.
أدّت خلافة بشار الأسد لأبيه في العام 2000، ومتابعته لدوره إلى تعميق وتضخيم كثير من النزاعات المتقلّبة في سورية. وكان من يؤمَل أول الأمر أن يستطيع طبيب العيون الذي تلقى تعليمه في بريطانيا، أن يعكف على تحديث بلاده. غير أن الانقضاض على حركة دمشق الإصلاحية في ربيع العام 2001 كان مقدّمة لتقلّص كلٍّ من قاعدة المساندة الشعبية للنظام وتوزيع الغنائم الاقتصادية، كما أدى إلى تعاظم السخط والخلاف الطائفي.1
علاوةً على ذلك، بدأ النسيج الاجتماعي في سورية بالتغيّر أيضاً. ففي السنوات التي سبقت الربيع السوري أغرق سوق العمل الشباب السوريون المتعطّلون، ولكن لم تتوفر آنذاك فرص التشغيل لاستيعاب المتعلّمين. ولم تؤَدِّ سلسلة القرارات الكارثية في المجالين الزراعي والاقتصادي إلى النتائج المرجوة، بل أعاقت الحراك الاجتماعي وولّدت الخيبة والإحباط لدى كثيرٍ من الشرائح الاجتماعية.
ويجدر بنا أن نتذكّر أن الأسد أعرب أول الأمر عن تفهّمه للانتفاضتين في مصر وتونس، غير أنه لم يظهر الاهتمام نفسه عندما وصلت الاحتجاجات إلى سورية. فقد أصرّ النظام على أنه ضحية مؤامرة، ورفض إجراء أية إصلاحات ملموسة.2 وبدلاً من ذلك، اختار سبيل التطرف الوحشي، على أمل أن يؤدي ذلك إلى عنف مضاد من جانب حركة كانت سلمية في بدايتها، الأمر الذي كان يبرّر ويسبغ الشرعية على القمع الذي يمارسه النظام. ورافق ذلك الأسلوب المنهجي الذي درج عليه النظام، وهو إضفاء الطابع الطائفي على الصراع من أجل حشد الفئة العلوية والأقليات الأخرى غير السنيّة واستمالتها إلى جانب النظام، وبالتالي إضفاء صبغة إسلامية راديكالية على التمرّد، ما يجعل القضاء عليه أمراً شرعياً ضرورياً.3
وفي الوقت نفسه، فاقم التمرد السوري حدّة المنافسة السعودية الإيرانية والتوترات السنيّة-الشيعية الأوسع نطاقاً، مثلما زادت تلك المنافسة حدة التمرد. وعندما طلب النظام السوري النجدة من إيران في أيلول/سبتمبر 2011، رأت المملكة العربية السعودية أن هزيمة الأسد المحتملة ستكون فرصة للحد من النفوذ الإيراني المتعاظم في المشرق، فبدأ كل من البلدين بدعم ممثّليه ووكلائه المحليين، ماضاعف من حدة الشقاق في سورية وزاده تطرّفاً.4
انصبّ ذلك، بدوره، في سياق ديناميكيّ أكثر اتّساعاً يضم، في ما يضم، مطامح تركيا الإسلامية، ومساعي روسيا لتحقيق التوازن، عالمياً، مع الولايات المتحدة. وقد ثبت أن واشنطن ارتكبت خطأً فادحاً عندما أوكلت لأطراف إقليمية إدارة القوى المناهضة للنظام على أساس مبرّرات طائفية.5 إذ ترتّب على ذلك المزيد من اسلمة الثورة، وساعد على خلق معادلة مؤداها: "إما الأسد أو الدولة الإسلامية" السائدة اليوم. فانجرفت سورية في حرب طويلة الأمد ومتعددة الأبعاد والجوانب، بحيث غدا طابعها المعقّد ذريعة لعدم التدخل فيها.
وما بقي الآن هو سورية مجزّأة تشمل، ضمنياً، مناطق عازلة يسيطر عليها اللاعبون الإقليميون، وتضاعفت أعداد أسياد الحرب، وتحوّلت شُعَبٌ من النظام إلى ميليشيات تنتفع وتتكسّب من اقتصاد حرب مُربح. كما برزت النزعات الراديكالية المتطرفة المتبادلة والاستقطابات المهلكة في كلا الجانبين، وشهدنا تدفق اللاجئين المتواصل داخل البلاد وخارجها.
إن الجهود الدولية التي بُذلت لمعالجة هذا الوضع لم تكن وافية بالغرض. فجولات المفاوضات المتتابعة لم تحقق أكثر من ترتيبات متفرقة وعابرة ومنقوصة وتدابير غير كافية لتخفيف المعاناة الإنسانية.
ويعود السبب المحوري لفشل جهود الوساطة الدولية إلى حوار الطرشان بين الولايات المتحدة وروسيا. فقد صُنِّف الصراع، وهو المعركة الدائرة بين النظام السوري وقطاع كبير من الشعب السوري باعتباره معركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتم ذلك على حساب أية خطة سياسية واقعية لبدء مرحلة الانتقال بعيداً عن حكم الأسد – وهو الشرط الوحيد لإنهاء المحنة في سورية.
لقد سعت روسيا، بلا هوادة، إلى دعم النظام واستخدام سورية لتحدي سطوة الولايات المتحدة في العالم. أما إيران، فإنها تعتبر فقدانها لنفوذها في سورية قضية وجودية، وتسعى بالتالي إلى أن تكون اللاعب الرئيس في لعبة الشرق الأوسط الكبير. ومع هيمنة سلاح الجو الروسي غلى الأجواء السورية، وسيطرة إيران على القوات البرية الكفؤة الوحيدة القادرة على دعم نظام الأسد، فقدت واشنطن الجانب الأكبر من نفوذها ولم يعد لها من خيار إلا التكيّف مع الأوضاع المتغيرة.
إذا كان من الممكن تحقيق السلام في سورية، فإن تحديات هائلة ستظل ماثلة للعيان. ويتطلب الوضع، أولاً، تقارباً بين التصورين الروسي والأميركي حول نظام إقليمي، وربما عالمي. كما يستلزم، ثانياً، وبصورة ضمنية أكثر، تفاهما بين إيران والمملكة العربية السعودية حول تقاسم السلطة، والأمن، والنفوذ في المنطقة. كما أن بلدان الجوار الأخرى لها أولوياتها الخاصة، ومنها تركيا، التي تتخوّف من التطلعات الكردية، وإسرائيل، التي يتعيّن عليها أن تقبل بأي كيان للسلطة في دمشق. ويعني ذلك، في أفضل الحالات، أن سورية في المستقبل المنظور، ستتأثر بمصادر النفوذ الخارجي، وستسيّر أمورها سلطة مركزية أضعف، وتتميز بدرجة عالية من الحكم الذاتي.
لكن، ومهما كانت نتيجة الحرب، سيكون من المستحيل أن نتصوّر أنه يمكن أن تولد سورية الجديدة إلا من خلال معادلة أعيدت صياغتها جذريا للمشاركة في السلطة. وينبغي أن يأخذ ذلك في الاعتبار الاعتبارات الديمغرافية لفترة ما بعد الحرب، والأوضاع الواقعية على الأرض، والحاجة إلى تقديم ضمانات طائفية لكل الجماعات، ومضاعفات هذه العوامل جميعها على القطاع الأمني. كذلك، لا بدّ من معالجة القضية الأكثر حيوية – ألا وهي: كيف يمكن إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع، بدءاً من الصفر تقريباً.
1 Human Rights Watch, No Room to Breathe: State Repression of Human Rights Activism in Syria (New York: Human Rights Watch, October 2007), https://www.hrw.org/report/2007/10/16/no-room-breathe/state-repression-human-rights-activism-syria.
2 Hugh MacIeod, “Inside Deraa,” Al Jazeera, April 19, 2011, http://www.aljazeera.com/indepth/features/2011/04/201141918352728300.html.
3 Leila al-Shami, “The Sectarianization of Syria and Smearing a Revolution,” al-Araby al-Jadeed, October 30, 2016, https://www.alaraby.co.uk/english/indepth/2016/10/30/the-sectarianization-of-syria-and-smearing-a-revolution.
4 Benedetta Berti and Yoel Guzansky, “The Syrian Crisis and the Saudi-Iranian Rivalry,” Foreign Policy Research Institute, October 8, 2012, http://www.fpri.org/article/2012/10/the-syrian-crisis-and-the-saudi-iranian-rivalry/.
5 Frederic C. Hof, “US Non-Recognition of the Syrian Interim Government,” MENASource (blog), Atlantic Council, September 26, 2013, http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/us-non-recognition-of-the-syrian-interim-government.
الجغرافيا السياسية للطاقة
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
مع أن ثروة الشرق الأوسط الهيدروكربونية تظل في غاية الأهمية لإمدادات الطاقة العالمية، فإن الانهيار الأخير في سعر النفط، الذي يُتوقع أن يبقى من الخصائص المميّزة لأسواق الطاقة لسنوات عدة مُقبلة، يزيد إلى حدٍّ كبير التحديات التي تواجه البلدان العربية.
في العام 1908، اكتُشف النفط في مدينة مسجد سليمان في المنطقة الجنوبية الغربية من إيران، معلناً بداية عصر النفط في الشرق الأوسط. وشكّلت الثروة الهيدروكربونية محرّكاً لاغنى عنه للتوسع الاقتصادي غير المسبوق منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وكان من نتائج ذلك تحوّل مشهود في الكثير من المجتمعات العربية. بيد أن السهولة التي أتت بها هذه العائدات، حجبت التفاوت الهائل في توزيع الثروة بين الأقطار العربية، وعقّدت التنمية السياسية والاقتصادية في المجتمعات المنتفعة من الموارد النفطية في المدى البعيد.
في شهر آب/أغسطس 2014، كانت كلفة برميل النفط الخام من فئة "غرب تكساس الوسيط" (West Texas Intermediate) تزيد على مئة دولار. وانخفض السعر في كانون الثاني/يناير 2016 لقترة قصيرة إلى ما يقل عن 30 دولاراً، مع أنه استقر بعد ذلك على سعر تراوح بين 40 و50 دولاراً.76 وتشكّل الإيرادات النفطية 80 في المئة أو أكثر من ذلك من عائدات البلدان المصدّرة للنفط في الشرق الأوسط،77 وبالتالي فإن انهيار الأسعار ولّد تحديات نقدية ضخمة في المنطقة التي كانت آنذاك تشهد اضطرابات عميقة الغور، وتشير التقديرات إلى أن الإيرادات النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي الست قد انخفض بواقع 390 مليار دولار في العام 2015، أي حوالى 20 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي. ومن المرجّح أن تكون الخسائر في العام 2016 أكثر من ذلك.78
يتّفق معظم الخبراء على أن العوامل المؤثّرة في الإمداد، مثل التخمة في الاستثمار في مجال الاستكشاف وزيادة الصادرات العراقية والإيرانية، قد لعبت دوراً أبرز في خفض الأسعار من عوامل الطلب، ومنها بطء الأداء الاقتصادي في الآونة الأخيرة في الصين وأوروبا والكثير من البلدان النامية.79 إلا أن الأهم من ذلك تَمثّل في أن مدى الانهيار لم ينجم عن الإمداد والطلب الدائريين ولا عن العوامل السياسية في المدى القصير، بل عن التحولات التكنولوجية، أي ازدياد كفاءة الطاقة، وثورة الغاز والنفط الصخريّين، والمراحل المبكرة من ازدهار صناعة السيارات الكهربائية، وهي التحولات التي تنذر بتغييرات بنيوية جوهرية ودائمة.80
لم تتنبأ أسواق العقود الآجلة بالانهيار، ومن المؤكد أن ضخامته ستمهّد لطفرة مقبلة في الأسعار، عندما يؤدي الانخفاض الحاد في استثمارات الاستكشاف إلى نقص الإمداد في السنوات المقبلة.
وتوضح نظرة أشمل إلى الوضع أن ثمة تغييرات عميقة وشيكة. ففي العام 1970، كان النفط يمثّل 50 في المئة من استهلاك الطاقة على الصعيد العالمي، وانخفضت النسبة هذا العام إلى 30 في المئة، وستواصل الانخفاض، وإن ببطء أكثر، مع استمرار التطورات التكنولوجية.81 ويمثّل الشرق الأوسط مايقرب من نصف احتياطي النفط المؤكّد وأكثر من 40 في المئة من احتياطي الغاز الطبيعي في العالم.82 وسيزيد من حصته في الإنتاج في العقود المقبلة، غير أن ثمة أسباباً وجيهة للاعتقاد بأن أسعار النفط لن تعود إلى 100 دولار للبرميل في المستقبل المنظور.83
أعلن الشيخ محمد بن زايد، ولي العهد في أبو ظبي، بأن الإمارات العربية المتحدة ستحتفل بتحميل آخر برميل من النفط،84 بينما تطرح "رؤية 2030" السعودية مشروعاً مستقبلياً مفصّلاً يتسم بالتنوع الاقتصادي.85 ومهما كانت صحة هذه التصريحات، فإنها تشير إلى أن منتجي النفط الكبار يهيّئون أنفسهم لانخفاض دائم في الأسعار.86
إن دول مجلس التعاون مجلس التعاون الخليجي، والجزائر إلى حد أقل، مستعدّة للتعامل مع انخفاض الأسعار لسنوات عدة. فهي لديها الحد الأدنى من الديون، وتحتفظ (باستثناء عُمان والبحرين) باحتياطي ضخم من العملات الأجنبية، وتتمتّع بكلفة إنتاج متدنية للغاية. مع ذلك، قد تجابه هذه البلدان تحديات عظيمة في الفترة المقبلة، عندما تواجه الحاجة إلى تقليص القطاعات العامة، مع خلق قطاعات خاصة نشطة قادرة على مواكبة الطفرة الديمغرافية الشبابية.
وقد اتخذت هذه الدول بعض الخطوات الإيجابية في هذا الاتجاه، منها: التخفيض الحاد في الإنفاق المحلّي ودعم المحروقات،87 والتحرك لتطبيق ضرائب القيمة المضافة، وتأكيد الحاجة إلى التنويع الاقتصادي والإصلاح السياسي المحدود. لكن في البلدان التي تحكمها أنظمة ملكية مطلقة واستخدمت الأسر الحاكمة الثروة النفطية لفرض عقود اجتماعية ذات طابع أبوي بطريركي، قد تولّد مثل هذه التحرّكات ردود فعل عكسية ونتائج مهمة على المدى الطويل عندما تتزايد المطالبة بالشفافية والصراحة والمساءلة.
وبالنسبة إلى العراق وليبيا، اللتين تدور فيهما رحى الحرب، فقد حلت الأزمات بالفعل. فالعراق، الذي أهدر مئات المليارات من الدولارات من عائدات النفط جرّاء الفساد وسوء الإدارة، على شفير الإفلاس ويجابه أزمة مالية خانقة.88 أما ليبيا، فقد جنحت بدورها إلى الانهيار الاقتصادي فيما تواصل الفصائل المتحاربة الاقتتال للسيطرة على دولة ما بعد القذافي وهيكلها الأساسي.
قد يؤدي انخفاض الأسعار في المستقبل إلى تقليل التفاوت الضخم في الثروة بين منتجي النفط في الشرق الأوسط من جهة، ومستورديه من جهة أخرى. ومن المستبعد استمرار المشتريات العسكرية التي شهدتها السنوات الأخيرة، فيما يجري تنفيذ الإجراءات التقشفية بعيدة الأثر.
لكن البلدان غير المنتجة للنفط في المنطقة، بما فيها مصر والأردن ولبنان والمغرب وفلسطين وتونس، قد تكون في المدى القريب أكثر تعرّضاً إلى الصدمات المالية. ذلك أن مستوردي النفط في المنطقة يفيدون ظاهرياً بسبب الانخفاض الكبير في تكاليف الإنتاج ونفقات دعم المحروقات. غير أن الكثير من هذه البلدان تفتقر إلى احتياطيات النقد الأجنبي، كما أنها غدت تعتمد على واردات نفط الخليج على هيئة مساعدات مالية، واستثمارات وفرص عمل، وتحويلات نقدية، ما أدّى إلى إعاقة التنمية السياسية والاقتصادية مع الزمن.
يواجه القادة العرب، على امتداد المنطقة، معضلة حقيقية محيّرة؛ فثمة حاجة ماسّة وعاجلة إلى تحوّلات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية لضبط الإنفاق غير القابل للتعليل والتفسير، فيما تتضاعف التحديات المحلّية والإقليمية. مع ذلك، قد تزيد هذه التحوّلات نفسها احتمالات الاضطرابات المحلّية، ذلك أن استمرار الانخفاض في أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التأزّم في الشرق الأوسط، ويمكن أن يفتح مجالات جديدة لأطراف لا تمتّ إلى الدولة بصلة ولجماعات متطرفة، إذا استمر الانخفاض في الإنفاق التقديري-المزاجي والمحسوبية والاستزلام السياسي.
فثمة حاجة ماسّة وعاجلة إلى تحوّلات اقتصادية، وسياسية، واجتماعية لضبط الإنفاق غير القابل للتعليل والتفسير، فيما تتضاعف التحديات المحلّية والإقليمية.
وثمة مؤشرات على أن بعض القادة على الأقل قد أخذوا يتفهّمون هذا المأزق. وعلى سبيل المثال، فإن برنامج "رؤية 2030" السعودية، الذي يرمي إلى إنهاء اعتماد المملكة العربية السعودية على الموارد الهيدروكربونية في غضون السنوات الخمس عشرة المقبلة،89 يمثّل على الأقل اعترافاً عامّاً مهمّاً بأن التحديث والتنويع الاقتصاديين عنصران جوهريان لضمان ازدهار المملكة في المدى البعيد. غير أن الجهود المبذولة لبلوغ هذه الغاية قد لا تتكلّل بالنجاح، إلا إذا تمكنت المجتمعات العربية من وضع مخططات واضحة كل الوضوح للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المستقبل.
دراسة حالة 8
السعودية – رؤى أم سراب؟
تطرح "رؤية 2030" الطموحة خريطة طريق للمملكة العربية السعودية لما بعد مرحلة النفط. وسيكون لنجاحها أو فشلها مضاعفات هائلة على العالم العربي بأسره.
هناك في الممكة العربية السعودية مبادرتان ناشطتان يمثّل ولي ولي العهد محمد بن سلمان بن عبد العزيز العنصر الريادي المُسيّر لكل منهما، وسيكون لهما مضاعفات ضخمة على المسارات السياسية والاقتصادية الداخلية في المملكة، وعلى نظام ولاية العهد والخلافة في الأسرة المالكة، وعلى دور المملكة كقوة إقليمية.
المبادرة الأولى هي المقاربة الفعّالة المُتعَسكرة التي تتبنّاها السعودية في سياستها الخارجية منذ تولّي الملك سلمان مقاليد الحكم في كانون الثاني/يناير 2015، ويمثّل التدخّل الذي تتزعمه الرياض في اليمن أبرز مرتكزاتها. ومن المفارقات أن نزعة توكيد الذات السعودية تعكس مخاوف بالغة العمق من انهيار النظام الإقليمي. وبالنسبة إلى السعوديين، تمثّل إيران المتهم الأول الذي تَعتبره المملكة المسؤول أساساً عن إشاعة الاضطراب في المنطقة، من خلال مناصرته لنظام الأسد في سورية، ومساندته الحوثيين في اليمن، وتقويضه مؤسسات الدولة عبر دعمه للفصائل الطائفية الإرهابية في المنطقة.
وللرد على ذلك، سعت السعودية إلى تقديم نفسها بوصفها الحصن المنيع للوضع الإقليمي الراهن، فساندت القيادات التي حاولت أن تقف في وجه تيارات التغيير، ومن بينها عائلة آل خليفة الحاكمة في البحرين، وعبد الفتاح السيسي في مصر، مع أن العلاقات مع القاهرة تضرّرت جرّاء اختلاف المواقف تجاه إيران وسورية. يُضاف إلى ذلك أن السعودية تمكّنت من ترسيخ علاقاتها مع القوى الإقليمية والدولية مثل الصين، والهند، وروسيا، وتركيا، وحتى إسرائيل. بيد أن القلق العميق ظلّ يساور المسؤولين السعوديين لأن الولايات المتحدة، خلال إدارة الرئيس باراك أوباما، تخلّت عن دورها التقليدي بوصفها القوة التي تؤمن الاستقرار وتضمن الأمن الإقليمي. وكان من النتائج غير المقصودة لصفقة "الطاقة مقابل الأمن" التاريخية (التي تكفّلت فيها الولايات المتحدة بالأمن الخارجي للسعودية مقابل الحصول على النفط السعودي) أن غدت المملكة أكثر اعتماداً على الدعم العسكري الأميركي، ما قلّل من قدرتها على الدفاع عن مصالحها الأمنية.
لقد قُتل عشرة آلاف شخص على الأقل، ونزح أكثر من ثلاثة ملايين1 بعد نحو سنتين ونصف السنة من الحرب التي تخوضها السعودية في اليمن، وهي حرب تتحوّل بصورة متزايدة إلى مايشبه المستنقع. وبالمثل، لازالت السعودية التي تعهدت بإطاحة الرئيس بشار الأسد عسكرياً، تفتقر إلى الوسائل الكفيلة بتنفيذ هذا التهديد.2
أما المبادرة السعودية الثانية، الأكثر أهمية، فهي خطة "رؤية 2030" الطموحة لإنعاش اقتصاد المملكة وتقليل اعتمادها على النفط.3 ومع أن السعودية تُعد منذ عهد بعيد المصدر الأكثر أهمية لإنتاج الطاقة، وتمتلك الآن نحو 500 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية،4 أخذ اقتصادها يتعرّض إلى ضغوط قاسية منذ انخفاض أسعار النفط بنسبة 70 في المئة بين حزيران/يونيو 2014 وكانون الثاني/يناير 2016. وبما أن نفقات الدفاع السنوية كانت في العام 2015 تقارب 90 مليار دولار (وهي أعلى مما في روسيا)، وعجز الميزانية يقرب من 100 مليار في العام 2015،5 فإن المملكة تستنزف احتياطياتها بالتدريج. وإذا افترضنا صحة تقديرات صندوق النقد الدولي بأن انخفاض أسعار النفط ينطوي على بعض العناصر الثابتة في السوق، فلا خيار أمام السعودية إلا إحداث تغييرات ضخمة في نظام اقتصادها السياسي.
ولّد اعتماد السعودية التاريخي على عائدات النفط تحدّياً ثلاثيّ الأبعاد يتمثّل في ضرورة: الإقلال من نفقات القطاع العام بصورة كبيرة، والتنويع الاقتصادي في الوقت نفسه، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص لمواكبة التزايد في أعداد الشباب.
تتضمن "رؤية 2030" السعودية منظومة متزامنة على نحو مُحكم من الإصلاحات النيوليبرالية، مثل الخصخصة، والتقشف المالي، وتقليص حجم الجهاز الحكومي. لكن حتى التغيرات الجزئية التدريجية تستلزم تحوّلاً عميقاً في الأسلوب الذي يتم بموجبه عمل المصالح التجارية في البلاد. ذلك أن الشفافية الحقيقية، الضرورية حتى للخصخصة الجزئية لأرامكو السعودية، تتطلب تفسيراً مفصلاً للحصة المُخصّصة من عائدات النفط للآلاف من أعضاء الأسرة الحاكمة. وتستطيع الاقتطاعات من خدمات الرفاه الاجتماعي والتنفيذ المتوقع لضريبة القيمة المضافة أن تزيد من مطالبة المواطنين بالمساءلة والمحاسبة. ولاشك أن عدداً من أصحاب المصالح الذاتية الخاصة، بمن فيهم العديد من أعضاء الأسرة المالكة نفسها، يتمنون فشل "رؤية 2030"، مثلما تتمناه كذلك النخب التجارية التي تفيد من ريع النقط، والمؤسسة الدينية التي تخشى أن تفقد نفوذها إذا بدأ النظام السعودي مرحلة من الانفتاح التدريجي وخفض التمويل لحملات الدعوة إلى الإسلام خارج البلاد. ولايمكن أن تتحقق هذه التحوّلات الاقتصادية والثقافية عميقة الجذور من خلال عملية تكنوقراطية يؤمر بها من القمة إلى القاعدة، لأن ذلك سيُدخل تعديلاً عميقاً على العقد الاجتماعي السعودي. وإذا توخّت الأسرة السعودية النجاح، عليها أن تجد آليات جديدة للحوكمة يشارك فيها المواطنون بوصفهم شركاء محوريين.
تُرى، هل ستؤدي "رؤية 2030" السعودية إلى إقامة مؤسسات حقيقية تُعلي من شأن المساءلة والمحاسبة، والعدالة، والشفافية، حتى في ما يتعلق بأعضاء أسرة حاكمة تحتل في غالب الأحيان مرتبة أعلى من مرتبة الدولة؟ أم أن تطبيق هذه الرؤية سيسلك المسار التقليدي المعهود، حيث يجري تطوير مشروعات استعراضية تؤول آخر الأمر إلى بعض أعضاء العائلة المالكة أو تُستخدم كمكرمات تُخصّص لنخب سياسية متنفذة.
سيكون الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الذي يبلغ الحادية والثمانين، بصورة شبه مؤكدة آخر أبناء عبد العزيز آل سعود الذين تولوا الحكم في المملكة. ومع أن نظام الخلافة السعودي غير واضح الآن، فإن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وهو ابن الملك المفضّل، استحوذ على سلطات غير مسبوقة. وبما أن مبادرة "رؤية 2030" السعودية تحمل بصمة الأمير محمد، فإن نسبة المخاطرة عالية على نحو استثنائي. إذ ما من سوابق، في التاريخ العربي أو العالمي الحديث، على عدول اقتصاد بهذه الضخامة ويدار بصورة مركزية عن الاعتماد على الهيدروكربونات والابتعاد عنه. وحتى لو طبِّق جانب بسيط من الخطة، فهذا سيترك آثاراً عميقة على أوضاع المملكة، ويطرح نموذجاً لاقتصاد ما بعد المرحلة الريعية للبلدان العربية الأخرى. أما إذا فشلت الخطة، فإن الدولة الأكثر ثراء بين الأقطار العربية ستُواجه مستقبلاً اقتصادياً متردّياً، وربما يصاحبه اضطراب سياسي. بينما تكون الفرصة الأفضل لإجراء إصلاحات مجزية خلال هذا الجيل قد فات أوانها.
1 “UN: At Least 10,000 Killed in Yemen Conflict,” Al Jazeera, August 30, 2016, http://www.aljazeera.com/news/2016/08/10000-killed-yemen-conflict-160830173324902.html.
2 “Saudi Arabia: Assad Must resign or Be Forced From Power,” Al Jazeera, December 15, 2015, http://www.aljazeera.com/news/2015/12/saudi-arabia-assad-resign-forced-power-151210111545090.html.
3 “Vision 2030,” Kingdom of Saudi Arabia, http://vision2030.gov.sa/en.
4 تمّ تقدير هذا الرقم عبر إستنباط بيانات الاحتياطيات الأجنبية لشباط/فبراير 2015 وآذار/مارس 2016. “Saudi Arabia: Time Series Data on International Reserves/Foreign Currency Liquidity,” International Monetary Fund, April 28, 2016, https://www.imf.org/external/np/sta/ir/IRProcessWeb/data/sau/eng/hstSAU.pdf.
5 For defense expenditures, see “SIPRI Military Expenditure Database,” Stockholm International Peace Research Institute, 2015, https://www.sipri.org/sites/default/files/SIPRI-Milex-data-1988-2015.xlsx; for the budget deficit number, see Vivian Nereim and Glen Carey, “Saudi 2015 Budget Deficit Is $98 Billion as Revenue Drops,” Bloomberg, December 28, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-28/saudi-2015-budget-deficit-is-98-billion-as-revenue-drops.
البيئة
المشهد الإنساني | المشهد السياسي | المشهد الجيوسياسي
ليست أسواق الطاقة العالمية العامل الوحيد الذي قد يؤثّر إلى حدٍّ بعيد في أوضاع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فمن المحتمل أن يترك تغيّر المناخ آثاره القاسية المباشرة وغير المباشرة على الناس في المنطقة. ففي 21 تموز/يوليو 2016، بلغت الحرارة في مترابة، الكويت 54 درجة مئوية (129.2 فهرنهايت)، وفي 22 تموز/يوليو بلغت 53.9 درجة مئوية (128 فهرنهايت) في البصرة، العراق.90 وإذا أكّدت ذلك المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، فستشير تلك الأرقام إلى أعلى درجات حرارة سُجِّلت على الإطلاق في النصف الشرقي للكرة الأرضية وآسيا. علاوةً على ذلك، تفيد دراسة أُجريت مؤخراً أن عدد الأيام الدافئة، وفقاً للمسار الراهن، سيرتفع بصورة حادة، حيث يُتوّقع أن ترتفع درجات الحرارة في أكثر الأيام سخونة من 43 درجة مئوية (109 فهرنهايت) إلى 46 درجة مئوية (115 فهرنهايت) بحلول أواسط القرن، وإلى ما يقارب 50 درجة مئوية (122 فهرنهايت) بحلول نهاية القرن.91 وقد دفعت هذه التوقعات بعض الباحثين إلى استنتاج أن درجات الحرارة وحدها قد تجعل بعض أجزاء المنطقة غير صالحة للسكن.92
إضافةً إلى توليد درجات حرارة غير مريحة، بل تنذر بالخطر على الحياة، سيكون لتغيّر المناخ آثار عميقة على إمدادات المياه والغذاء، وكذلك على نوعية الهواء.
إضافةً إلى توليد درجات حرارة غير مريحة، بل تنذر بالخطر على الحياة، سيكون لتغيّر المناخ آثار عميقة على إمدادات المياه والغذاء، وكذلك على نوعية الهواء. وتعاني منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شحّ الموارد المائية. فالبلدان العربية تضم أكثر من 5 في المئة من سكان العالم و10 في المئة من أراضيه، غير أن فيها ما يقل عن 1.2 في المئة في السنة من الموارد المائية المتجددة.93 ومن المتوقع أن تؤدي درجات الحرارة المتزايدة إلى إنقاص هذه الحصة بحلول العام 2030 بما يعادل 20 في المئة. وقد حذّرت اللجنة الدولية للتغيرات المناخية من أن موجات الجفاف قد تغدو أكثر تواتراً، وتُعرّض ما يتراوح بين 80 و100 مليون نسمة إلى ضائقة مائية بحلول العام 2025، وتؤدي إلى تزايد الضغوط على موارد المياه الجوفية.94
تساهم درجات الحرارة العالية، ومعها الممارسات الزراعية المتخلّفة، في عملية التصحّر، مع ماينطوي عليه ذلك من تداعيات على الزراعة وجودة الهواء على حدٍّ سواء. ويُستخدم نحو 85 في المئة من المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للزراعة، ويشمل ذلك الاستخدام المفرط لموارد المياه الجوفية التي لايجري رصدها وإدارتها بطريقة سليمة في معظم بلدان المنطقة.95 وتعاني بعض الدول من الجفاف الحادّ. ففي اليمن، على سبيل المثال، يحصل المواطنون على 88 متراً مكعّباً للفرد سنويّاً، أي أقل بكثير من التعريف العالمي للندرة، وهو 500 متر مكعّب.96 وتتنبّأ اللجنة الدولية للتغيرات المناخية بأن نسبة هطول الأمطار ستكون طفيفة فيما ترتفع درجات الحرارة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جنباً إلى جنب مع استمرار التكاثر السكاني، الأمر الذي سيسفر عن زيادة التبخّر ونقص المياه إلا إذا تغيرت أنماط الاستهلاك.97
يلحق التغير المناخي الضرر بجودة الهواء وإمدادات المياه على حدٍّ سواء، لأن التصحّر قد زاد من تلوّث الهواء الهبائي. كما أن الغبار الصحراوي قد تزايد بنسبة 70 في المئة في أجواء العراق والسعودية وسورية خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.98 وفي المقابل، ستنجم الزيادة المفرطة في ملوحة المياه في البحار التي ترتفع مستوياتها، عن مشاكل تتمثّل في تلوّث احتياطيات المياه الجوفية وإغراق الموانئ والمناطق الساحلية الواطئة المأهولة بكثافة سكانية عالية في مصر والكويت وقطر وتونس والإمارات العربية المتحدة.99
عالجت حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسألة ندرة المياه العذبة بتنفيذ مشروعات واسعة للتحلية. وتم الجانب الأكبر منها في بلدان الخليج التي يعمل فيها نحو 70 في المئة من معامل التحلية في العالم باستخدام الوقود الأحفوري.100 بيد أن العمليات الحالية عالية الكلفة وضارّة بالبيئة إلى حدٍّ يحول دون اعتبارها حلولاً دائمة. ذلك أن زيادة المياه المحلّاة تعني ازدياد الملوحة في المياه المحيطة بها، وارتفاع مستوى الطاقة المستخدمة في تلك العملية. وثمة حاجة إلى المزيد من الأبحاث الخاصة بمصادر الطاقة المتجدّدة، ومنها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتحويل تحلية المياه إلى استراتيجية أقرب منالاً وأكثر استدامة.
مافتئت التوترات القائمة بين بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبينها وبين بلدان الجوار غير العربية، تلعب دوراً مؤثّراً في تأزيم ندرة المياه التي قد تتحوّل إلى مشكلة مستعصية في المستقبل. إن كميّة كبيرة من المياه العذبة في المنطقة تنبع خارج حدودها. فنهر النيل يجتاز الأجزاء الشمالية الشرقية من أفريقيا، ويخترق، من جملة بلدان أخرى، كلّاً من أوغندا، وإثيوبيا، وجنوب السودان، والسودان، قبل أن يمر عبر مصر ويصب في البحر. كما أن نهرَي دجلة والفرات ينبعان في تركيا، ويمر الفرات في سورية، قبل أن يواصلا التدفّق عبر العراق. وقد تسبّب قيام إثيوبيا ببناء "سد النهضة" على النيل الأزرق لتوليد الطاقة الهيدروكهربائية في إثارة المخاوف في مصر من احتمال خفض مستوى التدفّق. وغدا ذلك أحياناً قضية محلّية يتنافس بشأنها السياسيون المصريون لإظهار من سيكون الأقدر بينهم على اتخاذ موقف صلب ضد إثيوبيا.101
من الصعب التأكّد بصورة يقينية من التداعيات الاجتماعية والسياسية للتغيّر المناخي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لأن التأثيرات البيئية لن تظهر بجلاء إلا في إطار زمني على مدى عقود عدة. وثمة دلائل على أن الجفاف الذي امتدّ سنوات عدة في شرق سورية قد أسهم في الضغوط الاقتصادية والاجتماعية عندما بدأت القلاقل في العام 2011.102 وسيفاقم ارتفاع درجات الحرارة وتناقص المياه في السنوات المقبلة تعقيدَ منظومة مهولة من القضايا التي تواجه المنطقة، والتي تتطلب الإعداد والتخطيط الحكيم والتعاون بين الدول المعنية. وإذا لم يحدث مثل هذا التعاون، ستشكّل آفاق القصور المتزايد واسع النطاق في تلبية الاحتياجات من المياه والغذاء والطاقة، وإمكانية نشوب النزاعات جرّاء هذا القصور، مدعاةً للفزع.
مقالمستقبل الإسلام السياسي في مُنعرج كبير
محمد أبو رمّان
لو تجاوزنا الجزر المتنوعة من الحركات الإسلامية العربية، عموماً، سنجد أنفسنا أمام تيارين رئيسين؛ التيار الأول هو الإسلامي السلمي، الذي يعلن قبوله باللعبة الديمقراطية ويشارك في العملية السياسية، مثل الأحزاب السياسية المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، أو ما شاكلها. أما التيار الثاني فهو الذي يؤمن بالعمل العسكري، ويرفض الدولة الديمقراطية، ويسعى إلى إقامة دولة إسلامية تُحكَم بالشريعة الإسلامية، كما يفهمها أنصار هذا التيار.
لو تجاوزنا الجزر المتنوعة من الحركات الإسلامية العربية، عموماً، سنجد أنفسنا أمام تيارين رئيسين.
على صعيد التيار الأول، الذي يعلن القبول بالعمل السياسي والسلمي، فإن من الواضح أنّه انتقل مع الثورات الشعبية 2011 وما تلاها، إلى مرحلة جديدة، مختلفة كليّاً عن المرحلة السابقة التي كان هذا التيار يكتفي فيها بالمشاركة المحدودة في الانتخابات ضمن اللعبة السياسية.
في كلٍّ من المغرب العربي وتونس، أصبحت تلك الحركات اليوم شريكاً في السلطة، نسبياً، وتواجه مشكلات الحكم والأزمات الاقتصادية، وتنتقل – تدريجياً - إلى "أحزاب برامجية" أكثر منها أحزاباً أيديولوجية، وتتطوّر رؤيتها للديمقراطية بصورة أفضل.
في المقابل، تبدو معضلة هذه الحركات أكثر وضوحاً في المشرق العربي؛ في مصر والأردن واليمن والعراق وسورية. ذلك أنّ الأفق السياسي ما يزال مغلقاً أمام إحداث تغييرات جوهرية في نظام الحكم، نحو الديمقراطية، بل إن هنالك انتكاسات في مسار التحوّل الديمقراطي، وتعاني هذه الحركات في العديد من الحالات، من ظاهرة تنامي الانشقاقات والخلافات الداخلية إلى درجة غير مسبوقة.
وعلى العموم، يتبلور داخل هذه الحركات الآن اتجاهان متميزان:
الاتجاه الأول يعكف على ممارسة "النقد الذاتي" وتطوير القبول بالعملية الديمقراطية، وفصل الجوانب الدعوية عن السياسية، تمهيداً للتحوّل إلى أحزاب سياسية مدنية مُحترفة، مع تجنّب خلط البرامج بالشعارات الدينية. وهذا التوجّه بات واضحاً في المغرب وتونس (حيث يتزايد الفصل بين الجوانب الدعوية والسياسية)، كما بدأ يتجلّى في الأردن، جزئياً، إذ خاضت جماعة الإخوان الانتخابات الأخيرة للمرة الأولى من دون شعارها المعروف "الإسلام هو الحل".
أمّا الاتجاه الثاني، فهو الذي ما يزال يصرّ على التنظيم وأولويته، والحفاظ على أدبيات الجماعة الكلاسيكية، وهو يشكّك في مسار العملية الديمقراطية، بعدما حدث في مصر، وفي موقف الغرب بسبب ما يحدث في سورية والعراق. ويستدعي بعض أفراد هذا الاتجاه اليوم ميراث سيد قطب، الذي يتحدث عن الحاكمية ودولة الشريعة والصراع مع العلمانيين والاتجاهات الإيديولوجية الأخرى.
التيار الثاني، في المشهد العربي، فهو التيار المسمّى "السلفية الجهادية"، وقد شهد خلال العامين الماضيين بروز تنظيم داعش، الذي أصبح التنظيم الأكثر حضوراً ونفوذاً في أوساط الحركات الجهادية في العالم، وبايعته العديد من الجماعات المحلية. ونقل هذا التيار العمل الإرهابي من الحيّز النخبوي (أي اختيار الأشخاص والعمليات وتحديد الأهداف)، كما كانت عليه الحال مع القاعدة، إلى المجال العام (عبر ظاهرة الذئاب المنفردة؛ أي احتمال أن يقوم أي شخص بعملية ضد أي هدف، كما حدث في العمليات الأخيرة في الغرب).
تُرى، ما هو الاتجاه الذي يمكن أن يسود وينتصر بين هذه الاتجاهات؟ وإلى أي تيار تنحاز مؤشرات المستقبل من التيارين (الجهادي والسلمي)؟
يرتبط الجواب على ذلك بالأوضاع السياسية عموماً؛ فإذا كانت الدول والمجتمعات العربية تتجة إلى الديمقراطية والانفتاح وإنهاء الحروب الأهلية وتغليب الاعتبارات الوطنية والإصلاحية، فإن التيار الذي يؤمن بالمزيد من الديمقراطية والاندماج هو الذي سيسود، والعكس صحيح.
الواقع أن المؤشرات الأولية لا تدعو إلى الاطمئنان على المدى القريب. فحتى لو تمكّن التحالف الدولي من القضاء على تنظيم داعش عسكرياً، فإن من الممكن أن تصعد نسخة جديدة أكثر خطورة طالما أن الشروط السياسية والمجتمعية متوافرة، والدولة العربية تعاني من أزمات داخلية عاصفة تكاد تطيحها في بقعة واسعة من المشرق العربي، فيما يبدو أن أمام المغرب وتونس فرصة أفضل لتطوير نسخة أنسب من الإسلام السياسي المنخرط في العملية الديمقراطية.
د. محمد أبو رمّان باحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، وكاتب في صحيفة "الغد" في الأردن.
مقالالمصالحة الوطنية في البحرين
خليل المرزوق
بعد ما يزيد على خمس سنوات من الاضطراب، تدخل البحرين مرحلة جديدة. ففي العام 2016، طبّقت الحكومة أكثر الإجراءات تشدّداً ضد شيعة البحرين على مدى عدّة عقود. واشتمل ذلك على تجريد الزعيم الشيعي آية الله العظمى عيسى قاسم من جنسيته؛ وحظر جمعية "الوفاق"، وهي أكبر تجمع سياسي في البلاد؛ ومضاعفة عقوبة السجن على الشيخ سلمان، الأمين العام لجمعية الوفاق. ومع تعاظم النزعة الطائفية في المنطقة وتصاعد التوتر السياسي بين إيران والمملكة العربية السعودية يوماً بعد يوم، فإن استمرار التدهور في البحرين ستكون له تداعيات سلبية تتجاوز حدود البلاد.
ثمة حل واحد لعدم الاستقرار في البحرين: إنها المصالحة الوطنية التي تهدف إلى إقامة نظام سياسي جامع يحتضن جميع الأطياف في المملكة.
ثمة حل واحد لعدم الاستقرار في البحرين: إنها المصالحة الوطنية التي تهدف إلى إقامة نظام سياسي جامع يحتضن جميع الأطياف في المملكة. والمطلوب حل يحافظ على النظام الملكي ويُعطي الشعب مشاركة سياسية أوسع. مع أن هذا الأمر مما يسهل قوله ويصعب فعله، ويتطلب تحقيق هذا الهدف التزاماً جديداً بالحوار من السلطات والمعارضة على حدٍّ سواء، يتطلّب كذلك التزاماً قوياً من جانب الأسرة الدولية لمساندة هذه العملية وتشجيع التسوية والحل الوسط.
يتعيّن على أية عملية مصالحة ذات مصداقية أن تتصدى للمظالم الأساسية التي يعانيها أهل البحرين جميعاً، وتوفّر حوكمة تصون حقوقهم ومصالحهم، وتُمأسس الضمانات لهذه الحقوق. ولا بدّ من تنفيذ الإصلاحات التشريعية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية. ويتطلب ذلك، بدوره، مساندة دولية قوية.
وصحيحٌ أن الوضع الراهن لا يدعو إلى التفاؤل، غير أن بوادر النجاح قد تلوح في الأفق حالما تُبدي جميع الأطراف استعدادها للحوار البنّاء. فلم يعد من الممكن أن يستأثر بحكم البحرين طرف واحد فحسب. فذلك ما لم تثبت جدواه بالنظر إلى التكوين الديمغرافي للبلاد. والبحرين مُلْكٌ لأهل البحرين كافة، كما أن لاستقرارها وازدهارها أهمية قصوى لدى أهل البلاد، والمنطقة والأسرة الدولية، ولا سيما حلفاء البحرين وأصدقائها الاستراتيجيين.
خليل المرزوق هو النائب الأول السابق لرئيس مجلس النواب البحريني ومساعد الأمين العام في الشؤون السياسية والدولية في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
مقالنحو عقد اجتماعي جديد لسورية
بسمة قضماني
نادراً ما يستطيع زعيم دكتاتور ممن واجهوا انتفاضة شعبية جديّة أن يعيد فرض سلطته على المجتمع. ويصدق ذلك على بشار الأسد في سورية.
ويعود ذلك، في جانب منه، إلى أنه ليس من السهل على مجتمع استيقظ من غفوته أن يعود إلى حالة الخمول مرة أخرى. وفي الوقت نفسه، فإن الجهاز الأمني لنظام الأسد قد فقد تماسكه كليَاً، وتشرذم إلى ميليشيات، وبصورة تعكس كذلك أوضاع التجزئة في أوساط المعارضة المسلحة.
إن هذا الوضع يحدّد معالم الطريق في المستقبل. ذلك أن أغالبية السوريين يريدون دولة تعامل جميع المواطنين على قدم المساواة. بيد أن إعادة بناء الجهاز الأمني في البلاد ستكون لها الأولوية، لأنها ستحدّد نجاح جميع الجوانب الأخرى لعملية الانتقال، بما فيها القدرة على تنفيذ عقد اجتماعي يريده السوريون.
ولا يمكن توفّر مثل هذا العقد الاجتماعي الشامل [في سوريا]، إلا بإقصاء الأطراف المتطرفة على جانبي الطيف الاجتماعي.
ولا يمكن توفّر مثل هذا العقد الاجتماعي الشامل، إلا بإقصاء الأطراف المتطرفة على جانبي الطيف الاجتماعي: أي الجهاديين الراديكاليين، من جهة، والدكتاتور الذي يتحمّل المسؤولية عن القتل الجماعي ونظام سجون الإبادة، من جهة أخرى. وبإقصاء هذين الطرفين، ستُتاح للسوريين الفرصة للمحافظة على ما بقي من مؤسسات الدولة ولإعادة تحديد الشروط لمستقبلٍ مشترك لجميع قطاعات المجتمع.
ولأن أحداً من السوريين لا يمكنه أن يقبل الظلم بعد اليوم، فإن البلاد بحاجة إلى التعامل مع مخاوف العلويين، وتطلعات الكرد، واغتراب المسيحيين، وخيبات السنة. والأهم من ذلك كله أن على سورية أن تتعامل مع ثقافة الرأي المخالف التي غدت صفة متأصّلة في نفوس الشباب، ذكوراً وإناثاً.
ويطلب من السوريين الآن أن يسارعوا دونما إبطاء إلى تهيئة المسرح لدولة مستقرة وديمقراطية فاعلة، ردّاً على الأسطورة القائلة بأنه ليس ثمة بديل عن حكم الأسد. وقد فعلت المعارضة المعتدلة الكثير للرد على جميع التحديات التي انطوت عليها الفترة الانتقالية – مثل وضع عقد اجتماعي شامل وخطة أمنية متكاملة تتصدى للإرهاب وتؤسس الحوكمة التشاركية المدنية. كما وُضع برنامج مفصَّل للعدالة الانتقالية، ويجري التخطيط لتنفيذه بطريقة لا تعرقل سير المفاوضات. وتجري الآن حملات توعية حيثما أمكن داخل سورية لنشر قيم التسامح والمصالحة، وطُرحت للنقاش خيارات عدّة لوضع دستور ديمقراطي وتطبيق اللامركزية التي ستحافظ على بنية الدولة، بينما تسمح للحكم المحلّي بالنمو وتعزّز حقوق الأقليات.
قلّما تجد المجتمعات الوقت اللازم للاستعداد لاستبدال النظام الدكتاتوري. غير أن سورية تحمل هذا البديل لحكم الأسد في أحشائها الآن، فيما يستعد الوليد المنتظر للخروج إلى النور. وعلى العالم ألّا يتوانى عن مساعدته على ذلك.
بسمة قضماني هي مديرة مبادرة الإصلاح العربية وعضو في فريق المعارضة السورية المفاوض في محادثات السلام في جنيف.
خاتمة
في غمرة التخلخل الديمغرافي، والاقتصادي، والاجتماعي والنفسي الذي شهده الشرق الأوسط منذ العام 2011، استكمل المنطق التنظيمي السائد في أغلب البلدان العربية مساره، حين فقدت أنظمة الحكم القدرة على توفير مايكفي من فرص العمل في القطاع العام لمواكبة التكاثر السكاني من جهة، أو إدارة تدفق المعلومات والاتصالات إلى جمهورها من جهة أخرى. وقد باتت الحكومات العربية تواجه الاستياء الشعبي المتصاعد فيما بدأت تتجلّى، بوضوح متزايد، إخفاقاتها في خلق اقتصادات نشطة ومزدهرة تخضع إلى إدارة سليمة.
في غمرة التخلخل الديمغرافي، والاقتصادي، والاجتماعي والنفسي الذي شهده الشرق الأوسط منذ العام 2011، استكمل المنطق التنظيمي السائد في أغلب البلدان العربية مساره.
وبينما كانت المؤسسات الحاكمة تنوء تحت وطأة ضغوط ضخمة على الصعيد العالمي، كانت الدول السلطوية في الشرق الأوسط تعاني، بصورة خاصة، درجة من الهشاشة والتباطؤ تمنعها من التعامل مع التحديات المتزامنة مع التغيّر التكنولوجي والديمغرافي، والاضطراب الإقليمي، وانخفاض عائدات النفط. وقد تمكّنت القوى السياسية المساندة للوضع الراهن من الاحتفاظ بالسلطة في معظم البلدان العربية، غير أن هذه السلطة كانت تعتمد بصورة متزايدة على القسر والإكراه.
وفي هذه الأثناء، يُعتقد أن الحروب الأهلية العربية المتزامنة تمثّل الأزمات الأكثر إلحاحاً التي تواجه الأسرة الدولية. وكان النزاع السوري كارثياً بصورة خاصة، وأدّى إلى معاناة لا مثيل لها، وإلى زعزعة أركان النظام الدولي بعد الحرب العالمية الثانية.
قد تستمر هذه النزاعات، على ما يبدو، لبعض الوقت، غير أن من واجب قادة المنطقة أن يبدأوا الآن بوضع رؤاهم وتصوّراتهم حول الشرق الأوسط لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع. ذلك أن التعامل مع التوترات والصراعات التي اكتنفت الكثير من البلدان العربية ستستلزم أشكالاً جديدة من الحوكمة داخل كل دولة ومعايير للسلوك المقبول بين الدول. ولن يتحقق الوضع الأخير إلا إذا اقتنعت القوى الإقليمية بأن النزاعات بالوكالة من شأنها تقويض استقرارها الداخلي. وهذا مشروع طويل الأمد، غير أن من واجب الأسرة الدولية دعمه بصورة عاجلة.
وفي الوقت نفسه، يتعيّن على اللاعبين الخارجيين زيادة جهودهم لدعم صمود الدول الواقعة في الخطوط الأمامية، ولاسيما تلك التي التزمت حكوماتها بالاستثمار في رأس المال البشري لديها. ونجد مثلاً واضحاً على ذلك في تونس، التي تعقّد انتقالها السياسي والاقتصادي بسبب الحرب الأهلية في ليبيا المجاورة. كما نشهد أمثلة أخرى في الأردن، والمغرب، وحتى في لبنان الذي أظهر قدرة مفاجئة على التكيّف عبر استضافة العديد من اللاجئين السوريين، على الرغم من الخلل السياسي الذي يعاني منه.
من السهل أن ينظر المرء نظرة يائسة إلى الشرق الأوسط ويخلص إلى أن الفوضى المستمرة أمر محتوم لا مناص منه. بيد أن مناطق أخرى قد عانت انهيارات مماثلة على الصعيد الإقليمي، عندما تداخلت العوامل الديناميكية المركّبة التي انطوت عليها النزعات المحلّية العديدة، وتبادلت التأثير في ما بينها، وأسهم كلٌّ منها في تحويل الآخر من حال إلى حال. وقد شهدنا ذلك في حروب الهند الصينية في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، والحروب اليوغوسلافية في التسعينيات، وفي سلسلة من حروب عدة في مرحلة ما بعد الاستعمار في أفريقيا، ومنها الحرب الأفريقية الكبرى في الكونغو في تسعينيات القرن الماضي وأوائل القرن الحادي والعشرين.
تمكّنت أغلب هذه المناطق من تجنّب الوصول إلى حافة الهوة السحيقة وإقامة أنظمة إقليمية أكثر استقراراً، على الرغم مما يشوبها من هشاشة، وطرحت بذلك بعض الأمل في أن يحدث مثل ذلك في الشرق الأوسط. وبعد سقوط سايغون في أيدي الفيتكونغ بأربعة عقود، يعتقد بعض الخبراء أن فيتنام على وشك أن تصبح أحد أسرع الاقتصادات في العالم خلال العقود القليلة المقبلة.103 ولم تتمكّن البوسنة وكوزوفو ومقدونيا من تسوية الخلافات الطائفية والسياسية التي أدّت آخر الأمر إلى تجزئة يوغوسلافيا السابقة، غير أنها لاتزال تعيش في سلام واستقرار نسبي لأكثر من خمس عشرة سنة. كما تخلّصت أفريقيا من سمعتها السابقة بوصفها المنطقة التي قطّعت أوصالها الحروب: فالحروب التي انتهت في القرن الحادي والعشرين كانت أقل من تلك التي نشبت؛ كما أن الكونغو، التي لايزال يسودها عدم الاستقرار، باتت أقل عنفاً مما كانت عليه في الماضي.104
ترتبط السيطرة السياسية بالسيطرة الاقتصادية ارتباطاً لا فكاك منه في كل دولة عربية تقريباً، وتكون الحصيلة هي الفساد والمحسوبية كآثار جانبية لا مناص منها.
ترتبط السيطرة السياسية بالسيطرة الاقتصادية ارتباطاً لا فكاك منه في كل دولة عربية تقريباً، وتكون الحصيلة هي الفساد والمحسوبية كآثار جانبية لا مناص منها. وقد اعتمد معظم دول المنطقة على عائدات النفط بصورة أعاقت التنمية السياسية والاقتصادية بأكثر من طريقة. وتتطلّب إقامة الأسس المؤسسية للنمو الاقتصادي المستدام الذي يوجّهه القطاع الخاص، فك هذا الترابط وإتاحة المجال للمنافسة الديناميكية والابتكار. أما القادة الذين فشلوا حتى الآن في تقدير السكان في بلادهم باعتبارهم مصادر التنمية الاقتصادية، فمن المستبعد أن يضعوا رفاه الناس في صلب الأولويات، إلا إذا اقتنعوا ألا بديل عن ذلك.
أتاحت الأزمات المالية الناجمة عن انهيار أسعار النفط، على الرغم من آثارها المدمرة، الفرص لدعاة الإصلاح السياسي: ففي الوقت الذي يواجه فيه المواطنون العرب تآكل أنظمة الضمان الاجتماعي السخيّة التي اعتادوا عليها منذ أمد بعيد، يكون من الطبيعي أن يتوقعوا المزيد من المساءلة والمحاسبة والفعالية في شؤونهم الخاصة. وبسبب الروابط الاقتصادية والإنسانية والسياسية بين الأقطار العربية، فإن هذه البلدان، حتى تلك التي تعاني من شحٍّ في الموارد، قد تأثرت جرّاء انهيار الأسعار.
يتطلّب فك الروابط بين أنظمة السيطرة السياسية والاقتصادية نماذج سياسية اقتصادية جديدة. وينبغي بناء ثقافة للتشاور والحوار تتمحور فيها الائتلافات السياسية حول أهداف محدّدة تجري متابعتها من خلال سياسات متماسكة. وفي السلالات الملكية الحاكمة، تعني المشاركة في السلطة إعطاء المواطنين مزيداً من الحرية في تحديد خياراتهم السياسية عن طريق البرلمانات المنتخبة، ومجالس الشورى، والمجالس الاستشارية المحلّية؛ ومع مرور الوقت، ستكون هذه الحكومات أقرب إلى الملكيات الدستورية. وفي جمهوريات شمال أفريقيا، بما فيها الجزائر ومصر وليبيا وتونس، تعني المشاركة في السلطة الفصل بين السلطات بحيث لا تستأثر مؤسسة أو دائرة سياسية وحيدة بالسيطرة على غيرها. وفي الدول المركزية التي يمزّقها التناحر والصراع، ومنها ليبيا وسورية واليمن، قد يكون من الضروري إحداث تغييرات أكثر إثارة، ومنها، على سبيل المثال، استحداث آليات دستورية تتيح للمناطق والمجتمعات المحلية تدبير أمورها وتمنح حماية فيزيقية للأقليات.
على الرغم من قتامة الصورة، ثمة منظومة من الأسس التي يمكن البناء عليها. فمع أن مستويات التنمية البشرية في العالم العربي تظل أدنى مما هي عليه في معظم المناطق الأخرى، ومع أن النزاعات الكثيرة تقوّض بعض المكاسب الأخيرة، باتت المنطقة العربية الآن تتمتع بمستويات عالية من معرفة القراءة والكتابة وتشهد تحسّناً على صعيد الإنجازات التعليمية لدى النساء. علاوةً على ذلك، وعلى الرغم من الضغوط الصارمة في كثيرٍ من البلدان العربية، حقّب المجتمع المدني مستوى لا بأس به من النضج، مؤكّداً بذلك أن روح الانتفاضات العربية لم تُهزم تماماً، مع أن اللاعبين المدنيين جهدوا لترجمة هذا الصمود والقدرة على التكيف إلى نفوذ سياسي. كذلك بدأ عدد قليل من الدول، وبخاصة تونس والمغرب إلى حدٍّ ما، بتقبّل ضرورة تحديث العلاقات بين الدولة والمواطن. كما بدأ بعض قادة دول الخليج على الأقل بالاعتراف بأن النموذج القديم قد بدأ يطاله العطب. بيد أن الأيام وحدها ستبيّن ما إذا كانت السلالات الملكية مستعدّة للسماح لمواطنيها بأن يسهموا بدور ملموس في الحوكمة.
تُظهر لنا التجارب في سياقات أخرى أن الخيارات السياسية المتبصّرة قد تؤدي إلى تعزيز الاستقرار وإلى حوكمة أفضل. بيد أن البلدان العربية قد تواصل أوضاعها الحالية الرثة، إلا إذا خرجت برؤى وتصورات عن مجتمعات أكثر ديناميكية وحيوية. وإذا انطلقت المراحل المقبلة من مشروع "آفاق العالم العربي" من الإطار التحليلي الذي يعرضه هذا التقرير، فإنها ستكتشف سبلاً معقولة للوصول إلى شرق أوسط أكثر ازدهاراً وسلاماً، وستسعى إلى الإفصاح عن خيارات سياسية تعزّز هذه النتائج.
وإذا كانت هذه الانتفاضات قد حقّقت نجاحاً ما، فإنها ساعدت على الأقل في إلقاء الضوء على التحديات عميقة الغور التي تواجهها المجتمعات العربية في مسيرتها الطويلة نحو التمدُّن والمستقبل الأفضل.
إن تخيّلنا لشرق أوسط جديد قد يبدو أشبه بمغامرة جريئة. ففي أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي، بدأت حركة من المثقفين الراديكاليين برفض الأجواء السياسية المتهافتة التي كانت سائدة في المنطقة آنذاك. وفي العام 1968، نشر أحد أعضاء تلك الحركة، وهو الفيلسوف السوري المنشق صادق جلال العظم الذي توفّي في كانون الأول/ديسمبر 2016 في منفاه في برلين، كتاب "النقد الذاتي بعد الهزيمة" الذي أُودع بسببه السجن. ومع أنه كان في ظاهره تحليلاً للهزيمة العربية المُخزية أمام إسرائيل في حرب الأيام الستة، شكّل هذا الكتاب المرجعي في واقع الأمر نقداً مرّاً للثقافة السياسية العربية. واستنكر العظم لجوء الزعماء العرب إلى اختلاق الأعذار والتنصّل من اللوم بدلاً من تحمّل المسؤولية عن الهزيمة العسكرية، وتهرّبوا بذلك من فرصة التجديد الثقافي.
وبعد نحو نصف قرن، استعرض العظم، حصيلة الفوران الذي شهدته المنطقة في السنوات الأخيرة.105 وتردّدت أصداء من حملته النقدية السابقة عندما أعرب عن اعتقاده بأن الانتفاضات العربية قد ساعدتنا على فهم أبعاد الواقع الإقليمي كما هو بالفعل: دول تهيمن عليها كيانات طائفية وإثنية، بدلاً من الكيانات الوطنية الشاملة، وأنظمة ديكتاتورية أفسحت المجال لاندلاع الحروب الأهلية، وانهيار الدولة، والإرهاب. وإذا كانت هذه الانتفاضات قد حقّقت نجاحاً ما، فإنها ساعدت على الأقل في إلقاء الضوء على التحديات عميقة الغور التي تواجهها المجتمعات العربية في مسيرتها الطويلة نحو التمدُّن والمستقبل الأفضل.
مقالترسيخ التعددية في المجتمعات العربية
مروان المعشّر
يمكن تعريف التعددية بأنها احترام وتقدير التنوع السياسي، والثقافي، والديني، والجنوسي. وقد غابت إلى حدٍّ بعيد عن السلوك السياسي والثقافي العربي. وإذا كان ثمة عامل وحيد أسهم كل الإسهام في ركود المجتمعات العربية خلال العقود الأخيرة، فهو النزعة إلى تكرار الصيغ الجاهزة التي غالباً ما تخنق الإبداع، فسادت الثقافات التي تُعرَض فيها الوقائع بوصفها حقائق مطلقة، وتُقدّم الزعماء والأحزاب والإيديولوجيات باعتبارها تحمل الحلول للمشاكل كافة.
الأمل في قيام مجتمعات مزدهرة بصورة مستدامة وتجديد العالم العربي، لا يمكن تحقيقه إلا بتوفّر التزام حازم بالتعددية بجميع جوانبها.
غير أن الأمل في قيام مجتمعات مزدهرة بصورة مستدامة وتجديد العالم العربي، لا يمكن تحقيقه إلا بتوفّر التزام حازم بالتعددية بجميع جوانبها. ويعني ذلك، من الناحية السياسية، حق الجميع، سواء كانوا عَلْمانيين أو دينيين، بالانخراط في المشاركة السياسية السلمية. ولا يحق لأحد أن يحتكر الحقيقة أو السلطة. وإذا لم يترسّخ التداول السلمي للسلطة بصورة كاملة في الدساتير الغربية والممارسات السياسية على السواء، فإن النزعة التسلطية لن تفضي إلا إلى المزيد من الشرذمة، والشقاق، والعنف.
يتعيّن على البلدان العربية أن تركّز على بلورة هُويات وطنية قوية قادرة على استيعاب جميع الولاءات الأخرى. وينبغي النظر إلى التنوع الثقافي، والإثني، والديني في العالم العربي بوصفه مصدر قوة لا ضعف. ويعني ذلك أن على الحكومات أن تُنمّي إحساساً بالمواطنة يُعلي من شأن التنوّع، عوضاً عن تشجيع أشكال ضيقة من الشعور القومي تؤكّد تفوّق فئات معينة على فئات أخرى. ومن العوامل الحيوية في تعزيز المواطنة الإقرار والاعتراف بحقوق المرأة، بجعل هذه الحقوق جزءا أصيلاً لا يتجزّأ من الدساتير والتشريعات.
يتطلّب تجسيد هذه التطلعات اتخاذ خطوات مهمة عدّة. فلا بدّ، أولاً، من إعادة صوغ مناهج التربية والتعليم الوطنية، والاستعاضة عن برامج التعليم المُسخَّرة لإظهار الخضوع والولاء لزعيم أو جماعة من الزعماء المقتدرين بمناهج تعلّم الولاء للوطن.
ثانياً، ينبغي أن يُطبَّق حكم القانون على الجميع بالتساوي، سواء كانوا من الأغلبيات أو الأقليات. فقد كانت العدالة الاجتماعية واحداً من المطالب التي طرحتها مختلف الانتفاضات العربية العام 2011. وكان المواطنون في البلدان العربية يعربون عن موقف معارض لممارسة المحسوبية- الذي توزع فيه المكرمات والامتيازات على البعض لقاء ولائهم لزعيم أو نظام – وهو نظام شاع منذ عهد بعيد في بقاع عديدة من العالم العربي. ونتيجةً لذلك، فإن الناس لا يشعرون بأن بوسعهم تحقيق التقدم في حياتهم على أساس الجدارة. وقد ارتدّ أكثرهم إلى الانتماء إلى هُويّات فرعية – سواء كانت دينية، أم قبلية، أم جغرافية – بوصفها قنوات أكثر فعالية يمكن من خلالها التعامل مع مظالمهم.
وثالثاً، ينبغي تأمين حماية قانونية لحرية الاختلاف. فمن الأمور الحيوية أن تقوم البلدان التي تشهد مرحلة انتقالية إلى أنظمة أكثر انفتاحاً، بمأسسة الحقوق الخاصة بجميع الشرائح الاجتماعية. وسيؤدي الترسيخ المبكر لهذه الحريات إلى ضمان انتقال أكثر سلاسة، ويكفل للمواطنين، في الوقت نفسه، أن حكوماتهم ستصون حقوقهم. وسيفضي ذلك، بدوره، إلى تعزيز التماهي، بصورة أقوى، مع الدولة في أوساط المواطنين.
ولا يكفي الالتزام بالتعددية كشرط وحيد لضمان الاستقرار والازدهار في العالم العربي، إلا أنه خطوة ضرورية أولى لوضع بلدان المنطقة على المسار الصحيح المؤدّي إلى تحقيق هذه الأهداف الأساسية.
يشغل مروان المعشّر منصب نائب الرئيس للدراسات في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وشغل سابقاً منصبَي نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية في الأردن.
هوامش
1 Perry Cammack and Marwan Muasher, “Arab Voices on the Challenges of the New Middle East,” Carnegie Endowment for International Peace, February 3, 2016, http://carnegieendowment.org/2016/02/12/arab-voices-on-challenges-of-new-middle-east-pub-62721.
2 “A Tale of Three Islands,” Economist, October 19, 2011, http://www.economist.com/node/21533364.
3 United Nations Development Programme, Arab Human Development Report 2002, http://www.arab-hdr.org/publications/other/ahdr/ahdr2002e.pdf.
4 World Economic Forum, “The Global Competitiveness Index 2014-2015 Rankings,” http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2014-2015/rankings/.
5 World Bank, “World Development Indicators: Adult Female Literacy,” http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&Topic=4.
6 Catriona Davies, “Mideast Women Beat Men in Education, Lose Out at Work,” CNN, June 6, 2012, http://www.cnn.com/2012/06/01/world/meast/middle-east-women-education/.
7 World Bank, “World Development Indicators: Labor Force Structure,” October 14, 2016, http://wdi.worldbank.org/table/2.2#.
8 انظر ملاحظات ميشيل باشليه، الرئيسة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العام 2012، http://www.unwomen.org/en/news/stories/2012/4/women-s-empowerment-in-the-middle-east-and-worldwide. وانظر أيضاً البيانات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة للعام 2016، التي تُظهر أن نسبة تمثيل المرأة البرلماني في الدول العربية هو الأدنى بعد منطقة المحيط الهادئ، http://www.unwomen.org/en/what-we-do/leadership-and-political-participation/facts-and-figures.
9 World Bank, “Fertility Rate, Total (Births per Woman),” October 14, 2016, http://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?end=2014&start=1990.
10 World Bank, “World Development Indicators: Fertility Rate,” http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=2&series=SP.DYN.TFRT.IN&country=.
11 U.S. Census Bureau, “International Data Base,” last modified September 27, 2016, http://www.census.gov/population/international/data/idb/region.php?N=%20Results%20&T=12&A=aggregate&RT=0&Y=2016&R=130&C=AG,BA,CN,DJ,EG,GZ,IZ,JO,KU,LE,LY,MR,MO,MU,SA,SO,SU,SY,TS,AE,WE,WI,YM.
12 Jack. A Goldstone, “Youth Bulges and the Social Conditions of Rebellion,” World Politics Review, November 20, 2012, http://www.worldpoliticsreview.com/articles/12507/youth-bulges-and-the-social-conditions-of-rebellion; and Omen Yair and Dan Miodownik, “Youth Bulge and Civil War: Why a Country’s Share of Young Adults Explains Only Non-Ethnic War,” Conflict Management and Peace Science 33, no. 1 (February 2016): 25–44, http://cmp.sagepub.com/content/33/1/25.
13 استناداً إلى منظمة العمل الدولية، يبلغ متوسط معدل البطالة لدى الشباب 30.5 في المئة في الشرق الأوسط، و28.2 في المئة في شمال أفريقيا، مقارنة بمتوسط عالمي يبلغ 13 في المئة، http://www.ilo.org/beirut/media-centre/news/WCMS_412797/lang--en/index.htm.
14 World Bank, “Visual Report: Why MENA Needs a New Social Contract,” June 3, 2016, http://menaviz.worldbank.org/new_social_contract/index.html#5.
15 Population Reference Bureau, “Youth Population and Unemployment in the Middle East and North Africa,” July 2011, http://www.un.org/esa/population/meetings/egm-adolescents/roudi.pdf/.
16 Richard Cincotta, “Will Tunisia’s Democracy Survive? A View From Political Demography,” New Security Beat, May 12, 2015, https://www.newsecuritybeat.org/2015/05/tunisias-democracy-survive-view-political-demography/.
17 World Bank, “More Jobs, Better Jobs: A Priority for Egypt,” June 1, 2014, http://documents.worldbank.org/curated/en/926831468247461895/pdf/884470EG0repla00Box385343B00PUBLIC0.pdf.
18 تستند الحسابات إلى تقديرات البنك الدولي لعدد السكان في العراق، وليبيا، وفلسطين، والصومال، والسودان، وسورية، واليمن؛ ورد ذلك في: http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL.
19 تستند الحسابات إلى إجمالي عدد الأشخاص الذين نزحوا بالقوة في الدول التالية: العراق، وليبيا، وفلسطين، والصومال، والسودان، وسورية، واليمن؛ ورد ذلك في: http://www.internal-displacement.org/database/.
20 تستند الحسابات إلى تقديرات البنك الدولي؛ وردت في: http://data.worldbank.org/region/arab-world; وأيضاً في:” World Bank, 2016, http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL/.
21 تستند الحسابات إلى تقديرات لعدد اللاجئين حول العالم (21.3 مليوناً)، وردت في: http://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html. حوالى 5 ملايين لاجئ أتوا من دول عربية مختلفة، (انظر: http://data.worldbank.org/indicator/SM.POP.REFG.OR) و5 ملايين آخرين من فلسطين، (انظر: http://www.unrwa.org/palestine-refugees).
22 “Syrian Refugees,” European University Institute, Robert Schuman Center for Advanced Studies, and Migration Policy Center, 2016, http://syrianrefugees.eu/.
23 UNHCR, World at War: Global Trends, Forced Displacement in 2014 (Geneva: UNHCR, 2015), http://unhcr.org/556725e69.html.
24 “Iraq IDP Figures Analysis,” Internal Displacement Monitoring Center, 2016, http://www.internal-displacement.org/middle-east-and-north-africa/iraq/figures-analysis.
25 تستند الحسابات إلى إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجليين، ورد ذلك في: http://www.unrwa.org/sites/default/files/unrwa_in_figures_2015.pdf.
26 Don Murray, “UNHCR Says Most of Syrian Arriving in Greece Are Students,” ed. Jonathan Clayton, UNHCR, December 8, 2015, http://www.unhcr.org/news/latest/2015/12/5666ddda6/unhcr-says-syrians-arriving-greece-students.html.
27 “Under Siege: The Devastating Impact on Children of Three Years of Conflict in Syria,” United Nations Children’s Fund (UNICEF), March 2014, https://www.unicef.org/publications/files/Under_Siege_March_2014.pdf.
28 “Confronting Fragmentation!: Impact of Syrian Crisis Report,” Syrian Center for Policy Research, February 11, 2016, http://scpr-syria.org/publications/confronting-fragmentation/.
29 “Millions of Yemenis Face Food Insecurity Amidst Escalating Conflict,” Food and Agriculture Organization of the United Nations, April 15, 2015, http://www.fao.org/news/story/en/item/283319/icode/.
30 “Iraq,” World Food Program, 2016, https://www.wfp.org/countries/iraq; and “WFP Libya: Situation Report #7,” World Food Program, March 31, 2016, http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/wfp283064.pdf.
31 “Syria Regional Refugee Response: Total Persons of Concern,” UNHCR, November 7, 2016, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=107.
32 “Syria Regional Refugee Response: Total Persons of Concern,” UNHCR, September 30, 2016, https://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=122.
33 “Where We Work, Jordan,” UNRWA, December 1, 2015, http://www.unrwa.org/where-we-work/jordan.
34 “Where We Work: Lebanon,” UNRWA, July 1, 2014, http://www.unrwa.org/where-we-work/lebanon.
35 تستند الحسابات إلى إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجليين في المخيّمان (158683)، مقسومة على إجمالي عدد اللاجئين الفلسطينيين المسجليين في الأردن (655833)، ورد ذلك في: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/region.php?id=77&country=107.
36 Maha Yahya, “Refugees and the Making of an Arab Regional Disorder,” Carnegie Middle East Center, November 9, 2015, http://carnegie-mec.org/2015/11/09/refugees-and-making-of-arab-regional-disorder-pub-61901; and Katherine Jones and Leena Ksaifi, “Struggling to Survive: Slavery and Exploitation of Syrian Refugees in Lebanon,” Freedom Fund, April 12, 2016, http://freedomfund.org/wp-content/uploads/Lebanon-Report-FINAL-8April16.pdf.
37 World Food Program, UNHCR, and UNICEF, “Vulnerability Assessment of Syrian Refugees in Lebanon: 2015 Report,” World Food Program, December 2015, http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/ena/wfp280798.pdf?_ga=1.225382618.1912382316.1461709493.
38 Raf Sanchez, Josie Ensor, and Magdy Samaan, “Daraya Surrenders to Assad Regime After Four Years of Siege and Starvation,” Telegraph, August 26, 2016, http://www.telegraph.co.uk/news/2016/08/26/daraya-surrenders-to-assad-regime-after-four-years-of-siege-and/; وأيضاً: "ملف المعتقلين وتغيير الديموغرافيا «يفجّران» هدنة الزبداني"، صحيفة الحياة، 16 آب/أغسطس 2015، http://www.alhayat.com/Articles/10603868/%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%88%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7--%D9%8A%D9%81%D8%AC%D9%91%D8%B1%D8%A7%D9%86--%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A.
39 “Europol and Interpol Issue Comprehensive Review of Migrant Smuggling Networks,” press release, Europol, May 17, 2016, https://www.europol.europa.eu/content/europol-and-interpol-issue-comprehensive-review-migrant-smuggling-networks.
40 “Confronting Fragmentation!” Syrian Center for Policy Research.
41 “Bahrain,” World Bank, 2016, http://data.worldbank.org/country/bahrain.
42 Jennifer Preston, “Movement Began With Outrage and a Facebook Page That Gave It an Outlet,” New York Times, February 5, 2011, http://www.nytimes.com/2011/02/06/world/middleeast/06face.html?_r=1; Rajia Aboulkheir, “Key Players in Egypt’s Jan. 25 Revolution: Where Are They Now?” Al Arabiya, January 25, 2014, http://english.alarabiya.net/en/perspective/analysis/2014/01/25/Key-players-in-Egypt-s-Jan-25-revolution-Where-are-they-now-.html; and Samaa Gamie, “The Cyber-Propelled Egyptian Revolution and the De/Construction of Ethos,” in Online Credibility and Digital Ethos: Evaluating Computer-Mediated Communication, eds. Moe Folk and Shawn Apostel (Hershey, PA: Information Science Reference, 2013), 316–30.
43 Charis Boutieri, “Jihadists and Activists: Tunisian Youth Five Years Later,” openDemocracy, July 29, 2015, https://www.opendemocracy.net/arab-awakening/charis-boutieri/jihadists-and-activists-tunisian-youth-five-years-later.
44 Ragab Saad, “Egyptian Political Parties and the Civil Society Crisis,” Tahrir Institute for Middle East Policy, May 10, 2016, http://timep.org/commentary/egyptian-political-parties-and-the-civil-society-crisis/.
45 Megan Detrie, “Cairokee: One Cairo Band Becomes a Revolutionary Discovery,” National, December 29, 2011, http://www.thenational.ae/arts-culture/music/cairokee-one-cairo-band-becomes-a-revolutionary-discovery; and Sarah Sirgany, “Incendiary Lyrics and High-Powered Motorbikes: Egypt’s Revolutionary Rock Band Won’t Keep Quiet,” CNN, April 3, 2014, http://edition.cnn.com/2014/04/02/world/meast/egypt-revolutionary-rock-band-wont-keep-quiet/.
46 Jihad Abaza, “Egyptian Students Protest Against ‘Oppressive’ Education System,” Aswat Masriya, June 27, 2016, http://en.aswatmasriya.com/albums/details/139; and Amina Ismail, “After University Crackdown, Egyptian Students Fear for Their Future,” Reuters, June 1, 2016, http://www.reuters.com/investigates/special-report/egypt-students/.
47"دراسة مسحية حول وضع منظمات المجتمع المدني المحلية في اليمن— 2015"، مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، 25 أيار/مايو 2015، http://www.economicmedia.net/new/detail.asp?sub_ID=270&sec_no=11&DATE=25%2F5%2F2016.
48 Shanta Devarajan and Lili Mottaghi, “Visual Report: Why MENA Needs a New Social Contract,” World Bank, January 2016, http://menaviz.worldbank.org/new_social_contract/index.html.
49 Muhammad Faour and Marwan Muasher, “Education for Citizenship in the Arab World: Key to the Future,” Carnegie Endowment for International Peace, October 26, 2011, http://carnegieendowment.org/files/citizenship_education.pdf.
50 Perry Cammack and Marwan Muasher, “Arab Voices on the Challenges of the New Middle East,” Carnegie Endowment for International Peace, February 12, 2016, http://carnegieendowment.org/2016/02/12/arab-voices-on-challenges-of-new-middle-east-pub-62721.
51 المصدر السابق.
52 كانت الإمارات العربية المتحدة وقطر فقط من بين الدول الأولى العشرين ضمن تصنيفات مؤشر التنافسية العالمي 2016-2017. انظر: http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf.
53 Tهذه الفقرة (والفقرتان اللاحقتان) مقتبسة من: The Second Arab Awakening: And the Battle for Pluralism (New Haven, CT: Yale University Press, 2015), 19–20.
54 Elias Lambrianos-Sabeh and David Graves, “Mid-East States Attempt to Diversify Economies Amid Low Oil Prices,” Forbes, August 26, 2016, http://www.forbes.com/sites/debtwire/2016/08/26/mid-east-states-attempt-to-diversify-economies-amid-low-oil-prices/#1a6dc8f07ee6.
55 Marwan Muasher, “Freedom and Bread Go Together,” Finance and Development 50, no. 1 (March 2014): 14–17.
56 المصدر السابق.
57 Question 210 in “Arab Barometer IV,” Arab Barometer, publication forthcoming 2017, http://www.arabbarometer.org/.
58 “Egypt: The Arithmetic of Revolution,” Gallup, April 2011, http://www.gallup.com/poll/157043/egypt-arithmetic-revolution.aspx.
59 “Thriving Economy Investing for the Long-Term,” Saudi Vision 2030, http://vision2030.gov.sa/en/node/6.
60 Yezid Sayigh, “Missed Opportunity: The Politics of Police Reform in Egypt and Tunisia,” Carnegie Endowment for International Peace, March 17, 2015, http://carnegieendowment.org/files/missed_opportunity.pdf.
61 Yezid Sayigh, “Crumbling States: Security Sector Reform in Libya and Yemen,” Carnegie Endowment for International Peace, June 18, 2015, http://carnegieendowment.org/files/Paper_Yezid-Sayigh_crumbling_states.pdf.
62 Sayigh, “Missed Opportunity.”
63 Omar Belhaj Salah, “Liberty and Security in Tunisia,” Sada (blog), Carnegie Endowment for International Peace, September 16, 2014, http://carnegieendowment.org/sada/56633.
64 Jeremy M. Sharp, “Jordan: Background and U.S. Relations,” Congressional Research Service, April 21, 2011, http://fpc.state.gov/documents/organization/162769.pdf.
65 Patricia J. Campbell, “Morocco in Transition: Overcoming the Democratic and Human Rights Legacy of King Hassan II,” African Studies Quarterly 7, no. 1 (Spring 2003): http://asq.africa.ufl.edu/files/Campbell-Vol-7-Issue-1.pdf.
66 Maati Monjib, “Record Gains for Morocco’s Islamist Party,” Sada (blog), Carnegie Endowment for International Peace, October 27, 2016, http://carnegieendowment.org/sada/64968.
67 Anthony Shadid, “Bahrain Boils Under the Lid of Repression,” New York Times, September 15, 2011, http://www.nytimes.com/2011/09/16/world/middleeast/repression-tears-apart-bahrains-social-fabric.html; and “Saudi Arabia: Repression in the Name of Security,” Amnesty International, December 1, 2011, https://www.amnesty.org/en/documents/MDE23/016/2011/en/.
68 Alexandra Siegel, “Sectarian Twitter Wars: Sunni-Shia Conflict and Cooperation in the Digital Age,” Carnegie Endowment for International Peace, December 20, 2015, http://carnegieendowment.org/files/CP_262_Siegel_Sectarian_Twitter_Wars_.pdf.
69 Marc Lynch, “How the Media Trashed Transitions,” Journal of Democracy 26, no.4 (October 2015): 90–100; Edward Webb, Media in Tunisia and Egypt: From Control to Transition? (New York: Palgrave, 2014); Rasha Abdulla, “Egypt’s Media in the Midst of Revolution,” Carnegie Endowment for International Peace, July 2014, http://carnegieendowment.org/files/egypt_media_revolution.pdf; Jared Malsin, “Pro-Regime Journalists Are Shaping Public Opinion in Egypt,” Columbia Journalism Review, January 22, 2015, http://www.cjr.org/b-roll/egypt_sisi_mona_iraqi.php.
70 Philip N. Howard and Muzammil M. Hussain, Democracy’s Fourth Wave?: Digital Media and the Arab Spring (New York: Oxford University Press, 2013); Tarek Elmasry et al., “Digital Middle East: Transforming the Region Into a Leading Digital Economy,” McKinsey & Company, October 2016.
71 “Arab Barometer IV,” Arab Barometer, publication forthcoming 2017, http://www.arabbarometer.org/.
72 جميع البيانات الواردة في هذه الفقرة مقتبسة من: the Chicago Project on Security and Terrorism, “Suicide Attack Database,” University of Chicago, accessed on April 19, 2016, http://cpostdata.uchicago.edu/. بين العامين 1982 و2000، قُدّر عدد الهجمات في جميع أنحاء المنطقة، نفذت معظمها حركة حماس وحزب الله وحزب العمال الكردستاني، بنحو 85. وشملت 42 هجوماً في لبنان، و15 في إسرائيل، و11 في الضفة الغربية وغزة، و2 في الكويت، و1 في كل من مصر وإيران والكويت واليمن.
73 The numbers of suicide attacks between 1982 and 2011 in Egypt, Libya, Syria, and Yemen were 7, 0, 5, and 20, respectively. But between 2012 and 2015, these respective numbers jumped to 21, 32, 201, and 88.
74 Sulaiman Momodu, “Somalia Rising From the Ashes,” Africa Renewal 30, no. 1 (April 2016): 36–37, http://www.un.org/africarenewal/sites/www.un.org.africarenewal/files/Africa_Renewal_EN_April_2016.pdf.
75 للمزيد من التفاصيل، انظر: Marc Lynch, The New Arab Wars: Uprisings and Anarchy in the Middle East (New York: Public Affairs, 2016).
76 “Crude Oil 1946-2016,” Trading Economics, 2016, http://www.tradingeconomics.com/commodity/crude-oil.
77 “After the Party,” Economist, March 26, 2016, http://www.economist.com/news/middle-east-and-africa/21695539-low-oil-price-manageable-short-term-gulf-states-must-make.
78 Aya Batrawy, “The International Monetary Fund Says Oil Exporting Countries in the Middle East Lost $390 Billion in Revenue Due to Lower Oil Prices Last Year, and Should Brace for Losses of Around $500 Billion This Year,” U.S. News & World Report, April 25, 2016, http://www.usnews.com/news/business/articles/2016-04-25/imf-expects-500b-revenue-loss-for-mideast-oil-exporters.
79 Clifford Krauss, “Oil Prices: What’s Behind the Volatility? Simple Economics,” New York Times, last updated November 2, 2016, http://www.nytimes.com/interactive/2016/business/energy-environment/oil-prices.html?_r=1; and Josh Zumbrun, “Supply or Demand? The IMF Breaks Down the Collapse of Oil Prices,” Real Time Economics (blog), Wall Street Journal, April 14, 2015, http://blogs.wsj.com/economics/2015/04/14/supply-or-demand-the-imf-breaks-down-the-collapse-of-oil-prices/.
80 “Commodity Special Feature,” in World Economic Outlook: Too Slow for Too Long, International Monetary Fund (Washington, DC: International Monetary Fund, April 2016), https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2016/01/pdf/SF_Commod.pdf.
81 المصدر السابق.
82 “BP Statistical Review of World Energy, June 2016,” BP, June 2016, https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/statistical-review-2016/bp-statistical-review-of-world-energy-2016-full-report.pdf.
83 In April 2016, the IMF projected a $25–$75 price band through the end of 2019, with a 68 percent confidence interval. See: “Commodity Special Feature,” in Too Slow for Too Long.
84 Sheikh Mohamed bin Zayed, “Remarks at the 2016 Government Summit” (speech, Dubai, February 9, 2016), Embassy of the United Arab Emirates, http://www.uae-embassy.org/news-media/his-highness-sheikh-mohamed-bin-zayed-keynote-remarks-2015-government-summit-dubai.
85 “Foreword,” Saudi Vision 2030, http://vision2030.gov.sa/en/foreword.
86 Karen E. Young, “Drop in the Bucket: Reduced Fuel Subsidies Offer Little Deficit Relief,” Arab Gulf States Institute in Washington, April 6, 2016, http://www.agsiw.org/drop-in-the-bucket-reduced-fuel-subsidies-offer-little-deficit-relief/.
87 Sarah Diaa, “GCC States in Agreement on 5% VAT,” Gulf News, February 22, 2016, http://gulfnews.com/business/economy/gcc-states-in-agreement-on-5-vat-1.1677576.
88 “Iraq’s Economic Outlook – Spring 2016,” World Bank, 2016, http://www.worldbank.org/en/country/iraq/publication/economic-outlook-spring-2016.
89 “Foreword,” Saudi Vision 2030, http://vision2030.gov.sa/en/foreword.
90 World Meteorological Organization, “WMO Examines Reported Record Temperature of 54°C in Kuwait,” July 26, 2016, http://public.wmo.int/en/media/news/wmo-examines-reported-record-temperature-of-54°c-kuwait/.
91 J. Leliveld, Y. Proestos, P. Hadjinicolaou, et al., “Strongly Increasing Heat Extremes in the Middle East and North Africa (MENA) in the 21st Century,” Climatic Change 137, no. 1 (July 2016): 245–60.
92 Hugh Naylor, “An Epic Middle East Heat Wave Could Be Global Warming’s Hellish Curtain-Raiser,” Washington Post, August 10, 2016, https://www.washingtonpost.com/world/middle_east/an-epic-middle-east-heat-wave-could-be-global-warmings-hellish-curtain-raiser/2016/08/09/c8c717d4-5992-11e6-8b48-0cb344221131_story.html.
93 United Nations Development Program, Water Governance in the Arab Region: Managing Scarcity and Securing the Future (New York: United Nations Publications, November 2013), http://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/huma_development/water-governance-in-the-arab-region.html.
94 World Bank, “Adaptation to Climate Change in the Middle East and North Africa Region,” December 21, 2007, http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/MENAEXT/0,,contentMDK:21596766~pagePK:146736~piPK:146830~theSitePK:256299,00.html.
95 World Bank, Making the Most of Scarcity: Accountability for Better Water Management Results in the Middle East and North Africa (Washington, DC: World Bank, June 2009), http://siteresources.worldbank.org/INTMNAREGTOPWATRES/Resources/Making_the_Most_of_Scarcity.pdf.
96 “Yemen’s Looming Water Crisis,” Stratfor, December 1, 2014, https://www.stratfor.com/sample/analysis/yemens-looming-water-crisis.
97 Habiba Gitay and Ian R. Noble, eds., “Executive Summary” to chapter 7 of The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vulnerability (Cambridge: Intergovernmental Panel on Climate Change, November 1997), http://www.ipcc.ch/ipccreports/sres/regional/index.php?idp=154.
98 Klaus Klingmuller, Andrea Pozzer, Swen Metzger, Georgiy L. Stenchikov, and Jos Lelieveld, “Aerosol Optical Depth Trend Over the Middle East,” Atmospheric Chemistry and Physics 16, no. 8 (Spring 2016): 5063–73. Quoted in Johannes Lelieveld, “Climate-Exodus Expected in the Middle East and North Africa,” Max Planck Institute for Chemistry, May 2, 2016, https://www.mpg.de/10481936/climate-change-middle-east-north-africa.
99 United Nations Development Program, Water Governance in the Arab Region.
100 Stephen Leahy and Katherine Purvis, “Peak Salt: Is the Desalination Dream Over for the Gulf States?” Guardian, September 29, 2016, https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2016/sep/29/peak-salt-is-the-desalination-dream-over-for-the-gulf-states.
101 آية امان، "سد النهضة.. معدلات مرتفعة في الانشاءات.. ومسار معقد في المفاوضات"، موقع المونيتور، 10 آب/أغسطس 2016، http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2016/08/egypt-ethiopia-renaissance-dam-construction-progress-talks.html; Liam Stack, “With Cameras Rolling, Egyptian Politicians Threaten Ethiopia Over Dam,” The Lede (blog), New York Times, June 6, 2013, http://thelede.blogs.nytimes.com/2013/06/06/with-cameras-rolling-egyptian-politicians-threaten-ethiopia-over-dam/; and “Ethiopia Blames Egypt for State of Emergency,” Voice of America News, October 10, 2016, http://www.voanews.com/a/ethiopia-blames-egypt-for-state-of-emergency/3544684.html.
102 “Drought Driving Farmers to the Cities,” IRIN, September 2, 2009, http://www.irinnews.org/feature/2009/09/02/drought-driving-farmers-cities.
103 Enda Curran, “Asia’s About to Spawn a New Tiger Economy: Good Morning, Vietnam,” Bloomberg, March 22, 2015, http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-03-22/asia-s-about-to-spawn-a-new-tiger-economy-good-morning-vietnam.
104 David T. Burbach, “The Coming Peace: Africa’s Declining Conflicts,” Sustainable Security (blog), Oxford Research Group, September 22, 2016, https://sustainablesecurity.org/2016/09/22/the-coming-peace-africas-declining-conflicts/.
105 خالد سلامة، "العظم: الربيع العربي كشف عن هويات وعصبيات تحت وطنية"، موقع DW، 28 آب/أغسطس 2015، http://m.dw.com/ar/العظم-الربيع-العربي-كشف-عن-هويات-وعصبيات-تحت-وطنية/a-18620694.
يتقدّم المؤلفون بالشكر إلى كلٍّ من جوزيف باحوط وناثان ج. براون وريناد منصور وفريدريك ويري لمساهماتهم القيّمة في هذا التقرير.
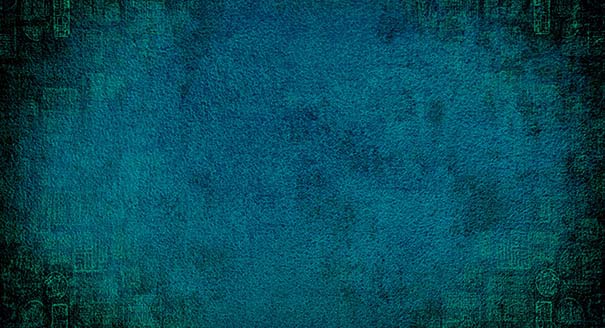
مقالتحذير لم يلق آذاناً صاغية
ريما خلف
حرب وموت ودمار. سماء تعجّ بقاذفات القنابل وافدة من كل صوب. مشاهد أصبحت معتادة لكثيرين من العرب. قضى مئات الألوف وشُرّد الملايين. استشرى العنف على أيدي جماعات مسلحة خارجة عن نطاق الدولة، واختُرقت الحدود. واقع المنطقة اليوم بعد عقود من الاستبداد والتدخل الأجنبي، فوضى ومعاناة.
هذه الكارثة توقعتها تقارير التنمية الإنسانية العربية التي صدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بدءاً من العام 2002. نواقص في الحرية والمعرفة وتمكين المرأة أدت إلى تعثر مسيرة التنمية وتهميش غالبية الناس. نواقص أدّت، تحت وطأة الاحتلالات العسكرية والاستباحة الخارجية، إلى مزيج متفجر من الغضب والإحباط واليأس. وفي غياب القنوات السلمية لمعالجة المظالم، سوف ينقاد بعض العرب إلى العنف غير عابئين بما يترتب عليه من عواقب وخيمة.
دعت تقارير التنمية الإنسانية إلى إصلاحات سياسية واقتصادية جدية تمكّن من انتقال منظّم وسلمي إلى الديمقراطية. لكن الاستجابة لم تعدُ كونها مبادرات مجتزأة وتجميلية. فظلت الحريات مخنوقة، واستمر انتهاك الحقوق، وقُتل الكثيرون بسبب آرائهم أو انتماءاتهم، أو قبعوا في السجون إلى أجل غير مسمى دون محاكمة عادلة.
أما الفلسطينيون فما زالوا، في قبضة الاحتلال الإسرائيلي الظالم الذي لا ينتهي، يعانون انتهاكات لهذه الحقوق وغيرها، ومنها حق تقرير المصير.
وبلغ السخط ذروته في العام 2011، عندما هبّت جموع العرب ضد الظلم. فأُطيح بالطاغية في تونس، وكانت بداية لانتقال سلمي إلى الديمقراطية. وحيث غلبت الحكمة، كما في المغرب، استُجيب لمطالب الشعب بإصلاحات هامة. وشدّد من هم أقل حكمة وتبصّراً قمعهم، فأقحموا بلدانهم في صراعات دينية ومذهبية وقبلية وعرقية، وتوسّلوا التدخل العسكري الأجنبي.
اشتدت المخاطر على حياة العرب، واتسعت دائرة الظالمين. وأُضيف الظلم المستحدث للجماعات العنيفة والشبكات الإجرامية على الظلم القديم للأنظمة الاستبدادية والقوى الأجنبية، فضاعت حتى البقية القليلة من حقوق العرب وحرياتهم.
ولا تترك الأزمات الراهنة الكثير من الخيارات. وليس لمن لم يَطَلْهم العنف حتى الآن أن يطمئنوا. فما لم تُنفّذ إصلاحات جذرية لتمكين الناس، ستمتدّ ألسنة اللهب إلى الجميع. لا بدّ من عقد اجتماعي جديد قائم على رضا المحكومين، وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية.
على الحكام العرب أن يعملوا على إنهاء القتال في الأقطار المجاورة، لا على تسعيره، وأن يحرصوا على حماية وحدتها وسلامة أراضيها بدعم الديمقراطية على أساس المواطنة المتساوية وحماية الحقوق الثقافية والدينية للجميع. ولا بد من تجنب اتفاقيات "تقاسم السلطة" على أسس طائفية وعرقية، فهي وإن ساعدت على وقف الحروب غالباً ما تفتّت المجتمعات.
وسيستمر الظلم ما استمر الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين. إن إخضاع شعب لشعب آخر أكثر من نصف قرن، لظلم طويل. وإن اعتبار الفلسطينيين أقل أهلية للتمتع بالحقوق الكونية من غيرهم، لأمر بغيض. إن في الدعوة إلى إقامة دول تؤسس المواطنة على الدين، سواء أكانت يهودية أم إسلامية أم غير ذلك، خرق لمبادئ المساواة ومناهضة التمييز العالمية، وإدامة للصراع وإحياء لممارسات التطهير العرقي ومفاقمة للمعاناة الإنسانية.
لمصلحتهم هم، وللسلام في العالم، على الدول العربية والقوى الدولية السير على درب الإصلاح وإنهاء الحروب والاحتلالات. أما إذا ظل هاجسهم الوحيد البقاء في السلطة، فإنهم سيسقطون في الهاوية لا محالة.
ريما خلف هي الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). وتولّت قبل ذلك منصب مساعد الأمين العام ومدير المكتب الإقليمي للبلدان العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنصب نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزير الصناعة والتجارة في الأردن.