الأرض الجافة: أزمة المياه المُتفاقمة في العراق
مقدّمة
تُعدّ المياه جزءًا لا يتجزّأ من تاريخ العراق، بلاد ما بين النهرَين ومهد الحضارات القديمة. وتُعزى استمرارية الحياة والتطوّر الإنساني في هذه المنطقة من العالم بشكلٍ كبير إلى وفرة مياهها، وخصوبة أرضها، وقدرة سكانها على الاستفادة من مواردها وتشكيل مجتمعات حولها. لكن البلاد التي كانت تُعرف في الأيام الغابرة بجنّة عدن تحوّلت في أيامنا هذه إلى صحراء قاحلة. فالموارد التي أتاحت للسكان فرصة العيش برخاء وازدهار في بلاد الرافدَين آخذةٌ بالانحسار، ما يؤدّي إلى تدهور الأوضاع البيئية وإشعال جذوة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
إن نقص المياه في العراق ناجمٌ عن عوامل عدّة هي: تردّي البنى التحتية، وضعف إمكانيات الدولة، ومشاريع توليد الطاقة الكهرومائية التي تواصل تركيا وإيران بناءها من جهة المنبع، ناهيك عن الظروف المناخية القاسية التي تعصف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وموجات الجفاف الحادة والطويلة، وتراجع معدّلات هطول الأمطار. وقد توقّعت بعض التقارير أن يُمسي العراق أرضًا بلا أنهار بحلول العام 2040، مع جفاف نهرَيه الرئيسَين دجلة والفرات، إن لم تتّم معالجة التهديدات المناخية المُحدقة. فهذان النهران، اللذان ينبعان من تركيا ويمرّان عبر سورية قبل الوصول إلى الأراضي العراقية، يؤمّنان ما نسبته 98 في المئة تقريبًا من إمدادات المياه في البلاد.
وإذ تشكّل هذه المعطيات مدعاةً للقلق، واقع الحال أن تداعيات هذا الوضع لن تقف عند هذا الحدّ. ففي حال لم تُعالَج أزمة المياه في العراق بصورة فعّالة، ستشتعل جذوة الاضطرابات المحلّية، وستؤدّي زعزعة الاستقرار إلى عواقب اجتماعية واقتصادية وسياسية وخيمة تطال أيضًا الدول المجاورة. لذا، يتعيّن على الحكومة العراقية والمنظمات الدولية اتّخاذ تدابير فورية لمعالجة أزمة نقص المياه في العراق.
تشخيص المشكلة
تنتشر أزمة المياه في جميع أنحاء العراق. وفي العام 2023، بعد أن مرّت البلاد بأربعة فصول من الجفاف، بلغ منسوب المياه في سدّ الموصل، الذي تتراوح سعته التخزينية بين 6 مليارات متر مكعب و11 مليارًا، أدنى مستوياته منذ إنشاء السدّ في العام 1986، وظهرت للمرة الأولى منذ أربعين عامًا ثلاثة معالم أيزيدية كانت تغمرها المياه. وإن لم تُتَّخذ تدابير عاجلة، يقدّر الخبراء أن بحيرة سدّ الموصل قد تجفّ قريبًا، ما سيترك نحو 1.7 مليون عراقي في الموصل من دون طاقة ومياه لريّ المحاصيل. وتوقّع المجلس النرويجي للاجئين في تقرير صدر في العام 2021 انخفاض إنتاج القمح في محافظة نينوى بنسبة 70 في المئة.
في غضون ذلك، يعاني إقليم كردستان العراق، الذي يقع في الشمال أيضًا، من مشاكل في المياه، على الرغم من مصادره المائية المتنوعة مقارنةً مع سائر مناطق البلاد. يحصل الإقليم على مياهه من أنهار دجلة والزاب الكبير والزاب الصغير، إضافةً إلى الأمطار والمياه الجوفية. مع ذلك، إن تراجع معدّلات هطول الأمطار وتدنّي كمية المياه التي تصل من تركيا وإيران يؤثّران سلبًا على مناسيب المياه في الكثير من السدود الرئيسة في الإقليم. فقد أوردت تقارير متواترة أن المخزون المائي في سدّ دوكان، الذي يؤمّن مياه الشرب لنحو 3 ملايين شخص في السليمانية وكركوك، لا يتجاوز مليارَي متر مكعب، مع العلم بأن سعته التخزينية تبلغ 7 مليارات متر مكعب من المياه. في غضون ذلك، انخفض منسوب المياه في سدّ دربندخان في السليمانية بواقع 7 أمتار، فأصبح يعمل بثلث طاقته فقط. وقد أضرّ هذا الانخفاض في منسوب المياه بالمنطقة وسكانها، كما تبيّن من خلال تراجع صيد الأسماك والنشاط السياحي والإنتاج الزراعي. وتوقّع تقرير صادر عن المجلس النرويجي للاجئين في العام 2001 أن يؤدّي نقص المياه إلى انخفاض إنتاج القمح في الإقليم إلى النصف خلال العام المقبل.
مع ذلك، يبقى الوضع في جنوب العراق هو الأسوأ في البلاد على الإطلاق. ففيما تضمّ المناطق الشمالية من البلاد مصادر مختلفة من المياه، ناهيك عن قربها الجغرافي من منبع النهرَين وروافدهما، ما يتيح لها إمكانية الحصول على كميات أكبر من المياه ذات الجودة الأفضل، يفتقر جنوب العراق إلى هذه الميزات. يُشار كذلك إلى أن جودة المياه وكميتها تتراجعان بشكل ملحوظ مع تدفّق النهرَين جنوبًا. وتظهر بعض الدراسات أن البلدات والمدن الواقعة في وسط البلاد وجنوبها تعتمد بشدّة على نهرَي دجلة والفرات للحصول على المياه، وازدادت هذه الحاجة خلال السنوات الماضية على وقع انخفاض معدّلات هطول الأمطار بنسبة 40 في المئة عن المعدّل الطبيعي.
وبما أن شبكة البنى التحتية المعنية بإدارة المخلّفات الصناعية والزراعية والنفطية في العراق محدودة ومتهالكة، تُلقى هذه المخلّفات أحيانًا كثيرة في الأنهار، ما يتسبّب بمخاطر صحية جسيمة. ففي العام 2018، نُقل حوالى 118,000 شخص في مدينة البصرة إلى المستشفى لمعاناتهم من أعراض حدّدها الأطباء على أنها متّصلة بتلوث المياه. وكشف المرصد العراقي لحقوق الإنسان بأن المياه في العراق ملوثة بشكل كبير بسبب تصريف النفط ومياه الصرف الصحي والمخلّفات الطبية في الأنهار. كذلك، أدّى انخفاض منسوب المياه وازدياد التلوث إلى تجاوز نسبة الملوحة في نهر شط العرب عشرة أضعاف المعايير المقبولة التي حدّدتها منظمة الصحة العالمية.
هذا وقد أثّر استنزاف الموارد المائية وزيادة التلوث وارتفاع معدّلات الملوحة على نُظم بيئية مهمة في البلاد. وكانت الجهود المبذولة لإنعاش الأهوار العراقية بعد العام 2003 ناجحة إلى حدٍّ ما، على الرغم من الدمار الذي لحق بها على يد نظام صدام حسين في أوائل التسعينيات. ويُعدّ عرب الأهوار، أو المعدان كما يسمّون في اللهجة العراقية، من بين أقدم الثقافات الحية المستمرة في عالمنا اليوم، وعاشوا في هذه الأراضي على مدى أجيال. تُعتبر هذه المنطقة نموذجًا عن التنوّع البيولوجي، إذ تحتضن اثنين وعشرين نوعًا من الحيوانات المهدّدة بالانقراض في العالم، وستة وستين نوعًا من الطيور المعرّضة للخطر. وفي العام 2016، أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الأهوارَ ضمن قائمة التراث العالمي.
أما اليوم، فقد شهدت مستويات المياه انخفاضًا شديدًا، وزحفت مياه البحر من الخليج العربي شمالًا إلى مسافة 189 كيلومترًا، وأسفرت عن تدمير أكثر من 24 ألف هكتار من الأراضي الزراعية واقتلاع 30 ألف شجرة. لقد قوّض مزيج التدهور البيئي والتغيّر المناخي مجدّدًا نمط حياة المجتمعات المحلية في هذه المنطقة كما في سائر مناطق جنوب العراق، ما أدّى إلى نزوح أعداد كبيرة من السكان إلى المدن حيث يواجهون صعوبةً في الحصول على فرص العمل. ويقدّر البنك الدولي بأن يصل العجز المائي في العراق إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا بحلول العام 2030، ما قد يفضي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في البلاد بنسبة تصل إلى 4 في المئة، أو ما يعادل 6.6 مليارات دولار تقريبًا. يُشار إلى أن تداعيات نقص المياه بدأت تظهر بشكل ملموس. فوفقًا لدراسة صادرة عن المنظمة الدولية للهجرة، نزحت 12,212 أسرة (أي حوالى 73,272 فردًا) حتى تاريخ 15 آذار/مارس 2023 في عشر محافظات عراقية في وسط البلاد وجنوبها، ومن المتوقّع أن ترتفع هذه الأرقام مع الوقت إذا بقيت الأمور على حالها ولم تُتَّخذ أي تدابير.
نتيجةً لذلك، قد ينتقل العراق من مرحلة الإجهاد المائي إلى مستويات الندرة الخطيرة في المياه. إن ندرة المياه والإجهاد المائي هما مفهومان نسبيّان يعبّران عن وضع حرِج يتمثّل في ارتفاع الطلب على المياه في ظل تأثّر الإمدادات المائية، إما بسبب انخفاض الكميات المتاحة من المياه أو بسبب تدهور جودتها. فيما يشير الإجهاد المائي إلى القيود المرتبطة بالبشر، على غرار البنى التحتية المتهالكة التي تقوّض توافر المياه وجودتها، تعني ندرة المياه الافتقار إلى موارد المياه العذبة. كان العراق يتلقى نحو 30 مليار متر مكعب من المياه في العام 1933، وتقلّصت هذه الكمية إلى 9.5 مليارات في العام 2023، ويُتوقّع أن يصل نصيب الفرد من المياه إلى 479 مترًا مكعبًا بحلول العام 2030، ما سيجعل البلاد تعاني من ندرة المياه. وبحسب مؤشر فالكنمارك للإجهاد المائي، أي بلد تصل فيه إمدادات المياه إلى أقل من 1,700 متر مكعب للفرد الواحد سنويًا، فهو يعاني من الإجهاد المائي.
القيود الداخلية والتحديات الخارجية
تجسّد أزمة المناخ الماضية والحاضرة في العراق أنماط الطقس المتغيّرة على المستوى العالمي والأنشطة البشرية التي تسبّبت عمدًا وسهوًا بتدمير بيئة البلاد وإضعاف قدرة نظامها البيئي على الصمود والتكيّف. على مستوى القيود الداخلية، أفضى اعتماد العراق منذ عقود طويلة على النفط إلى إرساء نظام ريعي يحصل بموجبه المواطنون على الموارد وشبكة الأمان الاجتماعي وفرص العمل، مقابل تقديم الولاء والطاعة للقيادة السياسية. ونتيجةً لهذا النظام الريعي، لم تعد الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا لسائر القطاعات الاقتصادية، ومن ضمنها الزراعة، فباتت البنى التحتية وأنظمة الريّ في العراق قديمة ومتهالكة.
وقد ازدادت هذه الظروف سوءًا بسبب إرث الحروب والعقوبات الاقتصادية والصراع الداخلي الذي مزّق العراق، ما أدّى إلى تعطّل الكثير من محطات ضخّ المياه التي أُنشئت في السبعينيات أو حتى خروجها عن الخدمة وتعذّر إصلاحها وإعادة تأهيلها. وتشير البنى التحتية القديمة والمتهالكة أيضًا إلى إهمال محطات معالجة المياه منذ فترة طويلة، الأمر الذي يفاقم تلوّث المجاري المائية. وبحسب وزارة البيئة العراقية، تلبّي مرافق معالجة المياه في بغداد حاجات خمسة ملايين شخص فقط، من أصل ثمانية ملايين شخص يقيمون في العاصمة.
ليست للقوى السياسية العراقية مصلحة كبيرة في إلغاء النظام الريعي، نظرًا إلى أن هذا النظام بالذات سمح لها منذ العام 2003 ببناء دويلات داخل الدولة، وإنشاء الميليشيات والآليات الدعائية. يُشار إلى أن أزمة تغيّر المناخ والتدهور البيئي ليست حديثة العهد في العراق، إلا أن النخب السياسية تجاهلتها إلى أن أصبحت قضية ملحّة. وحتى في الوقت الراهن، لا تبدو هذه النخب مستعدّة في الكثير من الأحيان إلى اتّخاذ خطوات مهمة لمعالجتها. على سبيل المثال، لم يبدأ العراق بعد بتنويع أنشطته الاقتصادية. فخلال العقد الماضي، شكّلت عائدات النفط حوالى 99 في المئة من صادراته، و85 في المئة من موازنته الحكومية، و42 في المئة من إجمالي ناتجه المحلي.
يقع عبء أزمة المياه وتداعياتها في الغالب على كاهل الفئات الفقيرة التي تعاني أساسًا من التهميش الاجتماعي والسياسي ومن قلّة الفرص الاقتصادية. أظهرت دراسة صادرة عن المجلس النرويجي للاجئين في العام 2022 أن 38 في المئة من الأُسر التي شملها الاستطلاع والبالغ عددها 1341 أسرة من خمس محافظات، عبّرت عن تصاعد حدة التشنّجات الاجتماعية بسبب التنافس على الموارد وفرص العمل الشحيحة، وأُرغِم كثرٌ إلى مغادرة بلداتهم بحثًا عن العمل. ومن المتوقّع أن تتفاقم هذه الأوضاع مع الوقت، إذ ستضطرّ أعداد متزايدة من الأُسر والأفراد للنزوح إلى مدن مكتظة بالسكان لا تتوافر فيها سوى فرص عمل وموارد محدودة.
توافد الكثير من الأُسر التي نزحت من المناطق الريفية الواقعة في جنوب العراق إلى البصرة، حيث عاشوا في مساكن عشوائية وغير متصلة بشبكة المياه والصرف الصحي الرسمية. نتيجةً لذلك، يعمدون إلى جرّ المياه بشكل غير قانوني من شبكة المياه، ما يلحق الضرر بالبنى التحتية المائية، ويستهلكون المياه الملوّثة التي تؤثّر سلبًا على صحتهم ورفاههم. باتت البصرة اليوم، بعدما ابتُليت لفترة طويلة بالفساد ورداءة البنية التحتية، إحدى أفقر المدن وأقلّها نموًا في البلاد، على الرغم من احتوائها على كميات هائلة من النفط. وينسحب ذلك أيضًا على بناها التحتية المائية التي تُعدّ من بين الهياكل المتداعية في المدينة. والجدير بالذكر أن محافظة البصرة تقع عند ملتقى نهرَي دجلة والفرات، لذا فالمياه هناك هي الأسوأ من حيث الجودة والكمية. وتسجّل درجات الحرارة المرتفعة في الكثير من الأحيان مستويات قياسية، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى سُحب اللهب والدخان المتصاعدة من مشاعل الغاز التي تلوّث سماء المدينة بصورة دورية، وتزيد من تبخُّر المياه.
ليست العوامل الداخلية وحدها المسؤولة عن الأزمات المائية في العراق، بل تسهم الظروف الخارجية أيضًا في الحدّ بشكلٍ كبير من كميات المياه التي تتلقّاها البلاد. كان العراق بلدًا غنيًا بالمياه حتى سبعينيات القرن المنصرم، حين بدأت تركيا ببناء سلسلة من السدود. ومنذ ذلك الحين، شكّلت المشاريع الهيدروليكية التركية مشكلة متواصلة بين البلدَين، لأنها قلّصت تدفّق المياه إلى العراق بنسبة تتراوح بين 30 و40 في المئة. مع ذلك، مضت أنقرة قدمًا بمشاريعها، ومن ضمنها سدّ إليسو الذي أُقيم على نهر دجلة وبدأ ملءُ خزانه المائي في العام 2018.
على الرغم من المشاريع الهيدروليكية التي أطلقتها تركيا وتبعاتها السلبية على العراق، فإنها تعاني بدورها من الإجهاد المائي، بحيث تراجع نصيب الفرد من المياه الصالحة للاستخدام من 1652 مترًا مكعبًا في العام 2000 إلى 1200 متر مكعب في العام 2023. لقد ألحق مزيجٌ من سوء الإدارة وتدهور الظروف المناخية أضرارًا جسيمة بالموارد المائية التركية. قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول تقاسم المياه بين البلدَين، إن "معدّلات هطول الأمطار في تركيا سجلت أدنى مستوى لها خلال 62 عامًا". ويُرجَّح أن تواجه تركيا ندرة متزايدة في المياه خلال العقود القليلة المقبلة، الأمر الذي يُنذر بالسوء للعراق.
سورية هي أيضًا من بين الدول التي تواجه أزمة مياه. فقد ذكرت تقارير في العام 2012 أن كميات المياه الصالحة للشرب في سورية انخفضت بنسبة 40 في المئة عما كانت عليه خلال سنوات ما قبل الحرب. والمياه المتبقية ملوّثة بشكل كبير، ما أدّى إلى تفشّي وباء الكوليرا في مناطق واسعة من البلاد. فبين 25 آب/أغسطس 2022 و15 شباط/فبراير 2023، تم تسجيل حوالى 100,000 حالة مشتبه في إصابتها بالكوليرا في جميع محافظات البلاد الأربع عشرة، ووفاة 100 شخص على الأقل. وبما أن نهر دجلة يمر عبر سورية قبل أن يصل إلى الأراضي العراقية، يتسبّب الهدر وسوء إدارة المياه بتقليص كمية المياه التي تدخل إلى البلاد ويؤثّران على جودتها.
تضيف سياسة إيران المائية مشكلة أخرى إلى التحديات التي يعاني منها العراق. فمنذ ثورة العام 1979، قامت إيران بزراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه، على غرار الشمندر السكري، من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء وتحصين نفسها لتفادي الاعتماد على الغرب. فعمدت الحكومة الإيرانية إلى بناء سدود سيئة التخطيط وإلى الحفر عشوائي للآبار من أجل تأمين كميات المياه الضرورية لتلبية احتياجات الريّ المتزايدة. وفي العام 2021، أدّى مزيجٌ من سوء إدارة الموارد المائية وتغيّر المناخ إلى حدوث واحدة من أسوأ موجات الجفاف التي شهدتها البلاد على الإطلاق. وفي العام 2022، نزل الإيرانيون إلى الشوارع للتعبير عن استيائهم من الأوضاع في البلاد، بدءًا من انتشار الفقر وغياب الفرص الاقتصادية ومرورًا بسوء معاملة النساء ووصولًا إلى نقص المياه.
على مرّ العقود، سعت إيران إلى تلبية احتياجاتها المتزايدة من المياه وتهدئة غضب سكانها من خلال إطلاق مشاريع عدّة خلّفت تداعيات سلبية على العراق. ويمكن القول إن أكثرها ضررًا كان بناء سدّ كولسة لتحويل مياه نهر الزاب الصغير إلى بحيرة أرومية ونهر سيروان، اللذَين تعتمد عليهما إيران في الريّ. وتسبّب سدّ كولسة بتراجع 80 في المئة من منسوب نهر الزاب الصغير. ونتيجةً لذلك، انخفض منسوب المياه بشكل ملحوظ في نهرَي الزاب الصغير وسيروان، وهما من الروافد الأساسية لنهر دجلة. وقد يؤدّي الاستمرار في سوء إدارة الموارد المائية في إيران إلى تداعيات مدمّرة تلقي بظلالها على العراق وإيران معًا، نظرًا إلى أن حوالى ثلثَي المياه الخارجة من إيران والبالغة 10.2 مليارات متر مكعب تعبر الحدود لتدخل العراق.
المسار نحو تحقيق الأمن المائي في العراق
في خضمّ هذه الأزمة المهولة، من شأن الحلول الواسعة النطاق، أو حتى المتوسطة، أن تكبح الكارثة الوشيكة أو حتى أن تعكس تبعاتها. في هذا الإطار، من الضروري معالجة الاختلالات البنيوية التي تعتري النظام، مثل الفساد وأوجه القصور التي تشوب عملية صنع القرار، من أجل التصدّي إلى الأزمة المناخية التي يعيشها العراق والأزمات المرتبطة بها. فعلى سبيل المثال، تفتقر القرارات في الكثير من الأحيان إلى الفعالية بسبب التشرذم القائم على مستوى صنع القرار بين الدولة والسلطات المحلية حول كيفية التعامل مع نقص المياه، وعدم اهتمام الأحزاب السياسية الكبرى في تأمين التمويل والدعم اللازمَين لوزارتَي الموارد المائية والبيئة (إذ لا يمكن تحقيق أرباح كبيرة منهما).
يُضاف إلى ذلك أن إصلاح البنى التحتية ضرورة ملحّة في العراق، وقد اتُّخذت بعض الخطوات في هذا الصدد. مثلًا، أكملت السلطات في الآونة الأخيرة بناء محطة لتحلية مياه البحر بتكلفة 200 مليون دولار في ضواحي مدينة البصرة، بدعم اليابان وتمويلها. ويهدف المشروع إلى توفير المياه لحوالى 400,000 من سكان المدينة البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وعملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تنفيذ مشروع مماثل يهدف إلى تحديث البنى التحتية المائية لما يصل إلى 650,000 شخص في البصرة، وتولّى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قيادة الجهود الرامية إلى إعادة تأهيل البنى التحتية المائية لمدينة الموصل. وتُعدّ هذه المشاريع، التي يتكفّل المجتمع الدولي بمعظمها، أساسية في الحفاظ على مستوى مقبول من جودة المياه وكميتها.
مع ذلك، ينبغي على الجهود المبذولة لمعالجة مشاكل العراق الداخلية أن تشمل تعزيز الدبلوماسية المناخية مع الدول المجاورة. من الناحية النظرية، يُفترض ألّا يكون هذا الأمر صعبًا، لأن تدهور الأوضاع في العراق لا يصبّ في مصلحة الدول المجاورة، نظرًا إلى أن حالة اللااستقرار قد تمتّد إلى داخل أراضيها. ويُعدّ تسهيل المحادثات بين إيران والعراق وتركيا خطوة مهمة نحو تحقيق تعاون ملموس. ومؤخرًا، أصبح العراق الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي انضمّت إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، الهادفة إلى "ضمان الاستخدام المستدام للموارد المائية العابرة للحدود من خلال تسهيل التعاون عبر الحدود الوطنية". علاوةً على ذلك، وقّع العراق على اتفاق باريس للمناخ في العام 2016 وصادق عليه رسميًا في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2021. هذا الاتفاق عبارة عن معاهدة دولية مُلزِمة قانونًا بشأن مكافحة تغيّر المناخ
في الآونة الأخيرة، كثّفت الحكومة العراقية مساعيها من أجل إطلاق عجلة الحوار حول تغيّر المناخ. ففي آذار/مارس 2023، استضافت البلاد مؤتمر العراق للمناخ في البصرة. وتلاه في العام نفسه مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه الذي عُقِد في العاصمة العراقية تحت شعار "شحة المياه، أهوار وادي الرافدين، بيئة شط العرب، مسؤولية الجميع"، لمناقشة التهديدات المتنامية الناجمة عن الجفاف وندرة المياه بين إيران والعراق وتركيا. لكن، لا بدّ من الانتظار لرؤية ما إذا ستجد التوصيات الختامية لهذه المؤتمرات طريقها نحو التنفيذ.
في العام 2021، أبرمت كلٌّ من تركيا والعراق اتفاقًا نصّ على التزام أنقرة بتدفّق عادل ومنصف للمياه، وعلى تحديد كميات الحصص المائية التي يجب على تركيا إطلاقها إلى كلٍّ من سورية والعراق. مع ذلك، لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق أوسع يشمل جميع دول حوض نهرَي دجلة والفرات. وبصرف النظر عن الاتفاقات الجديدة المُبرمة، تبقى العبرة في التنفيذ. لذا، على الأفرقاء الدوليين العمل مع الحكومات الإيرانية والعراقية والتركية لضمان تطبيق الاتفاقيات القائمة والالتزامات الإضافية في المعاهدات والمواثيق الدولية والإقليمية.
أخيرًا وليس آخرًا، على المجتمع الدولي والدولة العراقية دعم الناشطين المدنيين والسياسيين على الأرض، لأنهم أفضل من يستطيع نشر الوعي البيئي في أوساط المواطنين العراقيين، ناهيك عن أنهم جزءٌ من المجتمعات المحلية المتضرّرة ويمكنهم تنظيمها سياسيًا. في هذا الإطار، يُعدّ الضغط المجتمعي وسيلة لحثّ صنّاع القرار على العمل من أجل معالجة التدهور البيئي. لكنّ هؤلاء الناشطين يحتاجون في الكثير من الأحيان إلى الحماية. ففي شباط/فبراير 2023، تعرّض الناشط البيئي العراقي البارز جاسم الأسدي للاختطاف والتعذيب قبل أن يُطلق سراحه بعد أسبوعَين. تكشف هذه المحنة التي مرّ بها الأسدي عن التهديدات التي يواجهها الناشطون جرّاء جهودهم الرامية إلى الإضاءة على القضايا المرتبطة بالمناخ، والضغط على صنّاع القرار، وتوعية المواطنين بشأن التحديات البيئية.
خاتمة
أزمة المياه في العراق هي التهديد الجديد والأكبر المُحدق بالبلاد. ويُعدّ هذا التهديد مختلفًا عن العوامل السابقة المُزعزعة للاستقرار لأنه ناجم عن عوامل عدة مثل الاختلالات الداخلية، والتحديات المرتبطة بدول الجوار، والآفة العالمية المتمثّلة في تغيّر المناخ. إن أزمة المياه في العراق خطرة تحديدًا لأنها قادرة على تغيير المشهد البيئي والطبيعي في البلاد رأسًا على عقب، وتقويض استقرارها الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وحتى جعل بعض مناطقها غير صالحة للعيش. ولن تقتصر هذه التداعيات على العراق فحسب، بل ستمتدّ لتطال دولًا أخرى في المنطقة والعالم.
لا تشير الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة فعليًا إلى أن صنّاع القرار سيأخذون أزمتَي المناخ والمياه على محمل الجدّ، وأنهم سينفّذون خططًا مُجدية على المدى الطويل، وذلك تحديدًا لأن هذه الخطط يُرجَّح أن تهدّد النظام القائم والأفرقاء المستفيدين منه. وحتى إذا عمَد صنّاع القرار إلى اتّخاذ خطوات جديّة لمعالجة الأزمة التي تعصف بالبلاد، من المُستبعَد أن تكون هذه التدابير فعّالة، نظرًا إلى القيود المؤسساتية. لكن هذا لا يعني أن العراق محكومٌ بالفشل. فإذا أدرك المواطنون والسياسيون العراقيون على السواء أن تجاهل أزمة المياه سيغرق البلاد في لُجج انعدام الاستقرار، قد يشكّل ذلك حافزًا لهم لبذل قصارى جهدهم من أجل تفادي هذه النتيجة الوخيمة.
سياسات الحراك البيئي: نجاح حملة الحفاظ على مرج بسري في لبنان
مقدّمة
في 5 أيلول/سبتمبر 2020، أبلغ البنك الدولي الحكومة اللبنانية رسميًا بالإلغاء الجزئي للمدفوعات ضمن القرض المخصّص لتمويل مشروع زيادة إمدادات المياه، المعروف بمشروع سدّ بسري، وبلغت قيمة الجزء المُلغى من القرض 244 مليون دولار أميركي. فالحكومة لم تُنجز البنود التي تشكّل شروطًا مسبقة للبدء بأعمال بناء السدّ، وهي: وضع خطة للتعويض الإيكولوجي عن تداعيات المشروع على التنوّع البيولوجي والنظم الإيكولوجية؛ وتواجد مقاول في موقع العمل ضمن موعد أقصاه 4 أيلول/سبتمبر 2020؛ وإتمام ترتيبات تشغيل المشروع وصيانته خلال موعد أقصاه 24 آب/أغسطس 2020.
سُلِّطت الأضواء على مرج بسري الواقع على بعد 35 كيلومترًا جنوب بيروت، في العام 2014 حين وافقت الحكومة اللبنانية على تمويلٍ من البنك الدولي لمشروع تَبيَّن أنه مثير للجدل إلى حدٍّ كبير. لذا، نُظر إلى إيقاف المشروع على أنه إنجازٌ مهم للناشطين البيئيين اللبنانيين والسكان المقيمين في المرج والقرى المحيطة، مع أن الانفجار المدمّر الذي ضرب مرفأ بيروت قبل شهر من إلغاء المشروع حجب هذه المسألة جزئيًا.
أظهرت قضية مرج بسري أن المخاوف البيئية في لبنان لا يمكن فصلها عن السياسة. وهذا الأمر صحيحٌ ربما في كل مكان، بما أن هذه العلاقة تقع في صُلب حراكٍ اكتسب زخمًا عالميًا ويربط بين القضايا البيئية والعدالة. وقد تمّ التركيز على هذه العلاقة حين أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر 2021 "أن التمتّع ببيئة نظيفة وصحية ومستدامة يُعتبر حقًّا من حقوق الإنسان". ولهذه العلاقة أهميتها الخاصة في لبنان لأن التحركات المناهضة لمشروع سدّ بسري، التي نظّمتها الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري تحت اسم "أنقذوا مرج بسري"، برزت وسط المظاهرات التي شهدتها البلاد ضدّ الطبقة السياسية الحاكمة.
ففي تشرين الأول/أكتوبر 2019، تدفّق اللبنانيون إلى الشوارع على مدى أسابيع ونظّموا مظاهرات شعبية حاشدة ضدّ الفساد المستشري لقيادتهم السياسية الطائفية. وعوّلت الحملة على السخط الشعبي العارم من السياسيين وطريقة إدارتهم الشؤون المحلية، واستطاعت وضع هذه القضية البيئية في واجهة الاهتمام الوطني، على الأقل مؤقتًا. وبيّنت الحملة أيضًا أن الحراك من أجل قضية معيّنة له حظوظ أكبر بالنجاح حين يتمكّن الناشطون من ربطه بقضايا اجتماعية وسياسية أخرى.
سدّ بسري والحراك البيئي والسياسة
يعود مشروع سدّ بسري إلى خمسينيات القرن الماضي، حين اقترحه مكتب الاستصلاح الأميركي بدايةً على الجمهورية اللبنانية الفتيّة آنذاك. وكانت الفكرة خلف المشروع بسيطة إلى حدٍّ ما، حسبما أورد رولان نصور، منسّق حملة "أنقذوا مرج بسري"، وهي "نقل المياه إلى بيروت وضواحيها من خزّان بسري عبر خطوط إمدادات المياه". وكان ذلك يتطلّب بناء حاجز بارتفاع 73 مترًا، فضلًا عن مصادرة 570 هكتارًا من "الأراضي الزراعية والطبيعية في معظمها من نحو عشر بلديات تابعة لمحافظتَي الشوف وجزين".
وإذا كان مشروع إنشاء سدّ بشري قد استغرق عقودًا من الزمن قبل أن يتبلور فعليًّا، فهذا لا يعني أن لبنان كان معارِضًا لفكرة بناء سدّ. والحال هو أن السدود لا تزال تشغل "مكانة شبه مثالية" في الاستراتيجية الوطنية للمياه في لبنان، على حدّ تعبير أحد الناشطين البيئيين المحليين. هذا التركيز على السدود صحيح، مع أنها تتعرّض للانتقادات منذ عقود بسبب تداعياتها الاجتماعية والبيئية السلبية. وقد لخّصت منظمة الأنهار العالمية هذه الانتقادات في بيان صحافي أصدرته في تشرين الثاني/نوفمبر 2022 خلال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ: "تتسبّب السدود ومخطّطات الطاقة المائية بخسائر وأضرار فادحة، بما في ذلك إنتاج كميات كبيرة من غاز الميثان، وفقدان التنوع البيولوجي ونزوح السكّان". في العام 2021، وجّهت أكثر من 350 منظمة من ثمانية وسبعين بلدًا مناشدة إلى الأمم المتحدة لاستبعاد سدود الطاقة المائية من آليات التمويل المناخي.
في ضوء هذا الموقف، أصدرت الحركة البيئية اللبنانية، وهي ائتلاف يضمّ أكثر من ستين منظمة وجمعية بيئية، بيانات عامة ضدّ مشروع سدّ بسري في العام 2017، قبل أن تطلق حملة "أنقذوا مرج بسري" مع مجموعات أخرى في العام التالي. ولكن مظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 منحت اندفاعة للحملة، فقد بذل معارضو مشروع سدّ بسري مجهودًا متعمّدًا لربط تحرّكاتهم بالغليان الأوسع الذي شهدته البلاد. وقد تناقض هذا الخيار مع حملة مماثلة انطلقت في العام 2013 لوقف مشروع سدّ القيسماني في حمانا. ففي تلك الحملة، تمكّن المعارضون من حشد المجتمع المحلّي ضد السدّ، وفقًا لمنظمة "جبال" غير الحكومية، ولكنهم أخفقوا في بناء ائتلاف أوسع. وهذا كان أحد الأسباب التي سمحت لمشروع السدّ بالمضي قدمًا.
عارضت حملة "أنقذوا مرج بسري" المشروع بسبب تداعياته الخطيرة المحتملة. كتب مؤلّفو ورقة بحثية نُشرت في مجلة Engineering Geology أن السدّ سيُعرّض "آلاف الأشخاص وهيكليات مختلفة للخطر"، وأنه "ينطوي على مخاطر عالية بحصول الزلازل لفترة طويلة". علاوةً على ذلك، أشارت حملة "أنقذوا مرج بسري" إلى أن السدّ يشكّل تهديدًا للدور الذي يضطلع به هذا المرج بوصفه موطنًا للطيور المهاجرة المحميّة بموجب اتفاقية حماية الطيور المائية الأفريقية-الأوروبية-الآسيوية المهاجرة، ولبنان من الدول الأطراف الموقِّعة عليه.
لكن التأثير السياسي للسدّ هو الذي دفع القادة في البلاد إلى التصدّي للناشطين البيئيين. وشرح نصور، منسّق حملة "أنقذوا مرج بسري"، دوافع السياسيين بقوله إن "السدود تحمل معنى سياسيًا رمزيًا لأنها تمثّل فرصة للسياسيين للادّعاء بأنهم يحققون أمرًا ملموسًا". علاوةً على ذلك، وأسوةً بالكثير من جوانب الحياة السياسية في لبنان، بات مشروع سدّ بسري أسير السياسات الطائفية. والحال أن رئيس بلدية مزرعة الشوف، حيث كان من المقرّر إقامة السدّ، هو عضو في الحزب التقدّمي الاشتراكي الذي كان يرأسه سابقًا زعيم الطائفة الدرزية وليد جنبلاط. كان الحزب من أوائل المؤيّدين للمشروع، لكنه بدّل موقفه لاحقًا. وربما كان الدافع وراء هذا التراجع أن جبران باسيل، الذي كان وزيرًا للطاقة آنذاك، هو أيضًا رئيس التيار الوطني الحر الذي ربطته علاقة خصومة مع الحزب التقدّمي الاشتراكي.
وثمة بعدٌ آخر اكتسى على الأرجح الأهمية نفسها. فقد كان باسيل، صهر ميشال عون، الرئيس السابق للجمهورية، هدفًا أساسيًّا للمتظاهرين خلال احتجاجات العام 2019، ولا سيما أن أحد الهتافات التي تعرّضت له شخصيًّا كان من أكثر الهتافات التي لاقت رواجًا في الشارع. لقد وافق باسيل، خلال تولّيه حقيبة الطاقة في العام 2010، على استراتيجية جديدة لقطاع المياه في لبنان. وشملت هذه الاستراتيجية بناء أربعة عشر سدًّا، منها سدّ بسري الذي أقرّ مجلس الوزراء إنشاءه بعد عامَين؛ ووعد البنك الدولي بتمويله بعد مرور عامَين على إقرار المشروع.
في ظل تنامي زخم الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر 2019، رأى الحزب التقدمي الاشتراكي أن الفرصة سانحة لسحب أعضائه من الحكومة الخاضعة لهيمنة التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، محاوِلًا حماية نفسه من الإدانة الشعبية. بحلول ذلك الوقت، كانت حملة "أنقذوا مرج بسري" قد أصبحت جزءًا من المظاهرات. وقد صرّح نصور لأحد الصحافيين أن الحملة هي "انعكاس واضح" للشعار الأساسي الذي رفعه الحراك الاجتماعي، أي "كلّن يعني كلّن"، في إشارة إلى الفساد المستشري في المجتمع. وبما أن مشروع سدّ بسري كان قد أصبح مرتبطًا بالتيار الوطني الحر وبباسيل شخصيًّا، سعى الحزب التقدّمي الاشتراكي إلى كسب النقاط من خلال النأي بنفسه عن مشروع كان قد أيّده في السابق، وعزا جنبلاط التغيير في موقفه إلى الهواجس البيئية.
الحراك البيئي والدروس المُستقاة من حملة "أنقذوا مرج بسري"
يمكن استخلاص دروس عدّة من النجاح الذي حقّقه الناشطون البيئيون في منع إنشاء سدّ بسري، ولا سيما على ضوء التراجع المطّرد في هامش التعبير السياسي في لبنان خلال السنوات الأخيرة.
تكمن العبرة الأولى في أن حملة "أنقذوا مرج بسري" بيّنت الترابط القائم بين الحراك البيئي والسياسة، نظرًا إلى الأبعاد السياسية التي ينطوي عليها الكثير من القضايا البيئية في البلاد. فحين أدّت المصالح السياسية إلى اعتماد سياسات مضرّة بالبيئة، كثيرًا ما تمكّن الناشطون من قلب الأمور لصالحهم واستخدام السياسة لفرض الخيارات التي يفضّلونها.
كشف سعي هذه الحملة الناجح إلى ربط قضيّتها بمظاهرات تشرين الأول/أكتوبر 2019 عن حسنات التعويل على زخم حراك احتجاجي أوسع لفرض التغيير. وبيّن أيضًا أن استغلال التنافسات السياسية قد يفسح المجال أمام خيارات قيّمة، بما أن الطبقة السياسية في لبنان تحاول في الكثير من الأحيان، بمكرٍ، تصوير نفسها على أنها تقف إلى جانب الخير العام. لقد استغلّت الحملة الخلافات السياسية بين الحزب التقدّمي الاشتراكي من جهة وباسيل والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، وأيضًا رغبة الحزب التقدّمي الاشتراكي في عدم وضعه في السلة نفسها مع قوى سياسية أخرى وجّه إليها المتظاهرون جام غضبهم خلال الاحتجاجات.
تتمحور العبرة الثانية لحملة "أنقذوا مرج بسري" حول أهمية تبنّي نهج متقاطع وشامل في التعامل مع القضايا البيئية. وعلى ضوء تغيّر المناخ، ستصبح هذه القضايا بالتأكيد أكثر تشابكًا من ذي قبل. يشكّل الحراك المدني المناصر للبيئة اليوم مسألةً تتقاطع عندها مجموعة من المشاغل، بدءًا من تحدّيات بيئية تؤثّر في بعضها البعض، ومرورًا بالفساد المستشري في القطاعَين العام والخاص، ووصولًا إلى المصالح السياسية التي غالبًا ما تقوّض الخير العام. وما لم يتمكّن الناشطون من التوصّل إلى سبيلٍ لإدماج استجاباتهم مع هذه التحديات والتفكير بصورة استراتيجية، سيكون من الصعب عليهم بلوغ أهدافهم.
في العام 2019، شهد لبنان كيف يمكن لكارثة بيئية أن تغذّي الاحتجاج السياسي، الذي عزّز بدوره الحراك البيئي. وقد شكّلت حرائق الغابات التي طالت مساحات واسعة من البلاد قبل أيام من اندلاع احتجاجات العام 2019 أحد الأسباب المساهمة فيها. ففي 13 تشرين الأول/أكتوبر، اجتاحت النيران أراضٍ واسعة من الشوف وإقليم الخروب، ومناطق أخرى إلى جنوب بيروت. وكانت استجابة الدولة الأولية للحرائق سيئة جدًّا، ويُعزى ذلك في جزءٍ منه إلى عدم إجراء الصيانة الملائمة لطوافات الإطفاء. وتمّ إخماد الحرائق بفضل مساعدة خارجية من طوافات مكافحة الحرائق التي أرسلتها قبرص واليونان والأردن وتركيا، إضافةً إلى الجهود المحلية التي بذلها المدنيون من لبنانيين وفلسطينيين وغيرهم، وأخيرًا بفضل هطول الأمطار. لقد أثارت استجابة الدولة امتعاضًا كبيرًا، ساهم في اندلاع الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد بعد بضعة أيام، ما أكسب حملة "أنقذوا مرج بسري" زخمًا خلال الأشهر اللاحقة.
نجحت الحملة أيضًا في محاولاتها الرامية إلى التأثير في فئات واسعة من المجتمع اللبناني. ففي السابق، كانت الحركة البيئية في لبنان بالدرجة الأولى ظاهرة خاصة بالطبقة الوسطى. كتب كريم مقدسي: "تَمثَّل الإلهام والزخم الأساسيان لهؤلاء الناشطين في المجال البيئي - ومعظمهم من المهنيين وأفراد الطبقة الوسطى المتعلّمين في الغرب - في النجاح الذي حقّقته الحركة البيئية في أوروبا وأميركا الشمالية خلال الستينيات، وتكلّل من خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة البشرية الذي انعقد في ستوكهولم في العام 1972".
لماذا يُعدّ إشكاليًا أن تتألف حركةٌ بشكل كبير من أفراد الطبقة الوسطى؟ أولًا، من الأفضل للناشطين السعي إلى تحقيق أهدافهم في إطار أوسع تحالف ممكن من القوى والفئات الاجتماعية. ثانيًا، تتطلّب العدالة المناخية إيصال أصوات الفئات الأكثر ضعفًا. فالسياسات المضرّة بالبيئة تؤثّر بشدّة على الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع. لذلك، من المهم أن يشمل الحراك البيئي فئات واسعة من السكان لتمثيل مصالح الجميع.
صحيحٌ أن حملة "أنقذوا مرج بسري" كانت في بادئ الأمر ظاهرة خاصة بالطبقة الوسطى، إلّا أنها سعت إلى توسيع قاعدتها لتشمل مختلف الطبقات الاجتماعية عندما أدركت أن آلاف الأشخاص من خلفيات طبقية وطائفية متنوعة في مناطق الشوف وجزين وصيدا يعارضون إنشاء السدّ. وحقّقت ذلك من خلال تشكيل مجموعات عبر تطبيق واتساب، ما سمح للجيران بالتعرّف إلى بعضهم البعض بطرق لم تكن ممكنة سابقًا، وإدراك المصلحة المشتركة المتمثّلة في الوقوف ضدّ تنفيذ مشروع بسري.
وفي ظل تبدّل البيئة الاجتماعية في لبنان، يجب أيضًا إحداث تغيير في طبيعة الحراك البيئي اللبناني الذي يضمّ في الغالب أفرادًا من الطبقة الوسطى. لقد أدّت الأزمة المالية والاقتصادية التي عصفت بالبلاد إلى إفقار طبقة وسطى كانت أساسًا صغيرة نسبيًا، على وقع استمرار ارتفاع معدّلات اللامساواة في المداخيل والثروات. ومن المرجّح أن تتنامى أوجه التفاوت الاجتماعي مع تدهور الظروف المعيشية. لا بدّ من الانتظار لرؤية ما إذا ستجمع الاحتجاجات التي قد تحدث في المستقبل أشخاصًا من خلفيات متنوعة، أو ما إذا ستبقى الانقسامات على حالها أم ستتفاقم، ما قد يتسبّب بإضعاف جاذبية شبكات الحراك الاجتماعي.
يمكن أن تشكّل الخطوات التي اتُّخذت في منطقة عكار الشمالية في أيلول/سبتمبر 2022 نموذجًا يُحتذى به، حيث عمد ثمانون امرأة ورجلًا على الأقل من الجنسيّتَين اللبنانية والسورية من خمس عشرة قرية إلى تشكيل فريق من رجال الإطفاء المتطوّعين. الجدير بالذكر أن محافظة عكار هي الأشدّ فقرًا في لبنان، إلى جانب سهل البقاع، ويدرك سكانها ذلك جيّدًا. وفيما تواصل الدولة اللبنانية ونسبة كبيرة من اللبنانيين تحميل اللاجئين السوريين مسؤولية الأوضاع المتردّية في مختلف أنحاء البلاد، شهدت عكار مرارًا وتكرارًا تعاونًا وثيقًا بين اللبنانيين والسوريين. ويُعدّ فريق الإطفاء مثالًا على مبدأ "التعاون لا الصدقة" القائم على المساعدة المتبادلة، حين تهبّ مجموعة في مجتمع محلّي ما إلى خدمة مجتمعها.
أما العبرة الثالثة فهي أن الحراك البيئي يتعزّز إذا تمكّن الناشطون من الاتفاق حول الحلول العملية للقضايا التي يعالجونها. وإلّا، فسوف يفسحون المجال أمام الطبقة السياسية لفرض حلول تخدم مصالحها ولا تُفضي إلى حماية البيئة والسكان. في الواقع، اقترح أعضاء من حملة "أنقذوا مرج بسري" وعلماء مستقلّون بدائل عن سدّ بسري، تهدف إلى "الاستفادة من المزايا الطبيعية والجيولوجية للبنان". وشملت استخدام موارد المياه الجوفية في البلاد بشكل أكثر كفاءة، والحدّ من فقدان المياه في شبكة التوزيع (إذ يمكن أن تصل نسبة الفاقد إلى 50 في المئة في بعض المناطق)، إضافةً إلى إنشاء "برك تخزين صغيرة إلى متوسطة الحجم في المناطق الحضرية". هذه الاقتراحات كانت قيّمة، إلا أنها لم تُطرح بطريقة متماسكة ومنهجية، ما أتاح للسياسيين اقتراح مشاريع مائية جديدة لن تُفيد أحدًا سواهم.
خير مثال على النتائج السلبية الناجمة عن عدم اقتراح حلول ما حدث في العام 2015، عقب إقفال أكبر مطمر للنفايات في لبنان وتكدُّس النفايات في شوارع بيروت وجبل لبنان. أفضى هذا الوضع إلى ولادة حركة احتجاجية عُرفت باسم "طلعت ريحتكم"، أطلقها خبراء وناشطون مستقلون في المجال البيئي. وعلى الرغم من أن هذه الحركة جذبت حشودًا كبيرة – إذ لم تتجاوزها عدديًا سوى احتجاجات العام 2019 – فسرعان ما فقدت زخمها بعد أشهر قليلة وعجزت عن تغيير نموذج الحكومة للتخلّص من النفايات. وعُزي ذلك جزئيًا إلى عدم تقديم مجموعة موحّدة من المطالب.
مع ذلك، كانت لحركة "طلعت ريحتكم" تأثيرات مهمّة على الحراك المدني، إذ أفسحت المجال أمام وصول أشخاص قادرين على تقديم حلول سياسية للقضايا البيئية وغيرها، إلى مراكز القرار. يُنسَب الفضل عمومًا إلى هذه الحركة بأنها أطلقت الشرارة التي أدّت إلى تشكيل لائحة "بيروت مدينتي" في الانتخابات البلدية للعام 2016، والتي ضمّت عددًا من الناشطين المدنيين غير المنخرطين في السياسات اللبنانية التقليدية. صحيحٌ أن اللائحة لم تفز بمقعد في مجلس بيروت البلدي، إلّا أنها حصدت عددًا كبيرًا من الأصوات، ما أظهر أنها تحظى بالتأييد في أوساط ناخبين كثر. يمكن القول إن "بيروت مدينتي" أتاحت للناشطين المدنيين فرصة الدخول إلى البرلمان في الانتخابات التشريعية للعام 2018، وتشكيل كتلة برلمانية وازنة.
في هذا الإطار، أشارت منى فواز، وهي من بين مؤسِّسي "بيروت مدينتي": "عندما لم تتمّ الاستجابة لمطالب المتظاهرين، بدأ النشطاء في مناقشة الخطوات المقبلة، بحيث اقترح البعض المشاركة في الانتخابات المحلية". وأضافت أن فكرة الترشح للانتخابات البلدية لم تحظَ على الفور بتأييد كل الناشطين الرئيسين في حركة "طلعت ريحتكم"، وانتظر معظمهم انطلاق "بيروت مدينتي" بالكامل قبل الانضمام إلى الحملة.
يمكن استخلاص استنتاجَين أساسيَّين من تجربة "طلعت ريحتكم". الأول هو أن أي فصل بين البيئة والسياسة مصطنعٌ حين يتعلق الأمر بالعدالة البيئية. إن التخلّص من النفايات الصلبة مربحٌ للغاية، وقد أسهمت عائداته جزئيًا في نمو ثروات السياسيين في مختلف المناطق اللبنانية. لذا حين أقفل المطمر، سعوا جاهدين إلى إيجاد طرق أخرى لتمويل شبكات محسوبياتهم. قوّض ذلك مفهوم العدالة البيئية، لأن الدولة اللبنانية استمرّت في تطبيق نظامٍ عفا عليه الزمن لإدارة النفايات، ولا يزال يُلحق الضرر بالبيئة وبصحة المواطنين.
أكّد هذا الواقع كيف أن السياسيين والأحزاب في لبنان استغلّوا منذ فترة طويلة الموارد البيئية لتحقيق الأرباح المالية وتعزيز مصالحهم السياسية الطائفية. وانطبق ذلك بشكل خاص على قضية سدّ بسري. ففي الوادي حيث كان من المفترض تنفيذ المشروع، أدّت الهيمنة السياسية للحزب التقدّمي الاشتراكي إلى التقليل من القيمة المتأصلة للأرض – بتربتها وأشجارها وأنهارها والحياة البرية فيها – وإعطاء الأولوية إلى المصالح الطائفية. وقد حدثت هذه الديناميات مرارًا وتكرارًا في جميع أنحاء البلاد.
يمكن فهم مسألة فصل القضايا البيئية عن السياسة بشكل أفضل على أنها نزع الطابع السياسي عمّا هو سياسي بطبيعته. يرى السياسيون اللبنانيون أن مشروع سدّ بسري كان ليتيح مبلغ 244 مليون دولار يمكن توجيهه للاستخدام السياسي أو الشخصي. ولطالما تطرّقت التقارير التي تناولت الوضع في لبنان إلى فساد الطبقة السياسية. على سبيل المثال، أشار تقريرٌ صادر عن مبادرة الإصلاح من أجل اقتصادات شفافة (RITE) في العام 2022، إلى أن "بعض التحديات التي تواجه التمويل الدولي في لبنان مرتبطة بمشاكل الفساد المعروفة في البلاد ووتيرة الإصلاحات البطيئة". وذُكرت كلمة "فساد" اثنتَين وثلاثين مرة في التقرير الذي يتألّف من ثلاث وثمانين صفحة. ووفقًا للتقرير نفسه، استنكر قرارٌ للبرلمان الأوروبي حول لبنان في العام 2019 بشدّة "المستوى المرتفع جدًّا من سوء الإدارة وغياب الإشراف على الأموال التي خُصِّصَت للبنان في الماضي". وحتى اليوم، من غير الواضح حجم الأموال التي تصل من مصادر دولية إلى حسابات خاصة.
خاتمة
جسّدت حملة "أنقذوا مرج بسري"، على غرار حركة "طلعت ريحتكم" قبلها، العلاقة المتجذّرة بين البيئة والسياسة. لهذا السبب، قد يستفيد الناشطون البيئيون من تبنّي نهجٍ قائم على العدالة البيئية، من شأنه مساعدتهم في خوض غمار التحديات السياسية والاقتصادية المعقّدة التي سيواجهونها حكمًا.
واقع الحال أن الحملة تجاوزت مجرّد الاعتراض على إنشاء سدّ بسري، لتتطرّق إلى تظلّمات أوسع موجّهة ضدّ المؤسسة السياسية، ما أدّى إلى تشوُّش الخط الفاصل بين الحراك البيئي من جهة والمصلحة العامة والسياسة من جهة أخرى. وعلى نحو مماثل، جمعت حركة "طلعت ريحتكم"، التي انبثقت من أزمة إدارة النفايات، بين المناصرة البيئية واعتراضاتٍ سياسية أوسع. واتّضحت أهمية هذه العلاقة لأنها حشدت أعدادًا كبيرة من المؤيّدين، وألهمت ظواهر مثل "بيروت مدينتي". صحيحٌ أن المكاسب التي حقّقتها حركة "طلعت ريحتكم" على المدى القصير هي موضع نقاش في الكثير من الأحيان، إلّا أنها تركت تأثيرًا دامغًا في المشهد السياسي اللبناني.
وعلى غرار أزمة إدارة النفايات التي أدّت إلى انطلاق حركة "طلعت ريحكتم"، شكّلت حملة مرج بسري صورة مصغّرة عن النظام الاجتماعي السياسي اللبناني، ولا سيما في إطار السباق الدائم للحصول على الموارد. فالإساءة إلى التراث الطبيعي اللبناني هي معركة أخرى بين أعضاء النخبة السياسية الحاكمة في البلاد لا تراعي مخاوف المواطنين المتأثّرين والناشطين البيئيين على السواء. بل أضحت البيئة ساحة قتال بالوكالة لقضايا سياسية أوسع، ويتمّ فيها تجاهل حقّ المواطنين في إبداء رأيهم حول قضايا الشأن العام. وعلى ضوء هذا الواقع، يُعدّ السعي إلى تحقيق العدالة البيئية المسار الأفضل لتركيز اهتمام الناشطين على هدف واضح ونهائي، ما يعزّز قدرتهم على مقاومة جميع المساعي الرامية إلى تقويض جهودهم.
التحصين من المخاطر المناخية في إدارة المياه الجوفية في سلطنة عُمان
مقدّمة
أصبحت المخاطر الطبيعية المناخية مشكلة حرجة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة ومنها سلطنة عُمان. لقد تسبّبت عوامل متضافرة، مثل المناخ الجاف، ودرجات الحرارة القصوى، والأمطار الموسمية المحدودة الكمية، والمساحة الصحراوية الشاسعة، بخسائر اقتصادية وتداعيات اجتماعية مختلفة. وكذلك يمكن أن تؤثّر فترات الجفاف المطوّلة، وهي أيضًا من السمات المتكرّرة للمناخات القاحلة، في مصادر المياه التي تغذّي طبقات المياه الجوفية.
سلطنة عُمان معرَّضة بوجه خاص لهذه المخاطر المناخية نظرًا إلى عوامل عدّة. في الواقع، تفتقر مناطق واسعة في البلاد إلى الموارد المائية؛ ففي أجزاء من الشمال، لا يمكن الحصول على المياه إلا من القنوات المائية التقليدية التي هي من صنع الإنسان، والمعروفة بالأفلاج. وللبلاد أيضًا موارد محدودة من المياه العذبة، لذا تُعدّ المياه الجوفية مصدرها الأساسي للريّ والمياه العذبة. وتشكّل نُظم كثيرة للمياه الجوفية – بما في ذلك طبقات المياه الجوفية الكربونية في شمال ووسط جبال الحجر، وطبقات المياه الجوفية من الحجر الرملي في الجبال الشرقية والجنوبية، وطبقات المياه الجوفية الرسوبية في السهول والوديان الساحلية – مصادر مائية أساسية لعُمان، ما يوفّر المياه الجوفية للاستخدامات المنزلية والزراعية والصناعية. المؤسف أن الطلب المتزايد على المياه الجوفية، مقرونًا بتبعات تغيّر المناخ، يحفّز عوامل مثل الاستهلاك الواسع، والملوحة، والتلوّث، التي تهدّد طبقات المياه الجوفية الحيوية في البلاد. وقد أثار ذلك مخاوف كبيرة بشأن الطرق التي سيتسبّب بها تغيّر المناخ باشتداد التداعيات على المياه الجوفية. يُظهر الشكل 1 التباين في توافر المياه لكلّ مستجمع مائي في عُمان.
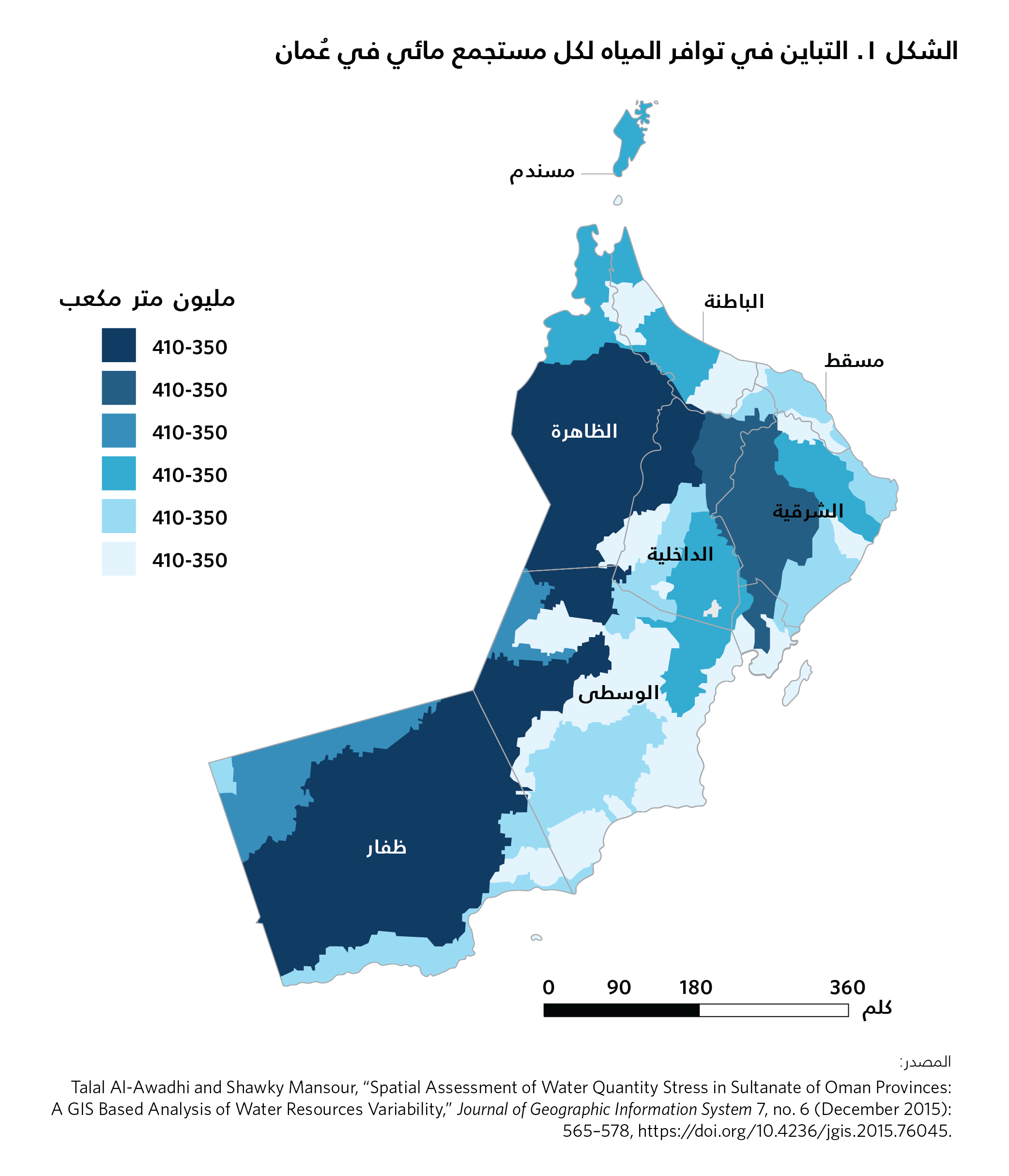
يستكشف هذا الفصل تأثيرات تغيّر المناخ على الموارد المائية في سلطنة عُمان والأُطر والسياسات المؤسسية لإدارة الموارد المائية في البلاد.
تغيّر المناخ والتحديات المائية
تلفت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، في تقريرها التقييمي الخامس، إلى أن تغيّر المناخ سيتسبّب بخفض موارد المياه السطحية والجوفية القابلة للتجديد، ما يزيد من حدّة التنافس على المياه بشكلٍ أكبر من العوامل الأخرى مثل الزيادة السكانية، وتغيير استخدام الأراضي، والتلوث، والممارسات غير الملائمة في إدارة الموارد المائية. وسيؤدّي تغيّر المناخ أيضًا إلى زيادة مخاطر الغمر بالمياه، والفيضانات الساحلية، والتآكل الساحلي في النُظم الساحلية والمناطق المنخفضة. وتقول الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ، في تقريرها التقييمي السادس: "من المتوقع أن تزداد تغذية المياه الجوفية في بعض المناطق شبه القاحلة، ولكن الاستنزاف العالمي لمخزون المياه الجوفية غير القابلة للتجديد سيستمر بسبب زيادة الطلب على المياه الجوفية (تتراوح درجة موثوقية هذا التوقع من متوسطة إلى مرتفعة)". وأشارت تقديرات الهيئة أيضًا إلى زيادة في النسبة العالمية السنوية للأعاصير المدارية الشديدة (المصنَّفة في الفئات من 3 إلى 5) بمقدار 1 إلى 10 في المئة تقريبًا، على افتراض ارتفاع درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتَين مئويتَين. ومن المرجّح أن تحدُث أعاصير مدارية أكثر شدّة في بحر العرب، على الرغم من أن تواترها العالمي سينخفض أو يبقى على حاله. تقع عُمان على الخط الساحلي لبحر العرب وتتأثّر بأعاصير بحر العرب في موسمَين اثنَين: ما قبل الرياح الموسمية وما بعد الرياح الموسمية. وتُظهر السجلات ازدياد حدّة الأعاصير المدارية في بحر العرب، مع بلوغ عددٍ كبير من هذه الأعاصير اليابسة في سلطنة عُمان.
علاوةً على ذلك، ازداد منذ العام 2007 عدد الأعاصير المدارية المصنَّفة من الفئة 3 إلى الفئة 5 التي بلغت اليابسة في عُمان. فعلى سبيل المثال، في العام 2019، ضرب إعصار شاهين اليابسة في شمال عُمان من خلال اتّباعه مسارًا نادرًا عبر بحر خليج عُمان. يُشار إلى أن آخر إعصار سُجِّل في المسار نفسه كان في العام 1890. وقد تسبّب الإعصار بكارثة في المنطقة المتضررة بسبب الفيضانات الطوفانية الشديدة. وبلغ معدّل هطول الأمطار المرتفع الذي سُجِّل يوم وصول الإعصار إلى اليابسة 350 ميلمترًا في عشر ساعات. وإعصار غونو في العام 2007، المصنَّف في الفئة 5، هو الإعصار الوحيد الذي سُجِّل خلال المئة عام الأخيرة في بحر العرب وبلغ اليابسة في شمال عُمان، متسبِّبًا بأضرار هائلة في مسقط.
تبعًا لذلك، يمكن أن يؤدّي تغيّر المناخ إلى تبدّل أنماط المتساقطات، ما يؤثّر في كميات الأمطار وغزارتها وتوزّعها في عُمان. ويؤدّي تراجع كمية المتساقطات أو التغييرات في أنماط هطول الأمطار إلى انخفاض تغذية المياه الجوفية وتفاقم مشكلات ندرة المياه، ما يؤثّر في معدّلات تغذية المياه الجوفية وتجديد طبقات المياه الجوفية. وتُظهر السجلات أنه سبق لسلطنة عُمان أن شهدت عددًا من مواسم الجفاف المطوّلة (انظر الجدول 1).
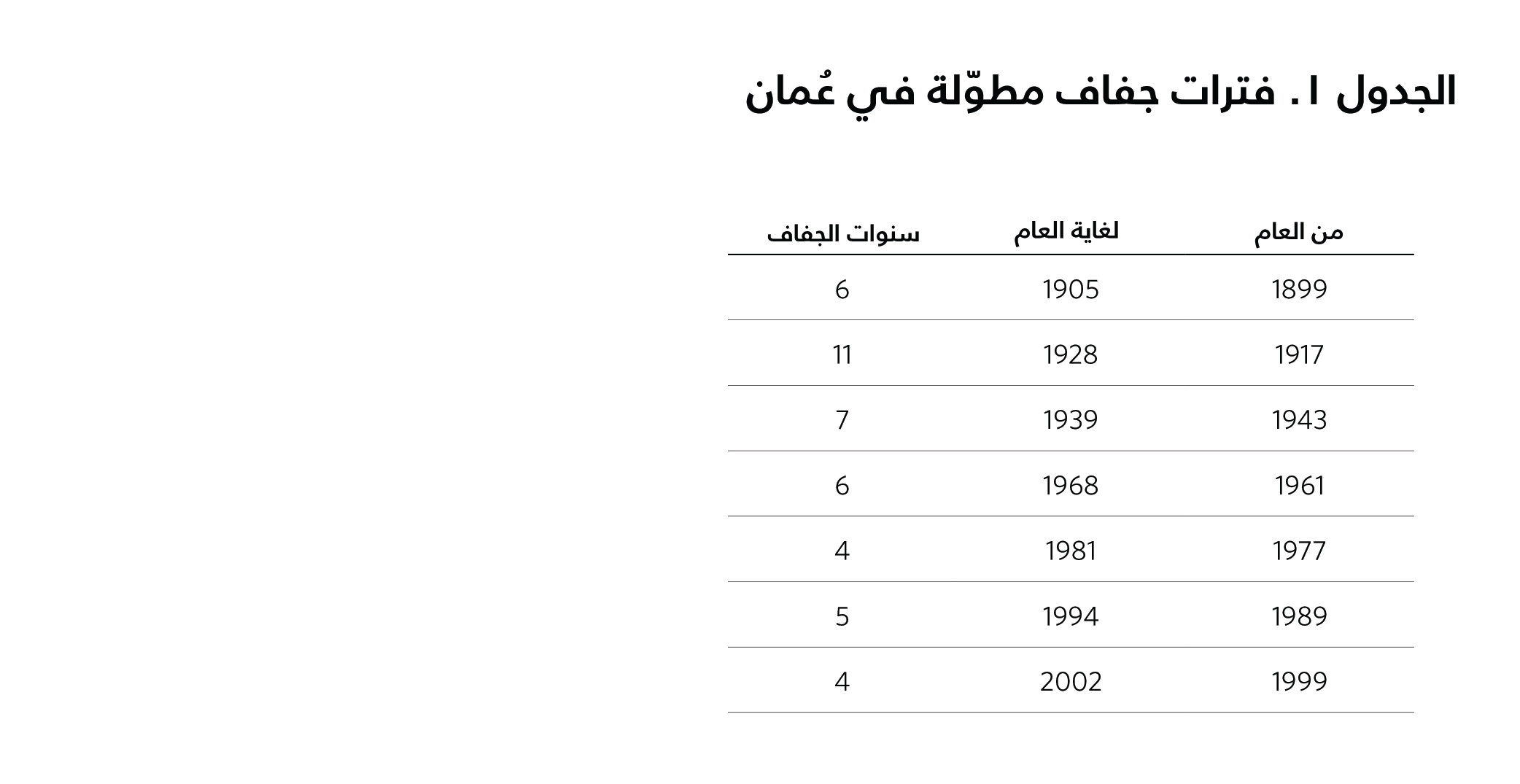
هطول الأمطار في سلطنة عُمان غير مستقر ومحدود جدًّا، وبعض السنوات تتخلّلها فترات تشهد تساقط الأمطار بغزارة. يُظهر الشكل 2 الاختلاف في معدّلات الأمطار في ثلاث محطات مختلفة في عُمان (مسقط، وسَيق في جبال الحجر الشرقية، وصلالة في جنوب البلاد). ويوجز الجدول 2 بيانات هطول الأمطار من المحطات المختلفة الثلاث نفسها بين العامَين 1980 و2020.
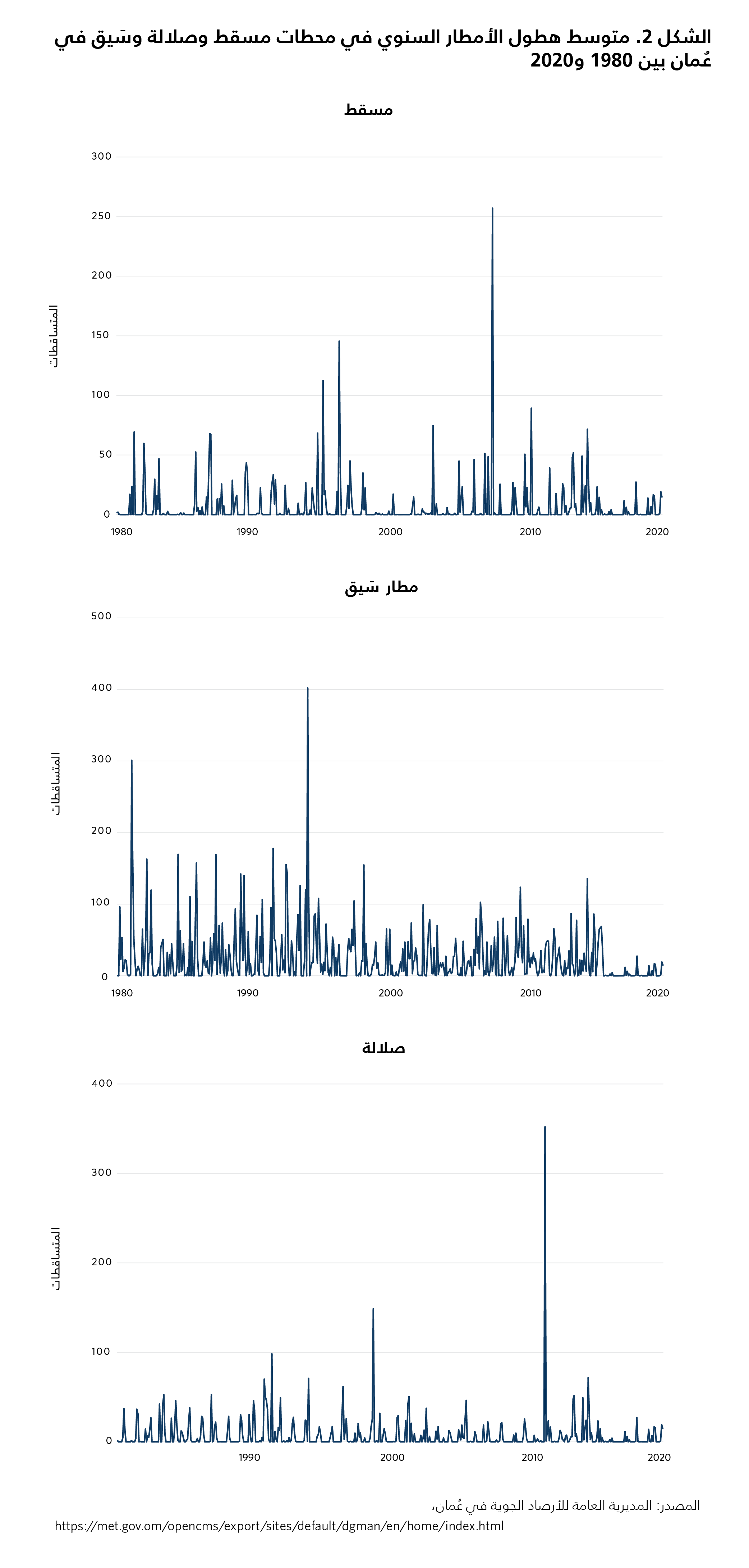
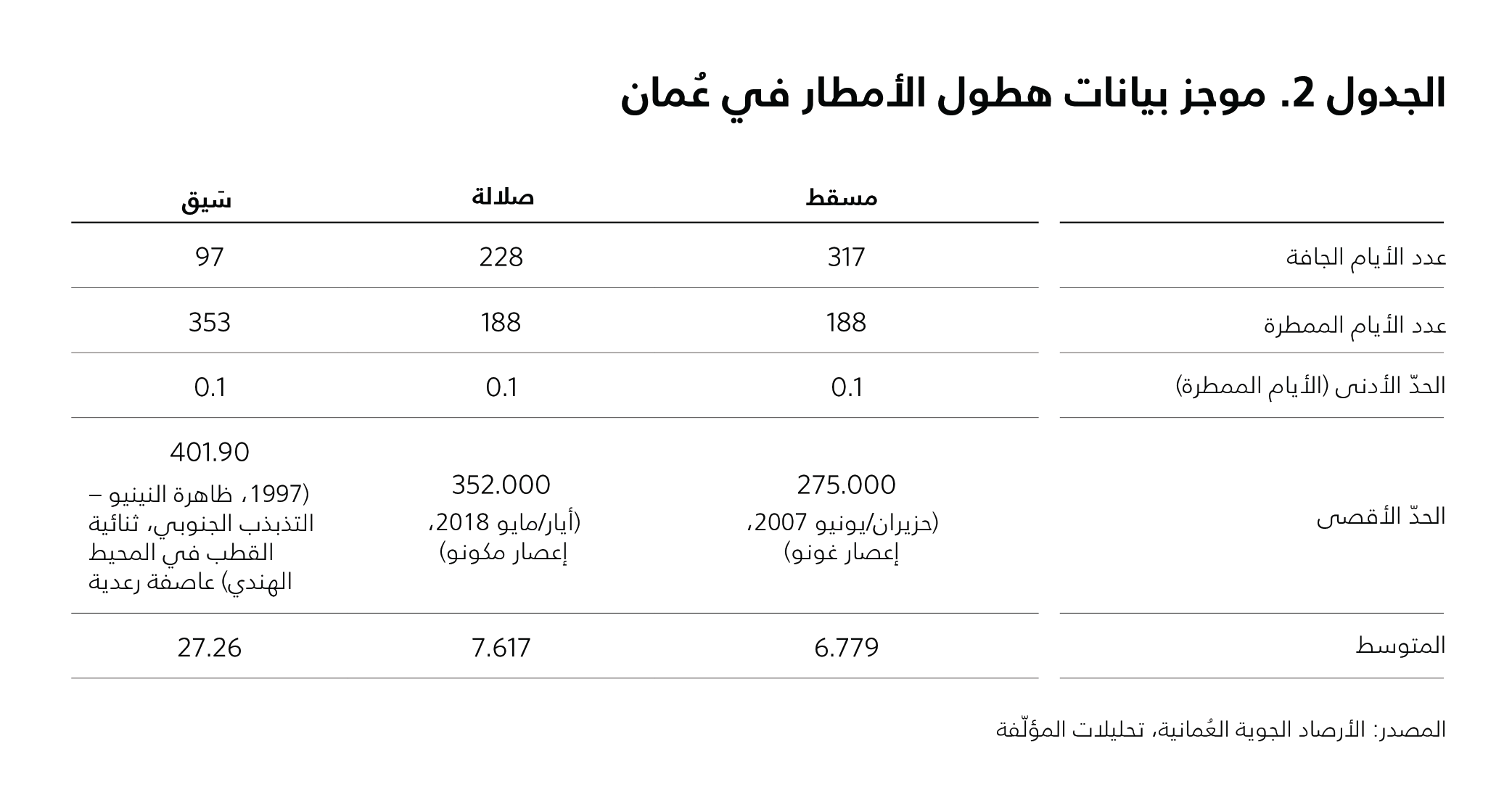
تترتّب عن موجات الجفاف في عُمان تداعيات اجتماعية اقتصادية على السكان المحليين، ولا سيما في ما يتعلق بنظام الري، والزراعة، ورعي الحيوانات في القرى العُمانية. وفي الوقت نفسه، تُبيّن السجلات التاريخية زيادة تواتر الأعاصير المدارية العالية الحدّة التي تبلغ اليابسة في عُمان. وقد ألحقت هذه الأعاصير المدارية، التي يمكن أن تتسبّب بفيضانات طوفانية شديدة ورياح عاتية، أضرارًا فادحة بالبنى التحتية في عُمان مرّات عدّة. ولكن على الرغم من خطر حدوث ضرر، تؤثّر الظواهر المناخية القاسية إيجابًا في طبقات المياه الجوفية في البلاد. على سبيل المثال، يقول الخبراء إن الإعصار المداري شاهين في العام 2021 أدّى إلى زيادة كمية المياه الجوفية في منطقة الباطنة. وفي المجمل، قد يكون حجم تغذية المياه الجوفية أكثر استقرارًا واستدامةً في الواقع.
تتم تغذية المياه الجوفية في عُمان من خلال هطول الأمطار وتسرّب مياه الفيضانات، في إشارةٍ إلى مياه الفيضانات الطوفانية التي تبقى على السطح لبضعة أيام ولكنها تتغلغل في نهاية المطاف في جوف الأرض من جديد. لكن معدّلات تغذية المياه الجوفية تتباين إلى حدٍّ كبير في أنحاء البلاد بسبب الاختلافات في المتساقطات، والطبيعة الجيولوجية واستخدام الأراضي. كذلك، يمكن أن يؤدّي ارتفاع درجات الحرارة المرتبط بتغيّر المناخ إلى زيادة معدّلات التبخّر، ما يسفر عن خسارة كميات إضافية من المياه الجوفية. ويمكن أن يتسبّب ارتفاع معدّلات التبخّر بتراجع توافر المياه وزيادة استنزاف مخزون طبقات المياه الجوفية. ويُعَدّ نضوب طبقات المياه الجوفية مشكلة كبيرة في سلطنة عُمان، ولا سيما في المناطق الساحلية حيث تُضَخّ المياه الجوفية بمعدّلات غير مستدامة. ووفقًا لدراسة أجرتها وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، تراجع منسوب المياه الجوفية بمقدار 10 أمتار في بعض المناطق خلال العقود القليلة الماضية.
الملوحة هي أيضًا مشكلة بالغة الأهمية في عُمان بسبب سوء إدارة نُظم الري. تُستخرَج المياه من طبقات المياه الجوفية من خلال آبار تُستخدَم لأغراض متعدّدة، بما في ذلك تأمين مياه الشرب، وريّ المزروعات، والاستخدام الصناعي. ولكن الاستغلال الجائر للمياه الجوفية قد يؤدّي إلى استنزاف الموارد المائية وتسرّب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية العذبة، ما يجعلها غير صالحة للاستخدام. ويمكن أن يؤول ارتفاع منسوب مياه البحر أيضًا إلى تفاقم اختلاط المياه المالحة بطبقات المياه الجوفية الساحلية. فمع ارتفاع منسوب مياه البحر، يمكن أن تتسرّب المياه المالحة إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية، فتصبح غير صالحة للاستعمال. وقد يطرح ذلك تحدّيات كبيرة لإدارة الموارد المائية في المناطق الساحلية في عُمان. على سبيل المثال، يُعدّ ازدياد الطلب على المياه لأغراض الزراعة وللاستخدامات المحلية والصناعية والسياحية السببَ الأساسي لتدهور نوعية مياه الطبقات الجوفية الساحلية في صلالة. إضافةً على ذلك، أدّى التسرب الجانبي للمياه المالحة من الصخور الكلسية في الجهتَين الشرقية والغربية لطبقة المياه الجوفية إلى تملّح الجزء الأوسط منها.
الموارد المائية والقواعد التنظيمية في عُمان
تُصنَّف سلطنة عُمان من بين الدول التي تعاني من ندرة في المياه، إذ تمتلك موارد محدودة من المياه العذبة ولا يتجاوز متوسط معدّلات هطول الأمطار فيها حوالى 100 مليمتر سنويًا. لذا، تُعدّ الإدارة المستدامة لطبقات المياه الجوفية أساسية لتلبية حاجات البلاد من المياه. هذا ويبلغ نصيب الفرد من إمدادات المياه العذبة المتجدّدة حوالى 330 مترًا مكعبًا سنويًا، وتشكّل المياه الجوفية المصدر الأساسي لنحو 70 في المئة من إجمالي المياه المُستخدمة في عُمان. عمومًا، تميل كميات الأمطار المحدودة إلى الهطول على مساحات صغيرة فقط، ولا توفر ما يكفي من المياه لزراعة الأراضي الجافة، أو الزراعة التي لا تعتمد على الريّ. تعتبر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن المياه الجوفية تشكّل المصدر الرئيس والأكثر موثوقيةً للمياه في سلطنة عُمان. مع ذلك، تحتضن الأودية في عُمان بعض المصادر المهمة للمياه السطحية، على غرار ضيقة وقريات في شمال عُمان، حيث تتدفّق المياه بمعدّل 60 مليون متر مكعب سنويًا، ووادي حلفين الذي تتجمّع مياهه في مساحة ضخمة تتجاوز 4,000 كيلومتر مربع.
يتم الحصول على المياه المخصّصة للريّ في المقام الأول من الخزانات الضحلة ومن مسارات تدفّق المياه الجوفية. لكن الطلب المتنامي على المياه الجوفية، إلى جانب التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ، أدّى إلى إجهاد طبقات المياه الجوفية في البلاد. كذلك، يتسبّب الإفراط في استخراج المياه ونقص القواعد التنظيمية إلى استنزاف المياه الجوفية بوتيرة غير مستدامة.
ينظّم المرسوم السلطاني رقم 40/2023، الذي صدر منذ فترة وجيزة، قطاع المياه والصرف الصحي، ويحدّد أحد عشر نشاطًا لا يجوز لأي شخص مزاولتها إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك، وتشمل هذه الأنشطة ما يلي: إنتاج المياه ونقلها والتزويد بها، إضافةً إلى جمع مياه الصرف الصحي ونقلها، ومعالجتها وتصريفها. ويهدف هذا القانون أيضًا إلى تحسين نظام إدارة المخلّفات من خلال منع تصريف المخلّفات الناتجة عن الأنشطة التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الطبية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة. وتسري أحكام هذا القانون أيضًا على إنتاج مياه الآبار أو نقلها أو التزويد بها، وتهدف إلى تحسين نوعية هذه المياه.
علاوةً على ذلك، يهدف القانون الجديد إلى استكشاف وتطوير مصادر مياه بديلة لتقليص الاعتماد على الإمدادات المحدودة، وتحسين تخزين المياه للتخفيف من تأثيرات التغيّرات في أنماط هطول الأمطار وموجات الجفاف، واتّخاذ تدابير للحفاظ على جودة المياه وحمايتها من التلوّث. وقد يشمل ذلك تطبيق أفضل الممارسات لإدارة قطاعَي الزراعة والصناعة، ومياه الجريان السطحي، والمسطّحات المائية، والنُظم الإيكولوجية. ويسعى القانون أيضًا إلى المساعدة على تعزيز أواصر التعاون والانخراط مع مختلف أصحاب المصلحة، بما في ذلك المجتمعات المحلية ومستخدِمي المياه، من أجل رفع مستوى الوعي حول تداعيات تغيّر المناخ على الموارد المائية وإشراكهم في عملية اتّخاذ القرارات. وستتمكّن السلطات، بفضل أنظمة المراقبة الصارمة، من تعقّب التغيّرات التي تطرأ على الموارد المائية وتتبّع مدى فعالية التدابير الجديدة، ومراجعة استراتيجيات إدارة المياه وتحديثها بصورة منتظمة، استنادًا إلى المعلومات الجديدة والظروف المناخية المتغيّرة. وفي نهاية المطاف، سيعزّز القانون قدرة المؤسسات المعنية بإدارة المياه على إدراج الاعتبارات المتعلقة بتغيّر المناخ في صُلب سياساتها وممارساتها.
تحصين عُمان من المخاطر المناخية
التحصين من المخاطر المناخية هو مقاربة جديدة لفهم تبِعات تغيّر المناخ على التنمية الاجتماعية الاقتصادية من خلال تحديد أفضل التدابير للحدّ من الأضرار الناجمة عن تغيّر المناخ في منطقة معيّنة. وقد عرّف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي استراتيجية التحصين من المخاطر المناخية بما يلي:
"مفهوم يهدف إلى تحديد المخاطر التي تواجه أي مشروع تنموي، أو مورد طبيعي أو بشري، نتيجة تقلّب المناخ وتغيّره، وإلى ضمان تقليص هذه المخاطر إلى مستويات مقبولة من خلال إجراء تغييرات طويلة الأمد تكون سليمة بيئيًا ومُجدية اقتصاديًا ومقبولة اجتماعيًا، على أن تُنفَّذ خلال مرحلة واحدة أو أكثر من مراحل المشروع: التخطيط والتصميم، والبناء، والتشغيل، ووقف التشغيل".
بعبارة أخرى، تنطوي هذه الاستراتيجية على إدماج المخاطر والفرص السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمختلف سيناريوهات تغيّر المناخ بصورة مباشرة في عملية تصميم البنى التحتية وتشغيلها وصيانتها.
يتطلّب تحصين الموارد المائية من المخاطر المناخية وضع الاستراتيجيات واتّخاذ التدابير اللازمة لضمان قدرة الموارد والنُظم المائية على الصمود أمام التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ والتكيُّف معها. وإضافةً إلى التحصين من المخاطر المناخية عمومًا، لا بدّ من إدماج الاعتبارات المتعلّقة بتغيّر المناخ في مختلف مراحل تخطيط وتصميم وتشغيل البنى التحتية والممارسات المتعلقة بإدارة الموارد المائية. وتستند هذه العملية إلى ركيزتَين (هما التخفيف من حدة التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ، والتكيّف معها)، وتنطوي على مرحلتَين (هما الرصد، والتحليل المفصّل).
من الممكن تحصين النُظم المائية من المخاطر المناخية في عُمان من خلال اتّخاذ الخطوات التالية:
- إجراء تقييم شامل لتأثيرات تغيّر المناخ على نظام مائي محدّد. لتطبيق سياسات أفضل من أجل إدارة الموارد المائية في عُمان، من الضروري فهم المخاطر التي تواجهها البلاد، ومن ضمنها ارتفاع درجات الحرارة، وتغيّر أنماط هطول الأمطار، وارتفاع منسوب مياه البحر، والظواهر الجوية المتطرّفة. قد يساعد في ذلك أيضًا تحديد المناطق المعرّضة بشدّة لخطر استنزاف المياه الجوفية وغيرها من المخاطر، مثل التلوّث الناجم عن السياسات التنموية.
- تطوير خطط لإدارة المياه في إطار مختلف سيناريوهات تغيّر المناخ ودراسة تداعياتها المحتملة على توافر المياه، وجودتها، وبنيتها التحتية. تشمل هذه الخطط الاحتياطية التفكير في تعديل الطلب على المياه، وتحديد أفضل الطرق لتوزيع المياه، وعرض موارد مائية بديلة. تعتزم عُمان وضع إطار تنظيمي لإدارة المياه الجوفية واستخدامها من خلال تطبيق نظام الحصص المائية التي يمكن استخراجها، لرصد ومراقبة استنزاف طبقات المياه الجوفية، مع إيلاء أولوية قصوى إلى المناطق المستنزفة في منطقة الباطنة في شمال عُمان، حيث يُعدّ الطلب على المياه الجوفية مرتفعًا على وجه الخصوص.
- التشجيع على الحفاظ على المياه واتّباع ممارسات فعّالة لتخفيف الطلب عليها، وتعزيز صمود الإمدادات المائية وتحسين كفاءة استخدامها. قد تنطوي هذه العملية على تطبيق تقنيات تضمن كفاءة استخدام المياه، والتشجيع على اتّباع ممارسات لترشيد استهلاكها، واتخاذ التدابير اللازمة لإدارة الطلب عليها.
خاتمة
نظرًا إلى هطول الأمطار المحدود وندرة الموارد المائية في عُمان، تُعدّ السلطنة عرضةً للتأثّر بشكلٍ خاص بتداعيات تغيّر المناخ. فقد أجهد اعتماد البلاد على طبقات المياه الجوفية إمدادات المياه وفاقم أزمتها المائية. لذلك، من الضروري ضمان الإدارة المستدامة للموارد المائية في مواجهة تغيّر المناخ.
في هذا الإطار، يُعتبر تحصين إدارة الموارد المائية في عُمان من المخاطر المناخية خطوة مهمة لتعزيز قدرة البلاد على الصمود والتكيّف. ويتطلّب ذلك اعتماد نهجٍ متكامل ومتعدّد الجوانب يأخذ في الحسبان الخصائص الفريدة لكل منطقة والنظام المائي الخاص بها. يُشار إلى أن تعزيز أدوات تقييم المخاطر المُحدقة بالموارد المائية وتحديد الأطراف المعنية، يتيحان للبلاد وضع استراتيجيات للتعامل مع المخاطر المناخية على مستوى المستجمعات المائية، والانتقال من مجرّد إدارة المخاطر إلى اقتناص الفرص من أجل تحسين إدارة الموارد المائية في السلطنة.
التكيّف مع تغيّر المناخ في سورية وسط الصراع
مقدّمة
على مدى اثنَي عشر عامًا من الحرب، واجهت سورية تحديّات عدّة منها تغيّر المناخ، وموجات الجفاف، ودمار البنية التحتية الأساسية، وضعف المؤسسات الحكومية، ناهيك عن التدنّي الحاد في منسوب مياه نهر الفرات العابر للحدود، الذي ينبع من تركيا ويسير في أراضيها ويتابع طريقه داخل الأراضي السورية. وأدّى ذلك إلى انعدام أمن المياه والغذاء والطاقة، الذي سبّب، وما زال يسبّب قدرًا هائلًا من المعاناة الإنسانية. علاوةً على ذلك، ساهم نقص المواد الغذائية والتضخم، وأسعار الحبوب المرتفعة في السوق العالمية نتيجة الحرب في أوكرانيا، في زيادة تكاليف المواد الغذائية بشكل كبير. وفاقم الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سورية في شباط/فبراير 2023 الأزمات الإنسانية ومخاطر تفشّي أمراض الكوليرا والتهاب الكبد والنوروفيروس، إضافةً إلى انعدام الأمن الغذائي.
واليوم، يقاسي 12 مليون سوري انعدام الأمن الغذائي، ويُعدّ 1.8 مليون آخرين معرّضين لخطر انعدام الأمن الغذائي، ناهيك عن أن نصف السكان يفتقرون إلى الأمن المائي ويعاني أكثر من نصف مليون طفل من سوء التغذية الحاد. وفيما يعيش 90 في المئة من السوريين في فقر مدقع ويحتاج 15.3 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية، لجأت أُسر كثيرة إلى سحب أطفالها من المدارس، واتّبعت آليات تأقلم غير صحية، مثل تفويت بعض وجبات الطعام اليومية أو الحدّ منها بشدّة. تؤدّي هذه الأوضاع إلى إدامة حلقة الفقر التي تهدّد رأس المال البشري وتُضعف أي فرصة لتحقيق الازدهار الاقتصادي الوطني في المستقبل، إضافةً إلى تقويض صحة وأمن ومستقبل الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، من أطفالٍ وفتياتٍ ونساء.
في ظل هذه الظروف البائسة، يتعيّن على المنظمات الحكومية والمؤسسات السياسية المحلية تحسين قدرة المجتمع السوري على الصمود في وجه تغيّر المناخ والجفاف، وإلّا فسيبقى ملايين المدنيين يفتقرون إلى أمن المياه والغذاء والطاقة، في ظل حالة انعدام الاستقرار الاجتماعي والسياسي. ففي موازاة مساعي إنهاء الحرب السورية، يجب أن تركّز جهود إعادة الإعمار ما بعد الصراع على تعزيز القدرة على التكيّف مع تغيّر المناخ. إضافةً إلى ذلك، على المجتمع الدولي أن يحثّ تركيا، التي تسبّبت مشاريع سدودها على طول نهر الفرات، مقرونةً بمعدّلات استهلاكها المرتفعة للمياه، بتراجع حاد في منسوب تدفّق المياه عند المصبّ، على الالتزام ببروتوكول العام 1987 الموقَّع مع سورية بشأن مياه نهر الفرات. ويُفترَض أن تساعد هذه الخطوات في تجنيب السوريين المزيد من المعاناة وتعزيز آفاق بناء مستقبل ينعم بالسلام لهم.
عاصفةٌ من الأزمات: تغيّر المناخ والجفاف والحرب
تواجه سورية تداعيات تغيّر المناخ منذ أكثر من قرن من الزمن، لكن الأمور اليوم تزداد سوءًا. فقد ارتفعت درجة الحرارة في البلاد بمعدّل 0.8 درجة مئوية (1.4 درجة فهرنهايت) خلال القرن الماضي، وتُقدِّر نماذج تغيّر المناخ بأن تطرأ زيادة إضافية تتراوح بين 3 و5 درجات مئوية (5.4 و9 درجات فهرنهايت) بحلول نهاية القرن الحالي. ويُتوقّع أن تواصل معدّلات هطول الأمطار انخفاضها بعد أن تراجعت بالفعل في جميع أنحاء سورية. وألحقت موجات الجفاف أضرارًا فادحة بالمنطقة ويُرجّح أن يزداد عدد الأيام الجافة وأن تطول فترات الجفاف. ومن المتوقّع أن ينخفض منسوب المياه في نهر الفرات بنسبة 23 في المئة بسبب التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ. نظرًا إلى هذه العوامل مجتمعةً، من المحتمل أن تشهد سورية انخفاضًا في إجمالي إمداداتها المائية بنسبة 20 في المئة بحلول العام 2050.
أدّت موجة الجفاف التي ضربت المنطقة بين العامَين 2020 و2022 إلى نقص الموارد المائية في جميع أنحاء سورية، ولا سيما في المحافظات التي تُعدّ سلّة الخبز التاريخية للبلاد، وهي الحسكة ودير الزور والرقة. وساهمت موجات الجفاف وأنماط الطقس المتقلّبة في فشل المحاصيل التي تعتمد على مياه الأمطار، وذلك بنسبة 90 في المئة. على سبيل المثال، تراجع إنتاج القمح السوري، الذي يُعتبر عنصرًا هامًّا لتحقيق الأمن الغذائي للسوريين، من 2.8 مليون طن إلى 1 مليون طن، أي بنسبة 75 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة. يؤدّي فشل المحاصيل إلى تراجع إمدادات الحبوب الأساسية وأعلاف الحيوانات، وإلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية، ناهيك عن أنه يهدّد سُبل عيش العمّال الزراعيين. الجدير بالذكر أن القطاع الزراعي يوظّف 14.6 في المئة من سكان سورية، ويعتمد حوالى نصف سكان المناطق الريفية على هذا القطاع لكسب رزقهم، في ظل نقص فرص العمل الأخرى إلّا في قطاع الأمن والميليشيات والبناء. وفي ظل محاولاتهم اليائسة لإيجاد فرص العمل وتأمين سُبل العيش، يشكّل الشباب والنساء، والأطفال حتى، أرضًا خصبة يمكن أن تستغلّها الحركات المتطرّفة لتجنيد أعضاء جدد.
إن فشل المحاصيل بصورة متكرّرة، والأزمة الاقتصادية، والتضخم، وتبعات الحرب في أوكرانيا على أسعار الحبوب العالمية كلّها عوامل أدّت مجتمعةً إلى ارتفاع حاد في تكاليف المواد الغذائية في سورية. وبين العامَين 2020 و2022، ازدادت أسعار المواد الغذائية بنسبة 800 في المئة، مسجِّلةً أعلى ارتفاعٍ لها منذ العام 2013. دفع ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الأحوال الاقتصادية منظمة الأغذية والزراعة إلى تصنيف سورية كـ"بؤرة ساخنة" للجوع ومصدر قلق بالغ ومستمر. وفي العام 2019، عانت نسبة 36 في المئة من سكان سورية انعدام الأمن الغذائي، وبحلول العام 2022، بلغت هذه النسبة 55 في المئة، نصفهم تقريبًا من المدنيين المقيمين في المناطق الريفية. وقبل وقوع الزلزال، كان عدد السوريين الذين يفتقرون إلى الأمن الغذائي في شمال غرب سورية يبلغ 3.1 ملايين شخص من أصل 4.1 ملايين، وازداد هذا العدد بشكلٍ كبيرٍ بعد الزلزال نظرًا إلى أن هذه المنطقة كانت الأكثر تضرّرًا من جرّائه.
استهدفت روسيا والحكومة السورية وتنظيم الدولة الإسلامية خلال سنوات الحرب البنية التحتية الهيدرولوجية، بما فيها 60 في المئة من محطات معالجة المياه، ومحطات الضخ، وأبراج المياه، ما أدّى إلى تضرّر ما بين 50 و95 في المئة من أنظمة الريّ في سورية، وافتقار نصف سكان البلاد إلى الأمن المائي. علاوةً على ذلك، حين توغّل الجيش التركي في شمال شرق سورية في العام 2019، سيطر على محطة علوك التي تشكّل مصدر المياه الأساسي لمليون شخص. يُشار إلى أن الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيلها تأتي من محطة كهرباء واقعة في منطقة خاضعة لسيطرة قوات سورية الديمقراطية التي يهيمن عليها الأكراد، وأن أي عملية صيانة أو تصليح لمحطة علوك تتطلّب تدخّل تقنيين من الخارج، ما يستلزم بالتالي وساطة دولية. وبين آب/أغسطس 2021 وآذار/مارس 2022، عملت المحطة بنصف طاقتها خلال 80 في المئة من الوقت، وبين أيلول/سبتمبر 2022 وآذار/مارس 2023، توقّفت عن العمل. ونتيجة الدمار الذي لحق بمرافق معالجة مياه الصرف الصحي، يتم تصريف 70 في المئة من مياه المجاري غير المُعالجة في البيئة، ما يسهم في تلوّث المياه السطحية والجوفية على السواء.
نظرًا إلى هذه الأوضاع المزرية، تضطرّ نسبة 52 في المئة من الأُسر إلى استخدام مصادر غير آمنة للمياه، ما يزيد خطر تفشّي الأمراض المنقولة في المياه. وقدّرت منظمة الصحة العالمية أن نسبة المصابين بالإسهال الحاد في محافظتَي الحسكة والرقة قد ارتفعت بواقع 50 في المئة خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2021. ونجم عن استخدام مياه الشرب غير الآمنة تفشّي داء الكوليرا، بحيث سُجِّلت 100 ألف حالة مشتبه بإصابتها بالكوليرا و100 حالة وفاة في البلاد بحلول نيسان/أبريل 2023. وثمة 6.5 ملايين شخص معرّضون إلى حدٍّ كبير لخطر الإصابة بالكوليرا في جميع أنحاء سورية. يُضاف إلى ذلك أن انقطاع الكهرباء ونقص المياه يقوّضان فعالية النظام الصحي، إذ إن 59 في المئة فقط من مستشفيات البلاد تعمل بكامل طاقتها.
تسهم المؤسسات الإدارية الضعيفة وغير الفعّالة التي تعجز عن التصدّي إلى مستويات الفقر والحرمان المتزايدة في البلاد، في إشعال شرارة التوترات السياسية والاضطرابات الاجتماعية. فعلى سبيل المثال، من أجل تفادي اندلاع أزمة إنسانية في ظل تغيّر المناخ وموجات الجفاف، يمكن أن تلجأ دولةٌ تنعم بالاستقرار إلى زيادة الدعم المخصَّص للمزارعين الذين يواجهون صعوبات مالية وللفئات الفقيرة في المجتمع، وأيضًا إلى استيراد الحبوب لتعويض النقص المحلي، حتى إن كان ذلك مكلفًا. لكن دولة ضعيفة مزّقتها الحرب مثل سورية، ولا تمتلك سوى احتياطيات محدودة من العملات الأجنبية، تواجه تحديات كبيرة تعيق قدرتها على زيادة واردات الحبوب أو الاستمرار في تكبّد تكاليف باهظة من أجل الحفاظ على دعم المواد الغذائية للفقراء. الجدير بالذكر أن الحكومة السورية تسيطر راهنًا على ثلثَي مساحة البلاد، ومعظمها مناطق واقعة في جنوب سورية وغربها ووسطها. تُنافسها على السلطة في جزءٍ من الشمال الغربي هيئة تحرير الشام الإسلامية المسلّحة، وفي الشمال تركيا ووكلاؤها السوريون، وفي الشمال الشرقي قوات سورية الديمقراطية. ومؤسسات الدولة في هذه المناطق ضعيفة وغير فعّالة وعاجزة عن تزويد السكان بشبكات الأمان الاجتماعي التي تشتدّ الحاجة إليها.
مشكلة السدود التركية عند المنبع
تعتمد الأراضي القاحلة في الغالب أو شبه القاحلة في سورية إلى حدٍّ كبير على نهر الفرات العابر للحدود من أجل تلبية حاجات البلاد من المياه والطاقة. ومنذ ستينيات القرن المنصرم، نفذّت تركيا مشاريع تنموية مكثّفة شملت بناء سدود على مجرى نهر الفرات وتوسيع شبكات الريّ في منطقة جنوب شرق الأناضول. يغطّي مشروع جنوب شرق الأناضول المتعدّد الأوجه نهر دجلة المجاور أيضًا، ويشمل اثنين وعشرين سدًّا وتسع عشرة محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية، ويوفّر مياه الريّ إلى نحو 1.8 مليون هكتار من الأراضي (ما يقارب 4.45 ملايين فدان). وبحلول العام 2023، أنجزت تركيا بناء ثمانية عشر سدًّا من السدود المخطَّط إنشاؤها على نهريَ دجلة والفرات، وأتمّت 54 في المئة من مشاريع الريّ.
جزءٌ كبير من هذه المشاريع التنموية محطّ خلاف. ففي العام 1987، وقّعت أنقرة ودمشق بروتوكول التعاون الاقتصادي والفنّي المشترك، ضمنت بموجبه تركيا تدفّق مياه النهر بمقدار 500 متر مكعب في الثانية إلى سورية. لكن خلال السنوات الأخيرة، لم تحصل سورية سوى على نحو 200 متر مكعب في الثانية من مياه النهر. وخلال فترة الجفاف بين العامَين 2020 و2022، تمكّنت تركيا من تلبية حاجاتها من مياه الريّ في جنوب شرق الأناضول من خلال تقليص تدفّق المياه باتجاه المصبّ، ما أسهم في فشل المحاصيل في سورية. ونجم عن ذلك أيضًا تدنّي منسوب مياه نهر الفرات بمعدّل خمسة أمتار، ما تسبّب بانقطاع المياه عن 5.5 ملايين شخص في محافظات حلب والرقة ودير الزور.
شكّل تدنّي منسوب المياه في نهر الفرات تهديدًا لعمليات السدود وسلامتها في سورية. فقد انخفضت المياه في خزانات سورية إلى مستويات قريبة من سعة التخزين الميت (أي كمية المياه المخزّنة التي تقع أسفل منسوب جميع منافذ وفتحات السدّ، ولا يمكن تصريفها إلا إذا انهارت جدرانه)، وتأثّرت أيضًا جودة المياه المتبقّية، وتراجعت قدرتها على توليد الطاقة الكهرومائية اللازمة لتلبية 70 في المئة من حاجات البلاد من الكهرباء. وخلال فترة الجفاف بين 2020 و2022، اقترب منسوب المياه في بحيرة الأسد، أي الخزّان المائي الذي تَشكَّل خلف سدّ الطبقة، من مستوى التخزين الميت بفارق متر واحد، ما هدّد بإلحاق الضرر بعنفات توليد الطاقة الكهربائية (التوربينات) وحدوث انغمار داخلي بالمياه. إن تضرّر التوربينات أو السدّ لن يؤدّي فقط إلى وقف عمل السدّ بالكامل، بل سيحتّم أيضًا إجراء إصلاحات تتجاوز قدرات فرق الصيانة التقنية المحلية، ناهيك عن الصعوبة الكبيرة في شراء قطع الغيار الضرورية. وفي آذار/مارس 2023، تم تعليق العمل في سدّ تشرين – ليس للمرة الأولى - بسبب انخفاض منسوب المياه في نهر الفرات، ما أدّى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو سبعة ملايين شخص.
يُظهر مثلان إضافيان كيف تمكّنت تركيا من تلبية حاجاتها من المياه، ما أثّر سلبًا على الوضع عند المصبّ، وهما نهرا الخابور والبليخ، اللذان ينبعان من تركيا ويتدفّقان عبر شمال شرق سورية، حيث يلتقيان بالفرات. وقد نجم عن المشاريع التنموية وبناء السدود عند المنبع في تركيا جفاف مياه نهر الخابور، خلال الصيف بدايةً ثم طيلة العام في الآونة الأخيرة. تمتلك سورية سدَّين على نهر الخابور (السدّ الشرقي والسدّ الغربي في شمال شرق البلاد) وكلاهما جافّان. ونظرًا إلى الموقع السياسي الضعيف للنظام السوري، ما كان منه إلّا أن قبل بهذا الوضع بحكم الأمر الواقع وصبّ اهتمامه بالكامل على تأمين المياه من المجرى الأساسي لنهر الفرات.
تسبّبت تطوّرات مشابهة في تركيا بجفاف نهر البليخ، الذي يحصل اليوم على مياهه في الغالب من الجريان السطحي من المنطقة الزراعية في مدينتَي أورفة وحران، ومياه الصرف الصحي من المدن المجاورة. وتصبّ مياه المجاري الصحية ومياه الريّ في نهر البليخ من داخل سورية أيضًا. إذًا، ينقل هذا النهر مياهًا شديدة التلوّث إلى نهر الفرات. وخلال فترات الجفاف والنقص الحاد في المياه، يمكن أن تسهم مياه البليخ بشكلٍ كبير في تدفّق مياه الفرات.
في ظل تدنّي المياه المتدفّقة من نهر الفرات، بات المزارعون السوريون يعتمدون على مياه الآبار لريّ المحاصيل. لكن الجفاف المتكرّر وسوء إدارة المياه الجوفية أدّيا إلى تراجع معدّل إعادة تغذية المياه الجوفية في سورية. ونظرًا إلى الانخفاض المطّرد في مستوى الأحواض المائية وارتفاع أسعار الطاقة، لم يعد باستطاعة الكثير من المزارعين الاعتماد على مياه الآبار في الريّ. لذلك، من غير المؤكّد ما إذا سيتمكّن السوريون من تلبية حاجاتهم المائية وضمان أمنهم الغذائي.
الآفاق المستقبلية: التكيّف مع تغيّر المناخ
بهدف تحقيق القدرة على الصمود والتكيّف في وجه التقلّبات المناخية، لا بدّ من تجهيز البنية التحتية، والمجتمع، والمزارعين، والمؤسسات لمواجهة الجفاف وغيره من الظواهر، ووضع خطة للاستجابة والتعافي. فمن خلال اتّباع مثل هذه التدابير التكيّفية، يمكن تقليل الضرر اللاحق بالمدنيين والاقتصاد المحلي والبيئة. لتحقيق هذه الأهداف، على المنظمات الإنسانية الدولية والمؤسسات السياسية المحلية اعتماد "تدابير لا يُندم عليها"، أي سياسات تبقى مُجدية بصرف النظر عن شدّة تغيّر المناخ على المدى القصير أو الطويل. ومع أن النظام السوري استغلّ المساعدات الإنسانية ووظّفها لخدمة أجندته الخاصة عن طريق توجيهها إلى مؤيّديه وبعيدًا عن خصومه، قد يحدّ التركيز على مثل هذه التدابير من تداعيات الفساد. ونظرًا إلى أن الجفاف وتغيّر المناخ والصراع جميعها عوامل تهدّد أمن الغذاء والمياه والطاقة في سورية، من الضروري تعزيز قدرة السوريين على الصمود والتكيّف كي يتمكّنوا من بناء مستقبل أكثر إشراقًا.
ينبغي على المنظمات الإنسانية بالتعاون مع المؤسسات الحكومية الاستثمار في عملية إعادة إعمارٍ تتقيّد بالمعايير البيئية في ما يتعلّق بإنشاء البنى التحتية المائية وأنظمة الريّ ومرافق معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة الطاقة، على أن تراعي في الوقت نفسه تداعيات تغيّر المناخ. فعلى سبيل المثال، إذا أُعيد بناء محطات ضخّ المياه السورية في مواقع أقرب إلى ضفاف نهر الفرات الآخذة مياهه في الانحسار، قد تتمكّن من العمل حتى في أوقات الجفاف. ومن الضروري أيضًا إصلاح أو تحديث التوربينات في سدود سورية، كي يحظى ملايين الأشخاص بإمدادات موثوقة من الكهرباء، ويحصل 5.4 ملايين شخص على المياه. إضافةً إلى ذلك، ينبغي توفير المواد المدعومة وقطع الغيار للمزارعين من أجل إصلاح معدّاتهم، ما يزيد من كفاءتهم وإنتاجيتهم، ويعزّز قدرة مَزارعهم على الصمود في وجه تغيّر المناخ.
ومن بين التدابير المهمّة الأخرى التي لا يُندم عليها رصد جميع الظواهر المناخية الخطيرة، وإتاحة توقعات حالة الطقس والأرصاد الجوية مجانًا للمجتمعات المحلية، ووضع نظام إنذار مبكر لأي موجة جفاف مقبلة. ويجب على المنظمات الإنسانية والمؤسسات السياسية المحلية أيضًا إعداد خطط احتياطية للمساعدة على حماية السكان الأكثر احتياجًا قبل حدوث موجة الجفاف وبعدها. وينبغي أن تنظر هذه الخطة أيضًا في توزيع البذور عالية الجودة والأسمدة ومبيدات الحشرات بشكلٍ مبكر على المزارعين، إما مجانًا أو بأسعار مدعومة للغاية، إضافةً إلى توفير إمدادات الطاقة المدعومة.
وبحسب شدّة موجات الجفاف المقبلة والوضع المالي للمواطنين السوريين، قد تدعو الحاجة إلى صياغة سياسة تحويلات نقدية مرتبطة بتغيّر المناخ ترمي إلى مساعدة العائلات الفقيرة على تغطية التكاليف المتزايدة للمواد الغذائية والطاقة والمياه. ومن أجل الحدّ من الفساد المستشري في معظم الأحيان في المناطق المتأثّرة بالصراعات، ينبغي توجيه السلع المدعومة وجميع أشكال الدعم الأخرى إلى الأُسر الفقيرة مباشرةً. ويجب توزيع بذور الخضروات مجانًا على السوريين في جميع أنحاء البلاد لزراعة الخضروات في حدائق منازلهم، بهدف الحدّ من انعدام الأمن الغذائي في أوساط الأُسر خلال موجات الجفاف. وسيسهم هذا الإجراء في تحسين وجبات الأُسر من خلال تنويع غذائها.
وبما أن الدول المتأثّرة بالصراعات تشهد هجرة الأدمغة وتواجه نقصًا في التقنيين، يتعيّن على الحكومة السورية والمنظمات الإنسانية إطلاق برامج تدريبية للمزارعين، تزوّدهم بمعلومات حول تبعات تغيّر المناخ، وتعلّمهم كيفية تقليل مخاطر فشل المحاصيل، ولا سيما في المناطق القاحلة وشبه القاحلة. وينبغي أن تركّز هذه البرامج بشكل خاص على طرق ترشيد استهلاك المياه، وتقنيات الحراثة التي تسمح بحفظ رطوبة التربة، فضلًا عن ممارسات جمع المياه وتخزينها، وتقنية الريّ بالتنقيط.
ونظرًا إلى أن تفشّي الأمراض المنقولة في المياه في سورية هو نتيجة عرضية لنقص المعارف بشأن كيفية ضمان الحصول على المياه الآمنة، يجب إطلاق حملة توعية حول جودة المياه. ومن أجل معالجة مشكلة النقص الكبير في البيانات، يمكن للمنظمات الإنسانية إنشاء معهد متخصّص في شؤون المياه لإجراء الأبحاث والتعلّم من أفضل الممارسات والسياسات المائية المطبَّقة محليًا، ثم نشر هذه المعارف في أوساط المزارعين.
أخيرًا، يتعيّن على المجتمع الدولي إقناع تركيا بالتقيّد بالتزاماتها الدولية في إطار بروتوكول العام 1987، نظرًا إلى التهديدات التي تطرحها أزمات المياه والطاقة على الأمن الإنساني. إذا تحقّق ذلك، فستسهم تركيا في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية وفي دعم بناء دولةٍ سورية مستقرة في المستقبل. يُشار إلى أن تركيا تستضيف أساسًا 3.6 ملايين لاجئ سوري وتسعى جاهدةً إلى تفادي تدفّقات أخرى للاجئين إلى أراضيها. ومن شأن إجراءات مثل تعزيز حصول السوريين على الغذاء والكهرباء والمياه بشكلٍ آمن وكافٍ، إضافةً إلى ضمان سلامتهم البدنية وتوفير فرص العمل لهم، أن تقلّص عدد الذين يطلبون اللجوء في تركيا وتشجّع بعض الذين غادروا على العودة إلى بلادهم. إذًا، لتركيا مصلحة وطنية في إرساء الأمن الإنساني في سورية والالتزام ببروتوكول العام 1987.
خاتمة
بعد اثنَي عشر عامًا من الحرب والدمار، بات المدنيون السوريون أشدّ عرضةً للتأثُّر بتداعيات تغيّر المناخ والجفاف. وقد أعاق الفقر، وضعف المؤسسات الحكومية، والأزمات الاقتصادية، والتضخّم، قدرتهم على التكيّف وأفرز أوضاعًا لا يُحسدون عليها. ففي العام 2023، كان أكثر من 13 مليون شخص في أمسّ الحاجة إلى المياه الآمنة، وأنظمة الصرف الصحي، ومستلزمات النظافة الشخصية. إذًا، يواصل السوريون الغرق أكثر فأكثر في لُجج الفقر الذي يهدّد أمن الأطفال والنساء وكبار السنّ على السواء. وأدّى سوء التغذية والفقر إلى حالات فشل النمو لدى 25 إلى 28 في المئة من الأطفال، ما يعرّض رأس المال البشري المستقبلي إلى الخطر. لذلك، يتعيّن على المنظمات الإنسانية والجهات المانحة والحكومة السورية أن تضافر جهودها لتعزيز القدرة على الصمود والتكيّف في وجه تغيّر المناخ وموجات الجفاف من خلال إطلاق عملية إعادة إعمار تتقيّد بالمعايير البيئية. إن لم يتحقّق ذلك، ستتواصل معاناة السوريين وسيسعى السكان إلى الهروب من واقعهم الأليم بأي وسيلة ممكنة.
الظلم المائي والأحواض النهرية العابرة للحدود الوطنية: واقع مرتفعات الجولان المحتلة
مقدّمة
يمتدّ 236 حوضًا نهريًا ونحو 300 خزان جوفي عبر الحدود الوطنية للدول في مختلف أنحاء العالم. ويعتمد أكثر من 140 بلدًا على هذه النظم المائية العابرة للحدود، ما يوفّر سياقًا غنيًا لمحلّلي السياسات والأكاديميين من أجل استكشاف النهج المثالي لإدارة المياه العابرة للحدود. لكن جهود معظم المحلّلين انصبّت على العلاقات العابرة للحدود بين الدول، مع التركيز على المفاوضات والدبلوماسية وتطوير البنية التحتية. ولا تزال آليات إدارة المياه السائدة تتغاضى عن مسائل الإرث الاستعماري، وحقوق الشعوب الأصلية في المياه، وإدماج منظور النوع الاجتماعي. وخير مثالٍ على ذلك حوض نهر الأردن، الذي يُعدّ حوضًا نهريًا معقّدًا، ومستغَلًّا على نحو جائر، ومقسَّمًا بطريقة غير متكافئة، ومعرَّضًا بشدّة للتأثّر بتغيّر المناخ. وفيما يركّز معظم الباحثين وصنّاع السياسات على القانون الدولي واستخدام البلدان المشاطئة لمياه الحوض، ينظر هذا التحليل في الظروف التي تعيشها المجتمعات المحلية المتروكة لمصيرها في مواجهة التهميش السياسي والإيكولوجي.
يتوقف هذا الفصل عند المسائل التالية: أولًا، تؤدّي القيود المفروضة على الأُطر والآليات العالمية السائدة حاليًا لإدارة المياه العابرة للحدود إلى مفاقمة حالة الحرمان التي تعيشها مجتمعات محلية منزوعة الجنسية مثل الجولانيين، وهم من السكان السوريين الأصليين في مرتفعات الجولان المحتلة. ثانيًا، تتيح الاستراتيجيات التي تتّبعها مجتمعات مثل الجولانيين من أجل التصدي للهيمنة والتكيّف مع هذه الوقائع السياسية والمناخية المركّبة، مسارات لإحداث تحوّل في طرق إدارة الأراضي والمياه. وختامًا، في سياق تغيّر المناخ، تمارس إسرائيل نفوذها من خلال تعزيز استخدام الطاقة المتجدّدة في الأراضي المحتلة، فتواصل إحكام قبضتها بلا هوادة على الموارد والأراضي عن طريق سردية التنمية الخضراء القائمة على نهج عدم التسييس وتحقيق التقدّم التكنولوجي في مرتفعات الجولان.
ينبغي على الوسطاء والمراقبين في الأحواض المائية العابرة للحدود إيلاء الاهتمام اللازم لسبل تكيّف المجتمعات المحلية المنزوعة الجنسية، على غرار تلك التي تعيش في مرتفعات الجولان، مع هذه التغييرات السياسية والجغرافية والمناخية. وفي ضوء ارتفاع أعداد سكان الأحواض الذين يطلبون اللجوء في بلدان مجاورة، مثل الأردن، من الأهمية بمكان إيلاء الاهتمام لأوجه الظلم التي يواجهونها في الحصول على حقّهم في المياه. وفي هذا الصدد، يمكن استخلاص دروسٍ مهمة لتعزيز الإنصاف والعدل في عملية وضع السياسات المتعلقة بإدارة المياه العابرة للحدود.
حوض نهر الأردن ومحدودية الأُطر العابرة للحدود
يقدّم حوض نهر الأردن مجموعة من المتغيّرات التي استقطبت الدراسات الأكاديمية، والتقارير المتعلقة بصنع السياسات، وخبراء العلاقات الدولية، ولا سيما بشأن قضايا التعاون بين الدول، والنزاعات، وتخصيص التدفقات. وحوض نهر الأردن فريدٌ من نوعه بوجهٍ خاص لأن إسرائيل المشاطئة له هي قوة احتلال تستخدم مجموعة ًمن الاستراتيجيات والأدوات لممارسة هيمنتها على أراضٍ ومياه عربية بوسائل تشمل الاستغلال الجائر للموارد المائية المشتركة. لقد عمدت إسرائيل، منذ احتلالها العسكري لأراضي البلدان المجاورة في الحرب العربية الإسرائيلية للعام 1967، إلى تعزيز موقعها الجيوستراتيجي من خلال إحكام قبضتها على روافد حوض نهر الأردن. وتمخّضت الترتيبات الثنائية عن اتفاق مُجحف للأردن أتاح لإسرائيل بسط نفوذها على استخدام رافد اليرموك إضافةً إلى الروافد العليا لنهر الأردن. ترفض إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، رفضًا قاطعًا منح المجتمعات المحلية المهّمشة الخاضعة لها (من فلسطينيين وسوريين) حقوقها الأساسية في المياه، فيما تستغل الموارد المشتركة لبلدان مشاطئة أخرى (سورية ولبنان والأردن). وقد حال ذلك، إضافةً إلى أمثلة أخرى عن استغلال إسرائيل للمياه من جانب واحد، دون إمكانية إدارة الحوض النهري بطريقة سليمة تعود في الواقع بالفائدة على المجتمعات المحلية.
والحال هو أن الترتيبات المائية العابرة للحدود في حوض نهر الأردن، وأبرزها الاتفاقية الموقّعة بين سورية والأردن في العام 1987، ومعاهدة السلام الإسرائيلية الأردنية في العام 1994، وما نجم عنها من بنى تحتية أعاقت التقدّم نحو الحصول على حصة أكثر إنصافًا وعدلًا من مياه حوض النهر. (تذكر مصادر أن السبب وراء فشل المفاوضات التي تمّت بوساطة أميركية بين إسرائيل وسورية في العام 2000 هو رفض إسرائيل الاعتراف بحدود ما قبل العام 1967، ما كان من شأنه أن يعيد لسورية الحق في الوصول إلى بحيرة طبريا في جنوب مرتفعات الجولان المحتلة، فتستعيد بالتالي حقوقها في الاستفادة من مياه البحيرة بوصفها دولة مشاطئة). ولكن على الرغم من أن المعايير والتنظيمات والقوانين المتعلقة بإدارة المياه العابرة للحدود قد تكون مفيدة وملائمة للدول القُطرية ومواطنيها، تظلّ غير كافية لمواجهة التحديات الوجودية للمجتمعات المحلية التي تعيش في نزاعات مطوّلة وتحت وطأة الاحتلال العسكري. ويقدّم سكان الجولان الأصليون في مرتفعات الجولان المحتلة مثالًا معبّرًا عن مجتمع محلي يحاول التكيّف مع الوقائع المتغيّرة في المياه والسياسة.
تشكّل مرتفعات الجولان، وهي عبارة عن هضبة بركانية مرتفعة تقع عند نقطة التقاء الحدود بين إسرائيل وسورية والأردن، موقعًا استراتيجيًا ذا أهمية جيوسياسية ومائية سياسية هائلة. وهي غنية جدًّا بالمياه، وتسجل أعلى مستويات هطولٍ للأمطار في المنطقة. تتراوح كمية الأمطار التي تتساقط سنويًا في مرتفعات الجولان بين 1000 مليمتر في الشمال و1600 مليمتر في جبل الشيخ، في حين أن متوسط الأمطار في المنطقة الوسطى يبلغ 800 مليمتر وفي الجنوب 500 مليمتر. منذ احتلال القوات الإسرائيلية لمرتفعات الجولان السورية في العام 1967، عمدت إسرائيل إلى إحكام سيطرتها على المنابع المائية لنهر الأردن، إضافةً إلى السيطرة على المياه الجوفية في الضفة الغربية الفلسطينية. وتحوّلت إسرائيل أيضًا، بفعل احتلالها للأراضي، إلى دولة مشاطئة تقع باتجاه منبع النهر، فيما لم يعد لسورية موقعٌ على ضفاف النهر. وبعدما كان الجولان يضمّ مجتمعًا محليًا مزدهرًا قوامه أكثر من 140 ألف نسمة في العام 1966، لم يتبقَّ بعد العام 1967 سوى 5 في المئة من سكّانه، يسيطرون على نسبة 5 في المئة فقط من إجمالي مساحة أراضي الجولان المحتلة. ولم تصمد سوى ست قرى من أصل مدينتَين و163 قرية و108 مَزارع. أما البقية فكان مصيرها الدمار الكامل. وقد رفض الجولانيون، الذين يبلغ عددهم حاليًا نحو 27 ألف نسمة، المحاولات اللاحقة لفرض الجنسية الإسرائيلية عليهم. في العام 1982، أعلنت إسرائيل ضمّ مرتفعات الجولان بصورة أحادية وبحكم الأمر الواقع، في خطوة اعتبرها المجتمع الدولي غير قانونية، ما دفع أبناء الجولان إلى اللجوء إلى التظاهر ضدّ فرض الجنسية وقرار الضم وإلى تنفيذ إضراب دام ستة أشهر. لا يزال موقف المجتمع الدولي واضحًا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، بمعزل عن القرار الذي اتّخذه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتل.
لقد وظّفت إسرائيل استثمارات طائلة لاستغلال الموارد المائية في مرتفعات الجولان، من خلال إنشاء بحيرات اصطناعية وسدود وخزانات لاستخدام المياه لصالح المستوطنات الإسرائيلية اليهودية حصرًا، والتي يبلغ عددها الآن أربعًا وثلاثين مستوطنة غير شرعية تضم 26,250 مستوطنًا. وقد حصلت المستوطنات على الأراضي والمياه لزراعة المحاصيل، وتربية الحيوانات، وزراعة الكروم واجتذاب السياحة. وبدأت إسرائيل، إلى جانب عمل شركات المياه الاستيطانية، بحفر آبار المياه الجوفية التي كانت محدودة جدًّا قبل العام 1967. حاليًا، تُنتج هذه الآبار نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه سنويًا، تستخدمها المستوطنات حصرًا. منذ إقرار قانون المياه في العام 1959، يُسمَح لإسرائيل فقط بالتنقيب من أجل استخراج المياه الجوفية، ولا يؤذَن بحفر آبار المياه الجوفية من دون الحصول على ترخيص صريح من الدولة.
يتمثّل الاستغلال الأكثر وقاحةً للموارد المائية في مرتفعات الجولان بالاستيلاء على المياه السطحية. تبلغ السعة الإجمالية لستة عشر مجمّعًا اصطناعيًا كبيرًا للمياه بنتها شركة "مي غولان" الاستيطانية للمياه 45 مليون متر مكعب، وتؤمّن المياه للمستوطنات اليهودية غير الشرعية، وتدعم أنشطتها الزراعية الصناعية. وتجمع خمسة مجمّعات منها، بسعة إجمالية قدرها 16.5 مليون متر مكعب، المياه الجارية من حوض نهر اليرموك. هذه المجمّعات المائية هي ممارسات استغلالية، فالمياه تقع في الأراضي السورية، وهي نظريًا من حق سكان مرتفعات الجولان.
إضفاء الطابع المحلي على الأحواض العابرة للحدود: تجربة أبناء الجولان السوري
التحول الذي أحدثته السياسات الوطنية الإسرائيلية في مرتفعات الجولان لا يروي سوى نصف الحكاية، أي واقع المستوطنين الإسرائيليين. أما أبناء الجولان فيعيشون واقعًا مغايرًا. فإعلان إسرائيل في العام 1968 بأن 98 في المئة من مرتفعات الجولان المحتلة ستكون مناطق عسكرية مغلقة، فضلًا عن السيطرة المركزية التي تمارسها إسرائيل على المياه، أثّرا بشكلٍ كبير على الممارسات الزراعية لأبناء الجولان. في العام 1996، أنتجت مرتفعات الجولان، التي تشكل جزءًا من محافظة القنيطرة السورية، أصنافًا متنوّعة من المحاصيل تشمل التفاح والعنب والقمح. وبعد العام 1967، باتت الأراضي الزراعية المتاحة لأبناء الجولان تقتصر على 5 في المئة فقط من مجمل الأراضي المحتلة. وخوفًا من التهديد الوشيك بمصادرة الأراضي، عمد الجولانيون إلى تكثيف أعداد بساتين التفاح والأشجار المثمرة في الأراضي المتبقية لهم. ونظرًا إلى تقييد حصولهم على المياه، اضطُروا إلى تطوير مواردهم المائية الخاصة، وفي نهاية المطاف أثّر ذلك على ممارساتهم الزراعية. وهكذا طوّر المجتمع المحلي، في منطقته الجغرافية الضيّقة الواقعة في شمال مرتفعات الجولان المحتلة، 12 ألف دونم (3000 فدّان) من الأراضي الزراعية المرويّة على مرّ العقود المتعاقبة منذ ستينيات القرن الماضي.
كان الحصول على المياه أداة أساسية لأبناء الجولان الساعين إلى حماية الأراضي المتبقّية لهم من مصادرة إسرائيل لها. وساعدت المياه أيضًا على تجذّر المزارعين المحليين في أرضهم وترسيخ هذه الجذور. فبينما كانت إسرائيل تبني خزانًا للمياه في مرتفعات الجولان، وتُحدث تحوّلًا ماديًا في المشهد الطبيعي، وتُنشئ بنية تحتية مائية حصرية في معظم أنحاء المنطقة، سعى أبناء الجولان إلى الدفاع عن أنفسهم وإعادة التجذّر في أرضهم من خلال العمل الجماعي في ما تبقّى من أراضٍ خاضعة لسيطرتهم.
بعد العام 1967، صادرت شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" بحيرة بركانية تدعى بركة رام وأطلقت عملية واسعة لاستخراج المياه منها دعمًا للمستوطنات الإسرائيلية التي كانت قد أُنشئت حديثًا. باشر الجولانيون، الذين مُنِعوا من الوصول إلى البحيرة، بذل جهود جماعية لاستعادة المياه من خلال البنية التحتية المحلية. فبدأوا بحفر برك ضحلة لجمع المياه الجارية. وفي الثمانينيات، باشروا إنشاء خزانات معدنية أسطوانية الشكل لجمع مياه الأمطار – وهو خيار عملي منخفض التكلفة يتيح لأبناء الجولان زيادة كميات المياه المتوافرة للري. وقد شُيِّدت المئات من هذه الخزانات التي تتراوح سعة كلٍّ منها بين 300 و1000 متر مكعب من المياه، في تحدٍّ للتنظيمات المائية الإسرائيلية. وبعد هذه الطفرة في الخزانات، إذا صحّ التعبير، استمر أبناء الجولان في التحرك ضدّ استحواذ إسرائيل على المياه، وذلك من خلال إنشاء تعاونيات مائية وشبكة أنابيب يموّلها ويطوّرها المجتمع المحلي لنقل المياه إلى الأراضي الزراعية. واليوم، تتلقى سبع عشرة تعاونية نحو 250 مترًا مكعبًا من المياه للدونم الواحد. ولكن، لا تزال تسود درجة عالية من عدم التكافؤ. فالمستوطنون الإسرائيليون يحصلون على أربعة أضعاف هذه الكمية، ما يمنحهم أفضلية شديدة في تسويق منتجاتهم الزراعية، ولا سيما التفاح.
تقدّم الممارسات التي طوّرها الجولانيون على مرّ العقود دراسة حالة عن التصدي للقيود التي تُفرَض على الحصول على الأراضي ومصادر المياه العذبة والسيطرة عليها. تتيح البنية التحتية المبتكرة، وكذلك ممارسات استخدام الأراضي والتعاونيات المائية المحلية، حيّزًا للعمل المستقل من أجل مقاومة سيطرة إسرائيل على الموارد، وقد نجحت هذه الإجراءات في الالتفاف على القيود التمييزية المفروضة على استخراج المياه وتخزينها واستخدامها في الزراعة.
فيما يشكّل تغيّر المناخ ومكامن الضعف المرتبطة بالمناخ ظاهرة خطيرة ومُقلقة، يعتبر المزارعون في مرتفعات الجولان المحتلة أن الاحتلال الإسرائيلي يقوّض بشكل أكبر قدرتهم على الحصول على المياه وتوافرها. ويجسّد هذا الأمر النظرية القائلة إن الوقائع السياسية تزيد من قابلية التأثر بتغيّر المناخ وتُعدّ أساسية لفهم كيف يتسبّب تغيّر المناخ بزيادة هشاشة المجتمعات المحلية الزراعية. وسوف يطرح تغيّر المناخ تهديدًا إضافيًا على تدابير التكيّف – مثل البنية التحتية المائية المحلية أو اختيار المحاصيل في مرتفعات الجولان – ما يفاقم مكامن الضعف التي تعانيها المجتمعات المحلية في ظلّ افتقارها إلى أي دعم مؤسّسي أو حكومي للتخفيف من وطأة هذه المخاطر.
في الواقع، تستخدم إسرائيل تغيّر المناخ ذريعةً لتبرير إحكام قبضتها بشكلٍ متزايد على أراضي الجولانيين في مرتفعات الجولان المحتلة من خلال مشروعها الجاري لتطوير طاقة الرياح. تسهم هذه الخطوة في الإبقاء على فكرة أن معالجة تغيّر المناخ ممكنة من خلال آليات يُفترَض أنها تكنولوجية وقائمة على الأسواق وغير مسيّسة، مثل اتفاقيات مبادلة المياه بالطاقة. لقد اعتمدت إسرائيل والأردن موقفًا غير مسيّس إلى حدٍّ كبير من مفاوضات المياه مقابل الطاقة الإشكالية، تحت ستار ما يُسمّى بعملية بناء السلام البيئي. وهذا يعبّر عن منحى مُقلق نحو نزع الطابع السياسي عن الظلم الواقع في ما يتعلق بتغيّر المناخ والمياه، وذلك على حساب المجتمعات المحلية التي تعيش تحت نير الاحتلال العسكري.
تتجلّى عملية نزع الطابع السياسي بأوضح صورها في مرتفعات الجولان المحتلة. فقد أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لتنفيذ مشاريع تطوير الطاقة الخضراء في أراضي الجولان. وتَعمَد إسرائيل، تحت ستار خفض الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة في إطار التزامها باتفاق باريس للعام 2015، إلى الدفع بعدوانية نحو تنفيذ مشروع توربينات الرياح في الأراضي المحتلة، على الرغم من المعارضة الشديدة التي يلقاها من معظم أبناء الجولان. وهذا الوضع يجسّد كيف تواصل إسرائيل، في سياق تغيّر المناخ، فرض نفوذها على الأراضي والمجتمع المحلي. وقد أسفرت الهجمات الأخيرة ضدّ الجولانيين التي شنّها الجيش الإسرائيلي وشركة "إنرجيكس" الإسرائيلية المتخصّصة بطاقة الرياح عن إصابة خمسة أشخاص بجروح خطيرة، ما دفع المجتمعات المحلية إلى التظاهر في مختلف أنحاء فلسطين.
تُظهر الأدلة في مختلف المناطق الجغرافية أن المجتمعات المحلية المهمّشة لا تُستبعَد فقط من مشاريع تطوير الطاقة الخضراء، بل غالبًا ما تدفع الثمن أيضًا. فقد تهدّد هذه المشاريع أنشطة السكان لتأمين سبل العيش، وأراضيهم، وحصولهم على المياه، وتقوّض نضالاتهم من أجل تقرير مصيرهم. هذا وتتجاهل عملية وضع السياسات المناخية المجتمعات المحلية – ولا سيما تلك المنزوعة الجنسية – تمامًا كما يحدث في إدارة المياه العابرة للحدود. يُضاف إلى ذلك أن اتّباع النهج القائم على عدم التسييس في معالجة القضايا المائية والمناخية باعتبارها مشاكل تتطلّب حلولًا ومقاربات تكنولوجية ومستندة إلى الأسواق، يُعدّ مقلقًا بوجهٍ خاص في الحالات حيث تسهم السياسة المناخية بوضوح في مفاقمة انتهاكات حقوق الإنسان وإطالة أمد الاحتلال العسكري.
خاتمة
لقد وقف المجتمع المحلي في مرتفعات الجولان، باعتباره مجتمعًا من السوريين المجرّدين من جنسيتهم والذين تحوّلوا إلى سكان منزوعي الجنسية في أرض محتلة – وقفة حازمة في وجه الهيمنة الإسرائيلية على الموارد المائية العابرة للحدود. وأظهر استخدام المجتمع المحلي لما يُسمّى بالبنية التحتية المضادّة من أجل استعادة موارده التي هي حق مشروع له، الأشكال التي يمكن أن يتّخذها اعتماد استراتيجيات وتكتيكات تكيّفٍ عملية خارج الآليات القائمة التي لم تعترف بوضع الجولانيين الهشّ بوصفهم سكّانًا منزوعي الجنسية. وتكشف هذه المقاربة المحلية الطابع في التعامل مع استغلال المياه العابرة للحدود عن الحاجة إلى إدارة مائية تحوّلية وأكثر شمولًا تراعي حاجات وتطلعات المجتمعات المحلية المهمّشة التي ترزح تحت وطأة الاحتلال العسكري المديد، ولا سيما حقّها في الحصول على مصادر المياه.
وتُبيّن هذه المقاربة أيضًا لماذا يجب على المفاوضات المتعلقة بالأحواض المائية العابرة للحدود التدقيق في قضايا العدالة لأنها ترتبط بتوزيع المياه داخل تلك البلدان. فمن خلال فهم استراتيجيات التكيّف التي اعتمدها المجتمع المحلي في الجولان لمعالجة أوجه الظلم التي يواجهها في الحصول على المياه والأراضي، واستخلاص الدروس من هذه الاستراتيجيات، يستطيع صنّاع السياسات والأكاديميون بلورة مقاربات قائمة على حقوق الإنسان والعدالة لإدارة المياه العابرة للحدود بما يعطي الأولوية للمجتمعات المحلية بدلًا من الشركات والحكومات من خلال تطوير آليات للإدارة المشتركة، ولا سيما في سياق الاحتلال العسكري المطوّل وظروف انعدام الجنسية والإقصاء.
محنة المياه في اليمن: لماذا تغيّر المناخ ليس سوى جزء صغير من المشكلة؟
مقدّمة
لم تبدأ مشكلة المياه في اليمن مع نشوب الصراع الحالي، بل إنها أزمة حوكمةٍ تسبّبت بها الإخفاقات في مجال الاستدامة، والتي تعود إلى حقبة ما قبل الاستقلال. فاستنزاف المياه الجوفية يتواصل منذ عقود، مُهدّدًا الأمن الغذائي للشعب اليمني وسبُل عيشه، وهو شعبٌ يعمل في الغالب في الزراعة. الواقع أن الدولة شجّعت، من سبعينيات القرن الماضي حتى أواخر التسعينيات، الاستخدام غير المُقيَّد للمياه الجوفية والطاقة المدعومة، بهدف تعزيز التنمية القائمة على الزراعة. ثم اتّبع اليمن، في تسعينيات القرن الماضي والعقد الأول من القرن الحالي، إدارةً أكثر استدامةً لموارده المائية من خلال إنشاء مؤسسات مياه جديدة، وإصدار التشريعات الإصلاحية، إلا أن هذه الإصلاحات الأساسية باتت مُعلَّقة منذ اندلاع الصراع في العام 2015. وتبقى الطريقة الوحيدة التي يستطيع اليمن أن يعالج بها التحدّيات المائية في السنوات المقبلة هي الالتزام مجدّدًا بهذا المسار السابق من أجل تحقيق إدارةٍ مستدامةٍ للمياه.
تتجلّى أزمة المياه المتفاقمة في اليمن في انعدام التوازن في البلاد بين الطلب على المياه العذبة (حوالى 3.9 مليارات أمتار مكعّبة سنويًا)، وإمدادات المياه المُتاحة من الموارد المتجدّدة (مليار متر مكعّب سنويًا من المياه السطحية، و1.5 مليار متر مكعّب من المياه الجوفية)، وهو ما أسفر عن استخراج مفرَط للمياه الجوفية. أضِف إلى ذلك أن خدمات المياه والصرف الصحّي حاليًا لا تصل حتى إلى جميع اليمنيين، فيما تُفاقِم الحرب المتواصلة الوضعَ أكثر. كذلك، يرتبط عجز القطاع الزراعي عن تحقيق الأمن الغذائي بالاستخدام غير الكفؤ للمياه، وسوء اختيار المحاصيل. هذه المخاوف بشأن المياه والأمن الغذائي تفوق حتى المخاوف المرتبطة بتغيّر المناخ، الذي وإن كانت تداعياته لا تزال غير مدروسة بالقدر الكافي وغير متّسقة (مثلاً تأثيراته على معدّلات هطول الأمطار)، سيؤدّي إلى المزيد من الضعف، ويقلّل غلّة المحاصيل ودخل المزارعين اليمنيين الذين يعتمدون على مياه الأمطار.
ينظر هذا الفصل أولاً في ارتباط مشاكل المياه الحالية في اليمن بفشل البلاد في تحقيق الإدارة المستدامة للمياه، ثم يستطلع فرص استئناف إصلاحات المياه. وبعد تناول الإرث الناجم عن سوء إدارة المياه في اليمن، يستكشف الفصل النجاحات التي حقّقتها الإصلاحات السابقة في قطاع المياه، والقيود التي كبّلت هذه العملية. وانطلاقًا من هذه الجهود، يدعو الفصل إلى إعادة البناء على هذه الإصلاحات وتحديثها من خلال انخراط الدولة فيها، وتطوير البنية التحتية بدعمٍ من المجتمع الدولي.
الإرث الناجم عن سوء إدارة المياه
كانت أزمة المياه الحادّة في اليمن آخذةً في التفاقم حتى قبل الصراع الحالي. فالمياه الجوفية تُعَدّ مصدرًا مائيًا حيويًا، إذ تمثّل 70 في المئة من استخدام المياه في البلاد، وهي ضرورية من أجل تأمين الغذاء لليمنيين الذين يعتمدون إلى حدٍّ كبير على زراعة الكفاف. وتحوي خزانات المياه الجوفية في اليمن على احتياطيات تصل إلى ما يقرب من 35 ألف مليون متر مكعّب، مع معدّل تغذية سنوية يبلغ حوالى 1300 مليون متر مكعّب. لكن كميات المياه المسحوبة تُقدَّر بحوالى 2500 مليون متر مكعّب سنويًا، وإذا ما استمرّ سحب المياه بالمعدّل الحالي، فيُقدَّر أن تُستنزَف موارد اليمن من المياه الجوفية في غضون عشرين عامًا فقط.
وكما هي الحال في سائر دول الشرق الأوسط، تُعزى أزمة المياه في اليمن إلى الإخفاقات في مجال الاستدامة منذ حقبة ما قبل الاستقلال، وتحديدًا في العام 1962 في شمال اليمن، وفي العام 1967 في جنوبه، وإن كان هذا الأخير لم يستقرّ سياسيًا حتى السبعينيات. وبين السبعينيات وأواخر التسعينيات، شجّعت الدولة الاستخدام غير المُقيَّد للمياه الجوفية والطاقة المدعومة، سعيًا منها إلى تطوير القطاع الزراعي والأمن الغذائي. فكان أن أدّى ذلك إلى تجفيف اليمن، الذي انحرف للأسف عن تقليده العريق القائم على إدارة المياه باستخدام المدرّجات الزراعية والبنية التحتية المُصمَّمة بعناية للريّ الفيضي. عوضًا عن ذلك، أسفر سوء استخدام المياه عن التخلّي عن الأنشطة الزراعية، وازدياد الهجرة من الأرياف إلى المدن، فاستعرت التوتّرات السياسية والاجتماعية في المرتفعات الخصبة في البلاد.
أصبح المزارعون قادرين على استخدام المزيد من المياه بعد أن أُتيحَت لهم تقنيات ضخّ المياه المدعومة، فتضاعفت مساحة الأراضي المرويّة بين العامَين 1970 و2004 بنسبة 1800 في المئة، من 37 ألف هكتار إلى 680 ألفًا، مع العلم أن ثلثَي هذه المساحة اعتمدت على المياه الجوفية. لكن السبب الفعليّ للاستخراج المفرَط للمياه الجوفية يُعزى إلى عجز الدولة عن ضبط استخدام هذه المياه من خلال التشريع والمراقبة وإنفاذ القانون. فحفر آبار المياه الجوفية لم يتطلّب ترخيصًا طوال عقود كثيرة، ناهيك عن أن الآبار لا تزال تُستخدَم مجانًا أو ليست حتى مزوّدة بعدّادات مياه. وحتى بعد إصدار قوانين المياه في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، غالبًا ما تَورّط رجال القبائل ومسؤولون نافذون في ما يُسمّى بالتنقيب العشوائي عن المياه من خلال عمليات الحفر غير القانونية.
في المقابل، يمكن النظر إلى التوسّع في زراعة محصول القات ذي العائد المالي العالي على أنه نتيجةٌ مباشرةٌ للسياسات غير المتبصّرة التي شجّعت على استخراج المياه الجوفية في السبعينيات والثمانينيات. فقد ازدادت زراعة القات، وهو مخدّر خفيف يتناوله الآن معظم السكان البالغين يوميًا، إلى أن هيمنت على الزراعات المرويّة في اليمن، وأصبحت تمثّل 30 في المئة تقريبًا من إجمالي عمليات سحب المياه الجوفية. ويُسهم هذا المحصول الذي يستهلك كمّيات كبيرة من المياه، (والذي يمكن زراعته من 3 إلى 4 مرّات في السنة، مقارنةً مع البن الأقل ربحيةً، بما أنه يُزرَع مرة واحدة في السنة)، في استنزاف المياه الجوفية، خصوصًا في المناطق الشمالية، حيث زراعة القات مسؤولة عن 40 في المئة من استخراج المياه من حوض صنعاء. والواقع أن القات يمثّل مشكلة بيئية واقتصادية واجتماعية معقّدة تؤثّر على نفقات الأُسَر، وتقلّل إنتاجية العمل، وتؤدّي إلى خسارة المحاصيل التصديرية التقليدية، على غرار البن. لكن إن كان حلّ هذه المشكلة صعبًا في ظل غياب الفرص الاقتصادية، ولا سيما للشباب، يبقى ضبط استهلاك المياه في زراعة القات خطوةً لا بدّ منها لمكافحة هذه الظاهرة غير السليمة.
فضلاً عن ذلك، أسفر الإرث الناجم عن سوء إدارة موارد المياه الجوفية عن انعدام مساواةٍ بين المزارعين المعتمِدين على الريّ، والمزارعين التقليديين الذين يعتمدون على مياه الأمطار. فنظرًا إلى أن الزراعة المرويّة تتطلّب استثمارًا مسبقًا، كانت الأفضلية للمزارعين الأكثر ثراءً، الذين حصلوا أيضًا على إعانات من الدولة لشراء المضخّات ومعدّات الحفر، واستفادوا من غياب التشريعات الناظمة لعمليات استخراج المياه الجوفية. ومع أن الزراعة التي تعتمد على مياه الأمطار أو مياه الجريان السطحي تراجعت إلى حدٍّ كبير، من حوالى 1,285,000 هكتار من الأراضي الزراعية في العام 1970، إلى 507,000 هكتار في العام 2018، لا تزال تسود في 50 في المئة من المناطق المزروعة في اليمن. ويُعَدّ ملايين اليمنيين الذين يعتمدون على هذا النوع من الزراعة أكثر عرضةً للتأثيرات المناخية من المزارعين المعتمدين على الريّ. لذا، من المتوقّع أن يُفاقِم تغيّر المناخ المخاطر التي يواجهها قطاع الزراعة، إذ سيؤدّي إلى تغيير مواسم البَذر للزراعات القائمة على مياه الأمطار، وإلى انخفاض غلّات المحاصيل المرويّة، مثل القمح والذرة الرفيعة. في موازاة ذلك، لم تقدّم الدولة سوى القليل من المعونة لمساعدة المزارعين الذين يعتمدون على مياه الأمطار من أجل الحفاظ على بنيتهم التحتية التقليدية المُخصَّصة لجمع المياه، أو توسيعها.
أزمة مياه وسط الحرب
تشير التحذيرات الملحّة بشأن أزمة المياه في اليمن إلى أمرَين، وهما ممارسات هدر المياه، والنموّ السكاني المتسارع. فاليمن يسجّل أحد أعلى معدّلات النموّ السكاني في العالم (3.34 في المئة تقريبًا بين العامَين 2012 و2021)، وقد يصل عدد سكانه الحالي البالغ 32 مليون نسمة إلى 55 مليونًا بحلول العام 2050. لكن الحرب التي اندلعت في العام 2015 ألحقت الضرر أيضًا بالموارد المائية، إذ استهدف المقاتلون البنية التحتية للمياه، فيما يواجه السكان صعوبةً مطّردة في الحصول على مصادر المياه الآمنة، ويعانون من ازدياد الأمراض المنقولة بالمياه، ومن تدهور الأمن الغذائي. ومن الممكن أن تتواصل هذه التداعيات في مرحلة إعادة الإعمار، إذ قد تحتاج الدولة إلى سنوات كثيرة لتتمكّن من توفير الخدمات الكافية، نظرًا إلى أن اليمن يعاني منذ فترة طويلة من ضعف الدولة وتُمزّقه الصراعات المطوّلة، ناهيك عن أن حجم الدمار الحالي الذي طاله قد يكون الأكبر على الإطلاق.
منذ بداية الصراع الحالي، لم يتمكّن سوى 60 في المئة تقريبًا من السكان من الحصول على مياه الشرب النظيفة، و20 في المئة منهم فقط على خدمات الصرف الصحّي الآمنة. فقد دمّرت الحرب البنية التحتية للمياه، من خلال الهجمات الجوية والقتال على الأرض، وتدهورَ قطاع إمدادات المياه، الأمر الذي خلّف سلسلةً من التأثيرات المتعاقبة على قطاعات أخرى، بما فيها الصحة والأمن الغذائي. فتفشّي وباء الكوليرا المتواصل، والذي بدأ في العام 2017 جرّاء انهيار شبكات المياه والصرف الصحّي، والخدمات الصحية، يُعَدّ واحدةً من أسوأ الأزمات الصحية في العالم. وقد عانى قطاع الأغذية بدوره خلال الصراع بسبب انخفاض قيمة العملة اليمنية، وغياب فرص العمل، ومُنيت نسبة كبيرة من اليمنيين بانعدام الأمن الغذائي أثناء تفشّي جائحة كوفيد-19. هذا وأدّت الصعوبات الاقتصادية التي خلّفها الصراع، مثل تدهور النظام المالي، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي.
وفي ظلّ تزايد ندرة المياه، وتدهور قدرات الدولة، يُتوقَّع نشوب المزيد من النزاعات المحلية على المياه والأراضي. فقبل الحرب الحالية، قدّرت الحكومة اليمنية أن 4000 شخص يموتون سنويًا جرّاء التنازع على حقوق الأراضي والمياه، وهو عدد أكبر بكثير من عدد الذين ماتوا جرّاء أيّ صراع سياسي داخلي آنذاك. والواقع أن النزاعات المرتبطة بالمياه تتخطّى الآن قدرات التشريع التقليدي والقبَلي، الذي كانت تُسَوّى بموجبه معظم النزاعات المحلية سابقًا. فخزانات المياه الجوفية التي وسّعت الحدود القبَلية والجغرافية، أصبحت الآن تتطلّب مراقبة رسمية وأُطُرًا تنظيمية، بيد أن ضعف مؤسسات الدولة والطلب المتنامي على استهلاك المياه لن يؤدّيا إلا إلى ازدياد التنافس بين مستخدِمي المياه الجوفية.
سُجِّل خلال الحرب تطوّر لم يُلاحَظ على نطاق واسع، ولكنه مهمّ، ساهم أيضًا في استنزاف المياه الجوفية، وهو الاستخدام المتزايد للطاقة الشمسية في الزراعة. فقد أصبحت ألواح الطاقة الشمسية من الوسائل التي لجأ إليها اليمنيون للتكيّف مع شحّ الوقود وانقطاع التيار الكهربائي. وكان الانتشار الواسع لهذه الألواح في اليمن، نتيجة غياب البدائل المُجدية، كبيرًا جدًّا، خصوصًا في المناطق الشمالية التي مزّقتها الحرب. لكن مع أن بعض التقارير قدّرت أن 50 في المئة من المنازل في المناطق الريفية، و75 في المئة منها في المناطق الحضَرية، تعتمد على الأنظمة الكهروضوئية، سيكون من الصعب معرفة الحجم الحقيقي لثورة الطاقة الشمسية في اليمن قبل انتهاء الحرب. أما في ما يتعلّق بقطاع المياه، فقد ساهم توفّر مضخّات المياه بالطاقة الشمسية في الزراعة باستنزاف المياه الجوفية في أنحاء كثيرة من العالم، إذ إن الطاقة الرخيصة تتيح للناس ضخّ المياه على مدار الساعة. وفي اليمن، بدأ المزارعون الأكثر ثراءً يستخدمون الطاقة الشمسية لضخّ المياه والريّ، وغالبًا لزراعة القات، في ظل غياب أيّ قواعد أو قيود.
حقبة إصلاح غابرة
في أواخر تسعينيات القرن الماضي وأوائل العقد الأول من القرن الحالي، سادت في اليمن موجةٌ من التفاؤل حيال مسألة المياه، إذ التزمت الدولة بإدارة مواردها المائية بصورة مستدامة، بدعمٍ من الجهات المانحة، ولا سيما الحكومتَين الألمانية والهولندية، والبنك الدولي. وأدّت الإصلاحات اللاحقة إلى إنشاء مؤسسات وطنية لإدارة المياه (بما في ذلك إدارة أحواض المياه الجوفية)، وتعزيز صنع السياسات المتعلّقة بالمياه، وتحقيق لامركزية إمدادات المياه.
يُعَدّ مفهوم الإدارة المتكاملة للموارد المائية أساسيًا لفهم الأفكار التي حفّزت هذه الإصلاحات. فقد توصّلت مجموعة خبراء من حول العالم، في مؤتمر عُقِد في دبلن، أيرلندا، في العام 1992، إلى إجماع حول إدارة المياه عُرِف بمبادئ دبلن. هذه الأخيرة أقرّت بالقيمة الاقتصادية للمياه، واقترحت ضرورة إدارتها إدارةً شاملةً باستخدام السياسات البيئية المتكاملة والمشاركة العامة. فاعتمدت شبكات الخبراء ومجتمع المانحين نموذج الإدارة المتكاملة للموارد المائية هذا، بعد أن رأوا فيه وسيلةً لإصلاح قطاعات المياه في الكثير من الدول النامية. وبينما حقّقت الإصلاحات القائمة على الإدارة المتكاملة للموارد المائية نتائج مختلطة في مختلف أنحاء العالم، وذلك بصورة رئيسة بسبب تنفيذها على عجل وانتهاج مقاربة واحدة لجميع المشاكل، فهي أكّدت مدى الحاجة إلى استدامة المياه، بإقرارها بأن المياه، بوصفها موردًا محدودًا، تتطلّب إدارة دقيقة وحماية. يُشار إلى أن الإدارة المتكاملة للموارد المائية أُدرِجَت اليوم ضمن هدف التنمية المستدامة 6.5.1 للأمم المتحدة، الذي ينصّ على تطبيقها في البلدان كافة، و"على جميع المستويات".
وقد ساهمت الإصلاحات القائمة على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، في اليمن والكثير من البلدان النامية الأخرى، في إنشاء مؤسسات جديدة لإدارة المياه استنادًا إلى مفهوم صنع السياسات المائية الموحّدة. تعني الإدارة المتكاملة للموارد المائية أن جميع جوانب استخدام المياه يجب إدارتها معًا، على المستويَين الوطني أو الإقليمي، وعلى مستوى النُظم الإيكولوجية المائية المختلفة (مثل أحواض الأنهار أو أحواض المياه الجوفية). وبحلول بداية العقد الأول من القرن الحالي، أنشأ اليمن بمساعدة جهات مانحة وزارةَ المياه والبيئة المسؤولة عن صنع السياسات المائية، والتي أصدرت استراتيجية وطنية لقطاع المياه، وبرنامجًا استثماريًا بنفقات طموحة بلغت ما يقارب الـ1.5 مليار دولار بين العامَين 2005 و2009. ثم أصدر اليمن في العام 2002 أول قانون وطني للمياه (عُدّل لاحقًا في العام 2006)، تناول مسائل أساسية مثل حقوق المياه، والترخيص للآبار لمنع الإفراط في ضخّ المياه. كذلك أُنشِئَت الهيئة العامة للموارد المائية بهدف دراسة أحواض المياه الجوفية وتخطيطها، وتطبيق أنظمة الترخيص والقياس لآبار المياه الجوفية.
إضافةً إلى ذلك، ساهمت إصلاحات المياه هذه أيضًا في بروز جيل جديد من العاملين في قطاع المياه، الذين تلقّوا تعليمهم في الخارج من خلال برامج جامعية مميّزة تستند إلى مفاهيم الإدارة المتكاملة للموارد المائية والتنمية المستدامة. وحتى أوائل العقد الأول من القرن الحالي، أُوكِلَت معظم المهام المتعلّقة بإدارة المياه إلى المسؤولين في وزارة الزراعة والريّ، الذين مالوا إلى تفضيل تنمية الموارد المائية على الإدارة المستدامة للمياه. وتلقّت مؤسسات المياه الجديدة مساعدات مهمّة في مجال بناء القدرات، منها التدريب، وأنظمة مراقبة الأداء، ومعدّات إدارة المياه. وقد حصل قطاع إمدادات المياه والصرف الصحّي على ثاني أكبر حصّة من تدفّقات المساعدات إلى اليمن، إذ ارتفعت هذه الحصّة من 36 مليون دولار في العام 2002 إلى 53 مليون دولار في العام 2009. كذلك، أُنشِئ المزيد من المؤسسات التي تُعنى بالأبحاث المائية، على غرار مركز المياه والبيئة في جامعة صنعاء، الذي حظي في البداية بتمويل الحكومة الهولندية.
وكان من ركائز الإصلاح الأساسية الأخرى تعزيز الاستثمارات في قطاع المياه في المناطق الحضَرية. فهذه الاستثمارات تولّد معدّل عائدات اجتماعية أعلى، مقارنةً مع الزراعة، إذ إن المياه البلدية تساهم أكثر في الناتج الاقتصادي، وفي تحسين الصحة والتعليم، ناهيك عن أنها يمكن أن تُعالَج ويُعاد تدويرها بشكل فعّال أكثر. وهكذا، حصل قطاع المياه في المناطق الحضَرية على أكثر من نصف الاستثمارات المتوخّاة في الاستراتيجية الوطنية. وجديرٌ ذكره أن المناطق الحضَرية في اليمن كانت تُزوَّد، قبل الإصلاحات، بإمدادات المياه بواسطة مزوّد وطني واحد. وقد حُوّل الكثير من فروع المزوّد الوطني في المناطق الحضَرية الكبرى إلى شركات مياه محلية مستقلّة ماليًا وإداريًا (وإن بقيت مرافق عامة)، حصلت على الدعم التقني من الجهات المانحة، ولا سيما ألمانيا. لكن إصلاحات اللامركزية هذه أثبتت أنها مثيرة للجدل بسبب وتيرتها السريعة، والمرافق اللامركزية التي وقع الاختيار عليها. فبعض هذه المرافق لم يكن مهيَّأً، فيما بعضها الآخر أُنشِئ لاسترضاء المحافظات غير المستقرّة سياسيًا. مع ذلك، نُظِر إلى اللامركزية على نطاق واسع على أنها ضرورية بسبب الفوائد الناتجة من تحسين الخدمات. وبفضل هذه الإصلاحات، استطاع بعض مرافق المياه المستقلّة مواصلة عمله أثناء الصراع.
السبيل للمضيّ قدمًا: إعادة البناء والتحديث
تعطّلت جهود اليمن الرامية إلى إصلاح عملية إدارة موارده المائية بفعل الاضطرابات السياسية في أعقاب ثورة العام 2011، ثم توقّفت فعليًا منذ اندلاع الحرب في العام 2015. والواقع أن مؤسسات المياه الحكومية الجديدة كانت ضعيفةً منذ البداية، مقارنةً مع المؤسسات الزراعية النافذة ومجموعات المصالح التي عارضت الإصلاحات أو قاطعتها إلى حدٍّ كبير. لكن فيما لم يتوقّع حتى أكثر الخبراء تفاؤلاً أن تحلّ الإصلاحات أزمةَ المياه بشكل كامل، شكّلت هذه الإصلاحات بدايةً مبشّرة. وعندما تباشر الدولة اليمنية جهود إعادة الإعمار بعد انتهاء الحرب، سيكون من الأهمية بمكان البناء على هذه الإصلاحات واستخلاص العبر من الماضي، وهو ما يمكن فعله بطرقٍ ثلاث.
أولاً، لا بدّ من تقوية مؤسسات المياه من خلال توفير الدعم التقني وإنفاذ القانون. فالهيئة العامة للموارد المائية، التي أُنشِئَت في إطار إصلاحات المياه، تُعَدّ مؤسسةً أساسيةً لإدارة موارد المياه الجوفية في اليمن. ولكن مع أن القانون الوطني منحها النفوذ اللازم لمراقبة عمليات استخراج المياه وتنظيمها، عبر إدارة تراخيص التنقيب وشروط الاستخراج، اقتصر عملها بشكلٍ كبيرٍ على قياس موارد المياه الجوفية في البلاد. واليوم، في ظلّ ضعف الدولة المركزية، وتعدُّد الحكومات المحلية القائمة بحكم الواقع، يمكن القول إن إنفاذ قانون المياه أصبح أسوأ من ذي قبل. وبالتالي، من الضروري أن تتوافر إرادة سياسية قوية لإيقاف التنقيب غير القانوني عن المياه، سواء عن طريق تقوية الهيئة العامة للموارد المائية وفروعها، أم من خلال إنشاء هيئات تنظيمية بيئية إقليمية أقوى. لقد كان التنقيب غير المنضبط كارثة كبرى، ويبدو أن الدولة كانت متواطئة مع ذلك، أو على الأقلّ عاجزة أمام هذا الواقع، إذ أقرّت بأن نسبة 99 في المئة من المياه المستخرجة غير مرخّص لها.
لا بدّ من الإشارة إلى أن صلاحيات الهيئة الوطنية للموارد المائية أوسع من ذلك حتى، إذ إن للهيئة سلطة تشكيل ودعم اللجان المعنيّة بخزّانات المياه الجوفية، التي يمكنها وضع التصاميم المفصّلة لإعادة تأهيل كل حوض من أحواض المياه الجوفية وحمايته. لكن مع أن فكرة إدارة المياه على مستوى الأحواض هي المنطلق الأساسي لإصلاحات الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لا يزال تطبيقها في اليمن يتطلّب الكثير من العمل.
ثانيًا، تُعَدّ المياه مسألة محورية لمستقبل المجتمع اليمني، وقد طال انتظار إجراء نقاش واسع النطاق حول أجندة إصلاح تشاركية. لقد أدّت الإصلاحات السابقة إلى قيام مؤسسات وجهات فاعلة ناشئة، مع تركيزٍ على تقويتها في مواجهة المصالح الزراعية الراسخة والقوية، وهي مصالح تتشابك مع قطاع الأعمال التجارية الزراعية، ومسؤولين حكوميين فاسدين على ما يبدو، ونخب قبَلية. ولم تتطرّق أجندة الإصلاح السابقة بشكل فعّال إلى النقاشات المجتمعية، أو الوساطة بين مصالح مختلف مُستخدِمي المياه، أو مسألة إصلاح قطاع المياه الزراعية نفسه.
يمكن لجهود الإصلاح التي ستُبذَل في المستقبل أن تعالج سوء أداء القطاع الزراعي في مجالَي البيئة والأمن الغذائي، مستعينةً كذلك بحوافز لمكافحة اقتصاد القات. فهذا القطاع فشل في تحسين الأمن الغذائي في اليمن، إذ عانى سبعة ملايين يمني من مستويات كارثية أو طارئة من الجوع في أواخر العام 2022، أثناء حالة الطوارئ الغذائية التي أعقبت اندلاع الحرب في أوكرانيا. هذا وآثر كلٌّ من قطاع الأعمال التجارية الزراعية، والنخب الحاكمة، الواردات الغذائية على الاستثمارات في الزراعة المحلية المستدامة، الأمر الذي ساهم في عجز القطاع الزراعي عن تلبية احتياجات اليمن الغذائية.
ثالثًا، من الضرورة بمكان التشديد على تقديم الدعم على مستوى المجتمعات المحلية لتعزيز قدرتها على الصمود، وتوفير أمن الإمدادات. فقد أظهر الصراع الحالي كيف أصبحت المجتمعات المحلية تعتمد على الاكتفاء الذاتي، إذ استعانت بالأنظمة التقليدية لجمع المياه، أو استخدمت تقنيات الطاقة الشمسية والبنية التحتية المُرتجلة لدمج الطاقة والمياه والإنتاج الغذائي، في ظل غياب إمدادات المياه والكهرباء الوطنية. من شأن وسائل التكيّف هذه التي تتولّاها المجتمعات المحلية، إذا ما صُمّمَت على نحو جيّد، أن تزيد القدرة على الصمود في وجه الصراعات المديدة، والعوامل الخارجية التي تفاقم الوضع، مثل تغيّر المناخ. كذلك، تمثّل وسائل التكيّف هذه حجر الأساس لبناء أنظمة إمداد أكثر لامركزيةً وتكاملاً، تستند إلى الموارد المتاحة محليًا.
خاتمة: خيارات مكلفة ولكن ضرورية
مع اقتراب الحرب من نهايتها، أمام اليمن فرصة للسعي أخيرًا نحو تحقيق الإدارة المستدامة لمياهه، والتحلّي بقدرٍ أكبر من الإرادة السياسية واستثمار المزيد من المال في قطاعه المائي. ولا بدّ أن تعالج الإصلاحات الضرورية الأسباب الكامنة وراء أزمة المياه، سعيًا إلى وقف ما يسبّبه القطاع الزراعي من استنزافٍ للمياه الجوفية، أو إبطاء وتيرة هذا الاستنزاف. لكن الوقت داهمٌ نظرًا إلى الإفراط في استخدام الموارد المائية، والأدّلة المتزايدة على تداعيات تغيّر المناخ. يحتاج اليمن إلى إجماع داخلي قوي ودعم دولي لإعداد خطة أشمل لإصلاح قطاع المياه، ولتجربة الحلول المختلفة على المستوى المحلي. وسيتطلّب الالتزام مجدّدًا بالإصلاح قيادة حكومية ودعمًا من المجتمع الدولي. وقد يستغرق ترسّخ خطة إصلاح قطاع المياه على المستوى الوطني بعض الوقت، لكن ثمّة خيارات استثمارية مهمّة ينبغي تحديدها على المدى القصير لتأمين الإمدادات البلدية.
وعلى الرغم من أن تبِعات تغيّر المناخ على هطول الأمطار في اليمن ليست متسّقة، تشهد البلاد متساقطات (حوالى 200 مليمتر سنويًا) أكثر من البلدان الأخرى في شبه الجزيرة العربية القاحلة. لذا، من شأن البنية التحتية المخصّصة لجمع مياه الأمطار وإعادة استخدامها (مثل السدود الصغيرة أو أنظمة التصريف)، أن تشكّل جزءًا من الحلّ لإعادة تغذية خزّانات المياه الجوفية، أو لبعض استخدامات المياه في المناطق الحضَرية. كذلك، من الضروري تطوير البنية التحتية لحماية أنظمة جمع المياه المحلّية وتوسيعها، خصوصًا في المناطق الريفية. في الوقت نفسه، ينبغي تثمين كل قطرة من المياه البلدية وإعادة استخدامها عن طريق توسيع أنظمة جمع مياه الصرف الصحّي البلدية وإعادة تدويرها. يُشار إلى أن الكثير من البلدان في الشرق الأوسط تستثمر أكثر فأكثر في اقتصاد مياه دائري من خلال إعادة تدوير المياه. فعلى سبيل المثال، ينقل الأردن مياه الصرف الصحّي المُعالَجة إلى المَزارع (بخلطها مع المياه العذبة في الأنهار والقنوات)، من أجل تقليص الطلب على المياه العذبة في الزراعة.
سيتعيّن على الدولة اليمنية، في إطار بحثها المُكلِف عن مصادر جديدة للمياه، أن تتعامل مع قصور تخطيطها الإقليمي. فقريبًا ستواجه مدنٌ كبرى مثل صنعاء وتعز مشاكل مياه مزمنة، ومع ذلك تستمرّ هاتان المدينتان في التوسّع بسرعة، إذ ارتفع عدد سكان صنعاء، منذ العام 1950، من 50 ألف نسمة إلى ما يزيد عن 3 ملايين. يرى بعض المراقبين أن اليمن قد لا يكون قادرًا على تحمّل تكاليف توفير إمدادات مياه إضافية عبر خيارات مثل إعادة التدوير، والنقل (مثلاً من أحواض أخرى أو من محطّات تحلية المياه الساحلية). وإذ يجري النظر في إنشاء محطات لتحلية المياه في المناطق المنخفضة القريبة من الساحل، مثل محطة تحلية المياه بالطاقة الشمسية في سيئون، يتعيّن على الدولة اليمنية أن تركّز أكثر على التنمية الإقليمية لمناطقها الساحلية، بما في ذلك زيادة توزّع السكان في هذه المناطق.
تغيّر المناخ والمياه في فلسطين في ظل ظروف الاحتلال
كُتب هذا المقال قبل أن تشنّ إسرائيل حربها على قطاع غزة خلال الأشهر التي تلت هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
مقدّمة
التهديد الذي يمثّله تغيّر المناخ في فلسطين هو مزيجٌ من العوامل البشرية والطبيعية والسياسية والتقنية، أي مشكلة شاملة تتسبّب بها قوى خارجة تمامًا عن سيطرة الفلسطينيين الذين لا يتمتعون بالحرية أو يمتلكون الوسائل اللازمة للتكيّف معها. وفي حين أن الجميع في إسرائيل/فلسطين سيتضرّرون على الأرجح من تغيّر المناخ، غالب الظن أن الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وغزة سيشعرون بالوطأة الأكبر لهذا الضرر، نظرًا إلى أنهم يعانون من الحكم العسكري الإسرائيلي، والاستيطان المتواصل للمواطنين اليهود على أرضهم، وتقييد حصولهم على مياههم. كذلك، ستكون المجتمعات الفلسطينية التي يحمل أفرادها الجنسية الإسرائيلية الأكثر تضرّرًا داخل إسرائيل، ولكن يجري التطرّق إلى هذه المسألة في تحليل منفصل.
ستطلق التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ ردود فعل تسلسلية وتسلك مسارات تؤدّي إلى تضخّم المشقّات الزراعية والاقتصادية الراهنة وتفاقم انعدام الأمن الغذائي – وذلك كلّه من خلال فرض إسرائيل سيطرتها باعتبارها تحكم فعليًا الضفة الغربية وغزة. وستكون الاستجابة الفلسطينية مُقيَّدة إلى حدٍّ كبير بالقرارات الإسرائيلية. وتخفيف إسرائيل قبضتها أو عدم تخفيفها هو ما سيحدّد قدرة الفلسطينيين على التعامل والتكيّف مع ما قد يحدث من موجات جفاف كارثية، وموجات حر، وسواها من الأحداث المهمة من الناحية الهيدرولوجية.
عند النظر إلى المسألة من منظور عالمي، يتبيّن أن إسرائيل/فلسطين هي إلى حدٍّ كبير ضحيّة تغيّر المناخ، وليست مساهِمةً فيه؛ حتى إن البيانات لا تشمل الفلسطينيين، وكأنّما لتبرز موقعهم السياسي المتدنّي. وعلى غرار الكثير من الدول الأخرى حول العالم، استشعرت البلاد بالفعل التأثيرات المُقبِلة، مثلًا من خلال درجات الحرارة القياسية التي سُجِّلت في القدس (98 درجة فهرنهايت) وأريحا (113 درجة فهرنهايت) في العام 2020. هذا وتسبّبت الحرارة غير المسبوقة بأنواع أخرى من الأضرار، مثل إجهاد الإمدادات الكهربائية واندلاع حرائق هائلة في النقب، وهي منطقة صحراوية وشبه صحراوية في جنوب البلاد.
ستكون تأثيرات تغيّر المناخ في إسرائيل/فلسطين مشابهة لتبعاته في بلدان أخرى في منطقة شرق المتوسط. يُتوقَّع أن يرتفع متوسط درجة الحرارة، ويُرجَّح أن تنخفض مستويات تساقط الأمطار والثلوج ربما بمعدّل 4 في المئة لكل ارتفاع في درجات الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة. وستزيد قلة انتظام هطول الأمطار، وفي هذا الإطار، ربما تصبح مواسم هطول الأمطار أقصر. وستحدث فترات طويلة من الجفاف في أحيان أكثر، وستزداد أيضًا وتيرة هطول الأمطار الغزيرة وحدوث الفيضانات المفاجئة، وستتبخّر كميات إضافية من الأمطار. ونتيجةً لتغيّر المناخ، سيقلّ حجم إمدادات المياه الطبيعية، حتى إنها ستصبح أكثر تقلّبًا من السابق. وسيتسبّب ارتفاع منسوب مياه البحر بازدياد ملوحة المصدر الرئيس لإمدادات المياه في غزة، وهو عبارة عن طبقة مياه جوفية ساحلية مالحة أصلًا. وسيتزامن تضاؤل إمدادات المياه الطبيعية هذا، وارتفاع درجات الحرارة وموجات الحر الطويلة مع ازدياد الطلب على المياه لأغراض الزراعة.
ترتبط تداعيات الاحتباس الحراري العالمي في إسرائيل/فلسطين بجغرافيا البلاد وخصائصها الطبيعية، أي مساحتها، وتضاريسها، والمناطق المناخية وأنماط هطول الأمطار، فضلًا عن موارد المياه السطحية والجوفية، وحدودها، وتجديدها، وتصريفها، واستخراجها. وتُضاف إلى هذه العوامل الخريطة السياسية التي سيُبيّن هذا الفصل أنها هي التي تحدّد مَن يحصل على ماذا، ومن أين، والكمية التي يحصل عليها. وتحدّد أيضًا، إلى درجة كبيرة، كيف يمكن أو لا يمكن للفلسطينيين الاستجابة للتأثيرات المناخية المتوقّعة، ولا سيما الأحداث الكارثية مثل فترات الجفاف الطويلة، وتبعاتها الزراعية، والمصاعب الاقتصادية التي تُعتبَر العوامل المحرّكة الأساسية لانعدام الأمن الغذائي.
الموارد المائية
تتميّز إسرائيل/فلسطين ببيئتها الغنيّة، إذ تقع في وسطها منطقة من الجبال، ويحيط بها البحر الأبيض المتوسط عند الساحل الغربي، وغور الأردن شرقًا، والنقب جنوبًا. وتُقدَّر المساحة الإجمالية للبلاد بـ28,090 كيلومترًا مربعًا. وتبلغ مساحة إسرائيل 22,070 كيلومترًا مربعًا، أو 78.6 في المئة من المساحة الإجمالية، من ضمنها صحراء النقب الممتدة على مساحة 13,000 كيلومتر مربع تقريبًا؛ وتبلغ مساحة الضفة الغربية المحاطة باليابسة من الجهات كافة 5655 كيلومترًا مربعًا، ومساحة غزة 365 كيلومترًا مربعًا. وتشكّل الضفة الغربية وغزة معًا 21.4 في المئة فقط من إجمالي مساحة البلاد. تتفاوت كمية تساقط الأمطار والثلوج تفاوتًا كبيرًا بحسب المكان والموسم والسنة، بحيث تتراوح في المتوسط من 800 إلى 900 مليمتر في السنة في الجبال الشمالية وتنخفض إلى أقل من 100 مليمتر في السنة في أقصى جنوب غور الأردن وأعالي النقب. ويُشار إلى أن الصحارى تُعرَّف بأنها مناطق تتلقّى أقل من 250 مليمترًا من الأمطار في السنة. وفترات الجفاف، الطويلة والقصيرة منها، ليست نادرة الحدوث. والتذبذب الملحوظ في هطول الأمطار هذا قد يجعل مفهوم "المتوسط السنوي لهطول الأمطار" الشائع الاستخدام، ذا قيمة ضئيلة لأغراض التخطيط.
تنقسم موارد المياه الطبيعية عادةً إلى قسمَين: سطحية وجوفية. يُعَدّ حوض نهر الأردن المصدر الرئيس للمياه السطحية. إنه "مجرى مائي دولي" وفقًا لقانون المياه الدولي، مشتركٌ بين خمسة أطراف مُشاطِئة، لبنان وسورية والأردن وفلسطين وإسرائيل، باتجاه عقارب الساعة. ويعبر بحيرتَين شمالًا، هما الحولة وطبريا، وينحدر جنوبًا في مسارٍ شديد التعرّج ليصبّ أخيرًا في البحر الميت.
قُدِّر متوسط التدفّق المتاح للمجرى المائي، قبل تحويله عند منبع البحر الميت، بـ1,287 مليون متر مكعب في السنة، مع تقلّبات شديدة. قد يكون هذا التدفق كافيًا لـ1.5 إلى 3 ملايين شخص، إذ يحتاج الشخص الواحد إلى كمية تتراوح من 500 إلى 1000 متر مكعب في السنة للاستخدام المنزلي وإنتاج الأغذية، اعتمادًا على حالة التكنولوجيا الزراعية. وتشير إحصاءات صدرت مؤخرًا إلى انخفاض معدّلات إعادة تغذية مصادر المياه. تزوّد سورية نحو نصف كمّية المياه التي تتدفّق في نهر الأردن، ولا سيما من مرتفعات الجولان، يليها الأردن ولبنان وإسرائيل والضفة الغربية بالترتيب التنازلي. في الواقع، قد تكون إسرائيل مساهِمة سلبية صافية بسبب ارتفاع حجم التبخّر – 230 مليون متر مكعب في السنة – من بحيرة طبريا.
تتوافر المياه الجوفية في الكثير من الطبقات الجوفية، بما في ذلك طبقة المياه الجوفية الساحلية (في إسرائيل وغزة)، وطبقة المياه الجوفية الجبلية (في الضفة الغربية)، التي هي الأكبر على الإطلاق. أما البقيّة فموجودة في إسرائيل. وتتغذّى طبقة المياه الجوفية الساحلية من إسرائيل بصورة أساسية، فيما تتغذّى طبقة المياه الجوفية الجبلية من تلال الضفة الغربية. بين العامَين 1973 و2009، بلغ متوسط إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية الساحلية 266 مليون متر مكعب في السنة، ومتوسط إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية الجبلية 686 مليون متر مكعب في السنة.
يجب أن يُنظَر إلى الأرقام السابقة على أنها تقديرات تستند جزئيًّا إلى الملاحظة، وكذلك إلى نماذج الرياضيات، خصوصًا في ما يتعلق بالمياه الجوفية. وتختلف هذه الأرقام بحسب نطاق السنوات التي تُحتسَب متوسطاتها. علاوةً على ذلك، فرضت إسرائيل، منذ استيلائها على مرتفعات الجولان والضفة الغربية وغزة في الحرب العربية الإسرائيلية في العام 1967، شبه احتكار على البيانات عن التدفقات الطبيعية. في المقابل، نظرًا إلى توزّع هذه التدفقات على مناطقهم المجزّأة، لا يمكن للفلسطينيين سوى إجراء قياسات متفرّقة في منطقة محدودة.
وذلك يقود إلى مسألة السيطرة على هذه الموارد المائية، باعتبارها العامل الحاسم في أنماط توزيعها، وكمّية المياه التي يحصل عليها كل طرف، ومتى، ومن أيّة مصادر. إضافةً إلى المساعدة على فهم توزيع المياه، هذه اعتبارات بالغة الأهمية للتقصّي عن التأثير المحتمل لتغيّر المناخ وما إذا كان الفلسطينيون سيتمكّنون من التكيّف معه.
إمدادات المياه في ظل منظومة الضوابط الإسرائيلية
لا يمكن فصل حوكمة المياه عن الحوكمة الشاملة. لقد أصبحت إسرائيل في أعقاب احتلالها الضفة الغربية وغزة في العام 1967، صاحبة السيادة الفعلية على المنطقة الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط. وهي تتعامل مع الأراضي والمياه في الأراضي المحتلة، في ما خلا تلك المملوكة من جهات خاصة، على أنها أملاكٌ للدولة تابعة لليهود في أيّ مكان من العالم. وفي العام 2022، بلغ إجمالي عدد السكان الفلسطينيين في إسرائيل/فلسطين أكثر من 7 ملايين نسمة، يحمل ما يزيد عن 1.64 مليون منهم الجنسية الإسرائيلية؛ ويقيم 3.2 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، منهم 360,000 نسمة في القدس؛ و2.17 مليون نسمة في غزة ذات المساحة الصغيرة، والتي قد تكون الكيان ذا الكثافة السكانية الأعلى على وجه الأرض. وقد بلغ عدد السكان الإسرائيليين اليهود 7.1 ملايين نسمة في العام 2022.
تنقسم الضفة الغربية إلى أربع مناطق. القدس الشرقية ضمّتها إسرائيل، ولكنّ أبناءها الفلسطينيين، وهم السكان الأصليون، يُعامَلون على أنهم مقيمون دائمون لا مواطنون، في حين أن اليهود الذين أقاموا في مستوطنات في المدينة بعد العام 1967 يُعتبَرون مواطنين. وينقسم باقي الضفة الغربية إلى مناطق يُشار إليها بطريقة ملتوية بأحرف فقط، وهي المناطق "ألف" و"باء" و"جيم". تتولّى السلطة الفلسطينية، التي تتّخذ من رام الله مقرًّا لها، مهام بلدية في المنطقة "ألف"، ومهام أمنية شكلية في المنطقتَين "ألف" و"باء". أما المنطقة "جيم"، التي تضم أكثر من 60 في المئة من الضفة الغربية ومعظم الأراضي الزراعية والمياه التي لا غنى عنها للنمو الاقتصادي الفلسطيني المستدام، فتخضع للحكم الإسرائيلي المباشر، وفيها أكثر من 450,000 مستوطن. وهي تعزل بإحكام المنطقتَين "ألف" و"باء".
تتفاقم التجزئة والاحتواء بسبب مجموعة واسعة من التدابير الأخرى، ولا سيما جدار الفصل المتعرّج الذي يقضم مساحات شاسعة من الأراضي. تجعل هذه التدابير إسرائيل المسيطر الفعلي على جميع المنافذ البرّية والبحرية. فالأجهزة الأمنية الإسرائيلية والمستوطنون يراقبون وينظّمون حركة دخول وخروج الفلسطينيين وبضائعهم. وتخضع غزة للحصار الإسرائيلي برًّا وجوًّا وبحرًا، وهي أيضًا محاصرة من مصر، ومعزولة عن الضفة الغربية. وتحكمها منذ العام 2007 حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية ولكنها حُرِمت من حقّها في تشكيل حكومة. وتتعرّض غزة منذ ذلك الحين للاستهداف بغارات إسرائيلية ألحقت الدمار بالبنى التحتية والمباني السكنية، وتسبّبت بأضرار في شبكة إمدادات المياه.
تُحدَّد إمدادات المياه وتوزيعها في إسرائيل/فلسطين ضمن هذه المنظومة من الضوابط الإسرائيلية. وتُنفَّذ هذه الضوابط في الضفة الغربية من خلال لجنة المياه المشتركة التي يُزعَم أنها تعاونية، والتي أُنشئت بموجب اتفاقية أوسلو 2، أما في غزة فتنفّذها حكومة حماس. والإجراءات التي تتّخذها اللجنة المشتركة هي أقرب إلى الهيمنة أو الاستعمار منها إلى التعاون. فهي تحافظ، من نواحٍ عدّة، على نظام المياه الذي كان سائدًا قبل اتفاقيات أوسلو، والذي منح ضابط المياه الإسرائيلي سلطة قانونية مطلقة من خلال إصدار أوامر عسكرية غير قابلة للطعن، ما يجعل منه قيصرًا حقيقيًّا للمياه.
في ظل هذه القيود، يُعدّ الفلسطينيون الطرف المُشاطِئ الوحيد الذي لا يحصل على كوب مياه واحد من مجرى نهر الأردن. ولكن حين خُصِّص للضفة الغربية 215 مليون متر مكعب في السنة بموجب خطة جونستون للعام 1955 التي جرى التفاوض عليها بين إسرائيل والدول العربية المُشاطِئة برعاية أميركية، استخدمت إسرائيل الخطة لإضفاء الشرعية على تحويلها مياه نهر الأردن خارج الحوض من بحيرة طبريا إلى السهل الساحلي وجنوبًا إلى النقب. وحاليًا تسحب إسرائيل، وفقًا للتقارير، كمية من المياه من حوض نهر الأردن تفوق بمقدار 30 في المئة على الأقل الكمية التي يسحبها الأردن، وبمقدار الضعفَين الكمية التي تسحبها سورية، وتزيد بأكثر من سبعة أضعاف عن الكمية التي يسحبها الفلسطينيون. أما لبنان، وهو من الدول المُشاطِئة أيضًا، فلا يُحوَّل إلى أراضيه أي كمّية من المياه تقريبًا. وقد خلّف استغلال نهر الأردن دمارًا بيئيًّا. فقد جفّفت إسرائيل بحيرة الحولة في مطلع خمسينيات القرن العشرين لتوسيع الأراضي الصالحة للزراعة؛ وتحوّلَ نهر الأردن، في مجراه السفلي، إلى خندق مائي ملوّث. أما البحر الميت، الذي يقع ربعه الشمالي الغربي في الضفة الغربية ولكن يُمنع على الفلسطينيين الوصول إليه، فقد تراجع منسوبه بدلًا من أن يرتفع كما هو الحال في باقي البحار. إنه مشهد مروّع حقًّا هذا الذي تنتشر فيه آلاف البالوعات التي تشكّل خطرًا على البشر وسائر الأنواع. لقد دُمِّر بالكامل موقعٌ ذو قيمة تاريخية ودينية لسكّان المنطقة وما بعدها.
ويجري تخصيص مياه الطبقة الجوفية الجبلية بطريقة مُجحفة أيضًا. ففي العام 2014، استخرج الفلسطينيون أقل من 20 في المئة من تغذيتها السنوية بالمياه. وقد بلغ إجمالي إمدادات المياه في العام 2021 في كلٍّ من الضفة الغربية (باستثناء القدس) وغزة نحو 440 مليون متر مكعب. يُشار إلى أن أقل من ثلث إمدادات المياه في غزة مستدام، أما الباقي فهو سحبٌ زائد للمياه. وفي الضفة الغربية، يشتري الفلسطينيون 95 مليون متر مكعب من شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت"، ما يُعدّ شكلًا آخر من أشكال التبعية المائية.
تُقسَم الإمدادات بالتساوي تقريبًا بين الريّ والقطاع الفرعي البلدي والصناعي. ويبلغ متوسط نصيب الفرد من إمدادات المياه المخصّصة لهذا القطاع نحو 85 ليترًا في اليوم. يعاني النظام بشكل عام من مشاكل تتمثّل في عدم الكفاية، والفاقد المائي الكبير؛ وتقطُّع الإمدادات، والدليل على ذلك خزّانات المياه المنتشرة على أسطح المنازل في كل مكان؛ وعدم المساواة بين المناطق والأُسر. يُشار كذلك إلى أن المياه ملوّثة بشكل عام تقريبًا بالبكتيريا القولونية. وهي أيضًا غير صالحة للشرب في غزة بسبب ملوحتها المرتفعة؛ ويوفّر عددٌ قليل من محطات تحلية المياه إلى توفير مياه الشرب بواسطة صهاريج المياه.
الزراعة هي ثاني أكبر القطاعات استخدامًا للمياه. ثمّة حوالى 90 ألف هكتار من الأراضي الصالحة للزراعة أو القابلة للزراعة في الضفة الغربية، و11,500 هكتار في غزة. والزراعة البعلية هي النمط السائد، ولا سيما في تلال الضفة الغربية وفي شمال غزة، حيث يزيد معدّل هطول الأمطار عن 400 مليمتر في السنة. تُزرَع مجموعة متنوّعة وغنيّة من المحاصيل البُستانية (بما في ذلك الفواكه والجوزيات والخضروات والزهور) والمحاصيل الحقلية (مثل القمح والشعير)؛ وتنمو أشجار الزيتون في أكثر من نصف المساحة المزروعة، وهي العمود الفقري للقطاع ومصدر الصادرات الزراعية الأساسي. يُمارَس الريّ في نحو 3 في المئة فقط من الأراضي الصالحة للزراعة، مقسومة بالتساوي بين غزة والضفة الغربية، وتُزرَع فيها الخضروات بصورة أساسية.
إسرائيل: مركز ثقل مائي
في سياق المنافسة الصفرية على الموارد، تُعدّ الخسارة التي تعاني منها فلسطين مكسبًا لإسرائيل. غالبًا ما دافعت إسرائيل عن رفضها زيادة كميات المياه التي يسحبها الفلسطينيون زاعمةً بأنها هي أيضًا تعاني من شحّ المياه؛ ولكن رئيس شركة "ميكوروت" تباهى هذا العام بأن إسرائيل هي "مركز ثقل مائي". تحصل إسرائيل على كميات من المياه أكبر بكثير من تلك التي يحصل عليها الفلسطينيون، وذلك من خلال استخراجها المياه بشكلٍ مُجحف من نهر الأردن والطبقة الجوفية الجبلية، إضافةً إلى الأحواض الفرعية الأصغر،. وتمتلك إسرائيل أيضًا الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لتحلية المياه، وهي عملية تستهلك الكثير من الطاقة. يُشار أيضًا إلى أن اكتشاف احتياطيات الغاز الطبيعي مؤخرًا يجعل تحلية المياه خيارًا أكثر جاذبية. علاوةً على ذلك، تمكّنت إسرائيل من تنقية كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في الريّ. في المجموع، استهلكت إسرائيل 2240 مليون متر مكعب في العام 2016 موزّعة على الشكل التالي: 543 مليون متر مكعب من المياه المالحة المحلّاة، و360 مليون متر مكعب من معالجة مياه الصرف الصحي، و1337 مليون متر مكعب من المياه السطحية والجوفية. يبلغ معدّل الاستخدام المنزلي للمياه للفرد الواحد نحو 100 متر مكعب في السنة، أو 270 ليترًا للفرد في اليوم على مدى سنوات عدة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون. يُروَّج لفكرة أن إعادة تدوير مياه الصرف الصحي تندرج في إطار التدابير الآيلة إلى الحفاظ على المياه، ولكن ذلك يتجاهل حقيقة أن إعادة التدوير تحول دون استخدام تلك المياه في تغذية الطبقات الجوفية. إن الاستنتاج الذي لا مفرّ منه هو أن تحويل إسرائيل إلى مركز ثقل مائي يتحقق إلى حدٍّ كبير على حساب فلسطين والدول العربية الأخرى المُشاطِئة لحوض نهر الأردن.
تغيّر المناخ: تهديد مُحدِق بالزراعة والأمن الغذائي
تؤدّي الزراعة أدوارًا مهمة عدّة في حياة الفلسطينيين، إذ تسهم في تعزيز الأمن الغذائي، واستحداث الوظائف، وتشكّل حصنًا في وجه التهديد الدائم الذي تطرحه المستوطنات الإسرائيلية. ولكي نفهم تمامًا حجم التداعيات التي سيخلّفها تغيّر المناخ على الأمن الغذائي والاستقرار السياسي في إسرائيل/فلسطين، من المفيد التطرّق بشكل موجز إلى أهمية هذه الأدوار الأساسية.
إن أكثر من 70 في المئة من الحيازات الزراعية الفلسطينية صغيرة الحجم وتقلّ مساحتها عن الهكتار الواحد، أما تلك التي تزيد مساحتها عن 2 هكتار فتشكّل 13 في المئة فقط من مجموع الحيازات، لكنها تشكّل أكثر من 60 في المئة من إجمالي مساحة الأراضي. هذا ويملك الذكور أكثر من 90 في المئة من جميع الحيازات. ويوظّف القطاع الزراعي حوالى 5 في المئة من القوى العاملة، مع العلم بأن عددًا كبيرًا منهم يعمل بدوام جزئي. لكن حصة القطاع من الناتج المحلي الإجمالي تسلك مسارًا تنازليًا - بحيث بلغت 7.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2020، أي أدنى من المتوسط العالمي البالغ 11 في المئة – لأسباب خارجة إلى حدٍّ كبير عن سيطرة القطاع، من ضمنها تضخّم قطاع الخدمات، والقيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل، واقتلاع أكثر من 800 ألف شجرة زيتون، سواء على أيدي المستوطنين أنفسهم أو في إطار استراتيجية ترمي إلى توسيع المستوطنات الإسرائيلية.
تُخصَّص المنتجات المزروعة على هذه الأراضي للاستهلاك المنزلي، ولا سيما في الحيازات الصغيرة، وللتسويق. لقد شهد حجم الصادرات الزراعية تقلّبات عدّة، إذ بلغ 15 في المئة في العام 2019 من مجموع الصادرات الفلسطينية، بما يعادل تقريبًا نسبة الواردات الزراعية. يسجّل الاقتصاد الفلسطيني الصغير عجزًا مزمنًا كبيرًا وهيكليًا في الميزان التجاري. وفي العام 2022، بلغ الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني حوالى 18 مليار دولار؛ وتجاوز عجز الميزان التجاري 6 مليارات دولار. ويُعزى ذلك إلى اقتصادٍ أرخبيلي قليل الكفاءة ويفتقر إلى الروابط بين المناطق والقطاعات، ولذا يعجز عن تحقيق فوائد تُجنى من اقتصاد أكبر. يُضاف إلى ذلك أن القطاع الزراعي في حدّ ذاته هو نتاج منظومة من الضوابط والحواجز الإسرائيلية. تشكّل إسرائيل الوجهة الرئيسة لجميع صادرات السلع الأساسية وهي أيضًا مصدر الواردات – بنسبة 88 في المئة و55 في المئة على التوالي في العام 2022 - وبالتالي فهي المستفيد الأساسي من الأنشطة التجارية الفلسطينية، بما فيها تلك المرتبطة بالزراعة.
يرتبط انعدام الأمن الغذائي – أي عدم توافر المياه والغذاء بكميات كافية وبقيم غذائية متنوعة وبأسعار معقولة لجميع أفراد المجتمع - ارتباطًا وثيقًا بالمشاكل الزراعية والمشقّات الاقتصادية. وتشير الأدلة إلى أن 60 في المئة "من جياع العالم يعيشون في بلدان تشهد صراعات". وبين العامَين 2014 و2016، واجه حوالى 20 في المئة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة حالة انعدام الأمن الغذائي المعتدل، بينما عانى 10 في المئة من السكان ظروفًا أشدّ قسوة. وأكّدت تقييمات سابقة أن أكثر من 7 في المئة من الأطفال أُصيبوا بفشلٍ في النمو الطبيعي.
يُضاف إلى هذه الظروف كلّها تغيّر المناخ الذي لا يمكن التنبؤ بتأثيراته على وجه الدقة، فهي تتبدّل باستمرار على وقع طريقة إدارة الاقتصادات الكبيرة والمتقدّمة لانبعاثاتها، لكنها قد تكون مدمّرة للغاية. ومن شأن كيفية استجابة الكيانات السياسية المتضرّرة، وخاصةً إسرائيل في هذه الحالة، أن تحدّد ما ستكون عليه النتيجة للشعبَين. في هذا الإطار، تبرز مشكلة تتمثّل في مدى قدرة المجتمعات على التطلّع إلى المستقبل من دون الوقوع في فخّ التكهّنات الجامحة. حتمًا، لا يملك صنّاع السياسات الفلسطينيين الترف السياسي اللازم للتفكير بشأن نهاية القرن على غرار التنبؤات للعالم ككل. يحصل في العالم. فحتى منتصف القرن الحالي، وهو التاريخ الآخر المحدَّد للتوقعات المناخية في الكثير من الأحيان، يبدو بعيدًا إذا أخذ المرء في الحسبان التوسّع المطّرد للمستوطنات الإسرائيلية والانزلاق الحاصل نحو يمين الطيف السياسي الإسرائيلي.
تُعدّ الزراعة القطاع الأول الذي قد يتأثّر سلبًا بتداعيات تغيّر المناخ. فمن شأن التقاء ظروف جوية أشدّ قسوة – مثل تراجع معدّلات هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة، وحدوث موجات حر أطول وأكثر تواترًا، وفترات جفاف مطوّلة، وعواصف شديدة، ورياح قوية (رياح الخماسين) - أن يعيق زراعة محاصيل كالقمح والشعير، ويزيد الضغط على جذور النباتات، ويؤدّي إلى جفاف الزهور وتكاثر الحشرات، ويقلّل كمية المحاصيل ونوعيتها. هذا وتشكّل حرائق الغابات بالفعل تهديدًا أيضًا، ولا سيما في المناطق التي دأب فيها الصندوق القومي اليهودي على زراعة أشجار صنوبر أوروبية ظنًّا منه أنها ستزيد هطول الأمطار (وفي محاولة سيئة الصيت لحجب معالم القرى الفلسطينية المدمّرة). وفيما لا يمكن التكهّن بحجم الحرائق وشدّتها، من الممكن أن تطال ألسنة النيران أشجار الفاكهة ومحاصيل أخرى.
ستكون الزراعة البعلية، وهي الطريقة الرئيسة للزراعة في المنطقة، الأكثر تضرّرًا، ولا سيما أشجار الزيتون والجوزيات والعنب. علاوةً على ذلك، قد يرتفع مستوى المياه المالحة العالي أساسًا في غزة، وتنخفض غلّة المحاصيل أيضًا. وبالتالي، سيُضطر الكثير من الأُسر التي تعتمد كليًا أو جزئيًا على الزراعة إلى محاولة تحقيق توازن دقيق بين طرح منتجاتها في الأسواق واستخدامها لتأمين حاجاتها الخاصة، ما يكبّدها مشقّات اقتصادية و/أو يؤدّي إلى تراجع التنوّع الغذائي. ويمكن أن تقوّض التحديّات الاقتصادية أيضًا القدرة على شراء المدخلات الزراعية، ما يتسبّب بتقليص غلّة المحاصيل بصورة إضافية.
يستورد الفلسطينيون أساسًا كميات كبيرة من المواد الغذائية التي يستهلكونها؛ فالتقلّبات الزراعية، مقرونةً بالنمو السكاني، تقتضي توفير موارد إضافية لسدّ العجز الغذائي. ولن يكون ذلك ممكنًا من دون تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وهذا لم يحدث حتى الآن. لقد أظهرت معدّلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد تقلّبات بين صعود وهبوط حادَّين خلال العقود الثلاثة الماضية تقريبًا، وتجاوز معدّل الفقر 27 في المئة في العام 2021. وتعتمد معالجة العجز الكبير في الميزان التجاري وميزان المدفوعات في فلسطين على التحويلات المستقرة من الفلسطينيين في الخارج؛ وكذلك على مداخيل الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، وعلى المساعدات الدولية، وهذان المصدران يُعتبران غير مستقرَّين لأنهما يتأثّران بالديناميات السياسية. ويتوقف سدّ العجز الغذائي أيضًا على توافر الإمدادات الغذائية والأسعار في السوق الدولية، التي يمكن أن تتأثر بالظواهر المناخية القاسية أو بأزمات أخرى. على سبيل المثال، تَسبَّب الغزو الروسي لأوكرانيا بارتفاع أسعار القمح، وهو سلعة أساسية في المنطقة. في المحصّلة، يفاقم تغيّر المناخ حالة انعدام الأمن الغذائي، ولا سيما في أوساط الفئات السكانية الأكثر فقرًا في المناطق الحضرية ومخيمات اللاجئين.
التأثيرات السياسية المُحتملة لتغيّر المناخ في فلسطين
غالب الظن أن التأثيرات السياسية ستكون رهنًا بمدى حدّة التداعيات المناخية. ففي حال أدّى حدثٌ كارثي إلى نقص في المياه لفترة طويلة وظروف جوية قاسية، متسبّبًا بمشاكل في القطاع الزراعي ومشقّات اقتصادية من شأنها أن تؤدّي إلى مستويات أعلى من انعدام الأمن الغذائي، هل ستندلع مواجهة شاملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين؟ وهل سيفضي هذا الوضع إلى طردٍ جماعي للفلسطينيين؟ وهل سيعبر الفلسطينيون اليائسون الحدود نحو دول الجوار طلبًا للإغاثة؟
ما زالت الأبحاث حول العلاقة بين ندرة الموارد والعنف والهجرة غير حاسمة. فعلى الرغم من كل الحديث حول حروب المياه في الشرق الأوسط، حالت الأوضاع الجيو-استراتيجية المتعلقة بكل حوض نهري دون وقوع ذلك حتى الآن. لقد حدثت موجات نزوح كبيرة للاجئين من وإلى منطقة الشرق الأوسط وغيرها من المناطق في التاريخ الحديث، وكان ذلك بشكل أساسي نتيجة صراعات عرقية وحروب أهلية وغزوات أجنبية. ومنذ بداية القرن الحادي والعشرين، اندلعت مواجهات عنيفة كثيرة في إسرائيل/فلسطين، مثل الانتفاضة الثانية في العام 2000 أو عمليات القصف الإسرائيلي المتكرّرة على قطاع غزة، لكن لم يُفضِ ذلك إلى نزوح ضخم للسكان. لا شكّ من أن النزوح إلى الخارج حدث بصورة بطيئة، إلّا أنه لا يُقارن بنطاق عمليات التهجير في العامَين 1948 أو 1967. مع ذلك، ستبقى الاضطرابات السياسية والتحرّكات السكانية الواسعة احتمالًا واردًا.
وفي استطلاع لآراء باحثين متخصّصين في قضايا الشرق الأوسط أُجري في ربيع العام 2023، عبّر ثلث الأشخاص المُستطلَعة آراؤهم فقط عن اعتقادهم بإمكانية قيام دولة فلسطينية خلال السنوات العشر المقبلة. علاوةً على ذلك، وصف أكثر من ثُلثَي الباحثين النظام السياسي الراهن في إسرائيل/فلسطين بأنه "دولة واحدة شبيهة بنظام الأبرتهايد". ولا يختلف ذلك عن تصريحات صادرة عن منظمات حقوق إنسان بارزة، سارت على خطى منظمة "بتسيلم" الإسرائيلية. وتترسّخ هذه الحقيقة يومًا بعد يوم، كما أظهرت الحكومة اليمينية الحالية التي تضمّ أعضاء عنصريين ذوي توجّهات "تميل إلى الفاشية"، يبدون عازمين على ارتكاب التطهير العرقي بحقّ الفلسطينيين. لطالما دأبت الولايات المتحدة والقوى الأوروبية على حماية إسرائيل من أي إدانة أو عقوبات دولية. وخير دليلٍ على الدعم الضخم الذي تقدّمه واشنطن عسكريًا وسياسيًا استخدامها حق النقض أكثر من 50 مرة للدفاع عن إسرائيل في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
إن افتراض أن الوضع الراهن سيدوم سنواتٍ كثيرة ليس بالأمر غير المنطقي. وفي حال تجسّد مستقبل أكثر إشراقًا، سيتم تأطير هذا النقاش بصورة مختلفة. في غضون ذلك، تقتضي الحكمة اعتماد المبدأ الاحترازي المتمثّل في افتراض أن إسرائيل لن تحيد عن نهجها القائم على حرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه، بما في ذلك استغلال موارده المائية.
ثمة اعتبار مهم آخر يجب أخذه في الحسبان: إلى أين يمكن أن يتوجّه السكان الذين قد يغادرون بصورة جماعية؟ لن تقتصر الظروف المناخية الكارثية على إسرائيل/فلسطين فحسب، بل ستعاني الدول المجاورة من تبعاتها أيضًا. لن يفكّر الفلسطينيون تحت أي ظرفٍ كان في اللجوء إلى لبنان، لأن الأوضاع فيه أسوأ ممّا قد تكون عليه الحال في ظل كارثة مناخية؛ والفلسطينيون الذين يعيشون هناك أساسًا سيرحّبون بمغادرته لو أُتيحت لهم فرصة ذلك. وسورية أيضًا في وضع يُرثى له، ولا سيما أن عملية إعادة الإعمار بعد الحرب ستكون طويلة ومضنية متى وإذا حدثت. وفي الأردن، يُعدّ وضع الموارد المائية حرجًا أيضًا، وفي حال حدوث أزمة مناخية حادّة، قد تكون ظروفه أسوأ من الضفة الغربية. أما مصر، على الرغم من أن أحوال المياه فيها أفضل بكثير، فيخيّم عليها اللايقين، إذ إن عملية بناء سدّ النهضة الإثيوبي العظيم تهدّد إمداداتها المائية، ناهيك عن أن مساحات شاسعة من دلتا النيل، وهي أكثر المناطق الزراعية خصوبةً في البلاد، قد تغمرها مياه البحر في وقتٍ قريب.
لم يكن ممكنًا لغاية اليوم تصوّر سيناريو معاكس: هل من الممكن أن يحاول عددٌ كبير من سكان الدول العربية المجاورة، ولا سيما الأردن، العبور إلى داخل إسرائيل/فلسطين؟ كيف سيكون ردّ إسرائيل، الدولة التي تستقبل اليهود فقط بشكل أساسي؟ على أي حالٍ، إذا واجه الفلسطينيون ظروفًا لا تُحتمَل، وحاولوا اللجوء بأعداد كبيرة إلى دول أخرى، فلا يجب أن يُعزى سبب نزوحهم إلى ظاهرة تغيّر المناخ (على الرغم من أنها الذريعة التي ستستعملها إسرائيل على الأرجح)، بل إلى الواقع المرير الذي يعيشونه أساسًا.
خاتمة
سوف تؤثّر الحسابات السياسية والاجتماعية في نهاية المطاف على التبعات الناجمة عن تغيّر المناخ، كما هو الحال في الكوارث الطبيعية الأخرى. وغالبًا ما تتكبّد الفئات الفقيرة والمهمّشة العبء الأكبر، بدل أن يتحمّله أولئك الذين يتسبّبون بالأزمة. ويندرج الفلسطينيون ضمن هذه الفئات المهمّشة، فقد حرمتهم إسرائيل من أرضهم، ومياههم، وحرية تنقّلهم، من جملة أمور أخرى، في ظلّ سعيها إلى فرض سيادتها بحكم الأمر الواقع على البقعة الجغرافية الواقعة بين نهر الأردن والبحر المتوسط.
ولكي يتسنّى للفلسطينيين التحضير لمواجهة تداعيات تغيّر المناخ والتكيّف معها، على إسرائيل رفع قيودها على استخداماتهم المائية، ليس من قبيل الإحسان، بل لأن الاتفاقيات الدولية تنصّ على أن للفلسطينيين الحق في الحصول على مصادر المياه. لكن الموارد المائية لن تكون وحدها كفيلة بتمكين الفلسطينيين من بناء مجتمع قادر على الصمود والتكيّف في وجه تغيّر المناخ، بل هم بحاجة أيضًا إلى اقتصاد قابل للاستمرار والنمو، وإلى التنقّل بحرية، وإلى حدود مفتوحة، وغير ذلك من الشروط اللازمة للعيش. ومن أجل تحقيق ذلك، يجب على إسرائيل إما أن تُنهي احتلالها أو أن تضع حدًّا لنهجها القائم على الفصل العنصري، وأن تتعلّم التعايش مع الفلسطينيين على قدم المساواة في جميع أنحاء البلاد.
من المؤسف للجانبَين الفلسطيني والإسرائيلي أن البلاد تسير على ما يبدو في الاتجاه الآخر. من أجل دفع إسرائيل إلى تغيير مسارها، على الفلسطينيين إعادة ترتيب بيتهم الداخلي، وعلى الولايات المتحدة وقف دعمها المطلق لإسرائيل، على أمل ألا تقع كارثة مناخية إقليمية تُرغم الجميع على السير في الاتجاه الصحيح.
الخزان الجوفي الساحلي في قطاع غزة في ظل الاحتلال وتغيّر المناخ
مقدّمة
أفضت حرب العام 1948 بين المستوطنين الإسرائيليين والجيوش العربية إلى احتلال المستوطنين أجزاء من فلسطين وإنشاء دولة إسرائيل. بحلول ذلك الوقت، تمّ تهجير ما يزيد عن 175 ألف فلسطيني من أكثر من 200 قرية في جنوب فلسطين التاريخية، الذي هو حاليًّا جزء من إسرائيل، إلى قطاع غزة. يُطلق الفلسطينيون تسمية النكبة على هذا الاحتلال والتهجير وإرغام مئات آلاف الفلسطينيين على مغادرة أراضي أجدادهم.
قبل النزاع، كان سكان المنطقة المعروفة بغزة يستفيدون من مياه جوفية عالية الجودة توفّر لهم القوت وسُبل العيش، وكانت الموارد المائية المتاحة تؤمّن حياة جيّدة لسكّانها. حتى أربعينيات القرن العشرين، قبل أقل من عقد على انتهاء الانتداب البريطاني في فلسطين، ضمّت غزة مساحة من الأراضي أكبر بثلاثة أضعاف تقريبًا من مساحة الجيب الحالي. ولكن عدد السكان بلغ 151 ألف نسمة فقط، أي كانت الكثافة السكانية 137 شخصًا فقط في الكيلومتر المربع الواحد. وكان سكّان غزة يستخدمون 27 مليون متر مكعب من المياه الجوفية في السنة.
حتى قبل أن تتسبّب الحملة العسكرية التي تشنّها إسرائيل حاليًّا على القطاع بتهجير 85 في المئة من السكان، كان 2.2 مليون شخص يعيشون في مساحة 365 كيلومترًا مربعًا فقط، أي كان ثمة أكثر من 5600 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، وتركّزت أعداد كبيرة من السكان بصورة خاصة في مخيمات اللاجئين، لذا شكّلت غزة واحدة من أعلى المناطق من حيث الكثافة السكانية في العالم. والآن تم تهجير ما يزيد عن 1.7 مليون نسمة إلى جنوب القطاع، ما أحدث اكتظاظًا شديدًا في مناطق الإيواء وتفاقُم مخاطر تفشّي الأمراض السارية. وحتى قبل اندلاع حرب 7 تشرين الأول/أكتوبر، بلغت نسبة البطالة في غزة 46.9 في المئة في العام 2021، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. وتُشكّل القيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حركة الأشخاص والبضائع من قطاع غزة وإليه عوامل أساسية في الوضع الاقتصادي المتردّي للقطاع.
لحقت أضرار جسيمة بالبيئة في فلسطين بسبب النزاع المسلّح واحتلال الأراضي. ويتجلّى ذلك بصورة خاصة في تدهور المياه الجوفية التي يعوّل عليها سكان غزة. فالاستخدام غير العادل لطبقة المياه الجوفية الساحلية، والقيود المفروضة على إدارة الموارد الفلسطينية وتنميتها، والحصار الإسرائيلي الخانق على غزة منذ العام 2007، كلّها عوامل أثّرت سلبًا في حصول المنطقة على المياه الجوفية واستخدامها. في غضون ذلك، تتزايد أعداد الفلسطينيين بوتيرة سريعة. ونظرًا إلى الصراع السياسي القائم منذ وقت طويل بين إسرائيل والفلسطينيين، يتعذّر وضع استراتيجية فلسطينية إسرائيلية طويلة الأجل للتعامل مع هذه التحدّيات البيئية. ولكن في انتظار التوصّل إلى مثل هذه الترتيبات، سيواجه سكان غزة الذين تتزايد أعدادهم سريعًا، مخاطر متعاظمة تهدّد سُبل عيشهم.
تدهور الموارد المائية في غزة
المصدر الرئيس للمياه في غزة هو الخزان الجوفي الساحلي الذي يمتدّ من جبل الكرمل في شمال إسرائيل إلى شبه جزيرة سيناء في مصر. يُفترَض أن يُدار الخزان، بوصفه موردًا مائيًا مشتركًا، بموجب القانون الدولي للمياه الذي يشدّد على "الانتفاع المنصف والمعقول" ويعطي الأولوية "للاحتياجات البشرية الحيوية". ولكن المياه الجوفية تحتاج إلى الأمطار لتغذيتها من جديد. وفي الفترة الممتدّة من 2015 إلى 2020، انخفض متوسط منسوب هطول الأمطار السنوي في غزة بنسبة تراوحت بين 20 و30 في المئة؛ وكذلك تراجع متوسط حجم إعادة تغذية الخزان الجوفي بالمياه بما نسبته 10 إلى 20 في المئة. والأسوأ من ذلك، تسبّبت زيادة الطلب والاستخراج الجائر للمياه الجوفية بمقدار 200 مليون متر مكعب في السنة وفقًا للتقديرات، بزيادة ملوحة طبقة المياه الجوفية الساحلية، ما يشكّل كارثة بيئية لسكان غزة الذين يعتمدون عليها لأغراض الاستخدام المنزلي والزراعي.
على الرغم من امتلاك إسرائيل موارد مائية طبيعية أخرى، فهي تَعمَد باستمرار إلى سحب مقدار كبير جدًّا من كمية المياه الجوفية المستدامة سنويًّا من الخزان الجوفي الساحلي، بحيث تتخطى على نحوٍ شبه مؤكّد حصّتها العادلة بموجب القانون الدولي للمياه. تملك إسرائيل أكثر من 1500 بئر في حوض الخزان الجوفي الساحلي، وقد تراوحت كمية المياه المستخرَجة في السنة من 400 إلى 480 مليون متر مكعب، أو 66 في المئة من إجمالي الكميات المستخرجة في العام 2013. واستُخدمت نسبة 45 في المئة تقريبًا من هذه المياه (200 مليون متر مكعب) في الزراعة. واستُهلكت نسبة 55 في المئة منها (243 مليون متر مكعب) لأغراض الاستخدام المنزلي أو الصناعي. وبعد حفر خمس وثلاثين بئرًا جديدة شمال شرق غزة، قرب أشدود وسديروت، بدأت إسرائيل بسحب 40 مليون متر مكعب إضافية في السنة في العام 2009، فزادت مستوى استخراجها للمياه بنسبة تناهز 10 في المئة.
تسبّبت عمليات الاستخراج من جانب المستهلكين الإسرائيليين بعائد آمن، كما يُسمّى، يقل عن 55 مليون متر مكعب في السنة (في غزة) – معادل لمتوسط معدّل تجديد المياه الجوفية أو أقل منه – من جزء الخزان الجوفي الساحلي الذي يمتدّ تحت غزة. وبما أنه المصدر الوحيد للمياه الجوفية، يُضطَرّ قطاع غزة المكتظ سكانيًّا إلى ضخ كمّية فائضة من المياه الجوفية سنويًّا بما يتجاوز العائد الآمن. يعوّل مواطنو غزة على 300 بئر بلدية فقط، موزَّعة على خمس وعشرين بلدية، للحصول على المياه للاستخدام المنزلي. في العام 2021، حصلت غزة على أكثر من 113.3 مليون متر مكعب من المياه للاستخدام المنزلي.
وفقًا لمنشورات سلطة المياه الفلسطينية، يمثّل تدهور جودة المياه في الخزان الجوفي الساحلي خطرًا يُضاف إلى تناقص منسوب المياه فيه. فتسرّب مياه البحر والمياه الجوفية الشديدة الملوحة، فضلًا عن التلوّث من مياه الصرف الصحي والأسمدة، يشكّل تهديدًا مُحدقًا بإمدادات غزة من المياه الصالحة للشرب من الخزان الجوفي. ومن شأن نفاد مياه الشرب أن يتسبّب بكارثة إنسانية كبرى، ما يؤدّي إلى استفحال الأوضاع المتردّية أصلًا في غزة. وفي محاولة لمعالجة المشكلة التي تلوح في الأفق، يعوّل معظم سكان غزة على بائعي المياه المحلاّة من القطاع الخاص للحصول على مياه الشرب. ولكن ممارسات المناولة والتخزين غير السليمة تنطوي على خطر التلوّث البيولوجي القاتل. ويتقاضى الباعة في القطاع الخاص أسعارًا باهظة عن المياه المستخدمة في الشرب والطهو، بحيث يصل سعر المتر المكعب إلى 50 شيكلًا إسرائيليًّا جديدًا (نحو 14 دولارًا للمتر المكعب).
توضح الرسوم البيانية أدناه مدى تأثّر جودة المياه في الجزء الغزّاوي من الخزان الجوفي الساحلي:
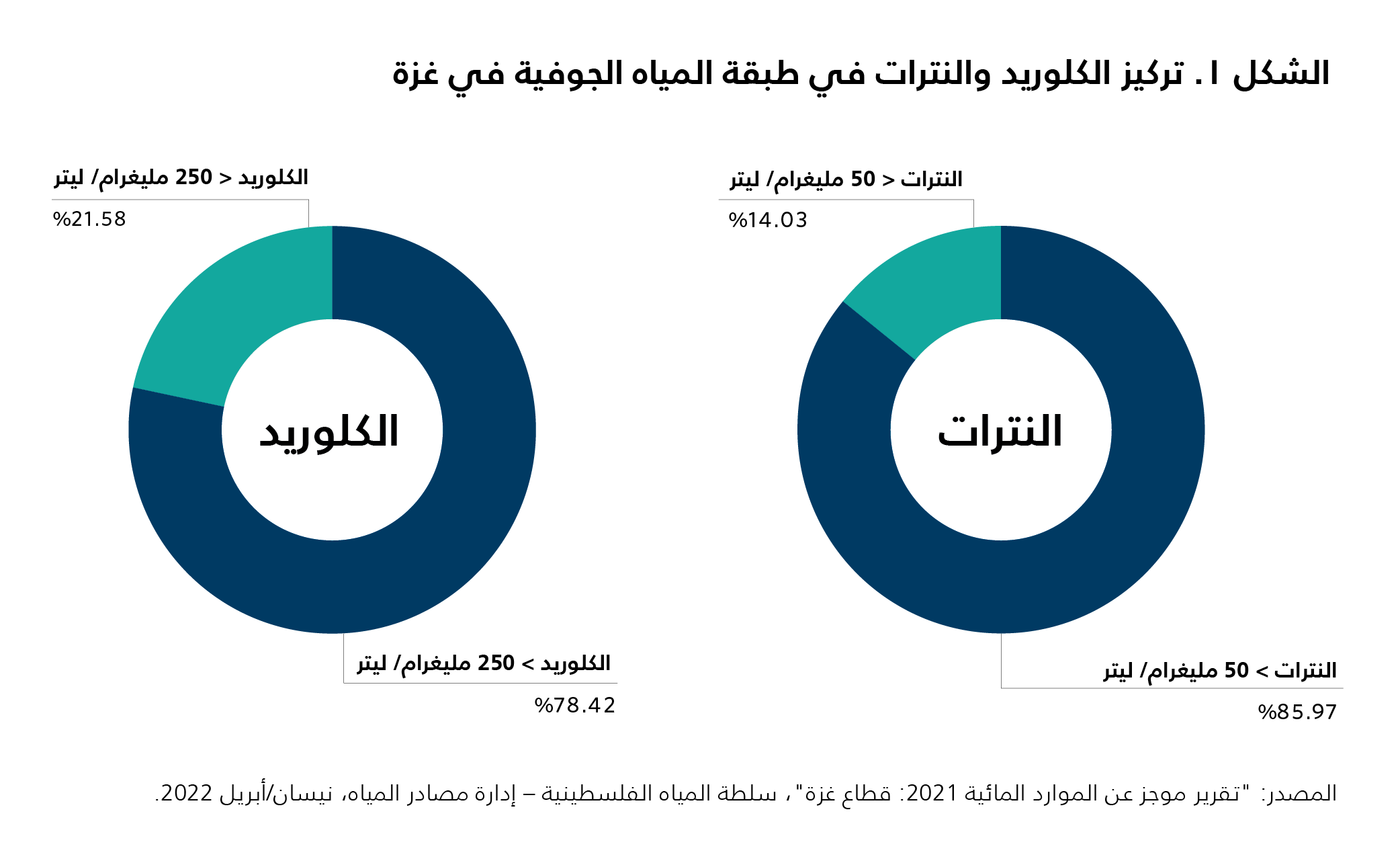
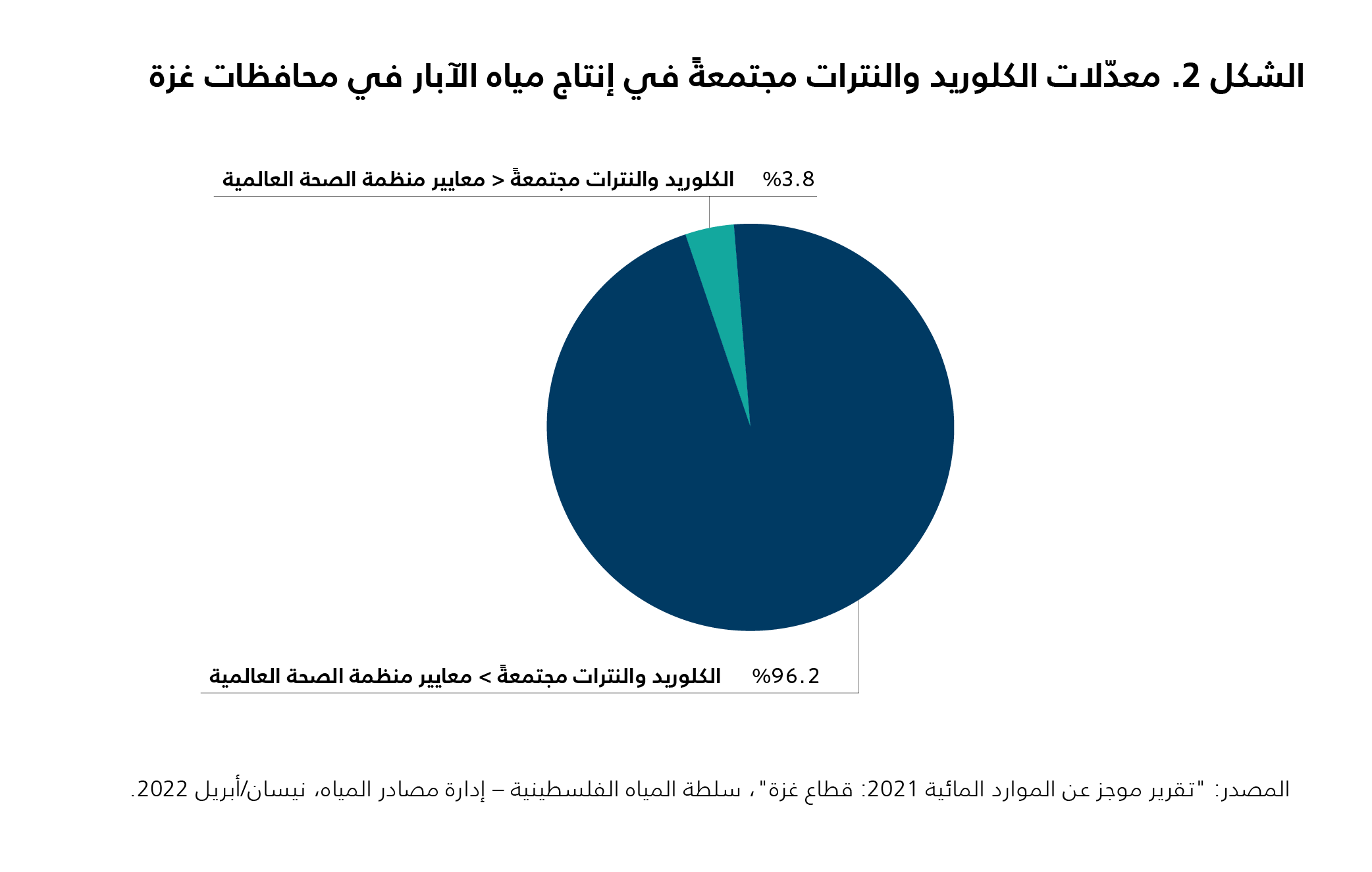
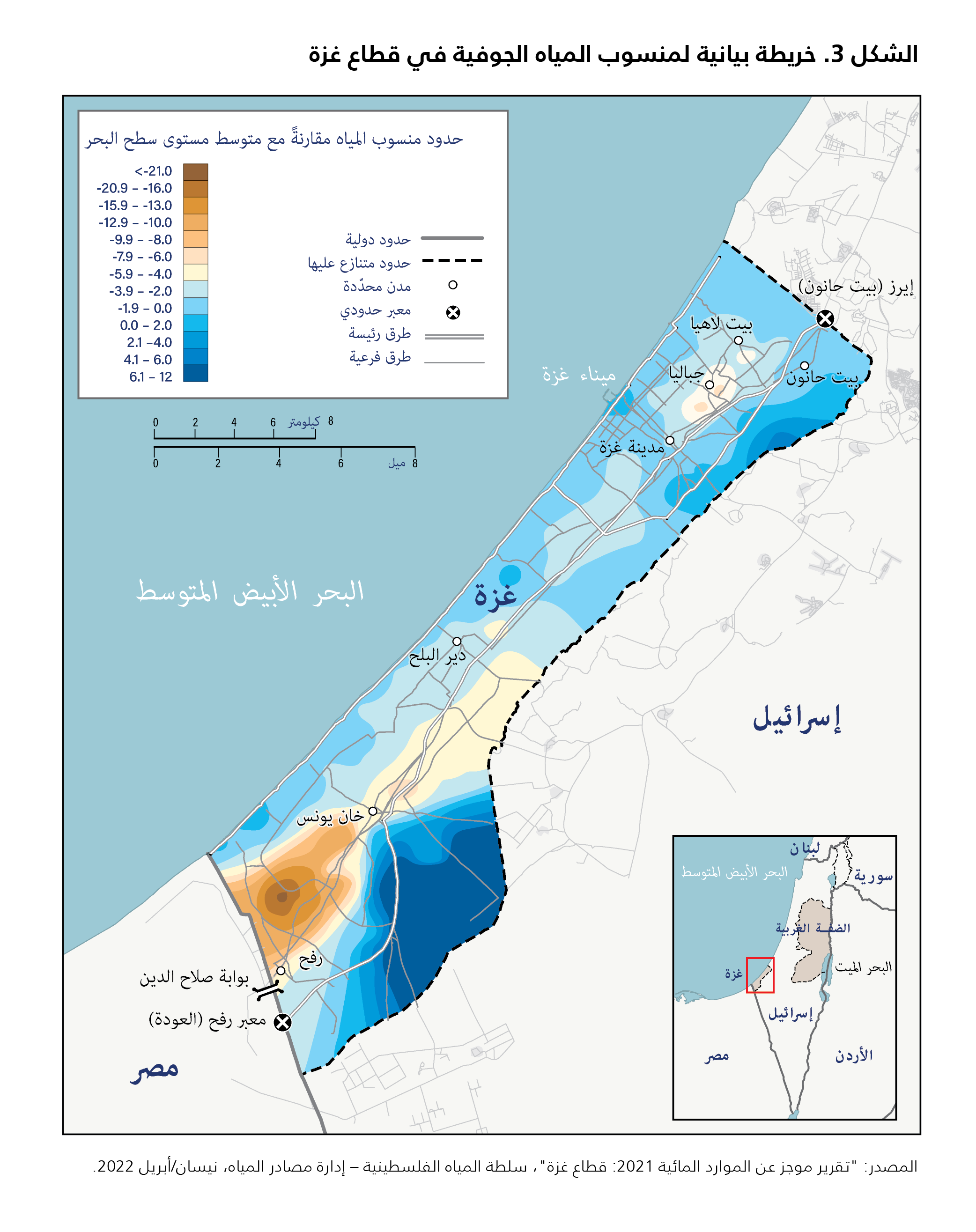
تركيز الكلوريد مرتفع بوجهٍ خاص في ثلاث مناطق واسعة تتأثّر بتسرّب مياه البحر، وهي: المناطق الواقعة غرب مدينة غزة؛ وجنوب غرب رفح؛ وغرب دير البلح. ويمثّل تركيز النترات مشكلة كبيرة أخرى (انظر الشكل 1). فالجزء الأكبر من مياه الآبار في غزة يحتوي على كميات من النترات تتخطى بدرجة كبيرة الحدّ المسموح به من النترات في الليتر الواحد بحسب معايير منظمة الصحة العالمية، ولا سيما في الآبار الواقعة تحت المناطق السكنية والمتضرّرة من تسرّب المياه العادمة من شبكة الصرف الصحي.
نظرًا إلى معدّلات الكلوريد والنترات مجتمعةً، خلص المؤلّفان إلى أن أحد عشر بئرًا فقط تؤمّن ما مجموعه 3.63 ملايين متر مكعب من المياه في السنة، تستوفي المعايير التي وضعتها منظمة الصحة العالمية. وهذا يمثّل 3.8 في المئة فقط من إجمالي كمية المياه التي توفّرها الآبار في قطاع غزة. أما النسبة المتبقّية من مياه الآبار، أي 96.2 في المئة، فهي ملوَّثة جدًّا بحيث لا يمكن اعتبارها مياهًا مأمونة (انظر الشكل 2).
يتسبّب الاستخراج الجائر بتراجع مستمر في منسوب المياه الجوفية (انظر الشكل 3)، الذي يتراوح من 21 مترًا فوق مستوى سطح البحر في الجزء الجنوبي الشرقي من قطاع غزة إلى نحو 21.5 مترًا تحت مستوى سطح البحر في الجزء الجنوبي الغربي من القطاع (منطقة رفح). وقد أسفر هذا التراجع عن تدهور جودة المياه الذي تطرّقنا إليه آنفًا.
تواجه غزة شحًّا خطيرًا في المياه وأزمة على صعيد جودتها. فالنمو السكاني السريع يؤدّي إلى زيادة الطلب على المياه، ولكن الموارد المائية الطبيعية المحدودة التي تنبع من إسرائيل تتعرّض للضغوط. ونظرًا إلى محدودية الموارد البديلة للمياه، يُضطرّ قطاع غزة سنويًّا إلى ضخ كميات من المياه الجوفية أكبر من الكميات التي تُعتبَر مستدامة.
التهديد المزدوج لتغيّر المناخ والسياسات الإسرائيلية
سيواصل تغيّر المناخ إحداث تداعيات خطيرة على حياة سكان غزة، بما يهدّد أمنهم الغذائي والمائي ويحول دون تلبية حاجاتهم من الطاقة والصحة والبيئة. يرى البنك الدولي أن قطاع غزة والضفة الغربية معرَّضان لمخاطر طبيعية تُصنَّف عالية، مثل الجفاف والارتفاع الشديد في الحرارة. وتوقّعت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيّر المناخ ارتفاع متوسط درجة الحرارة السنوية في المنطقة بحلول العام 2100 في جميع الفصول أكثر حتى من المتوسط العالمي، الذي يُقدّر أن يتراوح بين 2.2 و5.1 درجات مئوية. ويُتوقّع أن تصبح موجات الجفاف أيضًا أكثر تواترًا وأشدّ حدّة. فمنذ مطلع القرن الحالي، بلغت معدّلات هطول الأمطار مستويات أدنى من المتوسط التاريخي، ويُرجَّح أن يستمر هذا المنحى حتى العام 2050 على الأقل.
لا شكّ من أن تراجع هطول الأمطار وارتفاع معدّلات التبخّر نتيجة درجات الحرارة الشديدة سيؤثّران سلبًا على تجديد طبقة المياه الجوفية الساحلية، ويؤدّيان بالتالي إلى نقص متزايد في الموارد المائية. وسيكون لذلك تأثير مباشر على القطاع الزراعي: فتنامي موجات الجفاف وتفاقم ظاهرة التصحّر سيفرضان ارتفاع الطلب على المياه المستخدمة لريّ المحاصيل وزيادة أسعار المواد الغذائية، فضلًا عن تدهور إضافي في وضع التربة. وفي نهاية المطاف، سيزداد الطلب على موارد الطاقة حكمًا، وبالتالي سترتفع تكاليفها، لمحاولة التكيّف مع درجات الحرارة الشديدة ونقص المياه. وسيُفضي هذا الواقع إلى إجهاد أنظمة الصحة العامة، لأن ندرة المياه قد تتسبّب بتفشّي أمراض مثل الإسهال والكوليرا وجفاف الجسم.
علاوةً على ذلك، ستؤدي التقلّبات المتزايدة في هطول الأمطار، وهي من تأثيرات تغيّر المناخ، إلى ارتفاع عدد الفيضانات المفاجئة وشدّتها. وقد سبق أن اختبرت غزة تبعات الفيضانات المدمّرة. ففي كانون الثاني/يناير 2014، أعلنت الأمم المتحدة حالة الطوارئ في القطاع بعد يومَين من الأمطار الغزيرة التي تسبّبت بفيضانات شديدة، وبإجلاء آلاف السكان وإقفال عشرات المدارس في مدينة غزة. كذلك أدّى هطول الأمطار بشكلٍ كثيف في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر من العام نفسه إلى حدوث فيضانات في مناطق مختلفة من القطاع، ما أرغم السكان على إخلاء مساكنهم. لكن القيود التي تفرضها إسرائيل منعت سكان غزة من تطوير بنية تحتية للمياه والصرف الصحي قادرة على الصمود والتكيّف، وتطبيق ممارسات فعّالة لإدارة العمليات، تاركةً القطاع غير مهيّأ للظواهر الجوية المتطرّفة.
إضافةً إلى التهديد الذي يطرحه تغيّر المناخ، شهدت غزة سلسلةً من الحروب المتتالية خلال الأعوام 2008-2009، و2012 و2014 و2021 و2023. وقد ألحق القصف الممنهج أضرارًا بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي في القطاع، وشلّ القدرة على توفير الخدمات. وأرغمت الحروب الكثيرة أيضًا سكان غزة على منح الأولوية لأعمال الصيانة الطارئة وتعزيز القدرة على الصمود والتكيّف، بدلًا من تطوير البنية التحتية في القطاع.

تدفّق مياه المجاري غير المُعالجة من مضخة إحدى محطات الصرف الصحي إلى البحر الأبيض المتوسط بسبب النقص في إمدادات الطاقة الكهربائية، آذار/مارس 2023. تصوير ربحي الشيخ
بات من المستحيل عمليًا تشغيل الكثير من مرافق المياه والصرف الصحي الرئيسة، ولا سيما محطات معالجة المياه العادمة، بسبب موقعها القريب من الحدود مع إسرائيل. على سبيل المثال، تخدم المحطة الحديثة لمعالجة المياه العادمة في شمال غزة أكثر من 400 ألف شخص في القطاع، وفقًا للمؤلّفَين. لكن لا يمكن الوصول إلى المحطة على الإطلاق في فترات الحرب. وعلى الرغم من أن المرفق يمكن تشغيله عن بعد، فإن الخط الأساسي الذي ينقل المياه العادمة من شمال غزة إلى مرفق المعالجة قد تضرّر خلال الصراع. وعند توقّف العمليات في المرفق، تم تحويل أكثر من 30 ألف متر مكعب من مياه المجاري غير المُعالجة يوميًا إلى البحيرات في منطقة بيت لاهيا، ما تسبّب بتلوّث المياه الجوفية وازدياد خطر الفيضانات.
منذ أن تسلّمت حماس حكم غزة في العام 2007، فرضت إسرائيل حصارًا على القطاع. وصنّف الإسرائيليون مواد ومعدات البناء اللازمة لتطوير البنية التحتية للمياه والصرف الصحي - بما فيها مضخات المياه، وأنابيب الصلب، ومعدّات الاتصالات السلكية واللاسلكية، وآلات مثل الجرافات – على أنها مواد مزدوجة الاستخدام، ومنعوا وصولها إلى غزة. وفي بعض الحالات، يستلزم الحصول على إذن لإدخال مثل هذه المعدات وقتًا طويلًا للغاية، وفي حالات أخرى، يتم حظرها بالكامل.
يتعيّن على السلطة الفلسطينية والمقاولين من سكان غزة، بموجب عملية معقّدة للغاية للحصول على الموافقة، تحديد كمية المواد أو المعدات والغرض من استخدامها ومكان تركيبها، وتقديم تفاصيل عن الشركات المُتعاقَد معها، وإرسال هذه المعلومات إلى دوائر مختلفة في إسرائيل. وفي بعض الحالات، طلبت السلطات الإسرائيلية حتى من الوكالات المعنية تعديل المواصفات في مشاريعها المتعاقد عليها بشكلٍ تعارض على نحو كامل مع المتطلبات التقنية والمعايير الدولية المُطبَّقة حول العالم وفي إسرائيل نفسها.
إن الجهات المانحة والوكالات التي تدعم هذه الأنشطة في غزة شديدة الحرص على ضمان أن يمرّ دعمها المالي عبر قنوات السلطة الفلسطينية الرسمية، ما يتطلّب عمليات تقييم طويلة ومراقبة الغرض من استخدام هذه اللوازم. علاوةً على ذلك، يتعيّن على مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مراقبة استخدامات هذه المواد والمعدات.
تفادي وقوع كارثة إنسانية في غزة: الفرص والعقبات
تمثّل الطاقة المتجدّدة فرصة لمواجهة أزمات المياه والطاقة ولتلبية الحاجة الملحّة إلى تعزيز الأمن الغذائي في غزة. بإمكان القطاع الاستفادة من الطاقة الشمسية المتجدّدة على مدار السنة، إذ يبلغ متوسط ساعات سطوع الشمس 2861 ساعة في السنة، ويصل متوسط الإشعاع الشمسي إلى 5.46 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في اليوم. ويختلف هذا الرقم باختلاف المواسم، بحيث يبلغ 2.63 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في اليوم خلال كانون الأول/ديسمبر و8.4 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في اليوم خلال حزيران/يونيو. إذًا، باستطاعة قطاع غزة توليد كميات كبيرة من الطاقة من مصادر متجدّدة ونظيفة، ما يتيح له تشغيل البنى التحتية للمياه والصرف الصحي بصورة متواصلة أكثر وأقل عرضة للانقطاع.

محطة للطاقة الشمسية قيد الإنشاء، بطاقة إنتاجية قصوى تصل إلى 7.53 ميغاواط، كافية لتشغيل محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة والمشاريع المخصّصة لاسترداد هذه المياه وإعادة استخدامها في الريّ الزراعي، حزيران/يونيو 2023. يُشار إلى أن هذه المحطة تدمّرت جرّاء القصف الإسرائيلي خلال الحرب الراهنة على غزة. تصوير ربحي الشيخ
في غضون ذلك، تواجه غزة مشكلة أخرى تتمثّل في القيود المفروضة على استخدام سكان القطاع لأراضيهم. ففي شرق غزة، يُحظَّر تمامًا الدخول إلى منطقة واقعة ضمن مسافة 100 متر من السياج الفاصل مع إسرائيل. أما المنطقة الواقعة ضمن مسافة 200 متر أخرى، فالدخول إليها ممكن، إلّا أن الأنشطة التنموية ممنوعة راهنًا، من دون تغيير متوقّع. وعلى الرغم من أن هذه المساحة قد تبدو صغيرة، واقع الحال أنها كبيرة بالنسبة إلى غزة. وإذا تحسّنت الأوضاع السياسية وبدا التعاون معقولًا، يمكن استخدام هذه المنطقة الواقعة على مسافة تبلغ 300 متر من السياج على امتداد حدود قطاع غزة البالغ طوله 40 كيلومترًا، لتطوير الاقتصاد الأخضر في المنطقة، وبناء مرافق للطاقة النظيفة، وتعزيز إنتاج المياه والأنشطة الزراعية.
لمعالجة أزمة المياه في غزة، وضعت سلطة المياه الفلسطينية برنامجًا على مراحل يضمّ تسعة إجراءات هي: 1) إنشاء وحدة تنسيق برنامج غزة، 2) إطلاق مشروع متكامل لمراقبة المياه والصحة، 3) الارتقاء و/أو إعادة توزيع المياه للأغراض المنزلية وشبكة الإمدادات، 4) تحسين مستويات المياه الواردة من إسرائيل إلى غزة، 5) إدخال مشاريع لتحلية مياه البحر صغيرة الحجم والإنتاج وقصيرة المدى 6) البدء تدريجيًا بمشاريع تحلية مياه بحر كبيرة الحجم، 7) وضع و/أو توسيع نطاق خطط نموذجية لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المُعالَجة، 8) تسريع وتيرة الانتهاء من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الرئيسة، 9) وإتمام مراجعة مواصفات الجودة لاستخدام المياه في القطاع الزراعي في غزة.
لكن بعد مرور أكثر من عقدٍ من الزمن، لا يزال تطبيق الخطة متعثّرًا في الغالب. لقد تمّ إحراز بعض التقدّم في إطار برنامج غزة المركزي لتحلية المياه، من خلال إنشاء ناقلات مائية واسعة القطر وإعادة تشكيل نظام توزيع المياه. صحيحٌ أن بعض جوانب البرنامج طُبّق بالفعل، إلّا أن إجراءات عدّة مرتبطة بتوفير موارد مائية إضافية لم تُنفَّذ بعد.
على نحو أهم، لا يزال التقدّم المُحرَز في إطار تطوير مصادر مياه جديدة محدودًا، مع أن هذه النقطة تشكّل جزءًا أساسيًا من خطة سلطة المياه الفلسطينية. على سبيل المثال، أُنشِئت حديثًا ثلاث محطات صغيرة الحجم والإنتاج وقصيرة المدى لتحلية المياه، أنتجت كميات أقل من المتوقّع بسبب التحديات التشغيلية، بما في ذلك نقص توافر الطاقة الكهربائية، ومحدودية تحصيل الإيرادات، وعدم اتساق التمويل. وبحسب المؤلِّفَين، أُلغيت عملية شراء محطة كبيرة لتحلية مياه البحر بسبب سحب التمويل. وتُعدّ إعادة إحياء هذا المشروع ضرورية لتزويد غزة بالموارد المائية المخصَّصة للاستخدام المنزلي. وستكون مشاريع البنية التحتية الواسعة النطاق، مثل ناقلات المياه ومحطات الضخ العملاقة، من دون جدوى في ظل غياب مصدر مماثل للمياه.
كذلك، تصطدم الجهود المبذولة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي بصعوبات عدّة. لقد كشفت الأبحاث التي أجراها المؤلِّفان أن قطاع غزة كان قادرًا على بناء ثلاث محطات لمعالجة مياه المجاري، منها محطة معالجة المياه العادمة في شمال غزة، التي تعمل أساسًا بأكثر من طاقتها، بحيث تتلّقى أكثر من 7000 متر مكعب يوميًا فوق طاقتها الفعلية البالغة 35,600 متر مكعب يوميًا. هذا الفائض يؤثّر على البحيرات في شمال القطاع، ويلوّث المياه الجوفية، ويهدّد حياة السكان. في هذا الإطار، تعهّد الصندوق الأخضر للمناخ وبرنامج المعونة الإيرلندي (IrishAid) والوكالة الفرنسية للتنمية بتمويل مشروع لاستخدام حوالى 13 مليون متر مكعب في السنة من مياه الصرف الصحي المُعالَجة في الريّ. لكن التحديّات تتنامى، ومن ضمنها السياسات المُقيِّدة التي تفرضها إسرائيل على شراء المواد والمعدات. إذًا، من المستبعد أن ينطلق المشروع في وقت قريب.
خاتمة
في تاريخ كتابة هذه السطور، لا تزال الحرب الشاملة التي شنّتها إسرائيل على غزة مستمرة، وأسفرت عن عواقب مأساوية ألقت بظلالها على سكان القطاع وبنيته التحتية. ما زال من المبكر لأوانه تقييم حجم الأضرار والدمار، لكن 95 في المئة من سكان القطاع فقدوا إمكانية الحصول على المياه النظيفة، وتعرّضت مشاريع البنى التحتية المائية الكبرى للدمار.
وإلى حين التوصّل إلى تسوية سياسية تعترف بحق الفلسطينيين بأرضهم وحرية تنقّل الأشخاص والسلع، ستستمر الأزمات الإنسانية المتتالية التي تقاسيها غزة، وستظلّ الموارد المائية والصحية والمواد الغذائية محدودة فيها، وستواصل معدّلات الفقر مسارها التصاعدي، وستبقى مشاعر الإحباط واليأس تتملّك سكان القطاع، ولا سيما 70 في المئة من خرّيجي الجامعات الشباب الذين يضعون الهجرة إلى أوروبا نصب أعينهم، في ظل غياب فرص العمل والآفاق المستقبلية. تقع هذه المنطقة إذًا رهينة السياسات المُقيِّدة.
ستتطلّب عملية إعادة إعمار غزة استثمارات ضخمة. ولا بدّ من تعزيز إمكانية الحصول على موارد مائية ومصادر طاقة إضافية لأنها المحرّك الأساسي لاقتصاد القطاع. ويحتاج مشروع تحلية المياه واسترداد مياه الصرف الصحي المُعالجة وإعادة استخدامها في الريّ إلى التمويل، وكذلك إلى تسهيلات من الجانب الإسرائيلي. لكن حتى هذه المشاريع الطموحة لن تكون مُجدية إن لم تتوقف الحروب المتكرّرة على غزة. تُعدّ التنمية الاجتماعية والاقتصادية في القطاع أساسية. ومن شأن السماح بتنقّل الأشخاص والبضائع من غزة وإليها أن يساعد الاقتصاد على الازدهار. إضافةً إلى ذلك، يمكن أن يسهم تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة في تحسين قدرة السكان على تحمّل التكاليف، إذ سيمكّنهم ذلك من دفع فواتير المياه والكهرباء، ما سيساعد بدوره المنطقة على تحقيق قدرٍ أكبر من الأمن في مجالات المياه والطاقة والغذاء.
يبدو المشهد قاتمًا جدًّا عند الحديث عن مستقبل السكان الذين يُرغَمون مرارًا وتكرارًا على النزوح في غزة. وفي مؤتمر إعادة إعمار غزة الذي عُقد في القاهرة في العام 2014، قدّرت السلطة الفلسطينية الأموال الضرورية للإغاثة والتعافي المبكر وإعادة بناء قطاع المياه، والمياه العادمة، والصرف الصحي بنحو 236 مليون دولار، بحسب المؤلِّفَين. لكن بالنظر إلى الوراء، يمكن القول إن القصف الإسرائيلي الذي استهدف هذا القطاع الساحلي الفلسطيني المحاصَر في العام 2014 كان محصورًا بمناطق محدّدة. ونظرًا إلى نطاق وشراسة حرب الإبادة التي شنّتها إسرائيل في العام 2023 على أطفال ونساء ورجال غزة، ينبغي على المجتمع الدولي توقُّع أن تفوق تكاليف إعادة إعمار القطاع، وفقًا للتقديرات المتحفّظة، أرقام العام 2014 بأكثر من عشرين ضعفًا. وحتى لو تم تأمين الأموال وتنفيذ عملية إعادة الإعمار من دون عوائق، من المستحيل الاعتقاد بأن حجم الضرر البيئي يمكن معالجته. إن انتهاك حق سكان غزة في التمتّع ببيئة نظيفة يُضاف إلى القائمة الطويلة من انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خلال فصول هذا الصراع المديد. ولا يبدو أن القوى العظمى العالمية مستعدّة لفرض تحوّل سلمي من شأنه استعادة حقوق سكان غزة في الحصول المياه. وإلى حين تحقيق ذلك، تبقى آفاق الوضع الإنساني في غزة قاتمة للغاية.
مأسسة الهيمنة عن طريق مفاوضات السلام: المياه في الأراضي الفلسطينية المحتلّة
مقدّمة
غالبًا ما أُطِّر النزاع على الأراضي في فلسطين ضمن التصوّرات المتعلّقة بقضية المياه: بدءًا من الأيام الأولى للفكر الصهيوني، بما في ذلك كتابات المنظّر الإيديولوجي ثيودور هرتزل، ومرورًا برسالة رئيس المنظمة الصهيونية العالمية حاييم وايزمان إلى رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد لويد جورج حول كيفية اعتماد الاقتصاد الفلسطيني على إمدادات المياه؛ ووصولًا إلى مفهوم التنمية الوطنية الإقليمية للمياه في إطار مبدأ "المملختيوت" الذي وضعه رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق ديفيد بن غوريون، وإلى ادّعاءات رئيس الوزراء اللاحق شيمون بيريز بتحقيق إنجازات تقنية من خلال استغلال الموارد المائية. تتّسم مسألة الحصول على المياه بالأهمية في الخطاب الإسرائيلي باعتبارها "مقياسًا للقدرة الاستيعابية" المرتبطة بمقوّمات الاستمرارية على المدى الطويل. أما الفلسطينيون، فينظرون إلى الموارد المائية على أنها جزءٌ لا يتجزّأ من حقوقهم في المُلكية والأراضي.
يتشارك الطرفان طبقة المياه الجوفية الجبلية (حوض الجبل) الواقعة في الضفة الغربية، والتي تنقسم إلى ثلاثة أحواض فرعية هي الحوض الغربي، والحوض الشمالي الشرقي، والحوض الشرقي. وكانت إسرائيل احتلّت في حرب العام 1967 القدس الشرقية والضفة الغربية وغزة، التي تشكّل معًا الأراضي الفلسطينية المحتلّة، فلم توسّع بذلك هيمنتها على أراضي فلسطين التاريخية فحسب، بل سيطرت أيضًا على مناطق تغذية المياه الجوفية للحوضَين الغربي والشمالي الشرقي في الضفة الغربية. ويُعَدّ الحوض الغربي حوض المياه الأكثر إنتاجيةً في فلسطين وإسرائيل، وهو ينتج المياه الأعلى جودة. لكن التوقّعات الأخيرة الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية المعنيّة بتغيّر المناخ، وهي منظمة دولية تُقيّم التغيّر المناخي، تشير إلى أن منطقتَي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط معرّضتان بشدّة إلى استنزاف طبقات المياه الجوفية. هذه التوقّعات إنما تؤكّد على ضرورة أن تتولّى السلطات الحاكمة إدارة الموارد بكفاءة، لتَحول دون حصول تغيّرات لا رجعة فيها.
لا شكّ في أن ارتفاع درجات الحرارة وتناقص معدّل هطول الأمطار لهما دور في مدى تأثّر الموارد المائية بتغيّر المناخ، ولكن ضعف هذه الموارد وقدرتها على التكيّف هما أيضًا ظاهرتان تكشفان كيف تهدّد العوامل الهيكلية وأوجه اللامساواة الحياةَ البشريةَ من خلال عجز النُظم الطبيعية عن التكيّف مع التغيّرات المفاجئة. وفي الحالة موضع هذا النقاش، أسفرت التداعيات الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية منذ العام 1967 عن مزيدٍ من المصاعب، التي يمكن تقييمها من ناحية الاضطرابات في أنماط الحياة اليومية، مثل انعدام الأمن المائي المزمن، وتدهور الأراضي، ونقص الكهرباء والمياه، وانعدام الأمن الغذائي، والنزوح القسري، وفقدان مصادر الدخل. أخيرًا، يربط الفلسطينيون التدهور الحالي في مواردهم المائية بافتقارهم إلى السيادة. فعلى حدّ تعبير سامر العطعوط، الذي يتناول مسألة المياه وبناء الدولة في فلسطين التاريخية، إن السيادة "شرطٌ مسبق أساسي لأيّ أمّة من أجل تحقيق التنمية المستدامة والإدارة البيئية السليمة".
في أعقاب حرب حزيران/يونيو 1967 مباشرةً، أعلنت الحكومة الإسرائيلية أن الموارد المائية في الضفة الغربية تشكّل مسألةً عسكريةً بموجب الأمر العسكري رقم 92 (حزيران/يونيو 1967)، والأمر العسكري رقم 158 (تشرين الثاني/نوفمبر 1967). نصّ هذان الأمران على نقل السلطة على جميع الموارد المائية في الضفة الغربية وإدارتها إلى الجيش الإسرائيلي، وعلى أن أيّ مشروع جديد يخطّط له الفلسطينيون في ما يتعلّق بموارد المياه الجوفية الخاصة بهم يتطلّب الاستحصال على تصريح مسبق من الجيش الإسرائيلي. بعد ذلك، أناط الأمر العسكري رقم 418 (آذار/مارس 1971) عملية اتخاذ القرارات بمجلس التخطيط الأعلى في إسرائيل، الذي وضع في ما بعد حدًّا على الاستهلاك الفلسطيني للموارد المائية في الضفة الغربية أقصاه 125 مليون متر مكعّب من مياه حوض الجبل. ومذّاك الحين، استخدمت إسرائيل مسألة حصول الفلسطينيين على مياه الحوض المشترك، ومعالجتهم المياه العادمة، كوسيلة وسلاح لفرض هيمنتها. نتيجةً لذلك، بات الفلسطينيون في الأراضي المحتلّة يرزحون تحت وطأة التهديد الثلاثي المتمثّل في فقدان المياه العذبة والآسنة على السواء، وتلوّث المياه الجوفية بالمياه العادمة، والضغوط المتزايدة الناجمة عن تغيّر المناخ. وهكذا، أدّى الاتفاق الانتقالي الذي مضى عليه ثلاثون عامًا إلى إضفاء الطابع المؤسّسي على الهيمنة الإسرائيلية، بدلًا من أن يمهّد الطريق إلى وصول الطرفَين إلى المياه على نحو متكافئ.
إضفاء الطابع المؤسّسي على الهيمنة على المياه عبر اتفاقية أوسلو الثانية
أتاح موقع إسرائيل المُهيمن في الضفة الغربية لها تحويل التركيز من "حقوق" الأطراف المُعلَنة في المياه إلى "حاجاتهم". وخير مثالٍ على ذلك الاتفاق الانتقالي الفلسطيني الإسرائيلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (المعروف باتفاقية أوسلو الثانية)، الذي جرى توقيعه في 28 أيلول/سبتمبر 1995، وهو الاتفاق الوحيد بشأن المياه الذي لا يزال ساريًا حتى اليوم. فكان يُفترَض أن تتطوّر اتفاقية أوسلو الثانية لتصبح بحلول العام 1999 ترتيبًا دائمًا من شأنه حلّ مسائل أساسية ولكن شائكة مرتبطة بالقدس، واللاجئين الفلسطينيين، والمستوطنات اليهودية، والتدابير الأمنية، والحدود. لكن هذا الترتيب لم يبصر النور، وبقي إجمالي المياه المُخصَّص للفلسطينيين على حاله عمومًا، حتى مع زيادة عدد السكان الفلسطينيين بنسبة 75 في المئة منذ العام 1995.
وتناولت اتفاقية أوسلو الثانية استخدامات المياه والصرف الصحّي في المادة 40 من المُرفق الأول من ملحقها الثالث، حيث يبدو التفاوت في تخصيص المياه صارخًا. فقد تَقَرّر أن تحصل إسرائيل على 483 مليون متر مكعّب سنويًا، ما شكّل الجزء الأكبر من التغذية السنوية لحوض الجبل، التي قدّرتها الوثيقة بـ679 مليون متر مكعّب في السنة. أما الفلسطينيون، فتَقَرّر أن يحصلوا على ما يقلّ قليلًا عن 200 مليون متر مكعّب في السنة، ما شكّل زيادة طفيفة فقط عن الكمية القصوى التي حدّدها الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 418 للعام 1971، والبالغة 125 مليون متر مكعّب سنويًا. وعلى الرغم من البنود الجديدة التي نصّت عليها اتفاقية أوسلو الثانية، لا تزال الأوامر العسكرية التي أصدرتها إسرائيل في العام 1967 بشأن مياه الضفة الغربية سارية المفعول.
يُضاف إلى ذلك أن المصطلحات المستخدمة في الاتفاقية إشكاليةٌ هي أيضًا. فالفقرة السادسة من المادة 40 نصّت على أن "الجانبَين اتفقا على أن الحاجات المستقبلية للفلسطينيين في الضفة الغربية تُقدَّر بما يتراوح بين 70 و80 مليون متر مكعّب في السنة". هذا وتناولت الفقرة السابعة كيفية "تلبية الحاجات الفورية للفلسطينيين من المياه العذبة للاستخدام المنزلي"، وأقرّت بـ"ضرورة إتاحة كمية إجمالية للفلسطينيين خلال الفترة المؤقّتة، قدرها 28.6 مليون متر مكعّب في السنة". كما يبدو واضحًا من خلال هذه اللغة، ما يهمّ هو حاجات الفلسطينيين وليس حقوقهم.
كذلك، ألزمت اتفاقية أوسلو الثانية الفلسطينيين بتقديم مخطّطات مشاريع المياه للجنة المياه المشتركة المُنشَأة حديثًا. وقد كُلّفَت هذه اللجنة، التي تتألّف من عددٍ متساوٍ من الأعضاء الإسرائيليين والفلسطينيين، وتتطلّب قراراتها توافقًا، بمهمّة الموافقة على مشاريع المياه والصرف الصحّي الجديدة للتجمّعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافةً إلى أعمال صيانة البنية التحتية القائمة. كذلك شُكّلَت لجانٌ أخرى، على غرار فرق الإشراف والتنفيذ المشتركة، ولجنة الخبراء البيئيين الفلسطينية الإسرائيلية المشتركة.
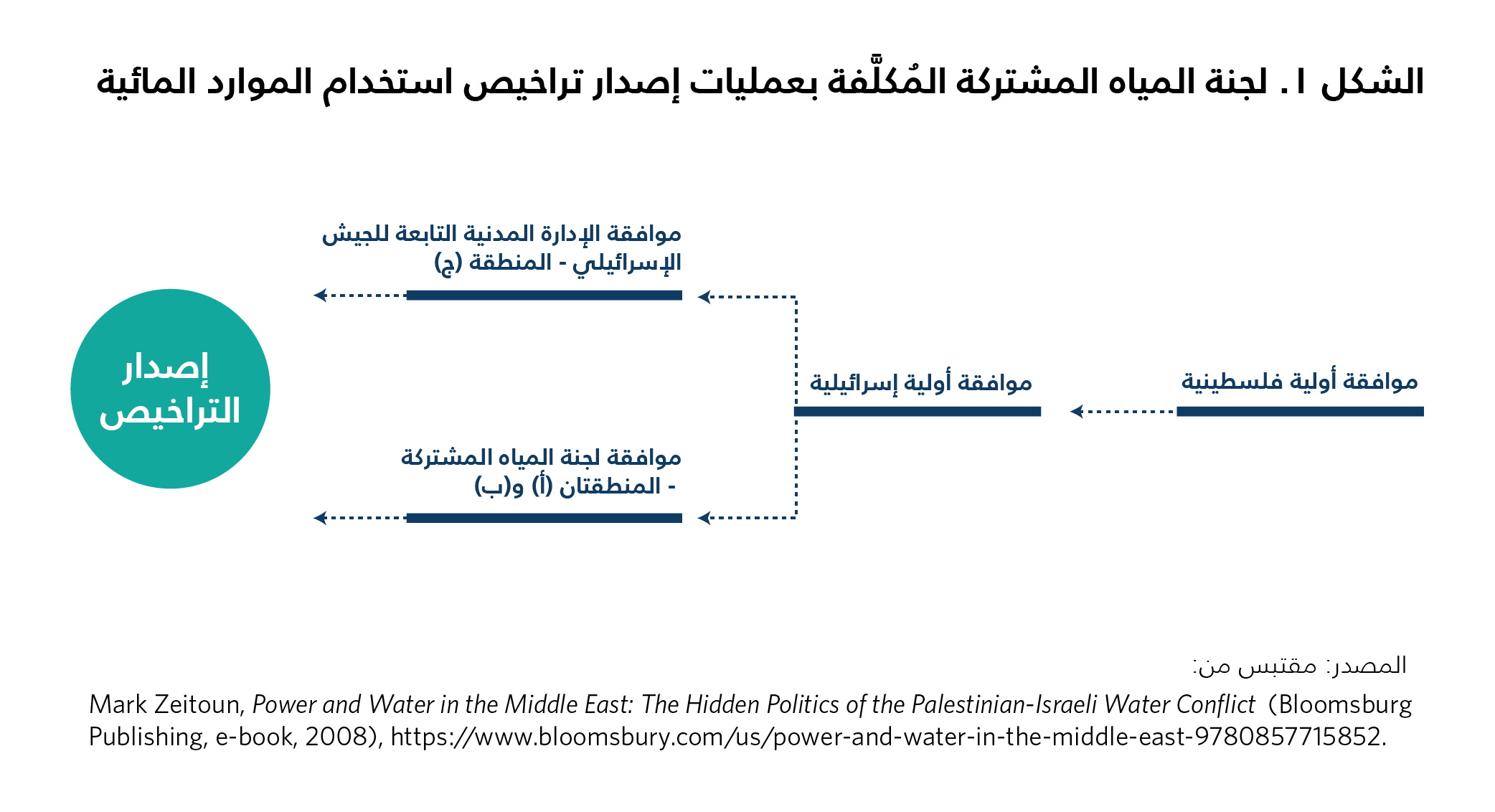
في أواخر تسعينيات القرن الماضي، أصبحت الاجتماعات بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين غير منتظمة، وتحوّلت اللجان المشتركة إلى منصّات لتبادل الاتهامات بارتكاب انتهاكات. وبينما أُشير رسميًا إلى عملية صنع القرار على أنها متساوية ومتبادلة، نظرًا إلى أن القرارات تتطلّب توافقًا، احتفظت إسرائيل باستخدام حقّ النقض ضدّ أيّ طلب يتقدّم به الفلسطينيون لإطلاق مشاريع جديدة، بما في ذلك في المنطقتَين (أ) و(ب) من الضفة الغربية. في المقابل، لم يكن لدى الفلسطينيين أيّ وسيلة للاعتراض على المشاريع الإسرائيلية أُحادية الجانب، مع أن السلطة الفلسطينية تتمتّع بدرجات مختلفة من الحكم الذاتي في هاتَين المنطقتَين. وقد منع حقّ النقض هذا الفلسطينيين من الحصول على موارد مائية إضافية، وبناء محطّات لمعالجة المياه العادمة في الضفة الغربية. أما أيّ مشروع مياه جديد يتقدّم به الفلسطينيون في المنطقة (ج)، فيستدعي بموجب اتفاقية أوسلو الثانية موافقة هيئةٍ إسرائيليةٍ بالكامل ضمن لجنة المياه المشتركة، وهي الإدارة المدنية الإسرائيلية التي تمثّل الفرع المدني للجيش الإسرائيلي وتُشرف عليها وزارة الدفاع. تضمّ الإدارة المدنية الإسرائيلية ثلاث عشرة لجنة فرعية، تتألّف بدورها من ممثّلين عن المستوطنات اليهودية (أنظر الشكل 1 أعلاه)، التي تُعَدّ جميعها غير شرعية بموجب القانون الدولي. يُذكَر أن منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية "بتسيلم" تُقدِّر عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية بما يزيد عن 413 ألف مستوطن، إضافةً إلى حوالى 200 ألف مستوطن في القدس الشرقية.
لا بدّ من الإشارة إلى أن المنطقة (ج) تضمّ جميع المستوطنات اليهودية ما عدا تلك الواقعة في القدس الشرقية. وقد أُبقيَت هذه المنطقة، التي تمثّل 61 في المئة من الضفة الغربية، تحت سيطرة إسرائيل الإدارية والأمنية التامّة، وينطبق ذلك أيضًا على الوصول إلى الموارد المائية واستخدامها، علمًا أن جميع مشاريع المياه الكبرى تُقام فيها، وتتطلّب ربطها بالمنطقتَين (أ) و(ب) لتحقيق الكفاءة، كما يوضح الفصل الخاص بشريف الموسى. كذلك تخضع مشاريع المياه والصرف الصحّي في المنطقتَين (أ) و(ب) إلى نظام التصاريح الإسرائيلي عن طريق لجنة المياه المشتركة، على الرغم من أن اتفاقيات أوسلو نصّت على أن تتولّى السلطة الفلسطينية إدارة الشؤون المدنية والأمنية في المنطقة (أ)، والشؤون المدنية في المنطقة (ب).
يُظهر الجدول 1 الترتيبات المؤسّسية التي تَفاوض بشأنها الجانبان الفلسطيني والإسرائيلي منذ عملية أوسلو للسلام، كاشفًا عن أنماط الهيمنة ومصالح كلٍّ من الطرفَين.

هذه الإجراءات تعني أن الفلسطينيين لم يُعطوا إلا ثلث كمية المياه الإضافية التي وُعِدوا بها. ولذا، عمَدَت الاستراتيجية الفلسطينية إلى زيادة إمدادات المياه لتلبية حاجات السكان المتنامية، عن طريق تقديم طلبات للترخيص لآبار إضافية. لكن لم تتمّ الموافقة إلّا على 30 في المئة فقط من المشاريع المُقدَّمة إلى لجنة المياه المشتركة خلال العقد الذي أعقب اتفاقية أوسلو الثانية. والواقع أن غالبية هذه المشاريع الموافَق عليها (146 مشروعًا من أصل 154) كانت مشاريع لإعادة تأهيل آبار قائمة، فيما جرت الموافقة على أربعة مشاريع جديدة وأربعة بديلة فقط منذ العام 1996. وفي الفترة عينها، وبينما وافقت سلطة المياه الفلسطينية على جميع المشاريع الإسرائيلية لإنشاء مرافق جديدة لتوفير إمدادات المياه إلى مستوطنات الضفة الغربية، عارضت إسرائيل بصورة شبه منهجية الطلبات الفلسطينية لحفر آبار جديدة. وبالتوازي مع تقييد وصول الفلسطينيين إلى موارد المياه المشتركة، جعلت قوات الاحتلال الإسرائيلية السكان يعتمدون على شراء المياه بتكاليف متزايدة من شركة المياه الخاصة الرئيسة في إسرائيل، "ميكوروت"، لسدّ حاجاتهم اليومية. هذه الشركة مُنِحَت، بعد "شرائها" الإمدادات المائية والبنية التحتية للمياه في الضفة الغربية في العام 1982، ترخيصًا لتزويد المستوطنات اليهودية والفلسطينيين بالمياه، ما "أرغم الفلسطينيين فعليًّا على إعادة شراء المياه المسروقة"، كما وصفت منظمة "الحق" الفلسطينية الحقوقية هذا الترتيب.
في العام 2013، سيطرت إسرائيل على كامل حوض الجبل، واستخرجت 94 في المئة من مياهه، في حين أن الفلسطينيين لم يستخرجوا سوى 6 في المئة من مياهه ولا يسيطرون اليوم إلّا على حوالى 10 في المئة من الحوض. وبين العامَين 2010 و2017، بلغت إمدادات الفلسطينيين من مياه آبار حوض الجبل وينابيعه 92.4 مليون متر مكعّب في السنة، أي أقلّ من كمية المياه التي استخرجوها في العام 1995، والبالغة 118 مليون متر مكعّب في السنة، وأقلّ بكثير من الكمية التي كان يُفترَض بإسرائيل تزويدها للفلسطينيين في الضفة الغربية، بموجب اتفاقية أوسلو الثانية، أي 200 مليون متر مكعّب سنويًا. هذا ويشتري الفلسطينيون إمدادات إضافية من المياه من شركة "ميكوروت"، تبلغ حوالى 95 مليون متر مكعّب سنويًا.
تشير منظمة الصحة العالمية إلى أن الحدّ الأدنى من المياه التي يحتاج إليها كل فرد في اليوم هو 100 ليتر، في حين أن متوسّط استهلاك المستوطن الإسرائيلي يبلغ 250 ليترًا يوميًا، أي ثلاثة أضعاف ما يستهلكه الفلسطينيون في الضفة الغربية، الذين يحصلون على 82.4 ليترًا فقط. وفي بعض المجتمعات الريفية، يعيش الفلسطينيون على 20 ليترًا بالكاد في اليوم، وهو الحدّ الأدنى الضروري للاستخدام المنزلي في حالات الطوارئ. في العام 2009، وجدت بعثةٌ لتقصّي الحقائق تابعة لمنظمة العفو الدولية أن 180 ألف فلسطيني إلى 200 ألف ممَّن يعيشون في مجتمعات ريفية لا يحصلون على المياه الجارية. وفي العام 2023، أفادت منظمة "بتسيلم" أن ما يزيد عن 600 ألف مستوطن يهودي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يستهلكون أكثر من عشرة أضعاف كمية المياه التي يستهلكها الفلسطينيون البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة تقريبًا.
يُضاف إلى ذلك أن المستوطنات اليهودية تقع في مناطق استراتيجية من الناحية الهيدرولوجية. فتقع مستوطنة أرئيل مثلًا ضمن نطاق "الجدار الأمني"، الذي يشير إليه الفلسطينيون بـ"جدار الفصل العنصري" أو "جدار الأبرتهايد". شيّدت إسرائيل هذا الجدار في محاولةٍ واضحة منها لتضمن للمستوطنين الأراضي التي استحوذت عليها عن طريق الحرب، وتمكّنُهم من الوصول مباشرةً إلى طبقة المياه الجوفية الكامنة تحتها. وكانت محكمة العدل الدولية أصدرت رأيًا استشاريًا في هذا الشأن، ذكرت فيه أن بناء الجدار انتهاكٌ للقانون الدولي، وأشارت على وجه التحديد إلى التأثيرات اليومية الضارّة للجدار على الفلسطينيين الذين يعيشون في الأراضي المحتلّة، وعلى وصولهم إلى المياه.
وعلى الرغم من أن لجنة المياه المشتركة تسمح للفلسطينيين بالتنقيب في الحوض الشرقي المتفرّع من حوض الجبل، والذي يمتدّ عبر المناطق (أ) و(ب) و(ج)، من المستحيل عمليًا تنفيذ مشاريع حفر آبار هناك. فتراخيص إنشاء الآبار خُصِّصَت بصورة رئيسة للمناطق حيث المياه قليلة كمًّا ونوعًا، ناهيك عن أن هذه المشاريع يجب أن تخضع لإجراءاتِ موافقة شاقّة. فمن كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2021، مثلًا، لم تَحظَ بالموافقة إلا خمس خطط فقط من أصل مئة خطة مُقدَّمة للمنطقة (ج). فضلًا عن ذلك، جفّ نصف الآبار الفلسطينية في الضفة الغربية بسبب موجات الجفاف المتكرّرة في السنوات العشرين الأخيرة. ولهذا السبب، تشير التقديرات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن ما يقرب من 14 ألف فلسطيني في حوالى مئة تجمّع سكني في المنطقة (ج) ليس لديهم أيّ اتصال بشبكة مياه وأيّ بنية تحتية مائية، ويُعَدّون معرَّضين بشدّة لخطر شحّ المياه.
لقد فشلت إذًا الاتفاقيات الناشئة عن عملية أوسلو للسلام في إحداث تغييرٍ في سلوك إسرائيل وهيمنتها وسيطرتها على 80 في المئة من موارد المياه المشتركة المُتاحة. وبالفعل، وصف الخبراء سياسات إسرائيل بأنها "هيمنة تكتسي حلّة التعاون"، "ومناصرة بيئية أُحادية الجانب"، وجريمة حرب متمثّلة في النهب". في موازاة ذلك، تتعرّض البنية التحتية المائية أيضًا بانتظام "للمصادرة والهدم من جانب إسرائيل". ففي العام 2020، كانت 84 منشأة من أصل 849 منشأة دمّرتها إسرائيل في الضفة الغربية مُخصَّصة للمياه والصرف الصحّي، وفي العام 2021، دمّرت إسرائيل 40 منشأة أخرى في الضفة الغربية. والواقع أن وضع المياه في الأراضي المحتلّة شهد تدهورًا كبيرًا في السنوات الأخيرة بفعل تأثير عاملٍ خطير آخر هو التآكل التدريجي لأنظمة الصرف الصحّي في الضفة الغربية، الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي والقيود المفروضة.
سياسة المياه القذرة في الضفة الغربية: الاستيلاء على مياه الصرف الصحّي والاستفادة منها
أُهمِلَت المعالجة السليمة لمياه الصرف الصحّي في أرجاء الأراضي المحتلّة كافة قبل "مفاوضات السلام" وأثناءها. فإسرائيل لم تستثمر في إصلاح المنشآت التي لا تعمل كما يجب، والتي كانت أقامتها في مدن جنين وطولكرم والخليل في الضفة الغربية في سبعينيات القرن الماضي. ولا تزال المنشأة في رام الله تعمل، إلا أنها غير قادرة على معالجة الكمّيات المتزايدة من المياه العادمة بشكلٍ مناسب. أما في غزة، فقد تردّى الوضع بفعل الحصار المشدَّد الذي تفرضه إسرائيل على القطاع منذ العام 2006، والذي يعيق استيراد معقّماتٍ مثل الكلور، وقطع الغيار اللازمة لتحديث المرافق القائمة أو حتى إدارتها كما يجب. وفي الضفة الغربية، تتسرّب مياه الصرف الصحّي غير المُعالَجة الصادرة عن المستوطنات اليهودية مباشرةً إلى المناطق التي يقطنها الفلسطينيون.
وكانت إسرائيل أعلنت أن المياه العادمة الصادرة عن المستوطنات تخضع بمعظمها للمعالجة، غير أن منظمة "بتسيلم" دحضت هذا الادّعاء، إذ إن 81 مستوطنة فقط من أصل 121 مستوطنة في الأراضي الفلسطينية المحتلّة تتّصل بمنشآت لتنقية مياه الصرف الصحّي، فيما تصبّ مجاري المستوطنات الأخرى في جداول الضفة الغربية وأوديتها. ناهيك عن ذلك، تُوجَّه المياه العادمة الخام الصادرة عن الإسرائيليين في القدس الغربية، والفلسطينيين في القدس الشرقية، إلى الضفة الغربية. هذا ولا يرتبط سوى 20 في المئة من منازل الفلسطينيين بأنظمة معالجة مياه الصرف الصحّي، التي غالبًا ما تكون متردّية بشدّة، في حين أن 90 إلى 95 في المئة من المياه العادمة الفلسطينية لا تُعالَج على الإطلاق.
فضلًا عن ذلك، تتسرّب مياه الصرف الصحّي والنفايات السائلة، التي تنتج عن محطّات المعالجة العاملة فوق طاقتها، والتي تُصرَّف مباشرةً في البيئة، إلى باطن الأرض ملوّثةً حوض الجبل في الضفة الغربية، في ظاهرةٍ يشير إليها الخبراء الإسرائيليون بـ"القنبلة المتسرّبة الموقوتة"، نظرًا إلى تداعياتها الخطيرة على الصحة العامة والقطاع الزراعي. تستخدم إسرائيل هذا التلوّث لدفع الفلسطينيين إلى تقديم تنازلات، وإرغامهم على التعاون مع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية. ولهذه الاستراتيجية شقّان: إرغام السلطة الفلسطينية على معالجة المياه العادمة الصادرة عن المستوطنات لدفع الفلسطينيين إلى الاعتراف بهذه المستوطنات بحكم الأمر الواقع، واستغلال مياه الصرف الصحّي الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن القادة الإسرائيليين والفلسطينيين وقّعوا ثلاث اتفاقيات، في السنوات الأولى من عمر لجنة المياه المشتركة، من أجل بناء محطّات إقليمية لمعالجة مياه الصرف الصحّي، ومعالجة المياه في نابلس وطولكرم والخليل، بتمويلٍ من المجتمع الدولي. لكن إسرائيل اشترطت لإنشاء هذه المحطّات أن يجري ربطها بالمستوطنات اليهودية، وهي استراتيجية استُخدِمَت خلال عملية التفاوض من أجل إرغام الفلسطينيين على القبول بالمستوطنات، الأمر الذي رفضه رئيس سلطة المياه الفلسطينية.
ردًّا على ذلك، لجأت إسرائيل إلى ما أسماه المحلّلون الإسرائيليون "الحلول أُحادية الجانب عند مصبّ المياه"، أي الاستيلاء على المياه "القذرة" الآتية من الجانب الفلسطيني وتكريرها على جانبها من الخطّ الأخضر، وذلك لتأمين المياه اللازمة لتلبية حاجاتها في مجال الريّ الزراعي وإعادة تأهيل مجاري المياه. بعد ذلك، حمّلت إسرائيل الفلسطينيين نفقات تشغيل هذه المياه الآسنة وصيانتها ومعالجتها، من خلال اقتطاع المبالغ المُسترَدّة من الضرائب والرسوم الجمركية الفلسطينية التي تجبيها بنفسها وتسيطر عليها، علمًا أن إجمالي المبالغ وصل إلى أكثر من 34 مليون دولار خلال فترة تزيد قليلًا عن عقدٍ من الزمن بعد اتفاقيات أوسلو.
ضرورة تصويب الخلل في توازن القوى بين الإسرائيليين والفلسطينيين
إن التعاون بين السلطات الفلسطينية والإسرائيلية مفيدٌ نظريًا لاستخراج المياه وتوزيعها، خصوصًا في مواجهة تغيّر المناخ، بيد أن الدعوات الدولية إلى إرساء هذا النوع من التعاون يجب أن تترافق مع تحقيقٍ في التدابير المؤسّسية التي تُبقي على الوضع القائم غير العادل. وعلى هذه المفاوضات أن تعالج المخاوف المتعلّقة بالأراضي والموارد، وإلا ستستمر في توليد اتفاقيات تُسهّل على إسرائيل توسيع نطاق استعمارها وهيمنتها. صحيحٌ أن الفلسطينيين أُرغِموا على التفاوض من موقع أكثر ضعفًا منذ أوسلو، إلا أنهم يستطيعون، لا بل ينبغي عليهم، مواصلة استخدام القانون الدولي ومكانته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، من أجل حشد الاهتمام والدعم الدوليَّين في ما يتعلّق بمسألة حصولهم على مواردهم.
الواقع أن المفاوضات الأخيرة أدامت الديناميات التي انطلقت في تسعينيات القرن الماضي. ففي كانون الثاني/يناير 2017، وقّعت إسرائيل والسلطة الفلسطينية على اتفاقٍ لتجديد انخراطهما في لجنة المياه المشتركة، وتعهّدتا باستئناف "التعاون" بعد تعليق اجتماعاتهما لأكثر من ستة أعوام. وقد تولّى تيسير هذا الاتفاق مبعوث الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، في إطار مشروعٍ أوسع لتحلية المياه من البحر الأحمر إلى البحر الميت، كان جرى التخلّي عنه في العام 2021 حينما احتجّ الأردن على غياب اهتمامٍ إسرائيلي حقيقي بالمشروع. وبينما كان يُفترَض أن يتيح اتفاق العام 2017 للفلسطينيين مدَّ خطوط أنابيب مياه جديدة من دون موافقة إسرائيل، فَرَضَ عليهم في نهاية المطاف الاستحصال على الموافقة الإسرائيلية قبل الحصول على المياه.
ناهيك عن ذلك، لم يسمح هذا الاتفاق، مثله مثل الاتفاقات التي سبقته، للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الموارد المائية والبنية التحتية للمياه في الضفة الغربية، فبقي اختلال توازن القوى على حاله منذ أوسلو. يقوم وصول الفلسطينيين إلى المياه على علاقاتٍ غير متكافئة لم تفعل الاتفاقات الجديدة شيئًا يُذكَر لتغييرها. وقد استخدمت إسرائيل، طيلة المفاوضات التي آلت إلى الاتفاقات، تكتيكات المماطلة والتأخير واستراتيجيات فرض الشروط للحفاظ على سيطرتها المُحكَمة على موارد المياه الأساسية للمستوطنات. هذا وتحتفظ إسرائيل بحقٍّ دائمٍ وأبدي على ما يبدو، في الموافقة على المشاريع الفلسطينية أو رفضها.
يُذكَر أن الولايات المتحدة غالبًا ما تولّت تيسير المحادثات بين السلطتَين الفلسطينية والإسرائيلية، وكانت بعد ذلك تُحدث ضجّة كبيرة كلما أعلنت عن اتفاقات أفضت إليها تلك المحادثات. ومع ذلك، لم تكن راغبةً في الاضطلاع بدور المحكّم المنصف والحازم، وهو أمرٌ مثيرٌ للسخرية نظرًا إلى أن الولايات المتحدة قادرة، أكثر من أيّ دولة أخرى، على إلزام إسرائيل بالإيفاء بالبنود المُتَّفَق عليها حول تقاسم المياه. صحيحٌ أن هذه البنود تصبّ في صالح إسرائيل بشدّة، ولكنها تمسي أكثر ضررًا للفلسطينيين عندما لا تُحاسَب إسرائيل على انتهاكها نصًّا وروحًا.
والأهم أن الولايات المتحدة قادرة على الحدّ من نمط الهيمنة غير المتكافئة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين طوال عقودٍ من الزمن واختلال توازن القوى بشكلٍ صارخ لصالحها. على سبيل المثال، إضافةً إلى تيسير الاتفاقات المتعلّقة بالمياه بين الجانبَين، كان بإمكان واشنطن الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستوطنات التي تُمعن في توسيع نطاق استعمار الأراضي الفلسطينية وتقوّض أي فرصة بالحصول المنصف على الموارد. كان باستطاعة الولايات المتحدة أيضًا، باعتبارها وسيطًا في هذا الصراع، أن تتصرّف على نحو أكثر حزمًا لضمان التقيّد ببنود الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها برعايتها. في وسعها مثلًا أن تحذو حذو وزير الخارجية الأميركي السابق جيمس بيكر الذي هدّد، خلال عهد الرئيس جورج بوش الأب، بتعليق المساعدات المالية السنوية لإسرائيل في حال استمرّت في رفض المشاركة في مفاوضات مدريد للسلام مع الدول العربية في العام 1991، والتي أفضت في نهاية المطاف إلى توقيع اتفاقيات أوسلو. فالوسيط الموثوق هو الذي يحرص، في مرحلة ما بعد الاتفاق، على ضمان وصول الجانبَين بشكلٍ عادل إلى الموارد المائية المشتركة، وعلى اتّخاذ إجراءات جادّة لتفكيك المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية (أو على الأقل وقف توسّعها بشكلٍ نهائي)، وغيرها من الخطوات.
إن المسار المأساوي للأحداث في غزة فرض رهانات جديدة. فردًّا على الهجوم الذي نفّذته حركتا حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز المئات في جنوب إسرائيل، شنّت الحكومة الإسرائيلية حربًا ضارية أخرى على قطاع غزة، وأنزلت عقابًا جماعيًا بسكانه. وعند تاريخ كتابة هذه السطور، كان القصف الإسرائيلي المتواصل والعشوائي قد أسفر عن مقتل أكثر من 25 ألف فلسطيني، من بينهم أكثر من 10 آلاف طفل، فضلًا عن التدمير الكامل لبنى تحتية مدنية ومستشفيات ومدارس وجامعات ومدن، والتجويع المتعمَّد لنصف سكان غزة. وأفادت بلدية غزة أن الهجمات الإسرائيلية ألحقت الضرر بمحطة كبيرة للصرف الصحي، ما أدّى إلى غرق الشوارع بمياه المجاري غير المُعالجة وارتفاع مخاطر تفشّي الأمراض المُعدية. وقيّدت إسرائيل أيضًا قدرة جميع سكان غزة على الحصول على الموارد الأساسية، مثل الغذاء والمياه، من خلال قطع جميع الإمدادات. وتندرج كلّ الممارسات التي ترتكبها إسرائيل في خانة جرائم الحرب، بدءًا من فرضها حصارًا كاملًا على القطاع، ومرورًا بتهجيرها القسري للمدنيين، ووصولًا إلى استخدامها قذائف تحتوي على الفسفور الأبيض في قصفها على المناطق المأهولة. وفي الضفة الغربية، عَمَد المستوطنون اليهود والجيش الإسرائيلي إلى قتل مئات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح منذ اندلاع الأحداث في غزة.
في الوقت الراهن، تخلّت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حتى عن التظاهر بأنها تؤدّي دور الوسيط، وانحازت من دون قيدٍ أو شرط إلى إسرائيل. لكن عدد الضحايا المدنيين المرتفع للغاية في غزة سيضع حدًّا في الغالب لنجاح المساعي التي تقودها الولايات المتحدة من أجل تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج في المستقبل المنظور. فالمملكة العربية السعودية مثلًا، الحريصة على تجنّب ردود فعل مناوئة من شعبها الداعم للقضية الفلسطينية، لن تمضي قدمًا على الأرجح في إضفاء الطابع الرسمي على تقاربها مع إسرائيل. في مثل هذا السياق، ستستعيد السلطة الفلسطينية زخمها لتوجيه أنظار العالم من جديد إلى التعديّات الإسرائيلية المستمرّة منذ ردحٍ طويل من الزمن على أراضي الفلسطينيين واستحواذها على مواردهم المائية، وأيضًا لحشد دعم الحلفاء من أجل إنهاء ما تمارسه إسرائيل من استهلاكٍ جائرٍ للمياه، وتوسيع المستوطنات، وانتهاك حقوق الفلسطينيين.
خاتمة
على مدى العقود الثلاثة الأخيرة، أدّى الاختلال الكبير في ميزان القوى بين الفلسطينيين والإسرائيليين، الذي مأسسته اتفاقيات أوسلو ولجنة المياه المشتركة التي تشكّلت بموجبها، إلى إلحاق الضرر بصحة الفلسطينيين وسلامتهم وأمنهم. لقد فشلت عملية أوسلو والاتفاقيات اللاحقة في معالجة المشكلة الأساسية التي تهدّد الأمن البيئي والبشري أو حتى الاعتراف بها، وهي: احتلال إسرائيل للأراضي واستحواذها على الموارد. غالبًا ما تصبح عمليات السلام التي تتبنّاها دول الغرب آليةً يتم من خلالها إضفاء طابع مؤسّسي على الهيمنة. ويتم الترويج للمفاوضات وما تولّده من اتفاقيات غير مسيَّسة على أنها تقنية وإجرائية، وكأن فشلها في معالجة المشكلة الأساسية، أو حتى الاعتراف بها، هو إنجازٌ ما، ليتّضح في النهاية أنها ساهمت فعليًا في مأسسة تغاضي المجتمع الدولي عن حقوق الفلسطينيين.
نتيجةً لذلك، تردّت الأحوال في فلسطين بشكلٍ كبير، وقد تصل قريبًا إلى نقطة اللاعودة. فنظرًا إلى التقاء عوامل عدّة مثل الاستخراج الكثيف للموارد، وحرمان الفسطينيين منها عن طريق تقييد وصولهم إليها وإلى التكنولوجيا اللازمة، ناهيك عن تلوّثها في سياق تفاقم التداعيات الناجمة عن تغيّر المناخ، سيعاني الفلسطينيون من العطش الحادّ ومن تدهور القطاع الزراعي. في شهر أيلول/سبتمبر 2023، أي بعد مرور ثلاثين عامًا على توقيع اتفاقيات أوسلو، أظهر استطلاعٌ أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية أن معظم الفلسطينيين يصفون الوضع اليوم بأنه أسوأ ممّا كان عليه قبل أوسلو؛ وأيّدت غالبيتهم التخلّي عن اتفاقيات السلام هذه. يُشار إلى أن القضية الفلسطينية عادت إلى واجهة المشهد الدولي من جديد بعد هجمات حركتَي حماس والجهاد الإسلامي في فلسطين وحملة القصف الإسرائيلية الضارية على قطاع غزة. اليوم، بعد سنوات طويلة من العمليات العسكرية التي أزهقت أرواح الفلسطينيين، إضافةً إلى احتلال أراضيهم والاستحواذ على مواردهم بذريعة إحلال السلام والمشاركة في المفاوضات وتعزيز التعاون، تواجه إسرائيل تهديدات متنامية بحدوث اضطراباتٍ ونزاعاتٍ مُزعزعة لاستقرارها.
السودان في صُلب التعاون العابر للحدود بشأن النيل
مقدّمة
يتمتّع نهر النيل مع رافدَيه، النيل الأزرق والنيل الأبيض، بقيمةٍ كبيرةٍ بصفته موردًا مائيًا طبيعيًا للبلدان التي تتقاسمه، وهي قيمة تزداد باطّراد مع تدفّق النهر في اتّجاه المصبّ. وبعيدًا عن المنابع التي ينشأ منها النهر، أي بحيرة تانا والمرتفعات الإثيوبية حيث ينبع النيل الأزرق، وبحيرة فكتوريا حيث ينبع النيل الأبيض، يتحوّل حوض النيل إلى أراضٍ أكثر جفافًا في كلٍّ من مصر والسودان وشمال إثيوبيا.
تسحب دولتا المصبّ الأبعد في مجرى النهر، أي مصر والسودان، القدرَ الأكبر من مياه النيل سنويًا، بما نسبته 57 و31 في المئة على التوالي من إجمالي سحب المياه من النهر. هذا الاعتماد الكبير على مياه النيل يشتدّ بشكل خاص على طول النيل الأزرق، الذي يأتي منه أكثر من 80 في المئة من إجمالي تدفّق المياه. ولهذا السبب اكتسبت العلاقات العابرة للحدود بين دول حوض النيل الثلاث الواقعة عند مصبّ النيل الأزرق، السودان ومصر وإثيوبيا، أهميةً كبرى من المنظور الهيدرولوجي.
لكن هذه العلاقة الثلاثية وُضِعَت على المحكّ مع بناء وملء سدّ النهضة الإثيوبي العظيم، الذي أُنشئ أساسًا لإنتاج الطاقة الكهرومائية لإثيوبيا، إذ تصاعدت التوتّرات بين الدول الثلاث على نحو مطّرد، خصوصًا بين مصر وإثيوبيا، مع اقتراب الانتهاء من بنائه. فاعتماد مصر على النيل بوصفه مصدرًا حيويًا لإمدادات المياه يضعها على طرفَي نقيض مع تطلّعات إثيوبيا الرامية إلى تعزيز موثوقية الطاقة من خلال استخدام قدرة السدّ الهائلة على توليد الطاقة الكهرومائية (وهو ما سيؤثّر على تدفّق النيل الأزرق، وبالتالي على توقيت إمدادات المياه في مصر وحجمها).
يُضاف إلى ذلك أن تداعيات تغيّر المناخ تطال حوض نهر النيل، وتتسبّب بالمزيد من الظروف الهيدرولوجية والمناخية المتقلّبة والمتطرّفة في الحوض. فقد شهد الحوض في السنوات الأخيرة جفافًا متواصلًا (مقترنًا بدرجات حرارة أكثر دفئًا)، وفيضانات شديدة (ناجمة عن هطول أمطار غزيرة خلال فترات قصيرة). هذه التبعات المتوقّعة لتغيّر المناخ تهدّد بمفاقمة النزاعات على مياه النيل عبر الحدود في المستقبل، مع استمرار الدول المُشاطِئة في التنافس على فوائد النهر، بما في ذلك إمدادات المياه، والطاقة الكهرومائية، والريّ. ومن المتوقّع أن يشهد الحوض مزيجًا من ارتفاع مستوى سطح البحر وحرائق الغابات على طول حدوده الساحلية على البحر الأبيض المتوسّط (ما يشكّل خطرًا على منطقة دلتا النيل الناشطة زراعيًا في مصر)، إضافةً إلى هطول أمطار غزيرة قد تؤدّي إلى ازدياد الفيضانات (ولا سيما في السودان المُعرَّض لها).
في خضمّ المواجهة المتوتّرة بين مصر وإثيوبيا بشأن سدّ النهضة، أُجِّلَت أولويات جارهما السودان إلى مرحلة لاحقة. هذا الأخير الذي يقع عند ملتقى النيلَين الأزرق والأبيض، وعند نقطة التقاء نهر عطبرة (ثالث روافد النيل الرئيسة) بالمنبع الأساسي للنهر، غالبًا ما يتعرّض لفيضانات مدمّرة تتسبّب بها الأمطار الغزيرة خلال موسم الأمطار الشديدة. ولذا، يبقى تحسين مكافحة الفيضانات أمرًا ضروريًا للسودان. يُضاف إلى ذلك أن قطاع الطاقة في البلاد، الذي غالبًا ما يعجز عن تلبية احتياجات الكهرباء المحلية، يتطلّب بدوره تحسينات واسعة النطاق، بما في ذلك تحديث البنية التحتية للكهرباء، والحصول على مصادر طاقة إضافية.
نظرًا إلى هاتَين الأولويّتَين المزدوجتَين، أي تحسين مكافحة الفيضانات وتعزيز الحصول على الكهرباء، يُعدّ البدء بتشغيل سدّ النهضة أمرًا مُستحبًّا للسودان أكثر منه لمصر. إذا ما تمكّنت إثيوبيا والسودان من التوصّل إلى اتفاقٍ حول تشغيل السدّ، فقد يُفضي ذلك إلى تخفيف الفيضانات في السودان، وتوفير كهرباء إضافية مُولَّدة في منشآت الطاقة الكهرومائية في السدّ. مع ذلك، تعتري السودان إلى حدٍّ ما المخاوفُ نفسها التي تعتري مصر، إذ إن السدّ قد يقلّل توافر المياه عند المصبّ، ما قد يؤثّر مباشرةً على الريّ والأمن الغذائي في هذَين البلدَين.
لكن حتى وإن كانت هذه المخاوف المتضاربة المشتركة مع كلٍّ من مصر وإثيوبيا تضع السودان في موقف حرج في ما يتعلّق بسدّ النهضة، لدى هذا الأخير أيضًا الفرصة للاضطلاع بدور مهمّ بوصفه وسيطًا للتعاون العابر للحدود بين جارَيه الواقعَين عند منبع النهر ومصبّه. فالسودان قادرٌ، إذا ما اضطلع بدور الشريك المركزي، أن يسهّل تبادل المياه مقابل الطاقة بينه وبين إثيوبيا (إلى جانب فوائد مكافحة الفيضانات)، والمياه مقابل الغذاء بينه وبين مصر. من شأن اتفاقيات تبادل الموارد هذه ذات المنفعة المتبادلة مع كلٍّ من إثيوبيا ومصر أن تلبّي احتياجاتهما من النهر، وتضمن في الوقت نفسه للسودان قدرًا أكبر من المياه والغذاء والأمن الغذائي.
لكن هذا الدور مُهدَّدٌ بعددٍ من الاضطرابات المحتملة، منها الصراع الداخلي الذي يشهده السودان حاليًا، وتشنّج العلاقات الدبلوماسية بين مصر وإثيوبيا، وكلفة الاستثمارات الضرورية في البنية التحتية؛ وقد يتأثّر أيضًا بمدى توفّر التمويل للتكيّف مع تبعات تغيّر المناخ. ينظر هذا الفصل بصورة مفصّلة في التأثيرات المترتّبة عن سدّ النهضة العظيم عبر الحدود، ويتناول كيف يمكن للسودان أن يؤدّي دورًا أساسيًا في رأب الفجوة الحالية بين مصر وإثيوبيا.
تأثيرات سدّ النهضة العابرة للحدود
بدأ بناء مشروع سدّ النهضة العظيم بصورة جدّية بعد العام 2011، حينما مضت إثيوبيا قدمًا بالتصاميم التي وضعتها لتشييد سدٍّ كبير لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل الأزرق. وقد واجه المشروع منذ البداية معارضةً من مصر والسودان، فيما لم تؤدِّ سلسلة المقترحات والمساعي للتوسّط بين إثيوبيا وجارَيها المُشاطئَين بشأن التأثيرات المحتملة للسدّ على الظروف الهيدرولوجية، والبيئية، والاقتصادية الاجتماعية عند المصبّ، إلى أيّ نتائج. وفي ظلّ غياب الإجماع حول كيفية دمج عمليات السدّ في عمليات النيل القائمة، بدأت إثيوبيا بتحويل مجرى النيل الأزرق إلى سدّ النهضة. ومع توقّف المفاوضات بين البلدان الثلاثة، شرعت إثيوبيا في ملء السدّ في تموز/يوليو 2020، ثم تزامنت عملياتُ ملئه في العامَين 2021 و2022 مع استكمال مراحل بنائه.
هذا الانقسام الأوّلي بين إثيوبيا ومصر والسودان تعمّق في العام 2013 عندما صادقت إثيوبيا على اتفاقية عنتيبي، المعروفة أيضًا باتفاقية الإطار التعاوني لدول حوض النيل، والتي برّرت الإجراءات الأحادية اللاحقة التي اتّخذتها إثيوبيا بشأن النيل الأزرق وسدّ النهضة. وقّعت ستٌّ من دول منابع النيل على الاتفاقية في العام 2010، واعتمدتها كبديل عن معاهدات حوض النيل السابقة (ولا سيما اتفاقية تقاسم مياه النيل للعام 1929، واتفاقية مياه النيل للعام 1959)، التي اعترفت فقط بحقوق مصر والسودان في المياه. ردًّا على ذلك، وقّعت مصر والسودان اتفاقيةً تعيد التأكيد على حقوقهما التاريخية في المياه على النحو الذي نصّت عليه اتفاقية العام 1959.
تتمحور نقطة الخلاف الرئيسة بين هذه الدول الثلاث حول تأثيرات سدّ النهضة على إمدادات المياه المتاحة لمصر والسودان عند المصب. فبينما ستكون للسدّ قدرةٌ على تخزين ما يصل إلى 74 مليار متر مكعّب من المياه (وهي ثاني أكبر قدرة تخزين بعد سدّ أسوان العالي في الحوض)، سيكون الغرض الأساسي منه توليد الطاقة الكهرومائية. لذا، من المتوقّع أن تكون أولوية عمل السدّ إطلاق المياه بدلًا من تخزينها. والواقع أن قرب السدّ من الحدود مع السودان (على بُعد 20 ميلًا فقط) يعني أن إثيوبيا لن تكون قادرةً على استخدام المياه المُخزَّنة فيه لتلبية أيٍّ من احتياجاتها من استهلاك المياه، مثلًا لاستخدامها في الريّ أو للأغراض المنزلية. لكن المخاوف بشأن كيفية تأثير ملء سدّ النهضة وتشغيله على استمرارية إمدادات المياه عند المصبّ تبقى مخاوف مشروعة، إذ تقدّر الدراسات أن يقلّص ملء السدّ تدفّق مياه النيل الأزرق بنسبة 30 في المئة، ما سيستدعي إعادة تنظيم عمل السدود في السودان.
يُثير احتمال تراجع إمدادات المياه من النيل قلقَ مصر بوجه خاص، نظرًا إلى أنها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على النهر، الذي يلبّي 93 في المئة من حاجاتها من المياه. فهي تستمدّ 98 في المئة من مواردها المائية من خارج حدودها، بما في ذلك خزّانات المياه الجوفية المشتركة، غير أن النموّ السكاني والاقتصادي السريع يعني أن طلب مصر على مياه النيل قد تجاوز العرض المتاح. فالقدر الأكبر من المياه التي تحوّلها مصر من النيل (أي ما يقارب 85 في المئة) يُستخدَم في ريّ الأراضي الزراعية للمساعدة في تلبية احتياجات الإنتاج الغذائي لعدد سكانها الكبير والمتزايد.
ولأسباب مماثلة، دعم السودان موقف مصر بشأن سدّ النهضة، ذلك أن إمدادات مياه النيل تُعَدّ بالغة الأهمية لإنتاج الأغذية الزراعية فيه. والواقع أن مصر والسودان توافقا تاريخيًا حول القضايا المرتبطة بنهر النيل، بحيث شكّلت اتفاقية تقاسم مياه النيل للعام 1929 واتفاقية مياه النيل للعام 1959، اللتان منحتا حقوق المياه فقط لبلدَي المصبّ هذَين الأبعد في مجرى النهر، الأساسَ لمعارضتهما المشتركة لأيّ مشاريع تهدف إلى تنمية الموارد المائية عند منبع النهر. لكن نظرًا إلى ازدياد تعرّض السودان للفيضانات مؤخّرًا بسبب تغيّر المناخ، وحاجته إلى تنظيم تدفّق المياه كأداة لمكافحة الفيضانات، أصبح أكثر استعدادًا لجني الفوائد المحتملة التي قد يقدّمها سدّ النهضة العظيم.
السودان شريكٌ أساسي في التعاون بين دول حوض النيل
إن المأزق الراهن حول سدّ النهضة الإثيوبي الكبير ناجمٌ عن المصالح المتضاربة بين إثيوبيا ومصر حول تشغيل السدّ وإدارة تدفّق مياه النيل. فمن جهة، تريد مصر أن تتدفّق مياه النهر في اتّجاه المصبّ من دون أن يعيقها السدّ، حتى تستمرّ في تلبية الطلب المرتفع على المياه؛ بينما تحتاج إثيوبيا، من جهة أخرى، أن يعترض السدّ تدفّق المياه لتوليد الطاقة الكهرومائية.
أمام السودان فرصة للاضطلاع بدور شريك تعاوني يسهم في تخفيف حدّة هذا النزاع العابر للحدود من خلال إبرام مجموعة من الاتفاقيات القائمة على تبادل الموارد. ويُعَدّ نجاح هذا النهج رهنًا بتوسّط السودان في سيناريو يعود بالمنفعة إلى الدول المُشاطِئة الثلاث، من خلال تأمين الموارد التي ترغب فيها مصر وإثيوبيا من بعضهما البعض، والتي لا تستطيعان راهنًا تبادلها بصورة مباشرة. هذه خطوة أساسية كي ينجح السودان في تحقيق تحوّلٍ في العلاقات بين الدول المُشاطِئة لنهر النيل من النزاع إلى التعاون.
لطالما أدّى السودان دورًا مهمًا كمُنتج إقليمي للموادّ الغذائية ومُصدّر لها، بفضل امتلاكه مساحات شاسعة من الأراضي الصالحة للزراعة وحصوله على الموارد المائية من النيل الأزرق والنيل الأبيض. يُعتبر مشروع الجزيرة في السودان واحدًا من أكبر المشاريع المرويّة في العالم، ويمتدّ على مساحة 850,000 هكتار تقريبًا، تخوّله أن يكون مصدرًا إضافيًا مهمًّا لإنتاج موادّ غذائية تستفيد منها مصر، التي تستهلك ما يُقدّر بـ80 في المئة من إجمالي كمية المياه المسحوبة من النيل بغرض الريّ. يُشار إلى أن الشراكة مع السودان لزيادة الواردات الغذائية قد تسمح لمصر بتحسين أمنها الغذائي في المستقبل من خلال توفير مصدر بديل وإضافي للإنتاج الزراعي لا يكون معرّضًا لمخاطر مثل فقدان الأراضي الزراعية بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وانتشار حرائق الغابات الناجمة عن تغيّر المناخ (وهذان العاملان يشكّلان مصدر تهديد لدلتا النيل المصرية الخصبة والمرويّة بشكل كبير).
لتسهيل هذه الشراكة، سيحتاج السودان من مصر إما أن يحصل على جزءٍ من حصتها من مياه النيل لتلبية احتياجات الريّ المتنامية، أو أن تساعده في تأمين استثمارات لتحسين كفاءة استخدام المياه المخصّصة للزراعة في مشروع الجزيرة (المعروف بأنه يعاني بسبب التوزيع السيّئ للمياه وسوء إدارة مياه الريّ). وقد تسهم التدابير المُتّخذة لتعزيز كفاءة استخدام مياه الريّ في السودان – مثل التوزيع الأفضل لمياه الريّ وإزالة الرواسب – في إنتاج قدرٍ أكبر من المحاصيل باستخدام كمية أقل من مياه الريّ.
على خلاف مصر، في وسع السودان تحقيق فوائد مباشرة من سدّ النهضة، أبرزها تعزيز قدرته على مكافحة الفيضانات وشراء الكهرباء التي يتمّ توليدها من الطاقة الكهرومائية. ويترافق تعرُّض السودان للفيضانات مع مجموعة من المخاوف بشأن الأضرار المحتملة، من بينها دمار البنى التحتية، وخسارة المصالح والأعمال، وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة، وسقوط الضحايا، فضلًا عن المشاكل المرتبطة بالصحة العامة، والصرف الصحي، والتداعيات البيئية. وقد يسهم التنسيق بين إثيوبيا والسودان بشأن تصريف المياه من سدّ النهضة بصورة مدروسة في تخفيف حدّة التداعيات التي لطالما تكبّدها السودان نتيجة الفيضانات. كذلك، في وسع السودان التوصّل إلى ترتيب مع إثيوبيا للحصول على الطاقة الكهرومائية التي يولّدها سدّ النهضة بهدف مساعدته على تقليص العجز في إمدادات الطاقة، ولا سيما أنه بحاجة ماسّة إلى مصدر موثوق لتوليد الطاقة الكهربائية. وهكذا، بإمكان إثيوبيا أن تتشارك الطاقة الكهربائية مع السودان، إذ إن السدّ قادرٌ على توليد ما يصل إلى 6,000 ميغاواط من الكهرباء. في المقابل، قد يسمح السودان لإثيوبيا باستخدام جزءٍ من حصته من مياه النيل للإسهام في ملء خزان سدّ النهضة من أجل تعويض كميات المياه التي من الضروري تصريفها لتوليد طاقة إضافية. قد يتمكّن السودان من تحقيق ذلك حتى بفضل كميات المياه المحفوظة بعد اتّخاذ التدابير المحتملة لتحسين كفاءة استخدام مياه الريّ في مشروع الجزيرة. وثمّة أيضًا خيارٌ آخر أمام السودان يتمثّل في التفاوض بشأن صفقة لشراء الطاقة بصورة مباشرة مع إثيوبيا.
هذه الترتيبات الثنائية المقترحة بين السودان ومصر من جهة (حول الأمن الغذائي)، وبين السودان وإثيوبيا من جهة أخرى (حول أمن الطاقة والتخفيف من الفيضانات) قد تمهّد الطريق، إن كُتب لها النجاح، أمام وضع إطار ثلاثي يضمّ الدول الثلاث. وعلى الرغم من صعوبة تصوّر ذلك في المرحلة الراهنة التي تسودها خلافات بين الدول المشاطِئة حول سدّ النهضة، من شأن التعاون على المستوى التقني أن يعود بالفائدة على دول حوض النيل الثلاث. إن تحسين عمليات سدّ النهضة بهدف توليد أقصى قدرٍ من الطاقة الكهرومائية، وتوفير إمدادات مياه موثوقة إلى دولتَي المصب، وتعزيز القدرة على تخفيف الفيضانات، قد يُسهم في تحقيق أولويات كلٍّ من الدول الثلاث.
العقبات التي تعيق دور السودان في التعاون العابر الحدود
تعترض تحديات كثيرة دور الوساطة الذي يمكن أن يؤدّيه السودان في التعاون العابرة للحدود في حوض النيل، وأكثرها وضوحًا هو الصراع الحالي الذي يشهده السودان بين الفصائل العسكرية المتناحرة، والذي أغرق البلاد في مستنقعٍ من الفوضى. فقد تركّزت الحرب المفتوحة المُندلعة بين القوات المسلّحة السودانية وقوات الدعم السريع منذ نيسان/أبريل 2023 إلى حدٍّ كبير حول العاصمة الخرطوم، وأدّت إلى تعطيل المؤسسات العامة في البلاد. أرغم غياب الاستقرار والافتقار إلى الخدمات الإنسانية الأساسية (بما فيها الغذاء والماء والكهرباء والرعاية الصحية) المدنيين على الفرار من الدولة التي مزّقتها الحرب وتكبُّد مخاطر كثيرة. ونظرًا إلى أن هذه الأعمال العدائية أدّت إلى انهيار الاقتصاد والحكم في السودان، يبدو جليًّا أن مسار البلاد نحو التعافي سيكون طويلًا بعد انتهاء الحرب.
وحتى لو استقرت الأوضاع في السودان، ثمة عقبات أخرى تعرقل دور البلاد العابر للحدود. فقبل هذه الأحداث، تدهورت الظروف الاقتصادية في السودان بشكل حادّ (إذ ارتفع معدّل التضخم ليصل إلى 318 في المئة في أواخر العام 2021). ومن المُرجَّح أن يتفاقم اقتصاد البلاد أكثر بعد إلى حين التوصل إلى حلٍّ محتمل للصراع. أما اتفاقيات تبادل الموارد وترتيبات التعاون المُقترحة بين كلٍّ من السودان ومصر وإثيوبيا، فلا تزال تتطلّب استثمارات كبيرة في مجالات عدّة، مثل تحديث البنية التحتية وخطوط نقل الطاقة في السودان استعدادًا لتلقي الكهرباء من إثيوبيا، وتحسين كفاءة استخدام المياه في القطاع الزراعي السوداني لزيادة الإنتاج الغذائي، وتعزيز التنسيق التقني والقدرة على التنبؤ بالفيضانات بهدف دمج مسعى تقليص خطر الفيضانات عند المصبّ في صُلب عمليات سدّ النهضة. وقد تكون الاستثمارات المطلوبة لتحسين البنية التحتية لنقل الطاقة وكفاءة استخدام مياه الريّ في السودان ذات تكاليف باهظة. وبالفعل، قُدّرت مؤخّرًا تكلفة الصيانة وإعادة الهيكلة اللازمتَين لقطاع الطاقة السوداني بمبلغ 3 مليارات دولار.
ثمّة عقبة أخرى ذات طابع أقل تقنيةً تعرقل آفاق التعاون الإقليمي بقيادة السودان وتتمثّل في مهمّة دفع مصر إلى المشاركة في هذا الترتيب. فهي الأكثر تأثّرًا من بين الدول الثلاث بأي تغيير يطرأ على الموارد المائية الواردة من نهر النيل، ولا سيما حين يتم تشغيل سدّ النهضة بكامل طاقته. كذلك، أن يُطلب من مصر وضع أمنها الغذائي جزئيًا في يدَي السودان قد يُعدّ خطرًا كبيرًا على آخر دولة يصبّ فيها نهر النيل. مع ذلك، يُشار إلى أن التأثيرات المُجتمِعة لعمليات سدّ النهضة الوشيكة والواسعة النطاق، وتداعيات تغيّر المناخ على دلتا النيل، هي عوامل قد تدفع مصر إلى تليين موقفها والبحث عن مسارات بديلة لحلّ الخلاف مع إثيوبيا. لكن المشهد السياسي بات محفوفًا بالتحديات على نحو متزايد. فالنزاع الدبلوماسي بين مصر وإثيوبيا يحتدم، إذ لوّحت مصر بصورة غير مباشرة بإمكانية تنفيذ عملية عسكرية ضدّ إثيوبيا.
في غضون ذلك، لا يزال ثمّة فرص قد تحثّ هذه البلدان الثلاثة على تحقيق تعاون عابر للحدود. فقد بات من الصعب تجاهل العلاقة بين التباين الهيدرولوجي المتزايد في حوض النيل وتغيّر المناخ، ما يُفسح المجال أمام مصادر جديدة للتمويل والاستثمار من مبادرات عالمية تسعى إلى تعزيز القدرة على الصمود في وجه المخاطر المناخية. في الواقع، يمكن الاستفادة من مبادرات مثل الصندوق الأخضر للمناخ، وصندوق التكيّف، وصندوق الخسائر والأضرار (الذي تم الإعلان عنه في الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP27) التي عُقدت في مصر) لدعم المساعي الرامية إلى التكيّف مع تداعيات تغيّر المناخ في حوض النيل، بما في ذلك اتفاقيات تبادل الموارد المُقترحة التي يستطيع السودان تيسيرها.
خاتمة
إن الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا حول سدّ النهضة متجذّرة وراسخة بقوّة. وتسهم عوامل متداخلة عدّة في مفاقمة المأزق الراهن، أبرزها المسائل المرتبطة بتخصيص الموارد المائية تاريخيًا، وتغيّر المناخ، والمخاوف بشأن الإنتاج الغذائي وتوليد الطاقة وضمان توافر الموارد المائية بشكلٍ مستدام. لكن من الممكن انتهاج مسار يوفّق بين مختلف هذه المصالح، إذ ما زال باستطاعة كلّ دولة من هذه الدول تحقيق أهدافها الأساسية المتعلقة باستخدام مياه النيل.
يستطيع السودان، نظرًا إلى موقعه الفريد، أن يؤدّي دورًا أساسيًا في تسهيل التعاون بين الدول المُشاطِئة الثلاث كي يتسنّى لها تحقيق أهدافها عبر إبرام اتفاقيات تبادل الموارد التي تعود بالفائدة على جميع الأطراف. صحيحٌ أن هذا النهج لا يخلو من العقبات، لكنه قد يؤمّن مستوى معقولًا من الأمن الغذائي لمصر، ويعزّز أمن الطاقة لكلٍّ من إثيوبيا والسودان، ويحسّن قدرة هذا الأخير على الحدّ من الفيضانات، ويوفّر الأمن المائي لجميع هذه الأطراف.
فيما ينطوي النهج المُقترَح بتولّي السودان دور الشريك الأساسي في تشجيع التعاون العابر للحدود بين مصر وإثيوبيا على إيجابيات عدّة، تجدر الإشارة أيضًا إلى الدافع المهمّ وراء هذا النهج. ففي وجه المخاطر الجسيمة التي يطرحها تغيّر المناح والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تخوضها المنطقة، من الضروري تحقيق التعاون العابر للحدود – ومن الأفضل أن يحدث ذلك عاجلًا وليس آجلًا – إذ ما من بديلٍ معقولٍ آخر.




