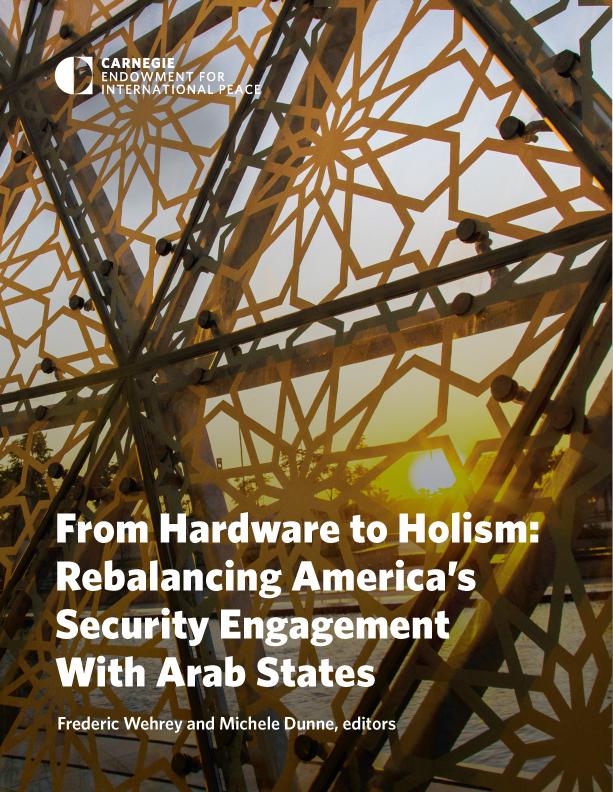إعادة تنظيم المساعدات الأمنية الأميركية
على الرغم من أن ما يُسمّى بالقوى العظمى بدأت بإرسال المساعدات الأمنية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قبل نحو قرنَين من الزمن، فإن المساعدات الأمنية في الزمن الحالي تعتبر من إرث الحرب الباردة بصورة أساسية. فخلال ذلك النزاع الطويل، عزّز كلٌّ من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي مساعداته الأمنية إلى حد كبير. وإضافةً إلى إمدادات الأسلحة، اشتملت هذه التعزيزات الجديدة على المساعدات الإنمائية التي غُلِّفت في إطار نموذجَين رأسمالي وشيوعي تُحرّكهما الأيديولوجيا، على التوالي، ويقترنان بمحفّزات شرط أن تُوفِّق الجهات المتلقّية سياساتها واقتصاداتها السياسية مع الكتلة المناسبة، أي الغرب أو الشرق. باختصار، كانت المساعدات الأمنية في زمن الحرب الباردة جزءًا من صفقة كاملة.
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، باتت هذه المقاربة الشاملة غير مستدامة بالنسبة إلى الدولة الروسية التي حلّت مكان الاتحاد. وهكذا أُسقِطت المساعدات الإنمائية والإرشاد الأيديولوجي والعضوية في كتلة من الدول ذات الاصطفاف الموحّد، وظلّت المساعدات الأمنية الأداة الأساسية الوحيدة في تظهير القوة الروسية. وحتى هذه المساعدات خُفِّض نطاقها. فالتحالفات العسكرية والانخراط ذو الطابع التطفّلي مع القوات المسلحة للجهات المتلقّية استُبدِلت على نحوٍ شبه كامل بمبيعات الأسلحة المقرونة بتدخلات أحادية قائمة على استراتيجية المنطقة الرمادية.
مسار المساعدات الأمنية الأميركية للشرق الأوسط مشابهٌ للمسار الروسي، ولو كان متخلِّفًا عنه بفارق زمني ممتدٍّ لعقدٍ أو أكثر، ومن دون إضافة الأنشطة الواسعة القائمة على استراتيجية المنطقة الرمادية. لقد شكّل التدخل الكارثي في العراق في عام 2003 ذروة المقاربة المتحررة من أي قيود التي استخدمتها الولايات المتحدة في حقبة الحرب الباردة. ووضعَ هذا المجهود الفاشل لتحويل العراق إلى شعلة للديمقراطية العربية، أو حتى لتشكيل حكومة وطنية شرعية وفعّالة، حدًا، بصورة نهائية ربما، لمحاولات قولبة الدول القومية المتلقّية كي تصبح على صورة أميركا. وعلى غرار روسيا، جعلت الولايات المتحدة من شحنات الأسلحة المكوِّن الأساسي في مساعداتها الأمنية. وفي حالة الولايات المتحدة، يُستكمَل ذلك ببناء قدرات الشركاء، أو ما تسمّيه وزارة الدفاع الأميركية BPC، من خلال برامج راسخة لصيانة المعدات وضمان استدامتها، وجهود أوسع نطاقًا لترقية القدرات العسكرية. تأمل واشنطن بأن يتيح لها بناء قدرات الشركاء إظهار قوتها بكلفة أدنى مع نشر عدد أقل من الجنود على الأرض مقارنةً بنموذج المساعدات الأمنية المتوارَث من حقبة الحرب الباردة.
تكاليف ومنافع نموذج المساعدات الأمنية في مرحلة ما بعد الحرب الباردة
لقد ساهمت العوامل العسكرية والاقتصادية والسياسية مجتمعةً في انتصار الولايات المتحدة على السوفيتيين في الشرق الأوسط خلال الحرب الباردة. وربما لم يكن ذلك ليتحقق لو لم تُدرِج واشنطن نقل الأسلحة في إطار المساعدات الأمنية الأوسع والدعم للتنمية والإشراك في التحالفات المدعومة من الولايات المتحدة. فهل بالغ صنّاع السياسات في الزمن المعاصر في تقدير أهمية نقل الأسلحة فيما قلّلوا من أهمية المساعدات الأمنية والإنمائية الأوسع نطاقًا؟
الجواب هو نعم على ما يبدو، وذلك لثلاثة أسباب.
أولًا، نقل الأسلحة رمزي. فدوره باعتباره مؤشّرا للضمانة الأمنية الأميركية يفوق عادةً قيمته العسكرية الفعلية. لقد عمدت حكومات عدّة في الشرق الأوسط، منذ عهد الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، إلى تنويع مصادر مشترياتها، مدفوعةً إلى حد كبير بالمخاوف من أن الولايات المتحدة ليست ملتزمة فعليًا بأمنها، حتى ولو اشترت أعدادًا كبيرة من نظم الأسلحة الأميركية الباهظة الثمن. والإخفاق في دمج بعض هذه الأسلحة ضمن عتاد الجيوش المتلقّية لم يحل دون الاستمرار في شرائها. وفي ذلك مؤشّرٌ على أن القيمة الرمزية للأسلحة أكثر أهمية حتى من جدواها القتالية في حسابات العملاء.
ثانيًا، يجري تنويع مصادر المشتريات للحد من التأثير الذي تمارسه جهة مورِّدة واحدة تفرض سيطرتها وشروطها في هذا المجال. وهكذا تزداد أعداد مصنّعي الأسلحة الراغبين في الدخول إلى سوق الشرق الأوسط المربحة. وخير دليل على الفاعلية المحدودة للاشتراط هو المحاولة السيّئة الطالع التي بذلتها إدارة أوباما للتأثير في الجيش المصري في أعقاب انقلاب تموز/يوليو 2013 من خلال تعليق المساعدات العسكرية في تشرين الأول/أكتوبر من العام نفسه. وقد استأنف أوباما العمل بالمساعدات الأميركية إلى مصر في آذار/مارس 2015، بعدما عجز عن الضغط على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي باشر في تلك الفترة تنويع المصادر التي تشتري منها مصر أسلحتها. وفي غضون عامَين، تراجعت الولايات المتحدة إلى المرتبة الثالثة على قائمة مورّدي الأسلحة إلى مصر. تؤمّن فرنسا راهنًا 40 في المئة من مشتريات الأسلحة المصرية. وتأتي الولايات المتحدة بعد روسيا، وبالكاد تتقدّم على ألمانيا التي تتصدّر مصر قائمة الدول التي تشتري صادراتها من الأسلحة.
ثالثًا، كانت مشتريات الأسلحة الباهظة الكلفة وغيرها من النفقات العسكرية عاملًا مساهِمًا في الركود الاقتصادي في عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط، فيما عزّزت في الوقت نفسه النفوذ السياسي للقوات المسلّحة. المفارقة أن الولايات المتحدة تبرّر عمليات نقل الأسلحة بذريعة أنها تساهم في الاستقرار، وهذا الكلام يعبّر، في أفضل الأحوال، عن نصف الحقيقة. فنقل الأسلحة يولّد، في الأغلب، مشكلات أكثر مما يساهم في الحلول. فمع انحسار القواعد السياسية للأنظمة، ازداد القمع الذي ساهم، مقرونًا بالتراجع الاقتصادي، في انعدام الاستقرار المزمن الذي تعاني منه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذا فضلًا عن أن عدم الاستقرار يتوالد ويجرّ مزيدًا من عدم الاستقرار. فالأوضاع الأمنية التي تزداد هشاشةً في الشرق الأوسط تدفع باتجاه شراء مزيد من الأسلحة من مورِّدين إضافيين، ما يولّد دوّامة تسلّح متواصلة لا تعود بالفائدة لا على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ولا على الولايات المتحدة.
المساعدات الأمنية في مقابل الأمن الفعلي
فيما تعزّزَ الطابع الأمني لعدد من بلدان المنطقة، ولعامة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تراجعَ الأمن بصورة عامة. تشير بعض الأدلة إلى أنه قد تكون هناك علاقة سببية بين الأمرَين. فبين عامَي 2000 و2018، بلغت حصّة التنمية في المساعدات الأميركية الإجمالية الثلثَين، في حين اقتصرت حصّة المخصصات العسكرية على الثلث فقط. ولكن في الشرق الأوسط، شكّلت المساعدات العسكرية 55 في المئة من مجموع المساعدات الأميركية للتنمية الخارجية الذي بلغ قدره 210 مليارات دولار. خلال تلك المرحلة، كان ما يزيد عن نصف المساعدات العسكرية الأميركية من نصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يُشار إلى أن القوات المسلحة في الشرق الأوسط هي الأكبر حجمًا على مستوى العالم، وذلك بحسب معدّل الحجم إلى عدد السكان، ومقياس الإنفاق كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. ففي العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بلغ حجم الأموال التي أنفقتها بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الدفاع كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي أكثر من ضعف المبالغ التي أنفقتها منطقة جنوب آسيا التي تحتل المرتبة الثانية في تصنيف المناطق من حيث الإنفاق على الدفاع. وبين البلدان العشرين التي تتصدر الإنفاق على استيراد الأسلحة، تقع تسعة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفقًا للكتاب السنوي لعام 2019 الذي وضعه معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، زادت بلدان الشرق الأوسط وارداتها من الأسلحة بنسبة 87 في المئة بين 2009-2013 و2014-2018. وفي المرحلة الأخيرة، أي 2014-2018، بلغت حصّة بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 35 في المئة من واردات الأسلحة العالمية، وأصبحت مصر، الفقيرة نسبيًا، ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم.
غالباً تفشل دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توفير الأمن بطريقة مناسبة لسكّانها على الرغم من أنها تُوظِّف استثمارات كبيرة في المجال الأمني. في عام 2019، كانت بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن الأقل سِلماً في العالم، وفقًا لمؤشّر السلام العالمي. فمن أصل تسعة بلدان صُنِّفت بأنها الأكثر خطورة في العالم لعام 2019، تقع خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويعيش نحو 90 في المئة من سكان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بلدان حيث مستوى الخطورة أعلى من المعدّل العالمي، في حين أن نحو مئة مليون نسمة تعيش في خمسة من البلدان الأكثر خطورة. بناءً عليه، تشير الأدلة إلى أن المساعدات الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لم تساهم في ظهور دول قوية خاضعة للمساءلة وتنعم بالسلام في منطقةٍ تتمتع بالاستقرار والأمن والأمان.
ليست النتائج أفضل بكثير لناحية مساهمة المساعدات الأمنية في تحقيق المصالح الأميركية. صحيحٌ أنه جرى احتواء التشدد الجهادي إلى حد كبير، ولكنه لم يشكّل، فيما خلا الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001، تهديدًا مباشرًا فعليًا للولايات المتحدة. وأمكن الحفاظ على تدفّق النفط، غير أن السبب الأساسي في ذلك يعود إلى قوى السوق لا إلى الأمن الذي يُفرَض من خلال التدابير العسكرية. أما المصلحة الوحيدة التي تحققت على نحوٍ واضح فهي مصلحة إسرائيل التي تزداد، وهذه مفارقة، استقلالًا عن الولايات المتحدة.
لقد دخلت روسيا من جديد إلى المنطقة في موقع القوة العسكرية، بعد انقطاع دام عقدًا من الزمن في أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي. ويحقق الوجود الصيني في الميدان الاقتصادي وفي مجال القوّة الناعمة نموًا مطردًا. وباتت فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة المنضوية في إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو) جهات منافِسة أساسية في أسواق السلاح المربحة في المنطقة. ولم يتم احتواء إيران التي تُعتبَر العدو الرئيس للولايات المتحدة في المنطقة. وتكتسب معظم البلدان العربية التي كانت على اصطفاف وثيق مع واشنطن، مثل مصر والإمارات العربية المتحدة، استقلالًا متزايدًا من الناحيتَين العسكرية والاستراتيجية. ويطرح غرق ليبيا وسورية واليمن في الفوضى، مقرونًا بالهشاشة المتزايدة التي تعاني منها الدولة في الجزائر والعراق ولبنان والسودان، علامات استفهام وشكوكًا حول استمرارية مختلف أشكال نظام الدولة الإقليمي القائم على مبادئ ومصالح متّفق عليها. ففي غياب مثل هذا النظام، سوف ينزلق الشرق الأوسط نحو تحالفات ونزاعات متبدِّلة باستمرار حيث يجب على الولايات المتحدة أن تتنافس مع مجموعة كبيرة من الأفرقاء لضمان مصالحها ومصالح حلفائها. في حال خضعت المساعدات الأمنية الأميركية للإصلاح، فهل سيمكنها ذلك، على الأقل، من معالجة بعض هذه التحديات؟
تكنولوجيا الأسلحة وإصلاح المساعدات الأمنية
تتخذ التطورات التكنولوجية في نظم الأسلحة شكلَين مختلفين. يتمثل الشكل الأول في المقتضيات المتزايدة على نحو مستمر والمرتبطة بتطوير الأسلحة الرائدة في مجالها، لا سيما الطائرات التي يقودها طيار، وبسعرها وصيانتها. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر الطائرة المقاتلة "إف-16" التي تشتريها البلدان العربية من 36 مليون دولار في مطلع الثمانينيات إلى 122 مليون دولار حاليًا. وبعدما كان ثمن مروحية "أباتشي" 11 مليون دولار في عام 1995، أصبح 61 مليون دولار في عام 2020. وتُفيد تقارير بأن الإمارات سوف تدفع 10.4 مليارات دولار مقابل 50 مقاتلة "إف-35" طلبتها في عام 2020، أي إن سعر الطائرة الواحدة يتخطى 200 مليون دولار. أما تكاليف الصيانة والتدريب الخاصة بالمعدات التي تُستخدَم فيها تقنيات تزداد تطورًا فترتفع بوتيرة أسرع. إضافةً إلى التكاليف المرتفعة، يجب أيضًا دمج هذه الأسلحة في إطار النظم الإلكترونية المعقّدة لمراقبة ساحة المعركة والتي صُمِّمت كي تكون جزءًا منها، وهذه النظم هي أيضًا باهظة الثمن وكلفة صيانتها مرتفعة. فهذه الأسلحة والنظم ذات التقنيات المتطورة جدًا صُمِّمت بصورة أساسية لاستخدامها من جانب الجيش الأميركي، وتستنفد حتى قدرات البنتاغون.
أما النزعة الثانية فهي على طرف نقيض من النزعة الأولى في طيف التسلّح. فهناك أسلحة متطورة وغير متناظرة تصبح أكثر سهولة في التشغيل، وتتراجع كلفتها، وتزداد فتكًا. والأمثلة الأبرز على هذه النزعة هي الطائرات المسيّرة والصواريخ. فاستخدامها الفعّال، الذي ظهر مثلًا من خلال التحرّك التركي في غربي ليبيا في عام 2020، وما أقدمت عليه إيران ضد منشآت النفط السعودية في بقيق في أيلول/سبتمبر 2019، يطرح علامات استفهام وشكوكًا حول كلفة نظم الأسلحة الأكثر تعقيدًا والأغلى ثمنًا وفعاليتها في ساحة المعركة. وهذه الأسلحة التي أطلق عليها جنرال أميركي اسم "أسلحة Costco" في إشارة إلى متاجر التجزئة الشهيرة، تطرح تحدّيًا فيما يتعلق بالدور الذي تؤدّيه الأسلحة الأكثر قيمة وتطورًا في المساعدات الأمنية الأميركية.
تترتب على هذه النزعات التكنولوجية المتباينة آثار مهمّة حتى على الجيوش المتطوّرة. فهي تتطلب، في حالة الجهات المتلقّية، تكييفًا أكثر تأنّيًا للمشتريات مع الاحتياجات والموارد والإمكانات مقارنةً بالسابق. فقد بات عدد كبير من الجيوش في الشرق الأوسط أقل قدرة على شراء الجيل الجديد من نظم الأسلحة المتطوّرة وصيانته وتشغيله، ولذلك قد تُلبّى احتياجاتها على نحوٍ أفضل من خلال التركيز بصورة أكبر على الأسلحة غير المتناظرة مقرونةً بالعناصر البشرية والتنظيمية في قواتها المسلحة. ولكن حتى الآن، يستمر السباق على حيازة الأسلحة المتطورة في المنطقة، بدافعٍ من الاحتياجات الفعلية وتلك المتعلقة بالسمعة، دون إجراء تحليلات متأنّية لكلفة تلك الأسلحة في مقابل منافعها.
نحو مساعدات أمنية أميركية أكثر فعالية
من غير الممكن العودة إلى نموذج الحرب الباردة القائم على المساعدات الأمنية الشاملة والمقرونة بدعم واسع للتنمية. ما يمكن فعله هو إعادة تصوّر المساعدات الأمنية الثنائية، وفي الوقت نفسه التشجيع على إنشاء هندسة أمنية شرق أوسطية. والخطوة الأساس في هذا الإطار هي إعادة توزيع الوزن المعطى لكل واحد من المرتكزات الأساسية للمساعدات الأمنية، وهي، وفقًا لترتيب الأهمية الحالي، عمليات نقل الأسلحة، وصيانة تلك الأسلحة، والتدريب والمشورة، وبناء المؤسسات. تشكّل المؤسسات العاجزة في البلدان المتلقّية عوائق أمام بناء جيوش فعّالة ذات كفاءة وتشغيلها، إنما أيضًا أمام إرساء توازنات مناسبة بين التزامات الأمن القومي والاحتياجات العامة الأخرى. وفيما تصبح الجيوش في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر تعقيدًا وفتكًا وكلفة، تزداد الحاجة إلى الارتكاز، في تطويرها وعملياتها، على الاستراتيجيات والموازنات والتنظيم الداخلي انطلاقًا من تحليل التهديدات والإمكانات. وفي هذا الصدد، يجب إصلاح وزارات الدفاع التي تعمل عادةً بصورة مستقلة عن الحكومات المدنية في المنطقة، وتتألف طواقم عملها في أكثريتها الساحقة من عسكريين ذوي مهارات غير كافية للاضطلاع بهذه المهام، ودمجها في مؤسسات حكومية أخرى وإخضاعها لرقابتها. وتتمتع الولايات المتحدة بمزايا مقارنةً بغيرها من الدول في مجال دعم بناء المؤسسات. والمنافع المحتملة التي تنتج عن هذا النوع من التنمية تتخطى بأشواط تلك التي يولّدها شراء منظومة أسلحة جديدة باهظة الثمن.
على المستوى الإقليمي، يتحقق التحسّن الأكبر في الأمن من خلال الحد من تدفقات الأسلحة. ولكن فرض الشروط ليس إجراءً فعّالًا بحسب ما أظهرته محاولات إدارة أوباما للتعامل مع السيسي. حظر السلاح إجراء مضلَّل أيضًا. ويُشار في هذا السياق إلى أن المحاولة التي بُذِلت في مطلع الخمسينيات لفرض حظر سلاح على مصر انتهت بإبرام صفقة السلاح المصرية-التشيكوسلوفاكية في عام 1955، فكان ذلك إخفاقًا تقليديًا من إخفاقات الغرب في الحرب الباردة. وفي أعقاب حرب الخليج الأولى، سعت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب إلى الحد من نقل الأسلحة التقليدية وغير التقليدية إلى العراق، وطلبت الدعم من كبار مورّدي الأسلحة في هذا المجال. وقد باءت هذه المساعي بالفشل.
يُشير هذا التاريخ المؤسف، وهذه مفارقة، إلى أن اعتماد مقاربة أوسع نطاقًا، بدلًا من مقاربة تركّز حصرًا على الحد من نقل السلاح، قد يكون لديه حظوظ أكبر في النجاح. يجب على صنّاع السياسات النظر إلى نماذج نشأت خلال الحرب الباردة ونجحت في تحسين التواصل، وخفض احتمالات النزاع، والحد من سباقات التسلّح. المثال الأكبر على ذلك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تتألف من سبع وخمسين دولة عضو، ولعله المثل الأكثر ملاءمة في هذا المجال. يجب العمل على إنشاء إطار أمني شرق أوسطي بعد طول انتظار وتأخير. فمن شأن مجهود يقود إلى بناء هذا الإطار أن يساهم في تحقيق مكاسب لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تفوق تلك التي تؤمّنها سلسلة من الالتزامات الرامية إلى الحد من نزاعات محددة ومن تأثيراتها في مجموعة كبيرة من الساحات الإقليمية.
خلاصة
الهيكلية الحالية للمساعدات الأمنية الأميركية لا تخدم المصالح الأميركية ولا مصالح دول المنطقة. فهي تركّز أكثر مما ينبغي على نقل الأسلحة، وتعاني من قصور شديد فيما يتعلق بتحسين المؤسسات الوطنية أو إنشاء إطار أمني إقليمي. تتحمّل الجهات المتلقّية للمساعدات الأمنية تكاليف غير متكافئة مع مواردها، وعلى الأرجح مع احتياجاتها الدفاعية الفعلية. حتى إن الأسلحة التي تحصل عليها ليست مناسبة من أجل التصدّي للتهديدات الأكثر أهمية التي تحدق بأمنها القومي. لقد حان الوقت، بعد طول تأخير، لإجراء مراجعة معمّقة للمساعدات الأمنية الأميركية، وإشراك المورّدين الآخرين والجهات المتلقّية في نقاش طال انتظاره حول الطرق والوسائل التي تتيح تعزيز الأمن مقابل كلفة أقل.
روبرت سبرينغبورغ باحث غير مقيم في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية في روما، وأستاذ مساعد في جامعة سايمون فرايزر في فانكوفر. كان أستاذ شؤون الأمن القومي في كلية الدراسات العليا البحرية وأستاذ كرسي محمد بن عيسى الجابر لدراسات الشرق الأوسط في كلية الدراسات المشرقية والأفريقية في لندن. أحدث مؤلّفاته "مصر" (Egypt) (2018)، و"الاقتصادات السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"(Political Economies of the Middle East and North Africa) (2020)، الصادران عن منشورات "بوليتي برس".
طمأنة الشركاء الخليجيين فيما تعيد الولايات المتحدة تقويم سياستها الأمنية
تَعتبر جميعُ البلدان تقريبًا في مجلس التعاون الخليجي، استنادًا إلى قراءتها للسياسة الداخلية الأميركية والمشهد العالمي، أن الولايات المتحدة تتّجه نحو إعادة النظر في تموضعها في الشرق الأوسط. في الأعوام الأخيرة، اتّسعت الهوّة بين ما تتوقّعه دول الخليج من الولايات المتحدة وما تبديه واشنطن من استعدادٍ لتقديمه، ما يجعل إعادة التقويم أمرًا محتومًا. على الرغم من أن نطاق التحوّل الأميركي وحجمه والغاية منه لا تزال موضع نقاش، تستعد الحكومات الخليجية لهذا التحوّل، حتى ولو كانت ستقاوم على الأرجح أي تغييرات كبرى. ولكن هذا الاستعداد يترافق مع تباين في المشاعر، وهو عبارة عن مزيج غريب من القلق والثقة بالنفس يحرّك لدى تلك الدول الأمل بأن تقدّم لها أيُ أطراف جديدة تَدخُل إلى الساحة الخليجية منافع أمنية مماثلة، إنما يقترن في الوقت نفسه بالإدراك الواعي بأن الولايات المتحدة تبقى الضامن المفضّل لها والذي لا يمكنها الاستغناء عنه.
لن تكون إعادة الضبط مهمّةً بسيطة للخبراء الاستراتيجيين والمخططين الدفاعيين في واشنطن. فالبصمة العسكرية الأميركية كبيرة وراسخة، وتبقى دول الخليج شريكة أمنية واقتصادية أساسية للولايات المتحدة، ولا يزال عدد كبير من الهواجس الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي مبرَّرًا (مع أنها قد تكون مضخّمة في بعض الأحيان). ولا يمكن بسهولة غض النظر عن قدرة هذه الدول على التأثير في السياسة الأميركية أو تكبيدها كلفةً ما، أو حتى تحييدها عن مسارها. إذا كانت واشنطن تسعى إلى إرساء منظومة أمنية أكثر تعاونًا وشمولًا تتيح خفض انخراطها في الشرق الأوسط، عليها أن تعيد ضبط موقعها في المنطقة، وفي الوقت نفسه، أن تُطمئن شركاءها من خلال خطوات حذرة ومدروسة.
علاقات قائمة على الدبلوماسية الدفاعية
أدّت الأولوية التي مُنِحت للعلاقات الأمنية خلال العقود الأربعة المنصرمة إلى تشويه العلاقة الأوسع بين الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين الأساسيين في مجلس التعاون الخليجي. لقد أصبحت الدبلوماسية الدفاعية الطريقة المفضّلة للتعامل بين الطرفَين، إنما أيضًا الطريقة المعتمدة لغياب البدائل الأخرى، وهي تمنح انطباعًا بالاستمرارية مع التقلبات الحتمية التي تشهدها السياسة الخارجية الأميركية عند تبدُّل الرؤساء والإدارات. غالبًا ما يتفوّق قادة القيادة المركزية الأميركية (الذين يركّزون على القواعد العسكرية واللوجستيات والعمليات؛ ويُديرون أعدادًا كبيرة من العناصر وموارد طائلة؛ ويمكنهم استرضاء نظرائهم المحليين) وضباط الاستخبارات (الذين يتوجسون من التهديدات الأمنية الداخلية والعابرة للأوطان التي تعتبرها الحكومات الشرق أوسطية الأكثر حدّة) على الدبلوماسيين المغمورين الذين عادةً ما يتبعون أجندات أكثر تعقيدًا، ولا يمكن أن يُتوقَّع منهم المبادرة سريعًا إلى تنفيذ وعودهم أو تقديم المكافآت. وقد كانت هذه الدينامية مناسبة تمامًا لدول الخليج؛ فقد ساهمت في تسهيل العلاقات، لا سيما من خلال تهميش النقاشات المزعجة عن حقوق الإنسان والحوكمة الداخلية والآفاق الاقتصادية، وفي إعداد كوادر من الضباط الأصدقاء للولايات المتحدة ومن المحاورين في الشأن الدفاعي.
الوجه الآخر للمسألة هو أنه غالبًا ما أخفت العلاقات الدفاعية المعقّدة تدهورًا في العلاقات السياسية، أو حجبت المنطق الاستراتيجي المتغيِّر، أو عتّمت على التحديات الأمنية غير التقليدية. حين تتباين النظرات إلى التهديدات أو السياسات المتعلقة بالتعامل مع هذه التهديدات، تبادر واشنطن دائمًا إلى إجراء استشارات دفاعية أو ما يُسمّى بحوارات استراتيجية لتهدئة الخلافات. غير أن هذا الأسلوب الذي يُستخدَم بمثابة وسيلة للطمأنة تسبّبَ بتفاقم المشكلات في العلاقات بين الطرفَين من خلال الالتفاف على الثغرات الاستراتيجية والتشنجات السياسية المتعاظمة بدلًا من معالجتها.
وهذا ينطبق أيضًا على دول الخليج. فالعلاقات الدفاعية تحجب أي تشنجات قد تظهر مع واشنطن. ويُنظَر إلى مسائل مثل الحقوق في إنشاء قواعد عسكرية، وشحن كميات كبيرة من الأسلحة التقليدية، والتعاون العسكري بأنها شكلٌ من أشكال بوليصة التأمين التي تربط الولايات المتحدة (وحلفاءها) بالمنطقة. ويتجلّى هذا النوع من الحسابات من خلال الصفقة التي تنوي الإمارات العربية المتحدة بموجبها شراء طائرات "إف-35": فالهدف الأساسي، بمعزل عن مدى شرعية المنطق العسكري (وهو في هذه الحالة تحقيق التفوّق التكنولوجي على الخصوم)، يتمثّل بضمان علاقة أبو ظبي مع المؤسسة الدفاعية الأميركية في العقود الثلاثة المقبلة، بغض النظر عن الخلافات السياسية. وقد سلكت قطر مسارًا مشابًها حين تعرّضت لضغوط شديدة من جيرانها في عام 2017. فقد عمد القطريون إلى شراء مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية و"رافال" الفرنسية و"إف-15" الأميركية كي يحافظوا على علاقات قائمة على حسن النوايا مع العواصم الغربية الكبرى.
لم تحقّق هذه المقاربة النتائج المتوقّعة على المستوى الدفاعي. فدول مجلس التعاون الخليجي لا تزال عاجزة عن ضمان أمنها الخارجي بنفسها. ويقوم تظهير القوة الخليجية على المساعدات العسكرية والضمانات الأمنية الغربية حتى في الحالات التي يتعارض فيها مع المصالح والتفضيلات الغربية. تنتج كلفةٌ مرتفعة عن الإخلال بالمصالح الراسخة والريوع العسكرية والترتيبات المؤسسية القائمة منذ أربعين عامًا. وتشكّل القواعد والمنشآت العسكرية الأميركية، والعقود والخدمات الدفاعية الممتدّة لعقود، والتعاون العسكري المتين عامل ربط قويًا بين دول الخليج والولايات المتحدة.
الأهم من ذلك، أدّى التركيز على الدبلوماسية الدفاعية إلى تشتيت الانتباه عن التهديدات الأمنية غير التقليدية التي تحدق بالاستقرار الخليجي. فالمقاربة الأمنية التي تنتهجها واشنطن لم تعطِ الأولوية للمسائل التي تحفل بها أجندة مجلس التعاون الخليجي، ولم تعمل على معالجتها، بدءًا من التغير المناخي والانتقال إلى استخدام مصادر أخرى للطاقة وصولًا إلى الحوكمة والتحوّل الاقتصادي.
تعرُّض العلاقات الأميركية-الخليجية لسلسلة صدمات
اليوم، تجد دول خليجية كبرى مثل السعودية والإمارات نفسها في اصطفافٍ مختلف عن الولايات المتحدة أو في تعارضٍ معها في مسائل كثيرة. هذا الواقع الذي حُجِب خلال رئاسة دونالد ترامب بسبب اعتماده مقاربة قائمة إلى حد كبير على الشخصنة والصفقات، برزَ بقوّة من خلال العودة إلى الأسلوب الأكثر انضباطًا في إدارة شؤون الدولة في عهد الرئيس جو بايدن.
لقد تعرّضت العلاقات بين الولايات المتحدة وشركائها الخليجيين لصدمات عدّة في العقود الأخيرة، بدءًا من الاجتياح الأميركي للعراق في عام 2003 وما نتج عنه من صعودٍ لإيران. وشكّلت الانتفاضات العربية في عام 2011 مصدرًا آخر للتشنجات بين الطرفَين. فاحتضان الولايات المتحدة (الذي يمكن القول بأنه كان متردّدًا ولم يُعمّر طويلًا) للتغيير الثوري أثار حفيظة الأنظمة الملكية المحافظة في الخليج. وتسببت المنافسة الإقليمية الفوضوية التي أعقبت الانتفاضات بمزيد من التوتر في العلاقات بين الطرفَين.
أما التحدّي الأكبر للعلاقات الأميركية-الخليجية فيتمثّل في الدبلوماسية النووية التي تنتهجها واشنطن مع إيران منذ عام 2012. فالطريقة التي استخدمتها إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما في إجراء المفاوضات أكّدت التصوّرات التي كانت دول الخليج قد كوّنتها مسبقًا عن الانخراط الأميركي مع إيران. والاستياء من الاتفاق الذي انبثق عن المفاوضات لم يكن نابعًا من بنوده الفعلية بقدر ما كان مدفوعًا بالشكوك من أن الولايات المتحدة قد تهمّش الهواجس الخليجية، لا سيما في ما يتعلق بشبكة إيران الميليشياوية وبرنامجها الصاروخي، بغية حماية نجاحها الدبلوماسي، فتمهّد بذلك الطريق أمام مزيد من التمدد الإيراني. وبطبيعة الحال، فُسِّرت السياسة التي انتهجتها الولايات المتحدة لاحقًا في العراق ولبنان وسورية واليمن من خلال هذا المنظار. وقد بلغ الاستياء من واشنطن ذروته حين لمّح أوباما في مقابله مع مجلة "ذي أتلانتيك" في عام 2016 إلى أنه يجب على السعودية وإيران "إيجاد طريقة فعّالة لتقاسم المنطقة المجاورة". فقد اعتُبِر هذا الكلام، عن صواب أو خطأ، أنه مؤشّر عن استيعاب أميركي لإيران ينمّ عن سوء قراءة أساسية للأطماع الإيرانية.
انكشفت حقيقة الأمور بالطريقة الأوضح حين تعرّضت منشآت نفطية سعودية كبرى لهجمات ضخمة في أيلول/سبتمبر 2019، وأفادت التقارير عن وقوف إيران وراء الهجمات ردًا على استراتيجية الضغوط القصوى التي انتهجتها إدارة ترامب. وقد تسببت الهجمات التي شُنَّت بواسطة الطائرات المسيَّرة والصواريخ، بخفض الصادرات النفطية السعودية إلى النصف لبضعة أسابيع، وأظهرت نقاط الضعف الجغرافية المستمرة التي تعاني منها دول الخليج في مواجهة الجبروت العسكري الإيراني. التزمت الولايات المتحدة الصمت نسبيًا؛ فقد أحجمت عن تحديد المعتدين وحمّلت السعودية المسؤولية، على الرغم من التقارب الظاهري بين الأسرة الحاكمة السعودية وإدارة ترامب.
في الواقع، أظهرت هذه الهجمات بوضوح لدول الخليج تراجع التزام واشنطن الأمني تجاه المنطقة بغض النظر عن هويّة الجالس في البيت الأبيض. فقد أعادت الولايات المتحدة تأطير أمن الطاقة في الخليج فتعاملت معه بصورة أساسية على أنه من مسؤولية القوى المحلية، وليس مصلحة عامة عالمية من شأنها أن تدافع عنها بالضرورة وبصورة أحادية. وشكّلت هذه المحطة بداية تغييرات مستقبلية في الموقف الأميركي، ما أرغم دول الخليج على اعتماد أسلوب جديد في التفكير الأمني والتخطيط الدفاعي. لم تُعرِّض واشنطن شركاءها المحليين للعدوان الإيراني فحسب، بل إنه لم يعد بإمكانهم أن يعتبروا الضمانة الأميركية التي يتباهون بها، أمرًا أكيدًا أو مطلقًا أو تلقائيًا. وهكذا دُفِن فعليًا ما تبقّى من عقيدة الرئيس جيمي كارتر التي قامت على الدفاع عن المصلحة القومية الأميركية في الخليج. ولكن أظهر ذلك، في الوقت نفسه، اعتماد الخليج الدائم على الولايات المتحدة؛ فقد طلبت السعودية نشر مدفعيات أميركية للدفاع الجوي على أراضيها واستُجيب لطلبها، وأظهرت دول الخليج اهتمامًا أكبر بنشر أنظمة الإنذار المبكر وأنظمة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع إضافةً إلى أنظمة الدفاع الصاروخي والدفاع المتعدد الطبقات المصنوعة في الولايات المتحدة.
غالبًا ما يلفت المسؤولون الخليجيون إلى التناقض بين رغبة واشنطن في أن تتحمّل القوى المحلية مسؤولية الأمن الإقليمي وبين توقعاتها بأن تستمر هذه القوى في الاصطفاف إلى جانب المعايير الأميركية وخيارات الولايات المتحدة في السياسات. ولكن الخطوات نفسها التي يعتبرها كثرٌ في واشنطن غير ضرورية أو متهوّرة أو عدائية، يُنظَر إليها في معظم الأحيان في العواصم الخليجية بأنها ضرورية ومبرَّرة ودفاعية. والأزمة في اليمن هي خير دليل على هذا الانقسام. ففي حين أن المسؤولين في الخليج يركّزون على مزايا التدخّل الذي تقوده السعودية، وضرورته الاستراتيجية، وقانونيته، يُبدي المسؤولون الأميركيون، وعلى رأسهم المشرِعون، قلقهم المتزايد من همجية هذا التدخل، ومن التأثير الإنساني للحصار المتواصل، ومن الأعباء الأخلاقية والسياسية المترتّبة على الولايات المتحدة. حتى في الوقت الذي تشدّد فيه واشنطن على الانتهاكات السعودية لقانون النزاع المسلّح، يحاجج المسؤولون السعوديون والإماراتيون بأن التساهل الدولي هو الذي أتاح للحوثيين التوسّع، والاستحواذ على ترسانة من الصواريخ، وتعزيز روابطهم مع إيران، ما جعل الحرب أمرًا محتومًا.
وجهات النظر الخليجية بشأن النقاش الأميركي حول خفض الوجود في الشرق الأوسط
فيما يناقش صنّاع السياسات في واشنطن مستقبل التواجد الأميركي في الشرق الأوسط، تراقب دول الخليج مسار النقاش بارتباكٍ وخوف. فهذه الدول واثقة على ما يبدو من أن شبكة العلاقات المكثّفة التي بنتها مع الولايات المتحدة سوف تحدّ من أي خطوات فجائية أو جذرية. ولكنها قلقة من صعود تحالف متنوّع ومتوسّع يرفع الصوت عاليًا للمطالبة بإعادة تقييم العلاقات الأميركية-الخليجية.
تعتبر دول الخليج أنها شريكة وفيّة وممتنّة دعمت السياسات الأميركية في معظم المسائل، والتزمت الصمت عند وقوع خلاف في الرأي مع الولايات المتحدة، ومثالٌ على ذلك حرب العراق والنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. في نظر هذه الدول، قوّضت الولايات المتحدة منظومة إقليمية كانت تعود بالفائدة على الأنظمة الملكية حين أقدمت على اجتياح العراق في عام 2003، ودعمت الحركات الثورية في عام 2011، وأعطت الأولوية للتوصل إلى اتفاق نووي مع طهران مقدِّمةً إياه على هواجس دول مجلس التعاون الخليجي. يُشار أيضًا إلى أن تعزيز دول الخليج لترسانتها من الأسلحة واعتمادها سياسات خارجية عدوانية جاء بعد هذه التغييرات الهائلة وليس قبلها. ففي نظر هذه الدول، الحفاظ على علاقات وثيقة هو السبيل الأفضل كي تُعوِّض واشنطن عن هذه الاختلالات التي صنعتها، وقد دفعت دول الخليج أكثر من تريليون دولار على مر عقود عدّة لضمان ذلك.
يطغى على التفكير الخليجي الخوف من أن تبرهن واشنطن عن سذاجة ووقاحة في الوقت نفسه فيما يتعلق بإيران. وفي هذا السياق، لا يزال عدد كبير من المسؤولين الخليجيين يتخوّف من أن الهدف من الدبلوماسية النووية مع إيران هو تمهيد الطريق أمام الولايات المتحدة لاستيعاب طهران، وتجاهل هواجس دول مجلس التعاون الخليجي، وفي نهاية المطاف السماح لإيران بفرض هيمنتها. يعتبر المسؤولون والمراقبون الخليجيون أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران الصاروخي وممارستها لنفوذها في المنطقة، فيجب أن يقترن أي اتفاق نووي مع إيران بحصول الدول الخليجية على ضمانات أمنية أميركية إضافية. لا شك في أن هذا المطلب يتعارض مع أهداف السياسات الأميركية في الشرق الأوسط، إذ تسعى هذه السياسات إلى خفض الالتزامات الأمنية بدلًا من توسيعها.
من وجهة نظر دول الخليج، ثمة حجج قوية أخرى مؤيِّدة لضرورة حفاظ الولايات المتحدة على التزام دائم تجاه المنطقة. فغالب الظن أن الخليج سيكون ساحة أساسية للمنافسة بين القوى العظمى، في ضوء المصالح الصينية في مجالَي الطاقة والاقتصاد الجغرافي ومناورات القوة الروسية. إذا خفّضت الولايات المتحدة دورها إلى حد كبير، فقد يدفع ذلك بالقوى المحلية إلى تعزيز انخراطها مع خصوم واشنطن الاستراتيجيين. يسارع المسؤولون في الخليج إلى الإشارة إلى أن هذا الخيار ليس المفضّل لديهم، ولكن المعطيات الجيوسياسية قد تقتضي خلاف ذلك. بيد أن هذا التحذير المسبق لا يتناسب مع الإقرار الواسع بأن روسيا شريك يُفرط بإغداق الوعود ولا يلتزم بتعهداته، في حين أن الصين ذات النزعة التجارية الانتهازية تُظهر ترددًا في تحمّل الأعباء الأمنية.
هل هناك فعلًا شركاء أمنيون بديلون؟
صحيح أن دول الخليج لجأت إلى التنويع الاستراتيجي قبل التشنجات الأخيرة، لكن القلق من انحسار الدور الأميركي ساهم في تسريع وتيرته. لطالما كانت دول الخليج حسّاسة إزاء تحوّلات القوّة العالمية، سواءً كانت حقيقية أو متصوّرة، ولطالما أظهرت حرصها على بناء علاقات مع القوى الكبرى حتى حين يكون هناك تباين في المصالح معها. لذلك، تُقدّم إعادة صعود روسيا في الشرق الأوسط ودخول الصين إلى المنطقة إمكانات مغرية، ولو كانت هناك مغالاةٌ في تصويرها.
لقد حاول جميع شركاء الولايات المتحدة تقريبًا في المنطقة تنويع إمداداتهم من الأسلحة خلال العقد المنصرم. وفي هذا الإطار، يستطيع زوّار معرض ومؤتمر الدفاع الدولي في أبو ظبي أن يروا المجموعة الواسعة من الأسلحة والخدمات غير الغربية التي باتت متوافرة لبلدان الشرق الأوسط. فحين مُنِعت السعودية والإمارات العربية المتحدة مثلًا من الحصول على طائرات مسيّرة ومسلّحة أميركية الصنع، أقدمت السعودية على شراء طائرات رينبو CH-4B Rainbow صينية فيما اشترت الإمارات طائرات وينغ لونغ Wing Long II صينية. وتفيد تقارير بأن منظومتَي "القبة الحديدية" و"مقلاع داوود" الإسرائيليتين تَردان في أعلى قائمة الأسلحة التي ترغب دول الخليج في شرائها.
إذن، تعبير دول الخليج عن نيّتها شراء نظم أسلحة متطوّرة من خصوم الولايات المتحدة هو إحدى الوسائل التي تلجأ إليها هذه الدول لإبداء استيائها من واشنطن وإظهار استقلالها عنها، ولكنه لا يمثّل تحولًا حقيقيًا ومنسَّقًا للابتعاد عن الولايات المتحدة. وتلقى هذه الخطوة أيضًا أصداء لدى الشعوب العربية التي تحظى الصين وروسيا بشعبية في أوساطها، وذلك خلافًا للولايات المتحدة. في هذا الصدد، تنظر السعودية مثلًا في إمكانية شراء المنظومة الدفاعية الجوية "إس-400" من روسيا، وهذا ما تفعله قطر أيضًا. يصب ذلك في إطار هدفَين استراتيجيين: فهو مؤشرٌ على استياء المملكة من السياسة الأميركية، ولكنه أيضًا وسيلة لكسب الحظوة لدى موسكو وضمان عدم اصطفافها إلى جانب طهران. أما الإمارات فأعلنت من جهتها في عام 2017 أنها ستتعاون مع روسيا من أجل تطوير طائرة من الجيل الخامس. بيد أن آفاق هذا التعاون منخفضة، وفي عام 2020، طلبت الإمارات مقاتلات "إف-35" أميركية.
يتّسم المنطق الذي تستخدمه دول الخليج في شراء الأسلحة ببعض المشروعية. فقد كشفت هجمات أيلول/سبتمبر 2019 أن السعودية هشّة جغرافيًا إزاء الهجمات الجوية؛ ولذلك منظومة "إس-400" الروسية جاذبة جدًا للمؤسسة الدفاعية السعودية. هذا فضلًا عن أن تكاليف شراء نظم الأسلحة الغربية وتشغيلها أعلى بكثير، وآليات الشراء من الدول الغربية تستغرق وقتًا طويلًا وتترافق مع مخاطر سياسية (وهو ما اختبرته السعودية والإمارات مؤخّرًا وسط معارضة الكونغرس لمبيعات الأسلحة إلى هاتين الدولتين على خلفية حرب اليمن).
ولكن مهما بلغت جاذبية الخيارات الروسية والصينية على صعيد شراء الأسلحة، لا يُقدّم أي منها في سلّةٍ واحدة الخدمات الأمنية والمنتجات، وفي نهاية المطاف، الضمانات التي تؤمّنها الولايات المتحدة. تدرك دول الخليج أن معضلتها الأساسية هي أن رهانها الأفضل على الأمن هو في الغرب، على الرغم من أن الازدهار قد يأتي من الشرق. فالضمانة التي يؤمّنها الدعم الاستراتيجي الأميركي لا يمكن استبدالها في المستقبل المنظور؛ ولذلك فإن أي تحوّط تقوم به دول الخليج في رهاناتها هو حكمًا محدود. يدرك المسؤولون عن الدفاع العرب أن التكنولوجيا الأميركية والغربية تبقى الأكثر جاذبية وإثباتًا لفعاليتها في القتال. وفي هذا الإطار، يُشار إلى أن 61 في المئة من مشتريات السعودية من الأسلحة كان مصدرها الولايات المتحدة بين عامَي 2013 و2017، وتأتي المملكة المتحدة في المرتبة الثانية (23 في المئة)، ثم تليها فرنسا (3.6 في المئة). تعود جاذبية الولايات المتحدة وقدرتها على الاستمالة، من جملة أسباب أخرى، إلى القائمة الطويلة لخدمات ما بعد المبيع، والتدريب، والدمج التي لا يُقدّمها عادةً المتعاقدون غير الغربيين، والتي تشكّل رابطًا دبلوماسيًا قويًا ومهمًا.
إعادة التقويم تتطلب تطمينات
يعتبر كثرٌ في واشنطن أن صورة السعودية والإمارات تلطّخت على نحوٍ دامغ باحتضانهما لإدارة ترامب، ودعمهما للانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي الإيراني، وتدخّلهما العسكري في اليمن (وبدرجة أقل في ليبيا). نتيجةً لذلك، تبدي أوساط كثيرة تململًا من الهواجس الأمنية التي تعبّر عنها هاتان الدولتان، وغالبًا ما يُصرَف النظر عن الجهود التي تبذلها السعودية والإمارات لإعادة تقويم وضبط سياساتهما منذ عام 2019 على اعتبار أنها جهود محدودة ومتأخرة جدًا. تُبدي الرياض وأبو ظبي – وكذلك الكويت والمنامة والدوحة وحتى مسقط - خشيتها من أن تعمد الولايات المتحدة، مع مرور الوقت، إلى إجراء خفوضات كبيرة في وجودها على الأرض، وإلى وقف مبيعات الأسلحة، وفي نهاية المطاف خفض التزامها.
ليست هذه المخاوف مبرَّرة بالضرورة. فقد تعهّد بايدن بـ"الدفاع عن سيادة [السعودية] وسلامة أراضيها وشعبها"، ولا مؤشرات (حتى الآن) عن توتّر في العلاقات. ولكن إذا لم تخضع العلاقات لإعادة تعريف على أسس سليمة، فمن شأن الدعوات، التي يطلقها مسؤولون سابقون ومُحلِلون، لإغلاق القاعدة البحرية في البحرين، وإلغاء مبيعات الأسلحة التي سبق الاتفاق عليها، ووقف صفقات الأسلحة في المستقبل، وإرساء توازنات بين دول الخليج وإيران، أن تلقى تجاوبًا أكبر لدى المسؤولين الأميركيين وكذلك داخل الكونغرس الأميركي.
القواعد الأميركية في الخليج هي العنصر الأكثر وضوحًا للعيان في العلاقات الأمنية بين الطرفَين، ولعلها تأتي في رأس قائمة المسائل التي يجب أن تخضع لإعادة التقييم. فالبصمة الأميركية الراهنة (بوجود قواعد ومنشآت في كل دولة من دول الخليج) مفرَطة الحجم والموارد، ومكشوفة سياسيًا، ومثيرة للجدل عسكريًا، إذ إن ردع إيران لا يحتاج إلى هذا الوجود الضخم. لا بل إن الطبيعة المتغيِّرة للحروب والتطورات التكنولوجية الإيرانية تجعل المنشآت الأميركية عائقًا في بعض النواحي. يمكن خفض البصمة الأميركية إذا عمدت واشنطن أيضًا إلى تشجيع الجهود التي يبذلها مجلس التعاون الخليجي لتطوير نظم الإنذار المبكر، ونظم الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، والدفاعات الجوية الحديثة، والأمن البحري.
أما مبيعات الأسلحة فهي مسألة أكثر تعقيدًا. ثمة ميلٌ في واشنطن إلى التمييز بين الإمكانات الهجومية والدفاعية، مع التعهّد بتأمين الإمكانات الدفاعية فقط. ولكن ليس هناك فارق واضح بين الاثنَين، والاعتماد الكامل على الدفاع الجوي والصاروخي غير مرضٍ استراتيجيًا، وغير كافٍ عملياتياً، وباهظ الكلفة. في هذا الإطار، ومع قيام الأمم المتحدة برفع جزءٍ من حظر السلاح المفروض على إيران في عام 2020، على أن يُرفَع جزءٌ آخر من الحظر في عام 2023، غالب الظن أن طهران ستعمد إلى زيادة أعداد صواريخها وطائراتها المسيّرة وإلى تعزيز تفوّق أذرعتها، والحفاظ على تقدّمها النووي. سوف تسعى دول الخليج إلى الحفاظ على تفوّقها التقليدي، لضمان ردع موثوق في مواجهة إيران، إنما أيضًا كي تُظهر لمواطنيها درجةً من الاعتماد على النفس. وما لم تُبدِ واشنطن استعدادًا لتحمّل عبء الردع بمفردها، سوف تظل مبيعات نظم الأسلحة المتطوّرة تشغل موقعًا متقدّمًا على أجندة العلاقات الثنائية بين الطرفَين. ولكن يمكن التفاوض على حجم هذه الصفقات الضخمة بهدف خفضه.
الأهم من ذلك، ينبغي التركيز على فرض شروط صارمة على ممارسة القوة في المنطقة، والتشديد على المساءلة في هذا المجال. تستطيع الولايات المتحدة أن تحدد بدقّة المعايير والظروف التي تمنح بموجبها المساعدة (بما في ذلك إعادة التموين، وخدمات الصيانة، والدعم اللوجستي أو الاستخباري) أو تحجبها عن التدخلات خارج دول مجلس التعاون الخليجي. ويجب أن تكون لدى واشنطن أيضًا رؤية واضحة عن أشكال المساعدة التي ترغب في حجبها عن شركائها، أو حتى في بعض الحالات، عن أشكال العقوبات التي تبدي استعدادًا لفرضها. فتعقيدات ساحات المعارك في الزمن الحديث، وتذبذبات السجل العسكري للولايات المتحدة، والانطباع بأن واشنطن تروّج لمعايير لا تتقيّد بها بالضرورة، والإدراك بأن هناك تراجعًا في الامتثال لقانون النزاع المسلّح، سوف تجعل مجتمعةً المقاربة القانونية أو التقنية المحضة أقل فعالية من الانخراط الدبلوماسي المكثّف والمتبصّر.
يعرف الخبراء الاستراتيجيون جيدًا أن إعطاء التطمينات أصعب وأكثر كلفة إلى حد كبير مقارنةً بالردع. لذلك من الجيّد أن تبدأ الولايات المتحدة بالتخلّي عن نزعتها إلى التطمين القائم على الدبلوماسية الدفاعية.
إميل حكيّم باحث أول لشؤون أمن الشرق الأوسط في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية.
خفض الوجود العسكري الأميركي
تحاول الولايات المتحدة، منذ أكثر من عقدٍ من الزمن، خفض تدخّلها في حروب الشرق الأوسط وتحويل انتباهها إلى آسيا. وقد تعثّرت المحاولات الأخيرة لتحويل الموارد العسكرية الأميركية بعيدًا عن الشرق الأوسط، بما في ذلك الانسحابات التي لم تتحقق، والحضور المعزَّز للقوات العسكرية بهدف "إعادة إرساء الردع". الآن، تنوي الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن إعادة النظر في الوضعية العسكرية الأميركية التي تعتبرها بائدة في الشرق الأوسط بغية تحرير الموارد الضرورية للتنافس مع الصين على نحوٍ أفضل. يبدو واضحًا بصورة متزايدة أن البصمة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط سوف تتغيّر. ولكن ليس واضحًا تمامًا كيف يجب أن تتغيّر الوضعية الأميركية وما هو السبيل لتغييرها بطريقة مسؤولة تصون المصالح الأميركية الجوهرية.
منطق الوجود الأميركي
يمكن القول بأن جذور الأمن الأميركي في الشرق الأوسط ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية، حين تسببت العمليات العسكرية المتوسِّعة بزيادة الحاجة إلى مصادر نفطية جديدة ووافرة. وقد فتح ذلك الباب أمام المقايضة، أي السماح للولايات المتحدة بالوصول إلى مصادر الطاقة في المنطقة مقابل الحصول على الأمن. ولكن لم تكن هناك حاجة إلى حضور عسكري كبير للحفاظ على هذه العلاقة. ففي مرحلة طويلة من الحرب الباردة، كان الحضور الأميركي في الشرق الأوسط محدودًا، وكان الهدف منه الحد من النفوذ السوفياتي المتوغِّل والتحوّط في مواجهة اجتياح سوفياتي محتمل. ولكن عقيدة كارتر لعام 1980، والهجمات على ناقلات النفط خلال الحرب الإيرانية-العراقية، والحاجة إلى احتواء العدوان العراقي في أعقاب حرب الخليج الأولى فرضت مجتمعةً أن يكون للولايات المتحدة حضورٌ دائم أوسع نطاقًا، وهو ما شكّل جذور التموضع الأميركي الراهن في الشرق الأوسط. وبعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر 2001، والنزاعات المتتالية في الشرق الأوسط، استمرت هيكلية القواعد العسكرية في النمو على نطاق واسع. وهكذا تضخّم حجم بعض المنشآت على غرار قاعدة العديد الجوية في قطر ومعسكر عريفجان في الكويت، وتحوّلت إلى قواعد عمليات أساسية ودائمة.
اليوم، تستوفي المجموعة الكبيرة من القواعد الأميركية في الشرق الأوسط عددًا من المقتضيات. وقد ساهمت العمليات الجارية في أفغانستان وتلك التي تستهدف التنظيم المسمّى الدولة الإسلامية في العراق وسورية في تعزيز الحاجة إلى هذه المراكز العملياتية. وهي تلبّي أيضًا متطلبات زمن السلم، مثل دعم مهام الردع في مواجهة إيران وأنشطة التعاون الأمني التي ترمي إلى تعزيز الإمكانات العسكرية للشركاء في المنطقة. وقد دُعِمت هذه الأنشطة من خلال الصفقات الراسخة لبيع الأسلحة إلى الشركاء الإقليميين، لا سيما دول الخليج، وسط عودة المنافسة بين القوى العظمى، أي بين الولايات المتحدة من جهة وروسيا والصين من جهة ثانية. هذا فضلًا عن أن هذه القواعد والعناصر الأميركية المتمركزة فيها هي بمثابة تذكير دائم بالضمانة الأمنية الأميركية القائمة منذ وقت طويل والتي تُعتبَر أساسية لطمأنة الشركاء.
تبدُّل الأولويات الأمنية الأميركية
لم يساهم التموضع العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، دائمًا، في تحقيق الأهداف الأميركية أو دعم المصالح الأميركية الأساسية، ما يؤشّر إلى الحاجة إلى إعادة النظر في الرابط بين المصالح الاستراتيجية والحضور على الأرض. وقد كان الحفاظ على الاستقرار والوصول إلى نفط الشرق الأوسط، لفترة طويلة، مصلحة معلَنة للولايات المتحدة. بيد أن تنويع مصادر الطاقة عالميًا، بما في ذلك ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة، مقرونًا بانخفاض استهلاك النفط، أدّى إلى إضعاف قدرة دول الخليج على السيطرة على سعر النفط. وفي حين أن بلدانًا كثيرة على غرار الصين لا تزال تعتمد على الشرق الأوسط لاستيفاء احتياجاتها من الطاقة، لم يعد الأمر كذلك بالنسبة إلى الولايات المتحدة.
تمثل حماية الداخل الأميركي مصلحةً دائمةً بالنسبة إلى الولايات المتحدة. ومن هذا المنطلق، يبقى ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط أولوية. فالنزاعات المتواصلة قد تولّد الظروف المواتية لظهور ملاذات آمنة للإرهابيين أو انتشارها. في حال تكاثرت التهديدات التي تنشؤها الدول، على غرار التهديد الإيراني، أو عزّزت شبكة أذرعها العالمية، قد يشكّل ذلك تهديدًا للداخل الأميركي. بيد أن هندسة القواعد الأميركية في المنطقة، والتي أُنشِئت أصلًا من أجل التصدّي للتهديدات التي تنشؤها الدول، غير مناسبة لمواجهة التهديد الفريد الذي يشكّله الأفرقاء غير التابعين للدولة، الذين يجسّدون الخطر الأكبر المحدِق بالأمن الداخلي الأميركي.
أخيرًا، على الرغم من أن الولايات المتحدة غرقت طوال عقود في مستنقع الشرق الأوسط وتورّطت في النزاعات الإقليمية، ربما تُحقّق وأخيرًا انعطافتها المنشودة منذ وقت طويل نحو آسيا. لقد أعلنت استراتيجية الدفاع الوطني لعام 2018 بوضوح أن القوتَين العظميين المنافستَين، الصين وروسيا، تشكّلان التهديد الطويل الأمد الأبرز للمنظومة الدولية بقيادة الولايات المتحدة. وتُشير التصريحات التي أدلى بها بايدن مؤخرًا إلى أن الصين ستكون محط تركيز إدارته. وهذا يُنذر بتحوّلٍ نحو آسيا على صعيد القوات والإمكانات والموارد، ما سيؤثّر حكمًا في التموضع الأميركي في الشرق الأوسط.
الحجج المناهضة للقواعد الأميركية
من وجهة نظر استراتيجية، لا يرتبط الوجود الأميركي في الشرق الأوسط ارتباطًا مباشرًا بالمصالح الأميركية الأساسية. يقول المنتقدون إن الوجود الأميركي المستمر سوف يساهم إن لم يؤجّج الاضطراب المستمر في الشرق الأوسط، والذي غالبًا ما يشكّل الدافع وراء العمليات الأميركية. تستشهد هذه الحجج بتراجع اعتماد الولايات المتحدة على النفط والغاز القادمَين من الشرق الأوسط، وظهور تنظيمات إرهابية إقليمية مُصمِّمة على مهاجمة القوات الأميركية، تحديدًا من أجل فرض انسحابٍ عسكري.
على مستوى العمليات، الوجود العسكري الأميركي المستمر في الشرق الأوسط يأتي مباشرةً على حساب القوات الأميركية في مناطق أخرى أكثر حساسية. في الوقت نفسه، يعتبر المنتقدون أن الوجود الأميركي المستمر يساهم في عجز دول الإقليم عن تطوير إمكاناتها العسكرية أو عدم استعدادها لذلك. ويسلّطون الضوء أيضًا على المخاطر المتزايدة التي تتعرض لها القوات الأميركية مع تطوُّر إمكانات الأعداء في الإقليم مثل إيران، ويزعمون أن الحاجة إلى الوجود في قواعد العمليات المتقدمة انتفت بفضل التطورات التكنولوجية الجديدة في الحروب.
هذه الحجج تؤيّدها أدلةٌ داعِمة. فقد تعرّضت القوات الأميركية للهجمات على يد تنظيمات إرهابية، لا سيما تفجير أبراج الخبر في عام 1996، والهجمات الصاروخية الأخيرة التي شنّتها مجموعات مدعومة من إيران في العراق. كذلك ساهم الوجود العسكري الأميركي في تعزيز أمن الأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، ما شجّع هذه الأنظمة السلطوية على قمع مواطنيها، كما حدث مثلًا في البحرين بعد انتفاضات 14 شباط/فبراير 2011.
نظرًا إلى وجود القوات الأميركية والالتزام الأمني الأميركي غير المعلَن، لم يستثمر عدد كبير من بلدان المنطقة على نحوٍ واسع في بناء جيوشه. وقد استخدم بعض الشركاء، على غرار السعودية والإمارات العربية المتحدة، إمكاناتهم الناشئة بطرق تتعارض مع المصالح الأميركية.
علاوةً على ذلك، وضعت الإمكانات المتزايدة للخصوم في الإقليم المنشآت العسكرية الأميركية في دائرة الخطر. في هذا الإطار، تُشكّل إيران تحديدًا خطرًا على قدرة القوات الأميركية على البقاء ومن الممكن أن تعرقل العمليات العسكرية الأميركية، فيما تعمل طهران على بناء إمكاناتها الصاروخية، وتستخدم تكنولوجيات جديدة مثل المركبات الجوية المسيّرة، وتُوزّع إمكاناتها على القوات والأذرع التي تتحرك بالوكالة عنها. إضافةً إلى ذلك، وفي حين أن التطورات في الإمكانات العسكرية الأميركية تتيح تنفيذ العمليات عن بعد، من غير المرجّح لها ولا يمكنها أن تحلّ مكان قواعد العمليات المتقدمة في الشرق الأوسط، سواءً في حال وقوع أحداث طارئة تفتعلها إيران أو ردًا على التهديدات الإرهابية.
ربط المصالح بالمهام والبعثات
أيّ تغييراتٍ في التموضع الأميركي في الشرق الأوسط يجب أن يتم بطريقة مسؤولة كي لا تمسّ بالمصالح أو العمليات العسكرية الأميركية الأساسية، ومن أجل الحفاظ على العلاقات مع الشركاء الإقليميين. إنها مهمّة صعبة، ولكن طال انتظارها. وفي هذا السياق، تُتيح مراجعة تموضع القوات الأميركية في العالم التي أعلن عنها وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في شباط/فبراير 2021 فرصةً من أجل إرساء الأسس اللازمة لإعادة النظر في الوجود الأميركي في الشرق الأوسط، فالمراجعة ترمي إلى الربط على نحوٍ أفضل بين البصمة العسكرية الأميركية في العالم والمصالح القومية.
مع مرور الوقت، اضمحلّت أهمية المصالح الأوّلية التي كانت في أساس الوجود الأميركي في المنطقة، فمصادر الطاقة لم تعد تشغل المكانة نفسها كما في السابق. في المراحل المقبلة، ينبغي أن يقوم الوجود العسكري الأميركي على القيمة الاستراتيجية الفعلية، لا على دعم الأهداف المتعلقة بالحفاظ على الإرث، ويجب أن تُربَط المصالح والأهداف الأميركية الأساسية مباشرةً بالمهام والبعثات. وينبغي أن يُملي ذلك بدوره عديد القوات وحجم الإمكانات المطلوبة لتنفيذ تلك المهام، وموقعها.
على سبيل المثال، بات ضمان حرية الإبحار في نقاط الاختناق البحرية الحسّاسة في مختلف أنحاء الشرق الأوسط هدفًا ثانويًا على الأرجح. من هذا المنطلق، يجب إعادة النظر في المستوى المناسب من الجهود والموارد المطلوبة للنهوض بهذه المسؤولية، لا سيما على خلفية تراجع مستوى الجاهزية البحرية الأميركية، وفرض ضرائب مرتفعة جدًا على موارد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. لا تتطلب هذه المهمة فرقة قتالية من حاملات الطائرات، ويجب ألا تُستخدَم مبرِّرًا للإبقاء على وجود حاملات الطائرات بصورة مستمرة في المنطقة. إذن، من أجل أداء هذه المهمة بمستوى مختلف من الموارد، يجب على الشركاء في الإقليم وغيرهم من الحلفاء، وعددٌ كبير منهم لديه أيضًا مصلحة في الحفاظ على حرية تدفّق مصادر الطاقة، الاضطلاع بمسؤوليات إضافية.
في المشهد الاستراتيجي الحالي، أصبح الهدف الأميركي الأكثر محورية في الشرق الأوسط هو تحقيق الاستقرار، لارتباطه بالمصلحة الأميركية الجوهرية المتمثّلة بحماية الداخل الأميركي. من هذا المنطلق، يجب أن تحتفظ الولايات المتحدة بإمكانية الوصول إلى عدد قليل من القواعد الأساسية في الشرق الأوسط في حال وقوع أحداث طارئة تفتعلها إيران أو أي مجموعات غير تابعة للدول، وأن تتمكن الولايات المتحدة من تنفيذ عمليات محدودة لمكافحة الإرهاب، وأن تقوم بأنشطة للتعاون الأمني في زمن السلم. ولا شك في أن ذلك سيحدث تغييرًا في موقع القوات التي تصنع البصمة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، وفي حجمها ونوعها.
خفض العديد العسكري بطريقة مسؤولة
ربطُ القوات بالمهام الأساسية، كما ورد آنفًا، سوف يحدّد ما إذا كانت الولايات المتحدة ستحتاج إلى الاحتفاظ بوجود عسكري بشكلٍ من الأشكال، على الرغم من أنه لا داعي لأن يكون هذا الوجود دائمًا. الأساس هو الإبقاء على قدر كافٍ من القوات والإمكانات في الشرق الأوسط، والتفاوض لاعتماد ترتيبات الوصول المناسبة من أجل إدارة العمليات الجارية ضد تنظيم الدولة الإسلامية وفي مواجهة مجموعة من الأحداث الطارئة المحتملة، بما في ذلك أحداث يفتعلها أفرقاء آخرون غير تابعين للدول، أو إيران.
ينبغي على الولايات المتحدة اعتماد هيكلية قواعد موزَّعة في أماكن عدة، بدلًا من التعويل على قواعد عمليات أساسية. يقتضي ذلك تطوير مجموعة من القواعد الأصغر حجمًا في مختلف أنحاء المنطقة، لا سيما القواعد البعيدة عن الأراضي الإيرانية، مثل قاعدة موفق السلطي الجوية في الأردن أو قاعدة الأمير سلطان الجوية في السعودية، لاستضافة القوات الأميركية بالتناوب. سيكون عدد كبير من هذه القواعد ما يوصف بالقواعد الدافئة لأن الدول المضيفة تتولّى تشغيلها وصيانتها مع احتفاظ الولايات المتحدة بالقدرة على الوصول إليها في الحالات الطارئة. وينبغي على واشنطن أيضًا تحويل العديد من المنشآت التي تُعتبَر غير ضرورية للمهام الأميركية الأساسية من "ساخنة" (hot) إلى "دافئة" (warm)، وإعادتها إلى الدول المضيفة.
يجب خفض البصمة الأميركية في قواعد العمليات الأكبر حجمًا، لا سيما تلك التي تقع ضمن المدى الذي تصل إليه الأسلحة الإيرانية، مثل معسكر عريفجان وقاعدة العُديد اللذين هما من المخلفات المضخّمة جدًا للحروب القديمة. ويجب أيضًا تصويب عديد العناصر وحجم الإمكانات في المنطقة كي تعكس المقتضيات الحديثة. فعلى سبيل المثال، يمكن خفض عديد العناصر في الأسطول الخامس الأميركي في البحرين دون التأثير في العمليات البحرية، في الوقت ذاته ينبغي تعديل مهمة فرقة اللواء المدرّع القتالية المخصصة للشرق الأوسط، والتي كانت هناك حاجة إليها سابقًا في العمليات البرّية في العراق، وتعيينها في منطقة أخرى. في غضون ذلك، ينبغي على القوات الأميركية أن تتناوب مداورةً على تنفيذ أنشطة التعاون الأمني التي ترمي إلى تعزيز إمكانات الشركاء والعمليات المحدودة لمكافحة الإرهاب.
علاوةً على ذلك، يجب أن تنشر الولايات المتحدة مسبقًا معدات تُعتبَر ضروريةً من أجل التصدّي لمجموعة من التهديدات أو مطلوبةً لمواجهة حالات طارئة محتملة في القواعد المذكورة، إضافةً إلى المعدّات اللوجستية اللازمة لتنفيذ هذه المهام. ويجب الاحتفاظ في المنطقة بأعداد محدودة من الإمكانات الأساسية والقوات المطلوبة لتنفيذ مهام حسّاسة في مجالَي الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، مثل مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، وقوات العمليات الخاصة، مع التركيز على الأصول القادرة على استيفاء مقتضيات متعددة، مثل الطائرات المسيّرة عن بعد التي يمكن استخدامها في مهام الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع وفي الضربات الجوّية.
يُعتبَر الحفاظ على إمكانية الوصول العسكري الأميركي، والقدرة على التحليق في المجال الجوّي أساسيًا من أجل تزويد الولايات المتحدة بالمرونة الضرورية للتحرر من الوجود الدائم في القواعد التقليدية في الشرق الأوسط. وهي مهمّة صعبة في الأغلب، فقد أصبحت القواعد رموزًا للالتزام الأمني الأميركي وتُستخدَم بمثابة خطوط دفاع أوّلية عند التعرّض لعدوان مناوئ. وفي هذا الإطار، يجب توجيه رسالة إلى الشركاء في الإقليم مفادها أن ما تقوم به الولايات المتحدة هو تصويب للحجم وليس انكفاءً، من أجل عدم الإضرار بالعلاقات مع هذه الدول، وهي ليست مهمّة سهلة لكنها ذات أهمية حيوية لنجاح أي بصمة أميركية في المستقبل. وكي لا تغرق الولايات المتحدة في نزاعات إقليمية تتطلب من جديد بصمة عسكرية كبيرة الحجم، سوف تكون الدبلوماسية عاملًا رئيسًا لصون العلاقات الأميركية مع الشركاء الإقليميين الأساسيين وضمان الوصول العسكري الأميركي المستمر.
بيكا واسر زميلة في البرنامج الدفاعي في المركز من أجل أمن أميركي جديد.
الحد من المحسوبيات والإثراء الشخصي في مبيعات الأسلحة الأميركية
تُعد الولايات المتحدة، إلى حد بعيد، المورِّد الأكبر للأسلحة إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فنسبة 45 في المئة من الأسلحة التي بيعت إلى المنطقة بين عامَي 2000 و2019 كان مصدرها الولايات المتحدة التي صدّرت، على امتداد عقود، الأسلحة إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظنًا منها أن ذلك سيساهم في ترسيخ التحالفات، ومنح الجيش الأميركي وصولًا إلى المنطقة، وأنه سيساعد، بالاقتران مع التدريبات والاستشارات العسكرية الأميركية، على بناء جيوش شرعية قوية وقادرة على الدفاع عن هذه البلدان في مواجهة التهديدات الخارجية.
ولكن في حالات كثيرة، ساهمت الأسلحة الأميركية في تدعيم الفساد والسعي إلى الكسب الريعي اللذين هما في أساس هشاشة الدولة في مختلف أنحاء المنطقة. فهذه الأسلحة التي أُريد لها أن تكون بمثابة ورقة ضغط على سلوك الدول المحلي والخارجي، منحت في معظم الأحيان الأنظمة مصدرًا للإثراء الشخصي والمحسوبيات السياسية، وكذلك أدوات للقمع والمراقبة وإسكات المطالبات الشعبية بالإصلاح.
لقد تعهّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجديدة بجعل مكافحة الفساد ركيزةً مهمّة في السياسة الخارجية الأميركية. وكانت لها انطلاقة جيّدة من خلال تعليق مبيعات الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة والسعودية، على الرغم من أن بعض المبيعات استمرت منذ ذلك الوقت. كي تتكلل مساعي بايدن بالنجاح، ينبغي أن يكون تحسين حوكمة تجارة السلاح إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإعادة إحياء جهود مكافحة الفساد في صادرات الأسلحة الأميركية، مكوّنَين مهمّين في السياسة الخارجية للإدارة الأميركية.
الفساد في مبيعات الأسلحة: خيار أم نتيجة غير متعمدة؟
غالبًا ما تَشتري أنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسلحة بكمّيات تتخطى بأشواط احتياجاتها الدفاعية، أو تشتري أسلحة لا تساهم حتى في رفع التحديات التي تواجهها تلك الدول لأن الهدف من شرائها هو مظاهر الوَجاهة. أحد الأسباب المعروفة جيدًا، هو أن شراء الأسلحة يساعد على تحفيز الولايات المتحدة ودول غربية أخرى على تأمين مظلّة أمنية للدول التي تشتري منها الأسلحة. ثمة دافعٌ آخر أقل حضورًا في النقاش وهو الدور الذي تؤدّيه مبيعات الأسلحة في إبقاء الحكومات الفاسدة والهشّة والمستبدّة في مواقعها. وغالبًا ما يندرج السعي إلى الكسب الريعي والمحسوبيات المرتبطة بشراء حكومات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للأسلحة في إطار النتائج المنشودة، وليس الآثار الجانبية المؤسفة.
تشكّل مبيعات الأسلحة مصدرًا مهمًا للإثراء الشخصي بالنسبة لعدد كبير من النخب في هذه البلدان، بما يساهم في تعزيز قبضتها المحكمة على السلطة. ولذلك رفضت هذه النخب، إلى حد كبير، فرض إشراف فعلي على مشتريات الأسلحة. على سبيل المثال، وثّقت المملكة المتحدة أن شركة "بي أيه إي سيستمز" ووكلاءها دفعوا رشاوى لا تقل قيمتها عن 6 مليارات جنيه استرليني للأسرة المالكة السعودية بين عامَي 1985 و2006. واتهمت الحكومة السعودية مؤخرًا نائب وزير الداخلية الأسبق سعد الجابري بهدر 11 مليار دولار من أصل 19.7 مليار دولار مخصصة لصندوق سعودي لمكافحة الإرهاب. يدّعي الجابري أن المبالغ التي دُفِعت كانت قانونية وغالبًا ما قُدِّمت بمثابة "مكافأة على عملٍ أُنجِز كما يجب". وفي العراق، استُدعي وزير الدفاع للمثول أمام مجلس النواب في عام 2016 لاستجوابه بشأن مزاعم عن هدر مليارات الدولارات على دفع رشاوى في وزارته. وقد ألقى بالملامة على نوّابٍ مارسوا ضغوطًا دعمًا لشركات دفاعية تربطهم بها علاقة محاباة. تكشف مثل هذه الفضائح ثقافة الإفلات من العقاب التي ينعم بها قادة المنطقة الذين هم مستعدّون لتخطي كل الحدود من أجل الحفاظ عليها.
لكن الرشاوى والعمولات المرتبطة بالعقود المختلفة لشراء الأسلحة لا تقتصر فقط على نخب النظام. فبعضها يتسلل نزولًا عبر الهرم من خلال المحسوبيات بهدف ترسيخ الدعم الأساسي – وقد تكون مساعدة النخب على الاحتفاظ بالسلطة عبر اللجوء إلى هذه الطريقة، الدافع الرئيس خلف بعض مشتريات الأسلحة. فعلى سبيل المثال، تصنّع مصر، من خلال اتفاق للإنتاج المشترك مع الولايات المتحدة، دبابات "إم-1" التي لا تتناسب مع احتياجاتها لمكافحة الإرهاب، لكنها تؤمّن وظائف ومحسوبيات عن طريق الشركات المعنيّة بتصنيع هذه الدبابات والتي يديرها الجيش.
وفي هذا الإطار، عقود التعويضات الدفاعية هي من الوسائل الفعّالة على وجه الخصوص في نشر المحسوبيات، وهي بمثابة عقود جانبية أشبه بالُمحلّيات وترتبط بصفقات تسلّح كبرى. حتى لو لم يمارس المتعاقدون الدفاعيون الأميركيون المعنيون بهذه العقود أي انتهاك للقوانين (مثل قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة)، فإن مزيج السرّية القصوى وغياب الضمانات ضد تضارب المصالح والعمولات يتيح للقادة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فرصةً ممتازة لاستغلال العقود والوظائف وغيرها من المنافع لمصلحتهم ومصلحة داعميهم الأساسيين. في مصر وقطر والسعودية والإمارات مثلًا، لا تخضع إجراءات التعويضات والمفاوضات على العقود لمناقصة تنافسية، ولا يُكشَف عنها في العلن. وبسبب هذه السرّية، غالبًا ما تخرج اتفاقات التعويضات إلى العلن من خلال التسريبات أو فضائح أخرى. مثلًا، في عام 2017، أورد الإنتربول أن الإمارات العربية المتحدة قبلت أن تتقاضى سيولة نقدية في إطار موجبات التعويض التي سُدِّدت إلى شركة توازن القابضة الإماراتية. وقد علّق المحلل الدفاعي ويليام هارتونغ على الواقعة قائلًا: "التعويضات ممارسة شائعة في تجارة الأسلحة العالمية، وهي غير منظَّمة إلى حد كبير. ...لست مطلعًا تمامًا على فكرة استخدام الدفعات النقدية التي تبدو في أفضل الأحوال شكلًا من أشكال الرشاوى الُمقننة". في عام 2006، ساهمت شركة رايثيون الدفاعية في إنشاء مزرعة قريدس في السعودية في إطار التزاماتها التعويضية. وبما أن وسطاء على غرار سماسرة التعويضات يتولّون في معظم الأحيان تنظيم هذه الموجبات، فهذا يتسبب بتعتيم إضافي على التدفقات المالية التي تترافق مع اتفاقات المشتريات الدفاعية.
تؤمّن عقود التسلح أيضًا الوسائل الإكراهية التي يُستعان بها للبقاء في السلطة، وتساعد على قطع الطريق أمام جهود الإصلاح التي يبذلها المواطنون. في عام 2019، باعت الولايات المتحدة أسلحة صغيرة بقيمة 3 ملايين دولار على الأقل إلى قطر، وبقيمة 1.3 مليون دولار إلى الإمارات، ومليون دولار إلى الكويت. تندرج هذه الأسلحة في إطار العتاد المعياري للجيوش، ولكن يمكن استخدامها أيضًا من جانب الأجهزة المحلية المعنية بإنفاذ القوانين. ونظرًا إلى أن هذه الصادرات كانت جميعها عبارة عن مبيعات تجارية مباشرة ولم تكن جزءًا من برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، كانت المعلومات التي كُشِفت عنها إلى العلن ضئيلة جدًا. وفي الآونة الأخيرة، بات من الأصعب تعقّب صادرات الأسلحة الصغيرة الأميركية: فقد نصّت تنظيمات جديدة أقرّتها الولايات المتحدة في عام 2020 على نقل الإشراف على أنواع كثيرة من الأسلحة، منها المسدّسات وبندقيات القنص ورشاشات "أيه آر 15"، من وزارة الخارجية إلى وزارة التجارة التي تُطبّق قواعد أكثر تراخيًا في مجال التدقيق في الصادرات، ولا تخضع لموجب إبلاغ الكونغرس.
يمكن أن تشمل صادرات السلاح الأميركية أيضًا تكنولوجيا المراقبة. مثالٌ على ذلك برنامج مشروع "الغراب الأسود" الإماراتي حيث أنشأ خبراء في استخبارات الإشارات يعملون لدى المتعاقد الأميركي سايبربوينت شبكة مراقبة قادرة على تتبُّع جميع الأشخاص والتجسس عليهم، بدءًا من أعضاء المجتمع المدني المؤيّدين للإصلاح وصولًا إلى المواطنين الأميركيين. وقد أُبرِم عقد سايبربوينت مع الحكومة الإماراتية بإذنٍ من وزارة الخارجية ووكالة الأمن القومي. وأتاح البرنامج للنظام الإماراتي رصد أي شبكات ناشئة منشقّة وتوقيف النشطاء حتى قبل اندلاع الاحتجاجات.
ثقب أسود في مبيعات الأسلحة
تستطيع الأنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تستخدم من دون رادع مشتريات الأسلحة بهدف الإثراء الشخصي وممارسة المحسوبيات والإكراه، لأن المنطقة بكاملها تفتقر إلى آلية فعّالة للشفافية والمساءلة في القطاع الدفاعي. وفقًا لمؤشر النزاهة في منظومة الدفاع الحكومية الذي تضعه منظمة الشفافية الدولية، تُصنَّف جميع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقريبًا بأنها ذات مستويات "مرتفعة جدًا" أو "حرجة" على صعيد خطر الفساد. وحدها تونس تُصنَّف في خانة المستوى "المرتفع". في معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتخذ مجموعة صغيرة، من الأشخاص المنتمين إلى الدوائر الداخلية للنظام، القرارات بشأن شراء الأسلحة، هذا فضلًا عن أن التدقيق الخارجي في الحسابات المتعلقة بالأسلحة ضئيل أو معدوم، وتدابير الحماية ضد تضارب المصالح أو العمولات الصريحة قليلة أو غائبة. وفي بعض الحالات، تعرّضَ الأشخاص الذين حاولوا التبليغ عن الفساد في القطاع الدفاعي للانتقاد اللاذع أو أسوأ من ذلك.
أقحم الفساد المرتبط بشراء الأسلحة المصالح الأميركية في المنطقة في وضعٍ يزداد تزعزعًا. فالأسلحة التي يتم شراؤها لأسباب مختلفة، تتعلق بدواعي الدفاع الوطني، نادرًا ما يمكن استخدامها أو صيانتها بصورة فعّالة. بدلًا من ذلك، غالبًا ما تساهم هذه الأسلحة في الظروف التي تجعل الدولة تعاني بدايةً من الهشاشة. فبين عامَي 2003 و2011 مثلًا، أنفقت الولايات المتحدة 20 مليار دولار لبناء الجيش العراقي المؤلَّف من 800000 عنصر. ولكن بسبب الفساد والتسييس، انهار هذا الجيش في مواجهة ما يُسمّى بالدولة الإسلامية في الموصل بعد ثلاث سنوات فقط. ومنذ اتفاقات كامب ديفيد في عام 1979، حصلت مصر على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار تقريبًا في السنة. ولكن أداءها كان ضعيفًا في إطار التحالف الذي شنّ عملية عاصفة الصحراء في عام 1991، وفشلت حملتها لمكافحة الإرهاب في سيناء خلال العقد المنصرم في تحقيق أهدافها المعلَنة.
مدخل للنفوذ الصيني والروسي
أكّد الجنرال كينيث ف. ماكنزي جونيور، قائد القيادة المركزية الأميركية، أن السبيل الأساسي كي تتصدّى واشنطن للنفوذ الصيني والروسي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو من خلال مبيعات الأسلحة إلى شركائها. فالفساد والمحسوبيات التي تتعزّز عن طريق مبيعات الأسلحة الأميركية في المنطقة وضعف المساءلة أو الإشراف المدني على العقود الدفاعية بصورة عامة، تتيح مجالات لتنامي النفوذ الروسي والصيني. تستخدم الدولتان بقوّة الفساد أداةً في السياسات الخارجية. ولا تُدرج أيٌّ منهما ضمانات لمكافحة الفساد في آلياتهما لمبيعات الأسلحة، وقد استخدمت كلتاهما الفساد لتوسيع نفوذهما في المنطقة. وبينما تعمد روسيا والصين إلى زيادة مساعداتهما الأمنية، يُشكّل قطاع مشتريات الأسلحة هدفًا سهلًا لهما بغية شراء النفوذ من النخب الإقليمية عن طريق الفساد. ونظرًا إلى غياب الإجراءات التي من شأنها التصدّي لهذه الممارسات، مثل الصحافة الحرة، والمجتمع المدني الحيوي، والإشراف البرلماني المتين، فإن الضوابط قليلة وغير كافية لمنع القوى العظمى من التدخّل بهذه الطريقة.
مأسسة مكافحة الفساد وتقنينها في ممارسات المساعدات الأمنية الأميركية
هذه التهديدات التي تطرحها مبيعات الأسلحة ليست جديدة، ولا حاجة إلى تشريعات جديدة بالكامل لمعالجتها. لقد سلّطت جلسات الاستماع في الكونغرس في أعقاب فضيحة ووترغيت وحرب فيتنام، الضوء على دور الفساد المرتبط بمبيعات الأسلحة الأميركية – بما في ذلك الكشف عن أن متعاقدين دفاعيين أميركيين دفعوا رشاوى لمسؤولين سعوديين – في تقويض الأمن القومي. وكان الحل إقرار تشريعات على غرار قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وقانون مراقبة تصدير الأسلحة اللذين يؤمّنان إطارًا سليمًا لإعادة تقييم صادرات السلاح الأميركية إلى أنظمة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتأكد من عدم تقويضها للمطالبات الشعبية بالإصلاح ومن عدم تسبّبها بمزيد من الهشاشة. ولكن هناك حاجة إلى إقرار تعديلات للتشريعات الحالية، إضافةً إلى تنظيمات راسخة لتحسين المساعدات الأمنية الأميركية.
أولًا، يجب على الكونغرس الأميركي أن يصدر قوانين تنص على إجراء وزارة الدفاع تقييمات للمخاطر واعتمادها آلية للمراقبة حرصًا على عدم مساهمة صادرات الأسلحة الفتّاكة وغير الفتاكة، عن غير قصد، في تفاقم الفساد والتسلط في الدول المتلقّية. وينبغي وضع خطوط حمراء وإجراءات لتعديل العقود أو إنهائها في حال تدهوُر حوكمة القطاع الأمني أو عدم استيفائها للمعايير.
ثانيًا، عانت شفافية مبيعات الأسلحة الأميركية من انتكاسات في الآونة الأخيرة. فقد صُنِفت مؤخرًا بعض المعلومات، التي كانت علنية في السابق، في خانة المعلومات السرّية، وحصل الكونغرس على معلومات أقل تفصيلًا بشأن مبيعات الأسلحة، إضافةً إلى غياب المعلومات عن مبيعات الأسلحة الصغيرة، وافتقار عقود التعويضات إلى الشفافية. يجب أن يفرض الكونغرس معايير جديدة للشفافية من أجل الكشف الآني عن مبيعات الأسلحة، وأن يطلب خصيصًا بيانات أكثر تفصيلًا عن المبيعات التجارية المباشرة، فضلًا عن أي مبيعات للأسلحة الصغيرة أو الخفيفة ينبغي أن تتم بموافقة وزارة التجارة.
ينبغي على الحكومة الأميركية أيضًا تعزيز الضوابط المتعلقة بالفساد التي تفرضها على مبيعات الأسلحة. فمبيعات الأسلحة التجارية المباشرة تخضع لتدقيق شديد من مختلف الأفرقاء، بما في ذلك الوسطاء مثل سماسرة التمويل والتأمين، فضلًا عن مراجعة المساهمات السياسية ورسوم التسويق. ولكن هذا التدقيق غير قائم في حالة الأسلحة التي تُباع بموجب برنامج المبيعات العسكرية الخارجية تحت رعاية وزارة التجارة. يجب نشر ملخّصات عن عقود التعويضات ومعلومات التملّك المفيدة المرتبطة بعقود التسلح، وينبغي وضع تقييمات محدّدة عن مخاطر الفساد المرتبطة بالعقود.
أخيرًا، ينبغي أن يكون العنصر الأهم لمراقبة عقود شراء الأسلحة قوامه المواطنون أنفسهم، من خلال ممثّليهم المنتخَبين، في البلدان المتلقّية. لقد أظهر مؤشّر النزاهة في منظومة الدفاع الحكومية لعام 2019 أن دولتَين فقط، هما الكويت وتونس، تملكان هيكلية تتيح نوعًا من التدخّل التشريعي في الشؤون الدفاعية؛ وأن معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفتقر إلى الإشراف البرلماني أو العام. وتُجرِّم بعض الدول، مثل مصر والكويت والإمارات، التدقيق في القطاع الدفاعي أو نشر أنباء عن القوات المسلّحة دون الحصول على تصريح بذلك. في حين يُعهَد الآن إلى برامج التعاون الأمني الأميركية المساعدة على تطوير علاقات مدنية-عسكرية سليمة في البلدان المتلقّية، بما يشمل دور الإشراف البرلماني على الشؤون الدفاعية. من الواضح أن الجيش الأميركي أمام مهمةٍ صعبة، فغالبًا ما يكون الفساد والمحسوبيات المرتبطة بشراء الأسلحة خيارات متعمّدة وليست آثارًا جانبية غير مقصودة. لذلك من الضروري التحلي بدرجة عالية من الإرادة السياسية وربط مبيعات الأسلحة بشروط مُحددة كي تبدأ دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تدريجًيا بتحسين مستوى الشفافية والمساءلة وتمكين مؤسسات مكافحة الفساد في الداخل.
دحض الأساطير المتعلقة بمبيعات الأسلحة والوظائف الأميركية
لطالما بُرِّرت مبيعات الأسلحة الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بذريعة أنها تؤمّن، كما يُعتقَد، أعدادًا كبيرة من الوظائف للمواطنين الأميركيين، وهي مقولةٌ اشتهرت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بتكرارها على نحوٍ مبالَغ فيه. ولكن الضغوط التي يمارسها مصنّعو الأسلحة المحليون وأساليب الشراء المحنّكة التي تلجأ إليها الحكومات في الشرق الأوسط أدّت إلى التعتيم على المسألة المتعلقة بما إذا كانت مبيعات الأسلحة تعود فعلًا بالفائدة على مجال التوظيف في الولايات المتحدة.1
تُبيّن مراجعة متأنّية للبيانات أن تأثير مبيعات الأسلحة الأميركية إلى بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التوظيف هو أقل من التأثير الذي تمارسه مبيعات الأسلحة في الداخل أو حتى صادرات الأسلحة إلى بلدان أخرى. ولكن النظرة السائدة التي لا تزال مستمرة هي بأن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمتلك ورقة ضغط على الكونغرس والبيت الأبيض بسبب الوظائف التي تولّدها مشترياتها من الأسلحة. وفيما تُغيّر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عاداتها الشرائية لتلبية الاحتياجات المتبدِّلة، ينبغي على صنّاع السياسات والسياسيين الأميركيين بذل جهود إضافية لفهم التأثيرات التي يمارسها بيع هذه الأسلحة، أو تعليق بيعها، على التوظيف الداخلي، واستباقها ومعالجتها.
تاريخيًا، عمدت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في معظم الأحيان إلى شراء أسلحة باهظة الثمن مصنوعة في الولايات المتحدة للحؤول دون توقّف خطوط التجميع الأميركية عن العمل. وبصورة عامة، لم تُستخدَم هذه الأسلحة المرتفعة الكلفة. ولكن فيما تَعمَدُ دولٌ ازدادت جرأةً في الآونة الأخيرة، مثل السعودية والإمارات العربية المتحدة، إلى نشر جيوشها في الخارج، ساهم طلبُ الحصولِ على طائرات متطورة وقنابل بسيطة، نسبيًا، في توليد عدد قليل من الوظائف الأميركية.
سوف تؤدّي التغييرات في مشتريات الأسلحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى انخفاض معدلات استحداث الوظائف في الولايات المتحدة لثلاثة أسباب. أولًا، تنفق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الآن معظم أموالها على الطائرات والصواريخ المتطورة بدلًا من الذخائر والآليات المدرّعة. ثانيًا، تطلب هذه الدول على نحوٍ مطرد دعمًا إضافيًا لصناعاتها الدفاعية الوطنية. وهي تُفضّل، ثالثًا، الأسلحة المتطوّرة التي لا يزال إنتاجها في بداياته، والذخائر التي يمكن بسهولة الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيعها. فشراء مقاتلات "إف-35" أو قنابل الجاذبية مع معدّات التوجيه لن يكون له التأثير السياسي نفسه الذي يمارسه شراء أسلحة باهظة الثمن بلغت مرحلة متقدمة من دورتها الزمنية.
ما هي كلفة الوظيفة الدفاعية؟
في تموز/يوليو 2020، خلص مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية إلى أنه من شأن عقود بيع صادرات دفاعية بقيمة 15.5 مليار دولار أن "تساهم في استحداث 127328 فرصة عمل أو الحفاظ عليها"، أي بمعدّل 8215 وظيفة لكل مليار دولار من الصادرات. هذا الرقم الإجمالي هو بداية مفيدة، ولكن مكتب الصناعة والأمن يتوقف عند رقمَين أساسيين آخرين. الأول هو تقييم واسع لآثار التعويضات، أي الموجبات التعاقدية التي تُقدّم محفّزات إضافية. والرقم الثاني يحتسبه التقرير من خلال استخدام بيانات مكتب التحليل الاقتصادي والإحصاء السكاني لوضع تقديرات عن استحداث الوظائف في القطاع التصنيعي. تُقدّم هذه الأرقام صورة أدق عن الوظائف المحتملة التي تساهم صفقات السلاح مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دعمها أو استحداثها.
يُبيّن الجدول 1 تقديرات مكتب الصناعة والأمن لمعدلات استحداث الوظائف، قبل التعويضات، في قطاعات متنوعة في مجال التصنيع الدفاعي. تختلف هذه المعدلات اختلافًا شديدًا؛ فتصنيع طائرة يولّد عددًا من الوظائف أقل من تلك التي يستحدثها إنتاج الذخائر. وأحد الأسباب هو أن العامل يتقاضى على الأرجح راتبًا أعلى لتصنيع طائرة مقارنةً بتصنيع قنبلة، لأنه يولّد قيمة أكبر. ولكن يمكن الافتراض بثقة أن معظم السياسيين يفضّلون أن يسجّلوا في رصيدهم استحداث 10000 وظيفة ذات راتب جيد في قطاع التصنيع بدلًا من 7000 وظيفة ذات راتب أفضل نوعًا ما في قطاع التصنيع.
| الجدول 1 مقارنات بشأن مساهمة صادرات الأسلحة في استحداث الوظائف بحسب القطاع (2016-2018) |
|||
| القطاع التصنيعي | قيمة عقود مبيعات الصادرات الدفاعية المبلَّغ عنها بين 2016-2018 (بمليارات الدولارات الأميركية) | الفرص الوظيفية التي استُحدِثت أو دُعِمت | الوظائف المستحدَثة لكل مليار دولار من قيمة عقود التصدير |
| الصواريخ الموجَّهة والمركبات الفضائية | 6.34 | 36,350 | 5,730 |
| قطع الطائرات الأخرى والمعدات الاحتياطية | 5.47 | 37,139 | 6,791 |
| الذخائر (باستثناء الأسلحة الصغيرة) | 2.79 | 17,433 | 6,251 |
| تصنيع الطائرات | 2.14 | 6,327 | 2,954 |
| قطع الصواريخ الموجَّهة والمركبات الفضائية الأخرى | 1.12 | 9,441 | 8,467 |
| الآليات المدرّعة العسكرية والدبابات ومكوّناتها | 1.55 | 5,493 | 3,544 |
منذ2016 إلى 2018، استحوذ قطاع التصنيع المتعلق بالطائرات على 36 في المئة من عقود الصادرات الدفاعية الأميركية في مختلف أنحاء العالم. وبلغت حصة الصواريخ والذخائر 37 في المئة، في حين أن حصة الآليات العسكرية كانت 7 في المئة فقط. وقد أنفقت دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تحديدًا مبالغ على الطائرات والصواريخ المتطورة أكبر بكثير من تلك التي أنفقتها على الذخائر والآليات المدرّعة. سوف يحدد رصيد الأرقام بين هذين القطاعين عدد الوظائف التي يتم استحداثها. والعامل المهم أيضًا هو موقع الصناعة في سلسلة التموين؛ فتصنيع مكوّنات الطائرات يساهم في استحداث عدد من الوظائف أكبر بكثير من تلك التي يولّدها تجميع الطائرات.
العملاء يعتمدون باطراد على التعويضات
تُظهر بيانات مكتب الصناعة والأمن أن التعويضات تُوجِّه المال، بوضوح، بعيدًا عن الوظائف المحلية وتُحوِّله إلى الدولة العميلة. في عام 2018، أشارت تقديرات مكتب الصناعة والأمن إلى أن المتوسط المتحرك للتعويضات كنسبة مئوية من قيمة العقد على امتداد ثلاث سنوات بلغ 39.4 في المئة. عند احتساب التعويضات، يتبين أنه حتى في قطاعات الصناعة الدفاعية الأفضل أداءً في الجدول 1، كان معدل الوظائف التي استُحدِثت أقل بكثير من المعدل في سوق الصادرات التجارية الأوسع.
يعمد مشترو الأسلحة المتطورة، على غرار دول الخليج، إلى المطالبة على نحوٍ متزايد بإعادة استثمار كمية كبيرة من قيمة مشترياتهم في بلدانهم، وهكذا تنخفض قيمة الأموال التي يمكن تخصيصها لاستحداث الوظائف في الولايات المتحدة. وعلى الأرجح أن نسب التعويضات لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوف تسجّل زيادة مطردة مع مرور الوقت. وفي هذا الصدد، تحاول كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بناء صناعات دفاعية وطنية، لا سيما من خلال المطالبة بالتعويضات. ليس واضحًا، بعد، إذا كانت هذه الجهود سوف تتكلل فعليًا بالنجاح، ولكن من المؤكّد أن هذه الدول سوف تستمر في توجيه الأموال نحو صناعاتها المحلية. وقد عمدت الإمارات التي يحتل مجمّعها الدفاعي Edge حاليًا المرتبة الثانية والعشرين بين أكبر المتعاقدين في القطاع الدفاعي في العالم، إلى إعادة النظر مؤخرًا في توجيهاتها بشأن التعويضات، وفرضت على الشركات استثمار 60 في المئة من قيمة العقد في الإمارات. ومن المرجح أن جزءًا كبيرًا من هذه التعويضات سيتخذ شكلإنتاج مرخَّص ونقل للتكنولوجيا، ما سيؤدّي إلى انخفاض مباشر في الوظائف الدفاعية الأميركية.
إذا لم تكن الدولة قادرة على المساهمة واقعيًا في إنتاج أسلحتها المنشودة، قد تطلب، بدلًا من ذلك، تعويضات في قطاعات مهمة أخرى. منذ عام 2016 إلى عام 2018، كانت نسبة 34 في المئة من قيمة عقود الصادرات الأميركية مرتبطة بالصواريخ، ولكن 6 في المئة فقط من القيَم التعويضية أُنفقت في هذا القطاع، لأن عددًا قليلًا جدًا من الدول المستورِدة يملك صناعة صاروخية متطورة. بدلًا من ذلك، أُنفِقت نسبة 48 في المئة من التعويضات على التصنيع المتعلق بالطائرات الذي بلغت حصته 36 في المئة من عقود الصادرات الدفاعية. إذًا، يعني ذلك أن بيع الصواريخ إلى الخارج لن يأتي على حساب الوظائف الأميركية في الصناعة الصاروخية، ولكن المتضرر في هذا المجال قد يكون قطاع تصنيع الطائرات. وفقًا لمكتب الصناعة والأمن، ساهمت التعويضات في قطاع تصنيع الطائرات في تحويل عدد من الوظائف إلى الخارج يفوق بـ2790 وظيفة العدد الذي استحدثته الصادرات. وليست صدفة أن الإمارات أنتجت في عام 2019 طائرتها القتالية الأولى.
إغلاق (أو التهديد بإغلاق) مصنع له وقعٌ سياسي أكبر من الوعد بتأمين وظائف في المستقبل. يُعرَف عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أنها تنقذ خطوط الإنتاج من خلال قيامها بشراء أسلحة لم تعد الولايات المتحدة تريدها. وفي واقعة شهيرة، ساهمت المشتريات المصرية والسعودية والعراقية في إبقاء خط تجميع دبابات أبرامز في أوهايو شغّالًا لسنوات طويلة. وساعدت المشتريات الكويتية والقطرية من مقاتلتَي بوينغ من طراز "إف-18" و"إف-15" على استمرار العمل في خطوط التجميع في ميسوري. وساهمت المشتريات الإماراتية في إنقاذ مصنع باتريوت في مساتشوستس. ولكن الأسلحة المتطورة التي تسعى دول الخليج الآن للحصول عليها تلقى طلبًا شديدًا، وليست المصانع التي تنتج تلك الأسلحة مهدّدة بالإقفال. فالطلبات على مقاتلات "إف-35" مثلًا ممتدّة لعقود عدة. ومن المستبعد إلى حد كبير أن تختفي هذه الوظائف المرتفعة الأجر في وقت قريب.
قد يؤدّي شراء أسلحة بلغت تقريبًا المرحلة النهائية من دورتها الزمنية الصناعية، إلى إنقاذ الوظائف بصورة مؤقتة، ولكن حتى هذه الصفقات يجب التدقيق فيها عن كثب. فتكنولوجيا الجيل السابق هي أقل محورية للأمن القومي الأميركي فضلًا عن أن الدول الساعية إلى تسلّق سلم الإنتاج قادرة على استيعابها بسهولة أكبر، ولذلك من الأسهل الاستعانة بمصادر خارجية لتصنيعها. فعلى سبيل المثال، اقترحت شركة "لوكهيد مارتن" نقل خطها الإنتاجي الكامل الخاص بمقاتلات "إف-16" إلى الهند مقابل طلب عدد كبير من هذه المقاتلات المنتمية إلى الجيل السابق. وقد حوّلت بالفعل إنتاج جميع أجنحة "إف-16" إلى الهند. بالمثل، وفي إطار صفقة أُبرِمت مؤخرًا مع السعودية لبيعها قنابل "بايفواي"، أجاز ترامب تجميع كمية غير مسبوقة من نظم الذخائر الإلكترونية داخل المملكة.
إذًا ثمة فرصة عابرة نسبيًا لزيادة عدد الوظائف التي تنقذها صادرات الأسلحة إلى الحد الأقصى. ولا تُتاح هذه الفرصة فعليًا إلا في الحالات حيث لا يكون السلاح الذي يرغب به العميل الأجنبي في مرحلة مبكرة جدًا ولا متقدّمة جدًا من دورته الإنتاجية.
دراسة حالة: صفقة السلاح الأميركية-الإماراتية لعام 2020
في أواخر عام 2020، أعلنت إدارة ترامب صفقة بقيمة 23.4 مليار دولار لبيع السلاح إلى الإمارات العربية المتحدة، وتخضع هذه الصفقة راهنًا للمراجعة من إدارة الرئيس جو بايدن. يمكن أن تُبيّن تفاصيل صفقة البيع كيف تؤثّر المعطيات الواردة آنفًا في التحليل. تَعرضُ بياناتُ مكتب الصناعة والأمن كل بند من بنود الصفقة مع قليل من التفاصيل الإضافية، لتتيح، بعد ذلك، لصنّاع السياسات التوصل إلى تقديرات عددية عن الوظائف المستحدَثة. ثم يستطيع صنّاع السياسات تحليل هذه الأرقام نوعيًا، انطلاقًا من المرحلة التي بلغها السلاح في الدورة الإنتاجية إضافةً إلى التعويضات المحددة قطاعيًا. وفي هذا الصدد، إذا استُخدِمت القيمة الإجمالية لاستحداث الوظائف التي حددها مكتب الصناعة والأمن، يصل عدد الوظائف التي تولّدها هذه المبيعات إلى 192000 وظيفة، وهو رقم كبير. ولكن عند وضع المعطيات الواردة أعلاه في الاعتبار، تبلغ التقديرات المحسَّنة، في أفضل الأحوال، نحو 55000 وظيفة.2
استنادًا إلى البيانات في الجدول 1، سوف يولّد الطلب الإماراتي الأكبر، وقوامه مقاتلات الإغارة المشتركة من طراز "إف-35" ومعدات ذات صلة بقيمة 10.4 مليارات دولار، نحو 24000 وظيفة. ولكن، على الأغلب، أن هذا الرقم مبالَغٌ فيه لأسباب عدة. فوفقًا لما أشرنا إليه آنفًا، قطاع تصنيع الطائرات غير فاعل نسبيًا على مستوى استحداث الوظائف. فضلًا عن ذلك، لم تبلغ مقاتلات "إف-35" بعد مرحلة الإنتاج بوتيرة كاملة، فشركة "لوكهيد مارتن" لم تتمكّن فعليًا من تصنيع الطائرات التي كانت قد التزمت بإنتاجها العام الماضي. وتُعد مقاتلات "إف-35" الخمسين، من أصل آلاف المقاتلات المقرر تصنيعها، مجرد جزء صغير من أي دورة إنتاجية محتملة. وإذا كان الحد الأقصى لمعدّل الإنتاج السنوي هو 180 طائرة، على الأرجح أنه سينقضي وقت طويل جدًا قبل أن تساهم هذه الصناعة في استحداث وظائف جديدة.
استنادًا إلى بيانات مكتب الصناعة والأمن عن القطاعات التي تُسدَّد فيها تعويضات، غالب الظن أن التعويضات المرتبطة بهذه الصفقات سوف تؤدّي إلى تراجع إضافي في الوظائف في صناعة الطائرات الأميركية. في الواقع، يُنتَج جزء كبير من البرنامج حاليًا عبر الاستعانة بمصادر خارج الولايات المتحدة. فالجزء الخلفي والذيول الأفقية والعمودية في جميع مقاتلات "إف-35" تتولّى تصنيعها شركة "بي أيه إي سيستمز" في المملكة المتحدة أو أستراليا.
سوف تساهم الصواريخ والقنابل التي طلبتها الإمارات العربية المتحدة، وعددها 14000، في إطار صفقة بقيمة 10 مليارات دولار للحصول على الذخائر والمؤازرة والدعم، في استحداث نحو 25000 وظيفة، أي أكثر بقليل من الوظائف التي تولّدها صفقة "إف-35". يستند هذا الرقم إلى تخصيص نصف مليار دولار من قيمة العقد لشراء القنابل، نظرًا إلى سعر القنبلة الواحدة. وعلى الأرجح أن هذه الذخائر سوف تُسلَّم في المدى المتوسط.
يُغطّي الجزء الأكبر من قيمة الصفقة الصواريخ المتطورة التي تُستخدَم في مهام على غرار القتال الجوي والقضاء على دفاعات العدو الجوية. تولِّد صادرات بقيمة مليار دولار في قطاعات متعلقة بالصواريخ عددًا مرتفعًا نسبيًا من الوظائف الداخلية التي يُفقَد عدد قليل منها بسبب التعويضات. قد تكون لهذه الأسلحة بعض الاستخدامات في المغامرات الإماراتية في ليبيا وأماكن أخرى، ولكنها لا تُستخدَم عمومًا في اليمن. ومن جهة أخرى، من شأن حظر بيع قنابل الجاذبية ومعدات التوجيه الخاصة بها أن يؤدّي إلى خسارة أقل من ألفَي وظيفة.
يعمد الجيش الأميركي، الذي يساوره القلق من حدوث نقص في صواريخه المتطورة، إلى تكثيف مشترياته. ومن أجل تلبية الطلب الداخلي، يموّل الكونغرس الأميركي إنشاء مرفق إضافي لإنتاج صواريخ ستاند أوف مشتركة جو-أرض. وتنوي الولايات المتحدة أن تشتري، في غضون السنوات الخمس المقبلة، أكثر من 74000 ذخيرة من ذخائر الهجوم المباشر المشتركة التي تسعى الإمارات إلى شرائها. ويعني ذلك أنّ ثمة غلوًّا على الأرجح في تقدير أعداد الوظائف الجديدة المرتبطة بصفقة السلاح الإماراتية، فغالب الظن أن خطوط الإنتاج ستستمر في العمل إلى أجل غير مسمّى.
أخيرًا، سوف يؤدّي مبلغ الـ2.97 مليارَي دولار المخصّص لشراء طائرات "إم كيو-9 بي" الموجَّهة عن بعد والمعدّات ذات الصلة، إلى استحداث نحو 7000 وظيفة. إنه الرقم الأكثر موثوقية بين صفقات المبيعات الثلاث المقترَحة للإمارات. يبتعد سلاح الجو الأميركي عن استخدام هذه الطائرات، ولذلك على الأرجح أن بيعها إلى الإمارات سينقذ، على نحوٍ مؤاتٍ سياسيًا، عددًا من الوظائف في أماكن مثل خط التجميع "جنرال أتوميكس" في بواي في ولاية كاليفورنيا. ويبدو أيضًا أن هذه الطائرات صُمِّمت للمهام البحرية مثل الحروب المضادة للغوّاصات، والتي هي أكثر انسجامًا مع المصالح القومية الأميركية.
التخفيف من التداعيات على التوظيف
نظرًا إلى أن الذخائر قد تكون الوسيلة الأكثر فعالية لتوجيه سلوك الدول العميلة في المدى القصير، وهي أكثر فعالية نسبيًا في توليد الوظائف، ينبغي على الكونغرس إيلاء اهتمام خاص للطلبات الداخلية. فمن شأن تحقيق استقرار أكبر في دورة المشتريات الداخلية لهذه الأسلحة التي تلقى طلبًا شديدًا من الجيش الأميركي، أن يؤمّن مستوى من اليقين تفضّله معظم الشركات على الطلبات الدولية الجاذبة ظاهريًا والتي قد لا تتبلور مطلقًا على أرض الواقع. وغالب الظن أن مجموعات اللوبي في القطاع الدفاعي تهتم بحجم الطلب وقابليته للتوقع أكثر من اهتمامها بهوية العميل.
يستطيع المحللون، من خلال إجراء بعض الحسابات الإضافية البسيطة، أن يُقدّروا بدقّة أكبر الآثار التي تترتب على التوظيف جراء القيود الاستهدافية المفروضة على مبيعات الأسلحة. فذلك يسمح لصنّاع السياسات قياس الخسائر في الوظائف في مقابل ضبط استخدام أنواع محددة من الأسلحة. وعلى الأرجح أن الصواريخ المتطورة المستخدَمة في الدفاع الجوي أكثر فاعلية في استحداث الوظائف مقارنةً بالطائرات وعلى وجه الخصوص القنابل الموجَّهة بدقة التي علّقت إدارة بايدن بيعها في الوقت الراهن.
إضافةً إلى هذه الحسابات، من شأن فهم الدورة الإنتاجية لكل سلاح أن يساعد على اتخاذ القرارات في السياسات. فوقفُ بيع الأسلحة المتطورة التي يطلبها العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسهل سياسيًا بسبب الطلب الكبير عليها في الداخل والخارج. أما الأسلحة الأقل تطورًا وكلفة التي تقترب من نهاية دوراتها الإنتاجية فتشكّل جزءًا أصغر من سوق الصادرات إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ولكنها تساهم على نحوٍ أكثر مباشرةً في النزاع في اليمن. وفي الحالتَين، ثمة أساليب ناجعة لممارسة ضغوط سياسية على العملاء دون المجازفة بخسارة عدد كبير من الوظائف.
الآراء الواردة هنا لا تُعبّر عن آراء كلية الحرب البحرية الأميركية أو دائرة سلاح البحرية أو وزارة الدفاع الأميركية. ويتوجّه الكاتب بالشكر إلى بيل هارتونغ على تعليقاته القيّمة.
جوناثان د. كافرلي أستاذ مادة الاستراتيجية في قسم الأبحاث الاستراتيجية والعملانية في كلية الحرب البحرية الأميركية.
هوامش
1 صحيح أن الصناعة الدفاعية توظّف عددًا كبيرًا من الوكلاء لتحقيق مصالحها، إلا أنه لا يجب المبالغة في الحديث عن تأثيرات هؤلاء الوكلاء. تشير تقديرات مركز سياسة الاستجابة إلى أن مجموعات اللوبي في القطاع الدفاعي أنفقت 113 مليون دولار في عام 2019، وهو جزءٌ صغير نسبيًا من مجموع الإنفاق في قطاع اللوبي والذي يبلغ 3.5 مليارات دولار. خلال الحملة الرئاسية في عام 2020، ساهم مانحون مرتبطون بشركات دفاعية بمبلغ 32 مليون دولار للحملات السياسية، أي ما نسبته 0.03 في المئة من مجموع المساهمات للحملات والذي بلغ 14 مليار دولار. وعلى الأرجح أن نذرًا يسيرًا من هذا المبلغ أُنفِق على تعزيز المبيعات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تؤمّن إيرادات أقل بكثير مقارنةً بالسوق الداخلية. كذلك تنفق دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أموالًا طائلة لممارسة تأثير على الولايات المتحدة، غير أنه ليس واضحًا أن هذه الجهود تنصب على دعم الوظائف.
2 من أجل احتساب الوظائف التي تولّدها صفقة لبيع السلاح، حاولتُ تقدير الرصيد في القطاعات الفرعية المختلفة في إطار صفقة معيّنة لبيع الأسلحة. مثلًا، في ما يتعلق بصفقة مقاتلات "إف-35" وطائرات "إم كيو-9"، احتسبتُ مجموع الوظائف التي استُحدثت في كل قطاع من قطاعات الطيران بين عامَي 2016 و2018، وقمت بقسمتها بالقيمة الإجمالية للمبيعات المدرَجة في العقد (جميعها واردة في الجدول 1 وفي تقرير مكتب الصناعة والأمن عن التعويضات). ثم ضربتها بـ0.4 لاحتساب التعويضات، وضربت الحاصل بكلفة نقل الأسلحة.
تنظيم التنافس الأميركي-الأوروبي على تصدير السلاح
في حين تبقى الولايات المتحدة الُمصدِّر الأول للأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تخوض دول أوروبية منافسة شديدة كي تحجز لنفسها المرتبة الثانية في تصدير الأسلحة إلى المنطقة. لقد استغلّت بلدان مثل مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة هذا التنافس الأوروبي الداخلي للتعبير عن استيائها السياسي أو التفاوض ببساطة على صفقات أفضل. في الوقت الراهن، لا يزال التنافس بين أوروبا والولايات المتحدة في مراحله الأولى. فالهيبة والقوة والعوامل السياسية تساهم جميعها في حفاظ واشنطن على مكانتها في موقع المورِّد الدفاعي الأكثر طلبًا في المنطقة، ولا تزال أكثرية الصناعات الدفاعية الأوروبية تعتمد تكنولوجيًا على الصناعات الدفاعية الأميركية. ولكن مع تطوّر هذه العوامل في السنوات المقبلة، قد تشتدّ المنافسة، بما يلحق الضرر بالمصالح الغربية والمحلية في المدى الطويل. لذلك يجب على صنّاع السياسات في أوروبا والولايات المتحدة التحرّك فورًا للتخفيف من حدّة هذا التنافس.
الورقة الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
غالبًا ما يستخدم مُورِّدو معدات الدفاع الأوروبيون حجّة تسويقية مشابهة لتلك التي تسوقها روسيا والصين؛ فهم مستعدّون، على النقيض من الولايات المتحدة، لغض النظر عن وجهة الاستخدام النهائية. وينطبق هذا الأمر بصورة خاصة على فرنسا، وبدرجة أقل على المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وغيرها من الدول.
ولكن بين عامَي 2017 و2021، تجاهلت واشنطن المخاوف بشأن حقوق الإنسان وغيرها من الإجراءات التقييدية المعهودة. فقد سعت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى إبرام صفقات كبرى لبيع الأسلحة واتخذت منها أولوية بحد ذاتها. وقد ضخّت هذه السياسة إيرادات إضافية في الاقتصاد الأميركي، لكنها أدّت إلى احتدام التشنجات في أجزاء عدة من العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. فقد استُخدِمت الأسلحة الأميركية في نزاعات فتّاكة تسببت بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان ولم تحقق منافع استراتيجية تُذكَر لواشنطن، ومنها الحرب في اليمن. على الصعيد الأوروبي، شجّعت السياسة التي انتهجها ترامب في تصدير الأسلحة مزيدًا من التساهل تجاه العملاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيما أدّت إلى تراجع التنسيق مع واشنطن.
الآن بينما تسعى إدارة الرئيس جو بايدن إلى إعادة ضبط السياسة الأميركية في تصدير الأسلحة بالاقتران مع خفض مرجّح للتدخل العسكري الأميركي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – وبما أن انخفاض أسعار النفط قد يؤدّي إلى تراجع حجم صفقات الأسلحة في المنطقة – ينبغي على الولايات المتحدة إلغاء سياسات ترامب المزعزعة للاستقرار. التحدّي مزدوج، إذ يجب على صنّاع السياسات أولًا أن يتأكدوا من أن خفض التدخل العسكري الأميركي في المنطقة لن يدفع بالقوى الكبرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى التوجّه نحو مورّدي الأسلحة الأوروبيين أو غير الأوروبيين؛ ويتعيّن عليهم ثانيًا أن يعتمدوا تنظيمات أفضل لضبط صادرات السلاح القادمة من أوروبا.
لقد أبدت مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة رغبتها في تطوير روابط استراتيجية جديدة بعيدًا عن الولايات المتحدة. وفي هذا الإطار، اشترت مصر، بدءًا من عام 2014، أسلحة من فرنسا وروسيا. وخلال أزمة مجلس التعاون الخليجي بين عامَي 2017 و2021، لم تتردد قطر في استخدام مشتريات دفاعية بقيمة مليارات الدولارات من أجل تجنّب العزلة والحفاظ على مكانة لها في عواصم غربية عدّة. ليس المقصود بذلك أن قطر تتحوّل من الأوروبيين بعيدًا عن الولايات المتحدة، أو تلجأ إليهم ليكونوا بديلًا محتملًا عن الولايات المتحدة. فواشنطن تبقى صديقًا لا بديل عنه للأفرقاء الخليجيين الذين يحرصون على الحفاظ على علاقاتهم معها وتعزيزها. واقع الحال هو أنه يُنظَر إلى مورّدي معدات الدفاع الأوروبيين، في هذا السياق، بأنهم مجرّد عنصر مكمِّل للحصول على أمان إضافي.
مطالب جديدة، ومورِّدون جدد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
ما يزيد الأمور تعقيدًا أن السوق الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تشهد تحوّلات عدة. فبعض البلدان تعمد إلى بناء قاعدة دفاعية صناعية وتكنولوجية محلية المنشأ. ومع تجسُّد هذه الطموحات على أرض الواقع، يتبدّل سلوك الشارين وشروطهم. على سبيل المثال، بعد إطلاق الشركة السعودية للصناعات العسكرية في عام 2017، بدأت الرياض بفرض مطالب جديدة في عقود الشراء، مثل نقل التكنولوجيا وتوطين خطوط التجميع. ويؤدّي هذا بدوره إلى زيادة الضغوط على صناعات الأسلحة الغربية، ومن الأمثلة على ذلك تصفية شركة الدفاع الفرنسية-السعودية "أوداس".
وساهم وصول أفرقاء جدد مصمّمين على انتزاع حصص في السوق من أيدي العمالقة الراسخين، في ارتفاع المستوى الإجمالي للمنافسة. فقد أدّى صعود تركيا الأخير في موقع القوة الإقليمية، من خلال سلسلة من المساعي العسكرية التوسّعية في أماكن عدة، إلى تدعيم صورتها كجهة مصدِّرة للمعدّات والخدمات الدفاعية. العوامل السياسية هي التي تدفع بعض الجهات، مثل قطر وحكومة الوفاق الوطني المعترَف بها من جانب الأمم المتحدة في ليبيا، إلى شراء المنتجات الدفاعية التركية، في حين أن تونس ودولًا أخرى تنجذب ببساطة إلى فاعلية الطائرة القتالية المسيّرة الرخيصة والشعبية "بيرقدار تي بي 2"، وإلى طائرة "العنقاء" المسيّرة "أنكا-إس" الأكثر تطوّرًا، إضافةًإلى أنظمة أخرى. وفيما يذوب جليد العلاقات بين أنقرة ودول الخليج، قد تُسجَّل زيادة كبيرة في صادرات الدفاع والطيران من تركيا.
كذلك تؤدّي التغييرات في البيئة الجيوسياسية العالمية إلى ظهور مورّدي معدات دفاعية جدد في المنطقة. فاتفاقات أبراهام التي وُقِّعت في آب/أغسطس 2020، واتفاقات التطبيع الأخرى التي أُبرِمت في أعقابها، تتيح لإسرائيل البحث عن فرص مرتبطة بالأمن والدفاع. وغالب الظن أن الإمارات وغيرها من البلدان العربية سوف تبدأ باستيراد معدّات وخدمات دفاعية من إسرائيل، لا سيما في المجالات حيث تُعتبَر الدولة اليهودية رائدة، مثل المركبات المسيَّرة عن بعد، ونظم الدفاع الجوي، والأمن السيبراني.
الالتباس الأميركي يثير منافسة متزايدة بين الأوروبيين
خلال الأعوام العشرة إلى الخمسة عشر الماضية، ازدادت واشنطن التباسًا وتحفّظًا، ما أثار بصورة غير مباشرة أطماعًا جيوسياسية في مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ففي ليبيا وسوريا واليمن، ومؤخرًا الصحراء الغربية، تسعى قوى إقليمية الآن إلى التأثير في النتائج من خلال اللجوء إلى وسائل عدة، بما في ذلك القوّة العسكرية. فقد نشرت السعودية والإمارات قواتهما المسلّحة في اليمن في مواجهة المتمردين الحوثيين، وكذلك في إطار مهام لمكافحة الإرهاب تستهدف تنظيم القاعدة وما يُسمّى بالدولة الإسلامية. وتدخّلت قطر وتركيا والإمارات والأردن ومصر بصورة مباشرة أو أرسلت أسلحة إلى حلفائها المحليين في النزاع الليبي، في خرقٍ لحظر السلاح الذي تفرضه الأمم المتحدة.
تحرص الولايات المتحدة حرصًا شديدًا على تطبيق اتفاقات المستخدم النهائي التي تحظر "التصرّف بالمعدات الدفاعية أو استخدامها لأغراض غير تلك التي حُدِّدت عند توريدها دون الحصول أولًا على إذن خطي من الحكومة الأميركية"، ما يحدّ من إدخال الأسلحة الأميركية الصنع أو استخدامها دون ترخيص في الحروب الأهلية في المنطقة. ولأنه لا يمكن قول الشيء نفسه عن المصدِّرين الأوروبيين، فقد فتح هذا التباين الباب أمام الصناعات الدفاعية الأوروبية لتصدير منتجاتها إلى المنطقة، ففي عام 2014، بدأت الإمارات باستخدام مقاتلات "ميراج 2000-9" الفرنسية الصنع بدلًا من مقاتلات "إف-16" الأميركية الصنع لشنّ هجمات جوية في ليبيا. وحذت، لاحقا، دول أخرى حذوها.
في تشرين الأول/أكتوبر 2020، فازت إيطاليا بصفقة بقيمة 1.2 مليار دولار مع مصر التي أرادت شراء فرقاطتَين أوروبيتين متعددتي الاستخدامات (FREMM)، وذلك بعد انقضاء خمس سنوات على صفقة اشترت القاهرة بموجبها النوع نفسه من الفرقاطات من فرنسا. وقد ساهمت عوامل عدّة في تحوّل مصر نحو إيطاليا للحصول على الفرقاطات الأوروبية المتعددة الاستخدامات، منها السعر (تباع السفينة الحربية الإيطالية بنصف سعر السفينة الفرنسية)، والخطوط الائتمانية، وحقوق الإنسان، والسياسة. في السياق عينه، توسّعت في الأعوام الأخيرة الهوّة السياسية بين قطر وفرنسا برئاسة إيمانويل ماكرون. وقد اختارت قطر شراء مركبات "بوكسر" القتالية المسلّحة من شركة كراوس-مافي فيغمان الألمانية، بعد ثلاث سنوات فقط من توقيعها عقدًا مع شركة نكستر الفرنسية المنافِسة للشركة الألمانية.
تسعى المملكة المتحدة، في إطار رؤيتها عن "بريطانيا عالمية" في مرحلة ما بعد بريكست، إلى العودة إلى الشرق الأوسط من بوّابة سياستها الخارجية. ولا تقتصر المقاربة البريطانية الجديدة على إنشاء قاعدة عسكرية دائمة في البحرين في عام 2018، بل تشمل أيضًا اعتماد أسلوب أكثر جرأة في العمل على تصدير الأسلحة، الأمر الذي سيترتب عليه تنافس أكثر حدّة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
يُشار في هذا السياق إلى أنه ليس من السهل تنظيم صادرات الأسلحة بطريقة فعّالة على صعيد الدول الأوروبية. فحتى الآن، لم توضَع آلية للحد من الخلافات في موضوع حقوق الإنسان. وتطرح التباينات مشكلة بشأن بعض البرامج الدفاعية المشتركة. على سبيل المثال، تتعاون فرنسا وألمانيا في مشروعَيهما المشتركين، منظومة القتال الجوي المستقبلية ومنظومة القتال البري الأساسية، ولكن الهواجس المتعلقة بحقوق الإنسان تبقى إحدى نقاط الخلاف بين الدولتَين المتجاورتين.
في كانون الثاني/يناير 2021، فرضت إدارة بايدن تعليقًا مؤقًتا لصفقات بيع الأسلحة الأميركية التي أبرمتها إدارة ترامب مع السعودية والإمارات، ومنها صفقة كبرى لشراء مقاتلات "إف-35" الرائدة في مجالها. وقد دفع هذا القرار الأميركي، الذي قد يتبيّن أنه مجرد إجراء شكلي مؤقّت، بالمملكة المتحدة وإيطاليا إلى اتخاذ تدبير مماثل. ولكن ذلك لا يعني أن دولًا أخرى في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، سوف تعتمد أيضًا ممارسات تنسجم مع التوجّهات الأميركية.
تخفيف حدة المنافسة من خلال الاتفاقات والقيود
يجب على إدارة بايدن الحد من التنافس بين الدول الأوروبية وكذلك بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية على تصدير الأسلحة، قبل أن تتفاقم التداعيات المخلّة بالاستقرار التي تترتب على هذا التنافس. منذ تسلُّم بايدن سدّة الرئاسة، سجّل منسوب النوايا الحسنة مستويات مرتفعة جدًا بين ضفتَي الأطلسي. ينبغي على واشنطن أن تنتهز هذه الفرصة لإعادة إدراج العمل الجماعي على جدول الأعمال، ودعوة حلفائها الأوروبيين إلى الانضمام إلى منتدى دبلوماسي جديد يرمي إلى توحيد معايير بيع الأسلحة والحد من الثغرات في مجالَي التدقيق في الاستخدام النهائي ومراعاة معايير حقوق الإنسان. من شأن هذا المنتدى أن يساهم في تحقيق درجة معيّنة من التناغم على صعيد تصدير الأسلحة وإدارة استخدامها من جانب الشارين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
استكمالًا لهذه المبادرة التي يجب أن تكون طوعية بطبيعتها، يتعيّن على واشنطن الاستفادة بصورة كاملة من إطارها التنظيمي المعروف بلوائح تجارة الأسلحة الدولية. تُقدّم هذه التنظيمات وسيلة لمنع الدول الأوروبية من تصدير الأسلحة إذا كانت نسبة 5 في المئة أو أكثر من مكوّنات الأسلحة مصنوعة في الولايات المتحدة. هكذا أقدمت الولايات المتحدة، في عام 2018، على منع بيع مقاتلات "رافال" الفرنسية إلى مصر بصورة مؤقتة، فقد احتوت الصواريخ المسمّاة SCALP في طائرات"رافال" على قطعة مصنوعة في الولايات المتحدة.
أخيرًا، يجب على واشنطن النظر في توسيع إطار اتفاق المستخدم النهائي بحيث لا يقتصر فقط على النظم المصنوعة في الولايات المتحدة التي تحصل عليها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل يشمل أيضًا الأسلحة التي تشتريها هذه الدول من مورّدين غير أميركيين مثل المورّدين الأوروبيين. لا يزال معظم اللاعبين الأساسيين في المنطقة يعتبرون الولايات المتحدة مُورِّدًا حيويًا للأسلحة. لذلك تستطيع واشنطن، ويجب عليها، استخدام مكانتها المميزة لإرغام شركائها في المنطقة على التوفيق بين استخدامهم لنظم الدفاع ومراعاة المعايير الأميركية. وفي ظل غياب خطوة جريئة تصبّ في هذا الإطار، فسوف يحتدم التنافس الأوروبي، وتتفاقم معه الفوضى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
حسن ماجد هو الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة "دي أند إس كونسالتينغ" للاستشارات الاستراتيجية في باريس، والمتخصصة في الأعمال الدفاعية والتحليل الجيوسياسي خصوصًا في الشؤون المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حائز على دكتوراه في الإدارة الاستراتيجية مع التركيز على العلاقات بين الدولة القومية وصناعة الأسلحة.
جلال حرشاوي زميل أوّل متخصص في شؤون شمال أفريقيا في معهد المبادرة العالمية في سويسرا.
إدارة الأطماع الروسية
كان تدخُّل روسيا في الحرب الأهلية السورية في أواخر عام 2015 وراء عودتها إلى سياسة النفوذ في الشرق الأوسط. اليوم، بعد مرور أكثر من خمس سنوات، تُقدّم هذه العملية مثالًا نموذجيًا عن المهارات التي يتمتع بها نظام فلاديمير بوتين في المجازفة المدروسة، والعمليات العسكرية المحدودة، وغرس سرديات قوية في عقول صنّاع القرارات في العالم. طوال مرحلة التدخّل، حظي المسؤولون الروس، على نحوٍ واضح، بآذان صاغية لدى جميع الحكومات تقريبًا في المنطقة. والهجوم الدبلوماسي الذي شنّه الكرملين بهدف الاستمالة وكسب الدعم محا ذكريات الغياب الروسي عن المنطقة على امتداد نحو ثلاثين عامًا، وقد بذلت موسكو مساعيَ حثيثةً لدقّ إسفين بين واشنطن وعدد من شركائها المقرّبين.
طوال سنوات، ذهب المسؤولون الأميركيون بعيدًا في توهُّم التراجع الروسي، ولم يدركوا أن اختفاء النفوذ الروسي في الشرق الأوسط كان، في الواقع، ظاهرة انتقالية شاذّة. لا شك في أن النجاحات التي تبجّحت بها موسكو لم تحدث في فراغ. فقد انتهز الكرملين سلسلة من الفرص التي أوجدها صنّاع السياسات الأميركيون وحظيت بدعاية واسعة، منها تردُّد الولايات المتحدة الشديد في التدخّل مباشرةً في الحرب الأهلية السورية، وأسلوب الرئيس السابق دونالد ترامب الشخصي والغريب جدًا في إدارة العلاقات الأساسية في المنطقة.
تؤكّد المقاربة الروسية في التعاطي مع الشرق الأوسط، في جزءٍ كبير منها، القول المأثور بأن 80 في المئة من النجاح في الحياة قائم على الاستعراض والتباهي. لقد سعى الكرملين بإصرار إلى انتزاع أقصى قدر ممكن من المنافع انطلاقًا من المجموعة المحدودة من الأدوات المتاحة له. ولكن قليلا من الجهود التي بذلتها موسكو ضاهت بالحدّ الأدنى الثقل الكبير الذي تتمتع به واشنطن في مختلف أنحاء المنطقة، ناهيك عن علاقاتها الواسعة وعن موارد النفوذ الأمني والاقتصادي والسياسي والعسكري التي تستند إليها واشنطن بصورة روتينية.
واقع الحال هو أن صعود روسيا من جديد في الشرق الأوسط أظهر براعة الكرملين في تحقيق نتائج دبلوماسية وعسكرية مهمّة من خلال الاكتفاء بتوظيف الحد الأدنى من الاستثمارات. فهل صحيحٌ أن روسيا التي تتساوى في إجمالي الناتج المحلي مع كوريا الجنوبية والبرازيل، والتي تملك بصمة عسكرية صغيرة إلى حد ما، أحدثت تحوّلًا في المشهد الجيوسياسي في المنطقة بكاملها؟ لا أظن ذلك. لكن واشنطن وقعت أحيانًا في الفخ الفكري المتمثّل بتضخيم النفوذ والإمكانات الروسية. وغالبًا ما نظرت أيضًا إلى الجهود الهادفة إلى التصدّي للغزوات الروسية بأنها غايةٌ بحد ذاتها، فتعاملت مع الشرق الأوسط على أنه جزءٌ من صراع عالمي أوسع نطاقًا تحت خانة المنافسة بين القوى العظمى والمعركة ضد النفوذ الروسي الخبيث.
أدوات روسيا المحدودة تنفيذًا لأطماعها في الشرق الأوسط
كانت نجاحات موسكو المزعومة في الشرق الأوسط في الأعوام الأخيرة مثيرة للدهشة على وجه الخصوص بسبب محدودية الأدوات التي تعتمد عليها القيادة الروسية. فقد أعطى بوتين وشخصيات قيادية أخرى، مرارًا وتكرارًا، الأولوية للمبادرات السياسية التي تمنحهم بروزًا واسعًا على الساحة العامة، وللهجمات اللفظية على الولايات المتحدة مفضّلين إياها على أي قدرة أخرى على تحقيق أهداف ملموسة في السياسات.1 ففي حين يتبجّح المسؤولون الروس باستعدادهم للانخراط الشامل مع مختلف الأفرقاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك الأفرقاء المثيرون للجدل مثل حماس وحزب الله، لم يوظّفوا أي رأسمال سياسي جدّي في العمل على التخفيف من حدّة التشنجات الإقليمية أو معالجة الأسباب المزمنة التي تقف خلف انعدام الاستقرار المجتمعي وضعف التنمية.
بدلًا من ذلك، يفضّل الكرملين الاعتماد على الحوار السياسي بين كبار الشخصيات، وعلى صادرات السلاح، والتعاون النووي المدني، ومشاريع التنقيب والشحن في قطاع النفط والغاز، وصفقات البنى التحتية، وصادرات الحبوب، والتجارة التقليدية، والأنشطة الاستثمارية من أجل الإعلان عن وجوده. تستحوذ مبيعات الأسلحة الروسية عمومًا على حصّة الأسد في التجارة الروسية مع المنطقة. ولكن هذه المبيعات هي مجرد جزء صغير مقارنةً بالمبيعات الأميركية. (بين عامَي 2000 و2019، بلغت المبيعات الأميركية أكثر من 45 في المئة من جميع الأسلحة التي بيعت إلى الشرق الأوسط).
تكاد روسيا تكون غير موجودة في قائمة الشركاء الاقتصاديين للمنطقة. فعلى الرغم من امتلاكها احتياطيات كبيرة بالعملات الصعبة ومن الإرث الطويل للمساعدات الإنمائية الواسعة النطاق في الحقبة السوفياتية، لم تُبدِ روسيا اهتمامًا بأن تكون من الدول المانحة الأساسية أو مصدرًا للمساعدات بعد النزاعات. وفي المسألة السورية، تحوّلت روسيا نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبلدان الخليج الثريّة لتمويل المساعدات الواسعة النطاق لإعادة الإعمار ومشاريع البنى التحتية. ووسط التداعيات الوخيمة التي أحدثها تفشّي جائحة كورونا في أجزاء عدة من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لم ترسل موسكو سوى شحنات ضئيلة من لقاح "سبوتنيك في" إلى البلدان المعوزة فيما حاولت إطلاق شراكات تجارية لمساعدتها على تخطّي المعوّقات التي تعترضها في إنتاج اللقاحات في الداخل الروسي.2 ولم تدعم توزيع كميات كافية من اللقاح عبر منصة "كوفاكس" التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية من أجل توفير اللقاحات للبلدان الهشّة ذات الدخل المتدنّي.
لقد شهدت العلاقات مع الدول المصدِّرة للنفط توتّرًا في بعض الأحيان. في مطلع عام 2020، أخطأ القادة الروس في تقدير تداعيات الجائحة على الطلب العالمي على النفط. وقد أظهروا تعنّتًا في تمسّكهم برفض النداءات المتكررة التي وجّهتها الرياض من أجل بذل جهود مشتركة لتثبيت السوق، وسعوا بدلًا من ذلك إلى استخدام التراجع في أسعار النفط الخام وسيلةً لمعاقبة منتجي النفط الصخري الأميركيين الذين استحوذوا على حصّة في السوق على حساب روسيا. فصدر ردٌّ عنيف للقادة السعوديين، ما أطلق حرب أسعار لم تُعمِّر طويلًا وقد أرغمت موسكو على اعتماد خفوضات أكبر في الإنتاج وصلت إلى خفض الإنتاج النفطي الروسي لعام 2020 بنسبة 9 في المئة تقريبًا مقارنةً بمستويات 2019. وقد سارع الكرملين والسعوديون إلى رأب العلاقات بينهما، وحقّق التنسيق بينهما تحت رعاية "أوبيك بلاس" نجاحًا تخطّى بأشواط التوقعات الأولية، ما أتاح لعقود خام برنت الآجلة أن ترتفع من جديد فوق مستوى الـ60 دولارًا في شباط/فبراير 2021.
تخطّي التنافس بين القوى العظمى
تبنّت إدارة ترامب التنافس بين القوى العظمى باعتباره مبدأً منظِّمًا أساسيًا لمقاربتها للسياسة الخارجية. وفقًا لهذه النظرة، تندرج الغزوات الروسية في الشرق الأوسط ومناطق أخرى، بصورة أساسية، في إطار سباق عالمي جديد على النفوذ يضع الولايات المتحدة في مواجهة القوى التعديلية مثل روسيا والصين. يقول المبعوث الأميركي السابق لدى سورية جيمس جيفري إن تطبيق هذه المقاربة في الشرق الأوسط أتاح على وجه الخصوص "تجنُّب التورّط في الشؤون المحلية مع الاستمرار في الضغط لدرء المخاطر الإقليمية وتلك التي يتسبب بها شبه الأقران. وقد عنى ذلك، في الممارسة، احتواء إيران وروسيا مع القضاء على التهديدات الإرهابية الخطيرة".3
من مساوئ هذه المقاربة أنها تنطلق من التسليم بأن الأهداف الأميركية والروسية في المنطقة هي بطبيعتها على تبايُن دائم. وقد شجّعت أيضًا التفكير المتفائل بأن استمرار ممارسة الولايات المتحدة لنفوذها قد يؤدّي بطريقة ما إلى طرد روسيا من أماكن مثل سورية (حيث تنشط منذ الستينيات)، أو إلى إخراجها من المنطقة بكاملها. وتجاهلت أيضًا، بما يتناسب مع أهدافها، واقع أن مجالات النفوذ الروسي في إسرائيل توسّعت إلى حد كبير خلال عهد بنيامين نتنياهو. حَفّز هذا التفكير، بطريقة مفهومة إلى حد ما، التدهور الشديد في العلاقات الثنائية الأميركية-الروسية وسلسلة كبيرة من الخطوات الروسية غير المواتية في أجزاء من العالم. بيد أن صنّاع السياسات الأميركيين ينظرون عمومًا إلى التصدّي للنفوذ الروسي بأنه غاية بحد ذاتها، ويضخّمون إمكانات الكرملين الفعلية على صعيد مواجهة النفوذ الأميركي، ويتجاهلون السبل الممكنة لاستقطاب التعاون الروسي في مجالات حيث لا يزال ممكنًا تحقيق بعض الاصطفاف في مصالح الطرفَين، على الأقل من الناحية النظرية.
يُعلّمنا التاريخ الحديث أن أهداف السياسة الروسية في الشرق الأوسط ليست متجذّرة ببساطة في تقويض المصالح الأميركية عند كل منعطف. ولعل إيران هي المثل الأبرز في هذا الإطار. فتدخُّل موسكو لفترة طويلة في المفاوضات حول الاتفاق النووي الإيراني كان شاهدًا على تعقيدات علاقاتها بطهران، ما يشير إلى أن الكرملين يقوم بما هو أكثر من أداء دور الجهة التي تُفسِد على الولايات المتحدة خططها في المنطقة. ومن المنظار عينه، تمكّنت إسرائيل من شنّ حملة عسكرية متواصلة ضد البنى التحتية الصاروخية والعسكرية الإيرانية في سورية دون أن تواجه ضغوطًا كبيرة من القيادة الروسية لحملها على التراجع.4 ويُشار أيضًا إلى أن العلاقة الراسخة جدًا بين نظام بشار الأسد وإيران تضع عوائق خطيرة أمام مساعي موسكو للتوصل إلى حل سياسي للحرب الأهلية السورية. ليس المقصود من كل ذلك أنه على صنّاع السياسات الأميركيين أن يتعاملوا بسذاجة مع الممارسات الروسية، أو أن يتجاهلوا الأنشطة الروسية المؤذية أو المخلّة بالاستقرار، أو أن يُعلّقوا آمالًا في غير محلها مثلًا على حدوث انقسام وشيك بين الروس والإيرانيين. ولكن في الحد الأدنى، يجب أن تبتعد الولايات المتحدة عن الخطوات التي تدفع بخصومها إلى تعزيز التقارب بينهم أو تزيد صعوبة الأوضاع المعقّدة أصلًا.
الاستثمار في نزعة روسيا إلى تجاوُز إمكاناتها
تُجري إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حاليًا مراجعةً للانتشار العسكري الأميركي في أنحاء العالم وتحاول إعادة ضبط علاقاتها مع شركاء إشكاليين في المنطقة. لن يكون تصويب الميزان مهمةً سهلة، لا سيما في ضوء تنامي الحراك الإيراني في مختلف أنحاء المنطقة. ولكن من الصعب تجاهُل أن الوجود الأمني الأميركي توسّع إلى حد كبير في المنطقة منذ عام 1991، وأن الأدوات العسكرية اكتسبت أولوية متزايدة في السياسة الأميركية. فيما تحاول إدارة بايدن إنهاء بعض هذه الالتزامات، سوف يكون عليها استنباط سياسات لا تلحق بها هزيمة ذاتية ولا تكون مصدرًا لانتصارات سهلة تحققها روسيا.
إذا كانت الولايات المتحدة جادةً بشأن خفض العبء الذي تتحمله في الشرق الأوسط، عليها أن تختبر على الأقل إمكانية اعتماد أسلوب مختلف في التعاطي مع موسكو، وذلك من خلال تجنُّب إغراء التعامل مع كل مظهر من مظاهر النشاط الروسي انطلاقًا من المثل القائل بأن كل مَن يحمل مطرقةً يرى كل شيء وكأنه مسمار. ويقتضي ذلك أيضًا محاولة إشراك روسيا في مبادرات دبلوماسية تتعلق بأمن الخليج الفارسي في المستقبل، والأزمة في اليمن، ومكافحة الإرهاب.
يتمثّل أحد عناصر النجاح الأساسية في القدرة على تحديد أولويات واضحة مع الحفاظ على درجة من الثبات والثقة بالنفس بشأن مكامن القوة الدائمة لدى الولايات المتحدة ومخزوناتها من النفوذ. أحيانًا بالنسبة للولايات المتحدة، يتطلب الحذر من الأنشطة الروسية المرفوضة التعامل بحزمٍ مع حلفاء الولايات المتحدة الذين يساهمون في غزوات الكرملين الانتهازية. تبرز في هذا الصدد عدة أمثلة إيجابية وسلبية. فعلى سبيل المثال، أظهر المسؤولون الأميركيون، في إدارتَي بايدن وترامب على السواء، ترددًا في انتقاد الدعم المالي والسياسي الذي قدّمته الإمارات العربية المتحدة للتدخل العسكري الروسي في ليبيا وشحنات الأسلحة التي أرسلها الكرملين إلى هناك. وفي حالة مصر، اتخذ المسؤولون الأميركيون موقفًا أكثر حزمًا، ونجحوا في قطع الطريق على الطلبات التي وجّهتها روسيا إلى الجيش المصري للسماح لها بإنشاء قواعد والتحليق في الأجواء المصرية. وأُحبِطت المحاولات الروسية لتوسيع التعاون الدفاعي مع الجيش اللبناني الذي تعرّض لضغوط من شريكَيه الأساسيين، أي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بالتنسيق فيما بينهما لإفشال هذه المساعي.
ينبغي على صنّاع السياسات الأميركيين أيضًا ألا يعقدوا آمالًا مفرَطة على قدرة العقوبات على تسوية المشكلات. فقد استغل الكرملين مثلًا بيع أنظمة صواريخ "إس-400" إلى أنقرة ليدقّ إسفينًا بين تركيا من جهة وواشنطن وبروكسل من جهة ثانية. وليست العقوبات المفروضة بموجب قانون مواجهة أعداء أميركا من خلال العقوبات (CAATSA)، كافية لتغيير حسابات أنقرة. ثمة خطرٌ بأن يتكرر السيناريو نفسه مع شركاء آخرين مخضرمين للولايات المتحدة بطرقٍ من شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات الأساسية دون أن تضع حدًا لصفقات الأسلحة التي تطرح إشكاليات.
في الوقت نفسه، لا شك في أن شركاء الولايات المتحدة في المنطقة مثل السعودية ودول الخليج الأخرى يدركون أن موسكو لن تساعدهم على الأرجح في التصدي للأنشطة الإيرانية الخبيثة، وأنها لن تُعرّض علاقاتها مع طهران للخطر. يعتمد الجيش السعودي بصورة شبه كاملة على الدعم الأميركي لتسيير عملياته. ولا يزال السعوديون يحتاجون إلى التشارك الاستخباراتي مع الولايات المتحدة، وإلى التدريبات الأميركية والدعم الأميركي للصيانة في العمليات الدفاعية الحالية والمستقبلية، ومن غير المرجّح أن ينخرطوا مع روسيا بطريقة يمكن أن تؤدّي إلى تقويض هذه المجموعة الأساسية والراسخة من أوجه الاعتماد على الولايات المتحدة. ومن شأن شراء عدد كبير من المعدات العسكرية الروسية المتطورة أن يتسبب بالخلل في جوانب أساسية من المنظومة العسكرية السعودية.
يواجه المصريون الوضع نفسه، ولو بدرجة أقل. لكن قرار القاهرة شراء أربع وعشرين مقاتلة روسية من طراز "سو-35" قد يتسبب بمواجهة مماثلة لما حدث بين الولايات المتحدة وتركيا على خلفية شراء هذه الأخيرة أنظمة الدفاع الجوي الروسية "إس-400". ليس السؤال الأساسي بالنسبة إلى صنّاع السياسات الأميركيين ما إذا كانت صفقة البيع مرفوضة، فمن الواضح أنها كذلك. ولكن لا يمكن الجزم في الحال بأن هذه الطائرات الروسية سوف تؤدّي إلى الإخلال بتوازن الأمن الإقليمي أو بالعلاقات الدفاعية الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي لا تزال تخدم المصالح الأميركية. على الأرجح أن إدارة بايدن ستشعر بأنها مضطرة إلى التلويح بالعقوبات بموجب قانون CAATSA، ولكن صفقة البيع تكشف عن محدودية العقوبات كأداةٍ لوقف التدابير الحكومية (وذلك خلافًا لتدابير الكيانات التجارية التي هي أقل قدرة بكثير على تحمّل المشقات والاختلالات). الأساس هو إرساء التوازن الصحيح من خلال توجيه رسالة استياء دون أن يُتوقَّع أن العقوبات بحد ذاتها سوف تدفع بالقاهرة نحو إعادة النظر في صفقة الأسلحة.
في المرحلة المقبلة، ينبغي على صنّاع السياسات الأميركيين التنبه إلى نزعة الكرملين لتجاوُز إمكاناته والتصرف بطريقة خرقاء. ومن شأن دراسة الهفوات الروسية أن تتيح استخلاص العبَر لصنع السياسات في المستقبل. مثلًا، مُني نشر كتيبة كبيرة من المرتزقة الروس في ليبيا بالهزيمة أمام التدخل العسكري التركي الذي قصم ظهر قوات اللواء خليفة حفتر وساهم في إنعاش الجهود الدبلوماسية التي تبذلها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تحت رعاية الأمم المتحدة. وبعد تسديد هذه الضربة إلى الكرملين، من الأجدى بصنّاع السياسات الغربيين أن يفسحوا مجالًا للتعاون على مشارف الانتخابات الليبية المرتقبة في أواخر عام 2021. من شأن هذا التعاون الذي يخاطب الانتهازية الاقتصادية الروسية، أن يساعد على إرساء الأسس لانسحاب القوات الروسية في مرحلة لاحقة.
ثمة مسائل أخرى في الأفق حيث يُرجَّح أن تصطدم الأطماع الروسية بالواقع. على سبيل المثال، وبعدما كانت مصر قد تحوّلت نحو صندوق النقد الدولي ووقّعت معه في عام 2020 اتفاق استعداد ائتماني يسمح للسلطات المصرية بسحب 1.7 مليار دولار، تنوي الآن استدانة 25 مليار دولار من روسيا لتمويل بناء المفاعل النووي المدني في مدينة الضبعة بعد تأخير طالت مدته في تنفيذ المشروع. وقد فشلت مشاريع المفاعلات النووية المدنية الروسية في الأردن وجنوب أفريقيا في عام 2018 وسط تساؤلات عن ترتيبات تمويلية مشبوهة ومنطق اقتصادي هزيل.5 ومن الواضح أن توصيف الحكومة المصرية الحالم لحيوية المشروع الاقتصادية تستدعي تدقيقًا عن كثب.6
خلاصة
دور الكرملين المستجِد في الشرق الأوسط هو واقعٌ لا يمكن ببساطة التخلص منه عن طريق التمني. في المستقبل المنظور، سوف ترى موسكو في المنطقة ساحةً مهمة كي تقضم شيئًا فشيئًا من قيادة الولايات المتحدة للنظام الدولي، وتثبّت ادّعاءها بأنها لاعبٌ مهم على الصعيد العالمي. ولكن من الخطأ المبالغة في تقدير عمق الإمكانات الروسية أو اعتبار النزعة الانتصارية الروسية والمغامرات في العلاقات العامة حنكةً في حل المشكلات. ففي حين أن دبلوماسية الكرملين الناشطة واستغلاله الحذر لأخطاء الأفرقاء الآخرين جعلا منه قوّة لا يُستهان بها، لن يرغب صنّاع السياسات الأميركيون في الإذعان للإرادة الروسية. ففي نهاية المطاف، الولايات المتحدة تملك أدوات متفوّقة إلى حد كبير، ما يؤمّن لها مزايا مهمة ومصادر لممارسة الضغط.
بالطبع، سوف يتوقف الكثير على قدرة صنّاع السياسات الأميركيين على تجنُّب تكرار الأخطاء التي ارتكبوها بأنفسهم والتي كانت من الأسباب وراء زعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط، وإلحاق الضرر بمكانة أميركا العالمية، فضلًا عن مساهمتها في خلق فرص كثيرة أمام موسكو. تُشكّل الجهود التي بادرت إدارة بايدن باكرًا إلى بذلها، وتتمثّل بتصحيح العلاقات عبر الأطلسي، وإعادة تأكيد القيادة الأميركية في الأمم المتحدة، وإعادة تثبيت المصداقية الأميركية في تبنّي المعايير والمؤسسات المتعددة الأطراف – تشكّل كل هذه العوامل انطلاقة جيدة ويجب أن تعود بالمنافع مع مرور الوقت. القبول بالدور الروسي في الشرق الأوسط لا يتعارض بالضرورة مع المصالح الأميركية. ولا يجب إغلاق الباب تمامًا في وجه البحث عن سبلٍ للتعاون مع موسكو في حال أُتيحَت مثل هذه الفرص.
هوامش
1 جاء على لسان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "لا نريد ممارسة النفوذ لمجرد إرغام الآخرين على تنفيذ تعليمات موسكو. ... ما نريده هو الأمن وتعايش الثقافات والحضارات والأديان. لم تتسبب أيٌّ من الخطوات التي أقدمت عليها روسيا في الشرق الأوسط لسببٍ أو لآخر، بالشقاق أو بزرع الانقسام بين مجموعات إثنية أو دينية أو حضارية". انظر: Foreign Minister Sergey Lavrov’s remarks and answers to questions during the Valdai International Discussion Club’s panel on Russia’s policy in the Middle East, Sochi, October 2, 2019,” Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation,” October 2, 2019, https://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3826083?p_p_id=101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw&_101_INSTANCE_cKNonkJE02Bw_languageId=en_GB.
2 تركيا والجزائر هما الشريكان الأبرز راهنًا لناحية قدرتهما الواعدة على إنتاج لقاح "سبوتنيك في"، على الرغم من أنه لم يُكشَف سوى عن تفاصيل محدودة بهذا الشأن.
3 يبدو أن جيفري عرّف النجاح بأنه توريط روسيا (إلى جانب نظام الأسد وشركائها الإيرانيين) في مأزق عسكري في سورية. ("لدينا خطة ألف. الخطة ألف لا تجيب عن السؤال "كيف ينتهي هذا كله؟" الهدف من الخطة ألف [هو] هو عدم حصول الروس والأسد والإيرانيين على جواب مفرح حول الطريقة التي سينتهي بها هذا كله، ولعل ذلك سوف يحملهم يومًا ما على القبول بالخطة باء. في الانتظار، إنهم في ورطة، ولا يعتبرون أنهم انتصروا في سورية".) انظر: Jared Szuba, “Outgoing Syria Envoy Reflects on Turkey, the Kurds and What Everyone Got Wrong,” Al-Monitor, December 9, 2020, https://www.al-monitor.com/originals/2020/12/trump-syria-envoy-jeffrey-mideast-policy-turkey-erdogan.html.
4 أحد الاستثناءات الصارخة كان إسقاط طائرة استطلاع عسكرية روسية عن طريق الخطأ على أيدي قوات الدفاع الجوي السورية ظنًا منها أنها مقاتلة إسرائيلية في خريف 2018، ما أسفر عن مقتل خمسة عشر جنديًا روسيًا.
5 تعطّلَ مشروع قادته روسيا بقيمة 76 مليار دولار في جنوب أفريقيا بعد حملة ضغط متواصلة شنّها نشطاء في المجتمع المدني ومشترعون طرحوا تساؤلات بشأن الأساس المنطقي لهذا المشروع وخرق قوانين الشراء الحكومية. فأثار ذلك فضيحةً تُوِّجت باستقالة رئيس جنوب أفريقيا آنذاك جاكوب زوما. انظر: Eugene Rumer and Andrew S. Weiss, “Nuclear Enrichment: Russia’s Ill-Fated Influence Campaign in South Africa,” Carnegie Endowment for International Peace, December 16, 2019, https://carnegieendowment.org/2019/12/16/nuclear-enrichment-russia-s-ill-fated-influence-campaign-in-south-africa-pub-80597.
6 وفقًا لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، "لا يشكل القرض الروسي بقيمة 25 مليار دولار عبئًا على مصر. فعلى الرغم من أنه مبلغ ضخم، سوف تسدّده مصر من خلال بيع الطاقة التي تولّدها المفاعلات النووية. هذا المشروع لن يُكلِّف مصر شيئًا". انظر: “Russia Lends Egypt $25 Billion for Dabaa Nuclear Power Plant,” Al-Monitor, February 23, 2020, https://www.al-monitor.com/originals/2020/02/power-plant-nuclear-egypt-russia-loan.html.
اعتماد سياسة متعددة الأوجه حيال المنافسة الأمنية الأميركية-الصينية
أثار تنامي نفوذ الصين ووجودها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخاوف في واشنطن ومختلف أنحاء العالم بشأن نوايا بكين في المدى الطويل وتداعيات ذلك على المنافسة بين القوى العظمى في المنطقة التي اكتسبت أهمية متزايدة بالنسبة إلى مصالح بكين الاقتصادية وسعيها إلى ممارسة نفوذها على الساحة العالمية، وقد قبِلت دول عدّة في المنطقة بالعروض الصينية التي رأت فيها وسيلةً لتنويع علاقاتها مع القوى العظمى. سوف تستمر الصين في ترسيخ بصمتها الاقتصادية والدبلوماسية، وبدرجة أكثر محدودية، انخراطها العسكري، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في السنوات المقبلة، ولو بوتيرة أبطأ مقارنةً بالعقد السابق بسبب تجدّد اهتمامها بالتنمية الداخلية في خضم الالتباس السائد عالميًا. ولكن الصين لا تسعى إلى الحلول مكان الولايات المتحدة، ومن غير المرجّح أن تحلّ مكانها في موقع اللاعب الأمني المسيطر في المنطقة في المستقبل المنظور، وغالب الظن أنها ستحافظ على سياسة الحياد التي تُحرّكها مصالحها الذاتية وسط الخصومات المعقّدة والنزاعات المحلية في المنطقة.
يطرح الثقل الجيوسياسي المتنامي الذي تمارسه الصين تحدّيات خطيرة أمام بعض الأهداف الأميركية، مثل ترويج القيَم الديمقراطية وتعزيز حقوق الإنسان، في منطقة غير ليبرالية إلى حد كبير حيث تفضّل الدول شركاء على غرار بكين لا يشكّكون في نماذج الحوكمة لديها وفي خروقاتها الداخلية. في الوقت نفسه، لدى الولايات المتحدة والصين مصالح مشتركة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بما في ذلك الحفاظ على الاستقرار وحرية التبادل التجاري. وهكذا بدلًا من النظر إلى المنطقة بأنها ساحة لمنافسة بين غالب ومغلوب، ينبغي على الولايات المتحدة اعتماد استراتيجية متمايزة تجاه الصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. في هذا الإطار، يجب على واشنطن التنافس مع بكين حيث هناك ضرورة لذلك من خلال تعميق انخراطها وتنويعه بالتنسيق مع حلفائها وشركائها من أجل تقديم خيارات بديلة والحرص على عدم تحوّل الصين إلى الشريك الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري الأوحد للمنطقة. ويتعيّن على الولايات المتحدة أيضًا العمل على تعزيز المساءلة السياسية وسيادة القانون وحقوق الإنسان في المنطقة، والاستثمار في بناء القدرات المؤسسية ليتمكّن القادة والمواطنون في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من التعاطي بصورة أفضل مع الحضور الصيني المتنامي. في الوقت نفسه، ينبغي على واشنطن أن تشجّع بكين على استخدام نفوذها المتنامي للعمل من أجل الخير العام وتحقيق السلام، وذلك من خلال الترحيب بمساهمات الصين البنّاءة. وعليها العمل مع الصين في المجالات ذات المصلحة المشتركة، مثل حظر الانتشار النووي والمساعي الإنسانية.
الاستراتيجية الصينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
توسّعت بصمة الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سريعًا خلال العقدَين المنصرمين، وتُصنَّف الصين راهنًا بين كبار الشركاء التجاريين والمستثمرين الأجانب في المنطقة. يعود الانخراط الصيني في المنطقة إلى ما قبل مبادرة الحزام والطريق. ولكن منذ إطلاق المبادرة رسميًا في عام 2013، وقّعت بكين عشرات الاتفاقات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول البنى التحتية والطاقة والتمويل والتعاون التكنولوجي، فضلًا عن مبادرات أكثر نعومة مثل التبادلات الثقافية وتعزيز السياحة. ويُعتبَر التعاون في مجال الطاقة، على وجه الخصوص، من أبرز الأولويات على قائمة بكين، فالصين تعتمد على الشرق الأوسط للحصول على نحو 40 في المئة من وارداتها من النفط والغاز الطبيعي. وركّزت بكين أيضًا على إنشاء ما يُعرَف بطريق الحرير البحري، من خلال إقامة شراكات مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبناء شبكة استراتيجية من الموانئ والمجمّعات الصناعية التي تتيح للصين الوصول إلى الخليج الفارسي وبحر العرب والبحر الأحمر، وفي نهاية المطاف، البحر المتوسط. ومن أجل تعزيز مبادرة الحزام والطريق وما يتّصل بها من مصالح اقتصادية واستراتيجية في المنطقة، بذلت الصين أيضًا جهودًا حثيثة لبناء روابط دبلوماسية مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال إطلاق آليات متعددة الأطراف مثل منتدى التعاون بين الصين والدول العربية، ومنتدى التعاون الصيني-الأفريقي.
مع تعمّق الانخراط الاقتصادي والدبلوماسي الصيني في المنطقة، توسّعَ بطبيعة الحال حضور الصين العسكري في المشهد العام. في عام 2017، افتتحت الصين قاعدتها العسكرية الأولى في الخارج، في جيبوتي. وقد اعتبرت بكين أن هذه القاعدة أساسية كي تتمكّن من المشاركة على نحوٍ مستمر في دوريات مكافحة القرصنة، وبعثات حفظ السلام، وعمليات الإنقاذ والإجلاء الطارئة، لا سيما في ضوء تزايد أعداد المواطنين الصينيين وتنامي المصالح التجارية الصينية في المنطقة. وأنشأت الصين أيضًا "شراكات استراتيجية" و"شراكات استراتيجية شاملة" مع جميع دول المنطقة تقريبًا. إضافةً إلى المكوّنات الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، تتضمّن هذه الشراكات، مع دول ذات ثقل إقليمي مثل مصر وإيران والسعودية، بعض عناصر التعاون العسكري من خلال التبادلات العسكرية، وبدرجة أقل، مبيعات الأسلحة. خلال العقد المنصرم، شاركت الصين في تدريبات عسكرية وتبادلات مع جيبوتي ومصر وإيران والسعودية والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول، وتوقّفت السفن الصينية في موانئ هذه الدول. أصبحت الصين أيضًا المورِّد الأساسي للمنطقة في مجال الطائرات المسيّرة المسلّحة والمتطورة، فملأت بذلك الثغرة التي تتسبب بها القيود الشديدة على التصدير التي تمنع الشركات الأميركية من بيع هذه التكنولوجيا إلى شركاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولكن فيما يتعلق ببيع الأسلحة الأثقل إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتخلّف الصين إلى حد كبير عن أفرقاء كبار آخرين بينهم فرنسا وروسيا والولايات المتحدة. وفيما تعمل الصين على تطوير صناعتها الدفاعية المحلية، قد تبذل مساعي جدّية لبيع مزيد من الأسلحة إلى دول المنطقة. ولكن على الأرجح أن الدافع الأساسي لهذه الخطوة سيكون المصالح التجارية وليس رؤية استراتيجية، الهدف منها التأثير في ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المنافسة الأميركية-الصينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
على الرغم من الحجم البارز لوجود الصين وانخراطها العسكريَّين في المنطقة، لم تُبدِ بكين، حتى تاريخه، اهتمامًا بالتفوّق على الولايات المتحدة في موقع المورِّد الأوّل للمنطقة في مجال القوة والأمن العسكريَّين. فوجود جيش التحرير الشعبي في المنطقة متواضع جدًا مقارنةً بوجود القوات والأصول الأميركية وشبكة القواعد والمنشآت الأميركية. وغالب الظن أنه سيبقى على هذا النحو، نظرًا إلى أن المهمة الأساسية لجيش التحرير الشعبي تبقى حماية مصالح الصين الجوهرية في شرق آسيا. حتى لو انسحب الجيش الأميركي من المنطقة، لن تكون لدى الصين مصلحة فعلية في الإسراع لملء الفراغ. ومع تراجع الدور الأميركي في فرض الأمن، قد تشعر الصين بأنها مضطرة إلى نشر أعداد أكبر من العسكريين وتوظيف مزيد من الأصول العسكرية لحماية مواطنيها واستثماراتها. ولكن أي تعزيز كبير لعديد جيش التحرير الشعبي في المنطقة يتطلب تحوّلًا أساسيًا في استراتيجية الصين الكبرى التي تقوم على السعي إلى تحقيق السيطرة العالمية من خلال اللجوء إلى القوة الاقتصادية بصورة أساسية وليس عن طريق التوسّع العسكري في العالم.
الأنباء التي تحدّثت مؤخرًا عن إتمام الصين شراكة استراتيجية شاملة مع إيران، تشمل عناصر التعاون الاقتصادي والعسكري على السواء، أثارت مخاوف من أن بكين تعمل على إبرام مواثيق من شأنها الإخلال باستقرار الشرق الأوسط وذلك على حساب الولايات المتحدة وشركائها في المنطقة، بما في ذلك السعودية وإسرائيل. ولكن يبدو أن هذه المخاوف مضخَّمة ومبالَغ فيها، نظرًا إلى أن لدى الصين مصلحة قوية وطويلة الأمد في الحفاظ على علاقة مستقرّة نسبيًا مع الولايات المتحدة ومع دول أخرى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، منها دول عدوّة لإيران.
لا تزال الاستثمارات والتجارة الصينية مع إيران تقتصر على الحد الأدنى، لا سيما مقارنةً بالأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تقوم بها الصين في المنطقة. كذلك تصدّرت الصين وإيران العناوين الرئيسة في كانون الأول/ديسمبر 2019، حين أجرت الدولتان تدريبات بحرية ثلاثية الأطراف وغير مسبوقة بالاشتراك مع روسيا في المحيط الهندي وخليج عمان. ولكن المحللين يشيرون إلى أن الهدف من هذه التدريبات كان تقديم دعم رمزي إلى إيران، ولم يكن مؤشّرًا على تعاون أمني عميق بين القوى الثلاث. مما لا شك فيه أن الصين تسعى إلى تعديل المنظومة الدولية لمصلحتها، ولكن مصالحها الأوسع على صعيد تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم تجعل نظرتها مختلفة جوهريًا عن النظرة الإيرانية أو الروسية. وسوف تستمر هذه المصالح في صد الصين وثنيها عن التنسيق الوثيق مع الدولتَين، وفي الحد من إمكانية شروعها في مراجعة واسعة لمقاربتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
في الواقع، استندت استراتيجية الصين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جهودها الآيلة إلى الحفاظ على الحياد في الخصومات الإقليمية المختلفة. ويُشار في هذا الصدد إلى أن "مبادرة النقاط الخمس" التي أطلقتها الصين من أجل "بسط الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط"، والتي أعلن عنها وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال جولته الأخيرة في الشرق الأوسط في آذار/مارس 2021، تختصر على نطاق واسع المقاربة التي تنتهجها بكين منذ وقت طويل في المنطقة. واشتملت النقاط الخمس على المناشدات المعهودة للحض على التعايش السلمي، والتوصّل إلى حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وحظر الانتشار النووي، وعلى وجه الخصوص إعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران والولايات المتحدة. ولفتت المبادرة أيضًا إلى اهتمام الصين بإطلاق حوار متعدد الأطراف مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، والتعاون المستمر في مجال التنمية.
في الشرق الأوسط وخارجه، لطالما تباهت بكين باعتمادها مبدأ "عدم التدخّل" سمةً أساسية في دبلوماسيتها تُميّزها عن القوى الكبرى الأخرى، وبموجب هذه السياسة، تُبدي الصين استعدادها للتعامل تجاريًا مع أي كيان سيادي بغض النظر عن نوع نظامه وعمّا يقوم به داخل حدوده. يمكن القول بأن المقاربة ذات الفكر التجاري و"القيمة لمحايدة" التي تنتهجها الصين في تعاطيها مع المنطقة تطرح تحدّيًا أكبر من روابطها العسكرية بالنسبة إلى الولايات المتحدة وشركائها الذين يفكّرون بالطريقة نفسها ويدفعون معها نحو تحسين الحوكمة وتعزيز المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان في منطقةٍ من العالم حيث تُصنَّف معظم الدول في أسفل مؤشّر الحرية العالمي الذي تضعه مؤسسة فريدوم هاوس. فانخراط بكين الدبلوماسي في المنطقة وجهودها العلنية لتسليط الضوء على نجاحات ما يُسمّى بنموذج "التنمية أولًا" الذي يعطي الأفضلية للتنمية الاقتصادية والاستقرار بقيادة الدولة بدلًا من الإصلاح السياسي وشموليته، وضمنًا، تسليط الضوء على إخفاقات النموذج الليبرالي الغربي، يمكن أن تؤدّي إلى تعزيز المعايير والممارسات القائمة غير الديمقراطية.
من الجوانب المقلقة الأخرى في انخراط الصين في المنطقة هو أنها، وعلى الرغم من تجنّبها الانحياز في النزاعات المحلية، استخدمت نفوذها المتنامي لدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحصول على دعم رمزي لمصالحها وسياساتها الجوهرية فيما يتعلق بتايوان وهونغ كونغ وسنجان والنزاعات على الأراضي في بحر جنوب الصين. وطالما أن دول المنطقة لا تدفع، داخليًا أو دوليًا، ثمن دعمها لمواقف الصين الرسمية أو أقلّه عدم انتقادها لهذه المواقف، غالب الظن أنها سوف تستمر بدعم سياسات بكين في الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات الدولية. يتمخض عن ذلك تداعيات على تعزيز حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية وعلى الاستقرار الإقليمي في الجوار الصيني وفي الساحة العالمية الأوسع.
ولكن تجدر الإشارة إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تسعى إلى العمل حصرًا مع الصين. فقد رحّبت هذه الدول بانخراط الصين المتزايد، ولكنها لا تزال تتخذ احتياطاتها من خلال الحفاظ على روابط وثيقة مع الولايات المتحدة وغيرها من القوى الخارجية الكبرى، ومنها دول أوروبية وآسيوية تملك أيضًا مصالح أمنية واقتصادية عميقة في المنطقة. فضلًا عن ذلك، وفي حين تسود منذ فترة طويلة مخاوف من أن الولايات المتحدة تنسحب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيما تُحوِّل أنظارها نحو منطقة المحيطَين الهندي والهادئ، لا يزال مسار الانخراط الصيني ملتبسًا أيضًا. في هذا الإطار، وردًا على الالتباس العالمي المتزايد والمنافسة مع الولايات المتحدة، تدفع بكين باتجاه تنفيذ استراتيجيتها الجديدة المعروفة بـ"استراتيجية التداول المزدوج" التي تشجّع الصين على تحويل انتباهها بعيدًا عن الأسواق الخارجية، وإيلاء القدر نفسه، بل قدر أكبر من التركيز لتنمية السوق والابتكار على المستوى الداخلي. يصرّ القادة الصينيون على أن هذه الاستراتيجية الجديدة لا تعني أن الصين تتحوّل نحو الداخل، وعلى أن مبادرة الحزام والطريق سوف تستمر. ولكن، واقعيًا، سوف ينقسم الاهتمام الصيني، وعلى الأرجح أن استثمارات الصين الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لن تتوسّع وفقًا للوتيرة السريعة نفسها التي شهدتها الأيام الأولى من تطبيق مبادرة الحزام والطريق.
نحو علاقات أميركية-صينية أكثر إيجابية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
في المستقبل المنظور، لن تكون المنافسة الأميركية-الصينية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سِباقًا على إقامة الشراكات الأمنية أو على السيطرة العسكرية، بل ستتركّز أكثر على بناء تحالفات دبلوماسية والتأثير على المعايير السياسية الإقليمية والعالمية. وقد ولّدت الصين، من خلال انخراطها الاقتصادي والدبلوماسي الواسع في المنطقة، وبدرجة أقل انخراطها العسكري – ويشمل ذلك أيضًا مساهمتها الأخيرة في مكافحة الوباء – الدعم لنموذجها غير الديمقراطي المعروف بـ"التنمية أولًا" في منطقةٍ تتجذر فيها نزعات الاستبداد بقوة. واستخدمت أيضًا تأثيرها لتوليد الدعم، ولو رمزيًا بصورة أساسية، لمصالحها الأساسية الأضيق على مقربة منها. تطرح هذه التطورات تحدّيات أمام الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة وشركاؤها الذين يفكّرون بالطريقة نفسها من أجل تعزيز حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية (في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك على مستوى العالم) وتأنيب الصين على انتهاكاتها لحقوق الإنسان وسلوكها المزعزع للاستقرار داخل حدودها وجوارها المباشر.
ولكن لدى الولايات المتحدة والصين، وكذلك دول أوروبية وآسيوية أخرى، مصلحة قوية مشتركة في تأمين الاستقرار في المنطقة وحرية التبادل التجاري وتدفّق موارد الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. لذلك، بدلًا من النظر إلى المنطقة من منظار تبسيطي على قاعدة الغالب والمغلوب، ينبغي على واشنطن اعتماد استراتيجية متعددة الأوجه لإدارة العلاقات مع الصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينبغي عليها الضغط لكبح الجوانب المخلّة بالاستقرار التي يتسبب بها نفوذ الصين المتنامي في المنطقة، من خلال تعميق الانخراط الأميركي وتنويعه بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة وشركائها. ولكن ينبغي على واشنطن أيضًا أن ترحّب بمساهمات بكين في ميادين الخير العام، مثل المساعدات الإنسانية وحفظ السلام وحماية الخطوط البحرية والوساطة في النزاعات، وأن تعمل مع الصين عندما يقتضي الأمر بما يصب في مصلحة السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
باتريشيا م. كيم باحثة عالمية في مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين، وباحثة زائرة في كلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا، وكبيرة محللي السياسات للشؤون الصينية في معهد السلام الأميركي.