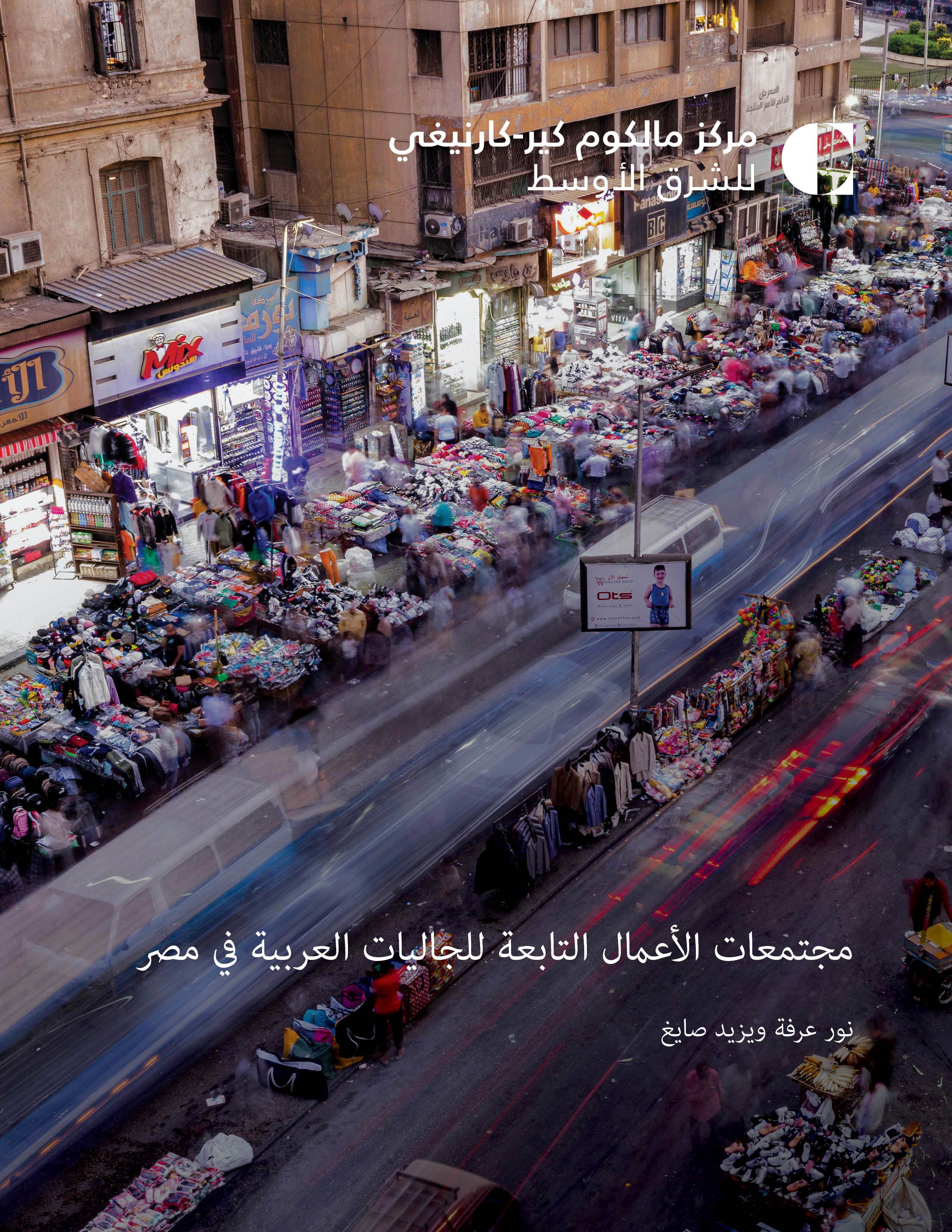مجتمع الأعمال السوري في مصر: أهمية رأس المال الاجتماعي
يسلّط مجتمع الأعمال السوري في مصر الضوء على أهمية كلٍّ من رأس المال المالي ورأس المال الاجتماعي – أي الشبكات الاجتماعية، والمعايير، والقيم، والمعتقدات التي يعتنقها الأفراد – في تحقيق مقوّمات البقاء الاقتصادي في اقتصادٍ سياسي معقّد. توافد رجال الأعمال السوريون إلى مصر بدايةً في ستينيات القرن الماضي، لكن معظمهم تدفّقوا بشكل جماعي بُعيد اندلاع الصراع السوري في العام 2011. فقد انتقل نحو 15 ألفًا من أصحاب الأعمال السوريين إلى مصر بحلول العام 2016، وارتفع العدد الإجمالي إلى 30 ألفًا بحلول العام 2023. وبحلول العام 2018، قُدّر حجم استثمارات السوريين في مصر بنحو 800 مليون دولار إلى مليار دولار، وتركّزت هذه الاستثمارات في قطاعات المنتجات الغذائية والمشروبات، والغزل والنسيج، وصناعة الأثاث والمفروشات. وقد أسفر النمو السريع لمجتمع الأعمال السوري في مصر بطبيعة الحال عن تحديات وفرص على حدٍّ سواء، ما أثّر على الشركات الكبيرة والصغيرة بطرقٍ متباينة. ولكن، على الرغم من أن الشركات المملوكة للسوريين وسواهم من غير المواطنين في مصر تواجه ظروفًا تشغيلية خاصة بها، يبقى من اللافت مدى التشابه بين تجاربها وتجارب الشركات الخاصة من الحجم نفسه المملوكة للمصريين. وتكشف هذه التجارب، في مجملها، عن طبيعة عمل الاقتصاد السياسي في مصر، الذي يعتمد إلى حدٍّ كبير على المعرفة الخاصة، والثقة بين الأشخاص، والعلاقات المتجذّرة في سوق شبه رسمية لمزاولة الأعمال.
من جهة، تُعدّ ريادة الأعمال، التي يُقصَد بها القدرة على اقتناص الفرص في السوق وجمع رأس المال اللازم لإقامة استثمارات جديدة، عاملًا حاسمًا في نجاح أو فشل أصحاب الأعمال السوريين في الأسواق المصرية. لكن من جهة أخرى، تتّسم الروابط الاجتماعية بالأهمية نفسها تقريبًا من أجل تحقيق مقوّمات البقاء والنمو الاقتصادي. ويتجلّى ذلك في مدى اعتماد رجال الأعمال السوريين على شبكاتهم الاجتماعية وسلوكياتهم المكتسبة في سورية، بما في ذلك الزبائنية والمحسوبية، من أجل التعامل مع المشهد الاقتصادي السياسي المعقّد في مصر وسياساتها غير الواضحة تجاه الهجرة، والدخول إلى الأسواق المصرية. إضافةً إلى ذلك، تساعد أوجه الاختلاف في رأس المال الاجتماعي على تفسير المسارَين المتباينَين لكلٍّ من الشركات السورية الصغيرة والكبيرة في مصر. فالشركات السورية الكبرى تمتلك رأس مالٍ اجتماعي في كلٍّ من المجتمعَين المحليَّين السوري والمصري، يشمل خبراء قانونيين ومسؤولين حكوميين وشبكات أعمال مصرية، ما يتيح لها الحصول على المشورة القانونية، وتأمين المساعدة من السلطات الحكومية، والدخول إلى الأسواق المصرية. أما الشركات السورية الأصغر حجمًا، فهي قادرةٌ على الصمود لأنها تمتلك بدورها رأس مالٍ اجتماعي، لكنه يقتصر في الغالب على المجتمع السوري المحلي، وبالتالي فهي تخدم زبائن معظمهم من السوريين، وضمن نطاق ضيّق جدًّا.
اضطلعت أوجه الاختلاف هذه بأهمية متزايدة منذ سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024. فالحوافز للعودة إلى سورية، التي لا تزال تواجه حالة من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي، تُعدّ أقوى لدى أصحاب الأعمال التجارية الصغيرة، الذين يعملون في مصر ضمن ظروف هشّة نظرًا إلى التحديات المتعلقة بإجراءات تسجيل الأعمال والبيئة السوقية الصعبة. في المقابل، قد تكون الشركات الكبرى متردّدة حيال المجازفة بالعودة إلى سورية، مفضّلةً ترسيخ انخراطها في الاقتصاد المصري.
التعامل مع حالة اللايقين
يواجه رجال الأعمال السوريون في مصر عمومًا تعقيدات قانونية نتيجةً للغموض الذي يكتنف اللوائح الإدارية واللايقين السياسي. فعلى الرغم من أن مصر وفّرت فرصًا اقتصادية لرجال الأعمال السوريين عقب اندلاع الحرب في سورية، سُرعان ما تغيّرت سياسة الهجرة التي كانت مرحِّبة بهم في البداية بعد تغيُّر النظام في مصر في تموز/يوليو 2013، فبات السوريون يخضعون لرقابة متزايدة ويواجهون تحديّات متزايدة في الاندماج ضمن السياق السياسي الاقتصادي المصري بسبب ضعف الحماية القانونية. منذ ذلك الحين، تبنّت السلطات المصرية ما تصفه الباحثة كيلسي نورمان بـ"سياسة هجرة غير متّسقة" تجاه اللاجئين السوريين المسجّلين وغير المسجّلين، وهم يشكّلون غالبية السوريين في مصر الذين يُقدَّر عددهم بنحو 1.5 مليون سوري. ووفقًا لها، سمحت هذه السياسة للحكومة المصرية بـ"تحقيق مكاسب اقتصادية من خلال مشاركة اللاجئين في الاقتصاد غير الرسمي، والتحويلات المالية التي تُنفَق محليًا، والمساعدات المُقدَّمة من المنظمات الدولية، فضلًا عن تعزيز مصداقيتها أمام المجتمع الدولي نظرًا إلى امتناعها عن ترحيل اللاجئين".
على سبيل المقارنة، يتمتّع السوريون الحائزون على الإقامة الاستثمارية في مصر بمزايا عدّة، ولكن كان عليهم أيضًا أن يتعلموا كيفية العمل في ظل اللوائح والمتطلبات الرسمية غير الواضحة والتعامل مع العوائق التي تؤثّر على انخراطهم في مختلف قطاعات الأعمال. فهم لم يتمكنوا مثلًا من دخول قطاع الصناعات الدوائية، حيث تزاحمهم نخب الأعمال المصرية التي تجمعها علاقات شراكة مع الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية. فقد قال رجل أعمال من حلب إن السوريين الذين كانوا يمتلكون شركات في قطاع الصناعات الدوائية في سورية لم يتمكّنوا، طيلة أكثر من عشر سنوات، من الحصول على التصاريح اللازمة لترسيخ حضورهم في هذا القطاع في مصر.1 وفي حين أن المصريين الذين يفتقرون إلى شركاء متنفّذين سياسيًا يواجهون بعضًا من العقبات نفسها، بما في ذلك في قطاعات أخرى، يبقى أن الإجراءات الرسمية التي تستهدف الشركات غير المصرية قد شدّدت في بعض الأحيان القيود أمام دخول الشركات السورية إلى قطاعات معيّنة، مثل الشرط الجديد الذي صدر في العام 2018 والذي يُلزم بالحصول على تصريح أمني من أجل تأسيس شركات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
نتيجةً لهذه التعقيدات، مرّ الكثير من أصحاب الأعمال السوريين في مصر بسلسلةٍ من التجارب والأخطاء قبل أن يتمكّنوا في نهاية المطاف من تأسيس أعمالهم. وفي بعض الحالات، لم يحدث ذلك إلا بعد سنوات عدّة على وصولهم إلى البلاد. في الواقع، بدأ الكثير من السوريين عملهم في مصر كموظفين في شركات أخرى، ليس فقط لأن ظروفهم لم تسمح لهم بتوفير رأس المال المالي على الفور، ولكن أيضًا بسبب حالة اللايقين المحيطة بالعمل ضمن الاقتصاد السياسي المعقّد في مصر. كذلك، يشكّل الحصول على الإقامة القانونية والحفاظ عليها تحديًا إضافيًا: وقد تم تسليط الضوء على ذلك بعد أن "أوقفت الحكومة المصرية على نحو مفاجئ تجديد التأشيرات السياحية في أواخر حزيران/يونيو 2024"، وكانت هذه التأشيرات هي الإجراء الذي لجأ إليه بعض السوريين للبقاء في مصر. وهكذا، اضطرّ كثرٌ منهم إلى "مغادرة البلاد والدخول إليها مجدّدًا بعد الحصول على موافقة أمنية مكلفة".
أسفر تذبذب الوضع القانوني واللايقين السياسي عن تأثيراتٍ متناقضة. فمن جهة، أنشأ السوريون الذين يحملون صفة اللجوء أو تأشيرات تعليمية، والذين لا يُسمح لهم بمزاولة نشاط تجاري، أعمالاً تجارية صغيرة يمكنهم تجنّب تسجيلها رسميًا. ومن جهة أخرى، رأى أصحاب الأعمال السوريون الكبار فرصةً في البيئة الاستثمارية ذاتها التي اعتبرها نظراؤهم المصريون محفوفةً بالمخاطر بين العامَين 2015-2016، حينما أدّت الأزمة الاقتصادية إلى التفاوض على قرض مع صندوق النقد الدولي. وأفضت الأزمة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 48 في المئة في العام 2016 وإلى ارتفاع كبير في معدّل التضخم. واضطرّت الحكومة المصرية إلى إجراء إصلاحات في السوق، ما سهّل على السوريين تسجيل أعمالهم بشكل رسمي. مع ذلك، لجأ أصحاب الأعمال السوريون بشكل روتيني إلى شبكاتهم الاجتماعية مع المصريين والسوريين على حدٍّ سواء لمساعدتهم في التعامل مع البيئة الاقتصادية والقرارات غير المكتوبة، والحصول على معلومات موثوقة حول المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة للعمل في الأسواق المصرية.
توظيف رأس المال الاجتماعي الموروث
اعتمدت الشركات السورية في مصر بمعظمها بدايةً على رأس المال الاجتماعي القائم أو الموروث، أي العلاقات مع أفراد الأسرة والأصدقاء وغيرهم من أبناء الجالية السورية، إضافةً إلى شبكات أعمال سبَق أن أُنشِئت في سورية. على سبيل المثال، تمكّن رجل أعمال من حلب من إعادة إنشاء شركته السورية المتخصّصة في التصنيع والتجارة في مصر، مستفيدًا من رأس المال الاجتماعي الذي كان قد بناه سابقًا في سورية.2 وقد تمّت هذه العملية على مرحلتَين: أولًا، العمل بصفة مندوب مبيعات في مصر لصالح عميل سابق كان يتعامل معه في سورية - وهو يركز الآن بشكل أساسي على سوق الجالية السورية في مصر، التي تشكّل 80 في المئة من عملائه - ثم تأسيس أعمال تجارية باسمه الخاص من أجل توجيه أنشطته نحو السوق المصرية الأوسع. تكشف المقابلات مع أصحاب محلات بقالة سوريين عن مسار مماثل، إذ اعتمدوا أسلوب "العمل على الطريقة السورية" لجذب الزبائن السوريين وبالتالي تحقيق نموٍّ كافٍ يسمح لهم بتوسيع نطاق الأعمال.3 إضافةً إلى ذلك، أفسحت الطريقة السورية المجال أمام الشركات السورية للوصول إلى عملاء غير سوريين أيضًا. في الواقع، خلُص الباحثون مازن حسن وسارة منصور وستيفان فويغت ومي جاد الله إلى أن رأس المال الاجتماعي السوري لا يسهم فحسب في بناء الثقة في المعاملات التجارية بين السوريين في مصر، بل قد يدفع أيضًا النظراء المصريين إلى التعامل مع الشركات السورية بشكلٍ أفضل من تعاملهم مع الشركات المصرية.
ومن الأهمية بمكان أن رأس المال الاجتماعي الذي اكتسبه رجال الأعمال السوريون في سورية ساعدهم على التكيّف مع الأُطر القانونية والتنظيمية المعقّدة في مصر، ولا سيما بعد أن باتت السياسات الرسمية أكثر تقييديةً عَقب تغيُّر النظام في العام 2013. وكان هذا التكيّف ضروريًا للنمو. وقد مكّن رأس المال الاجتماعي الموروث أصحابَ الأعمال السوريين من التأقلم مع ما وصفه الخبير في الاقتصاد السياسي عمرو عادلي بـ"الرأسمالية البلدية" أو "الأسواق المألوفة" في مصر، التي تتميّز بالتداخل الكبير بين الروابط الاجتماعية والاقتصادية. وعادةً ما تلجأ الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى الشبكات الاجتماعية لخفض تكاليف المعاملات، من خلال الحصول على معلومات عن السوق، الأمر الذي يسهّل سير الأعمال ويعزّز القدرة التنافسية في سياقٍ من الغموض القانوني. في غضون ذلك، تُعدّ الثقة، والتضامن، والتوصية أو الواسطة عناصر أساسية في المعاملات التجارية، وغالبًا ما تُمارَس في إطار شبكات الزبائنية.
استفاد رجال الأعمال السوريون من خبرتهم السابقة مع شبكات الزبائنية في الاقتصاد السياسي السوري قبل العام 2011 من أجل الحصول على فرص العمل، والمزايا والخدمات، والمعلومات، وغيرها من الموارد في مصر. وقد ساعدهم رأس المال الاجتماعي الموروث هذا على الاندماج بشكلٍ سهلٍ نسبيًا في الأسواق المصرية المألوفة، ما سمح لهم بالتعامل مع المشهد القانوني والاستفادة من الجوانب المبهمة والثغرات. فوفقًا لأحد محامي الشركات، يعتمد أصحاب الأعمال السوريون مثلًا على وسطاء مصريين يلجأون إلى ممارسات مثل التوصية، والواسطة، وحتى الرشاوى للالتفاف على الإجراءات الرسمية المطلوبة، والاستفادة من الجوانب المبهمة والثغرات الواردة في الأُطر القانونية والتنظيمية المصرية ومن الممارسات السائدة بحكم الأمر الواقع في البلاد.4 أما رجال الأعمال السوريون الذين لا يستطيعون تحمّل تكلفة تسجيل شركاتهم ضمن إطار الإقامة الاستثمارية، فقد يسعون إلى الامتثال لبعض المتطلبات القانونية، بينما يتجاوزون بعضها الآخر. وقد مكّنهم رأس المال الاجتماعي الموروث من اتّباع القوانين والإجراءات الرسمية بهذا الشكل الانتقائي. عمومًا، تزداد أهمية رأس المال الاجتماعي كلّما كبُر حجم الأعمال التجارية – ويُقاس ذلك برأس مالها العامل وإجمالي مبيعاتها - ما يُظهر أن العلاقات الاجتماعية قد تكون أكثر تأثيرًا من سعر المنتجات في تحديد العلاقات مع الجهات الفاعلة الأخرى في السوق.
الانتقائية في اتّباع الإجراءات الرسمية
هذه الممارسات والأشكال من الشبكات الاجتماعية مألوفة للشركات السورية. ولكن كما أشار عادلي أيضًا، فإن الروابط العاطفية المشتركة والمصالح المتبادلة التي "يمكن أن تتيح إمكانية الحصول على الفرص الاقتصادية، وإن بشكلٍ غير كامل... تجعل هذا الأمر مستحيلًا لأولئك المستبعدين اجتماعيًا".5 تساعد هذه الديناميّات المختلفة في تفسير التباين في المسارات والحظوظ بين الشركات السورية الصغيرة وبين الشركات السورية المتوسّطة أو الكبيرة في مصر منذ العام 2011. وتوضح كذلك لماذا تواجه الشركات الكبيرة حتى قيودًا تعيق قدرتها على النمو أو على تنويع أنشطتها. إذًا، لا يستفيد أصحاب الأعمال السوريون جميعًا بشكلٍ متساوٍ من العلاقات مع سلطات الدولة المصرية أو المحامين. يُضاف إلى ذلك أن قرار تسجيل النشاط بشكلٍ رسمي يعتمد أساسًا على حجم الشركة وتوقّعات نموّها. في الواقع، تميل الشركات السورية الأصغر حجمًا إلى البقاء غير مسجّلة، وتواصل العمل بشكلٍ غير رسمي، ما يحدّ من آفاق نموها. وهكذا، أصبح الكثير منها جزءًا من القطاع غير الرسمي الضخم في مصر، الذي قُدِّر أنه يمثّل 62.5 في المئة من إجمالي العمالة في العام 2018.
يمكن القول إن الشركات السورية الأكبر حجمًا تواجه مجموعة أكثر تعقيدًا من الخيارات، إذ تتعامل مع أشكال مختلفة من تسجيل الأعمال في سياق الاقتصاد المصري الأوسع الذي يصحّ وصفه بأنه شبه رسمي. ونظرًا إلى فقدان الثقة في اللوائح والتنظيمات الإدارية الرسمية، التي يصفها رجال الأعمال السوريون بأنها غير شفّافة وغالبًا ما تُطبَّق على أساس استنسابي، فهم يتبنّون استراتيجية "انتقائية" أو "ملتوية" يعرّفها عادلي بأنها أسلوب عملٍ يجمع ما بين العناصر الرسمية وغير الرسمية أحيانًا. وغالبًا ما يحذو هؤلاء الذين ينجحون في تنمية أعمالهم حذو المصريين في الاعتماد على الشبكات الاجتماعية غير الرسمية للتعامل مع الجوانب المبهمة والثغرات الواردة في الأُطر القانونية المصرية ولزيادة قدراتهم المتباينة في الحصول على المعلومات. ويُعدّ تسجيل الشركات بأسماء أصدقاء أو شركاء مصريين إحدى الوسائل المُستخدَمة للعمل بطريقة قانونية في ظلّ الالتفاف على المتطلّبات القانونية التي يصعب استيفاؤها. فعلى سبيل المثال، اتّبع رائد أعمال سوري بدأ مشروعًا غير رسمي من منزله في مجال الطعام والشراب مسارًا بديلًا من خلال تسجيل شركة لإنتاج الأغذية وسلسلة متاجر لبيع الموادّ الغذائية والسلع المنزلية (سوبرماركت) بالشراكة مع رجل أعمال سوري آخر كان هاجر إلى مصر في الثمانينيات ويحمل الجنسية المصرية وتجمعه علاقاتٌ مع مسؤولين مصريين.6
يكشف المسار الذي اتّبعه رجل الأعمال الحلبي الآنف الذكر أن الشركات التي يملكها أشخاصٌ من غير المصريين تستخدم رأس المال المالي ورأس المال الاجتماعي على السواء للتعامل مع الجوانب الرسمية، والجوانب الرمادية المبهمة، والجوانب غير الرسمية من النشاط الاقتصادي في مصر. فهو قد التزم بالتنظيمات القانونية لتسجيل شركة تصنيع لأنه كان يملك الاستثمار الأولي المطلوب بقيمة 35 ألف دولار لإنجاز ذلك. لكنه استفاد من الجوانب التنظيمية المبهمة من خلال إنشاء شركة تصدير إضافية مُسجَّلة بأسماء أصدقاء مصريين، لأن القانون لا يُجيز لغير المصريين امتلاك شركات تصدير للسلع المصنّعة. وقد أتاحت هذه الانتقائية السائدة في اتّباع الإجراءات الرسمية لرجل الأعمال هذا تجنّبَ دفع تكاليف تسجيلٍ باهظة لشركته التجارية، والحفاظَ على نموذج عمله الأصلي الذي كان يتّبعه في سورية، من أجل تصدير سلعٍ صناعية إلى خارج مصر.
خاتمة
تمكّن رجال الأعمال السوريون من إعادة تأسيس أنفسهم اقتصاديًا واجتماعيًا في مصر، وأصبحوا قادرين على التنافس في السوق المحلية بفضل رأس مالهم الاجتماعي وحنكتهم التجارية. مع ذلك، تختلف درجة اندماجهم في السوق بحسب حجم العمل التجاري والوضع القانوني، وبالتالي يؤثّر سقوط نظام الأسد عليهم بطرق مختلفة على الأرجح. فقد أصبح احتمال العودة إلى سورية، الذي كان بعيد المنال في وقتٍ سابق، ممكنًا الآن لجميع السوريين، على الرغم من أن حالة اللايقين السياسي والاقتصادي تردع كثرًا منهم عن العودة. وكما هو متوقع، كانت أعلى نسبة من الذين أبدوا نيّتهم بالعودة إلى سورية في أوساط السوريين المسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إذ بلغت 42 في المئة حتى كانون الثاني/يناير 2025. قد لا ينطبق ذلك بالقدر نفسه على فئاتٍ أخرى من السوريين في مصر، ولكن بما أن الشركات الصغيرة الناشطة في القطاع غير الرسمي هي الأقل اندماجًا في الاقتصاد المصري، غالب الظن أن تعمَد إلى العودة حالما تسمح لها الظروف في سورية بذلك. في المقابل، من المرجّح أن تبقى الشركات السورية الكبيرة في مصر وتواصل المساهمة في اقتصادها، ولا سيما بعد أن استثمرت الكثير من أجل الحصول على وضعٍ قانوني سليم وبناء اسمٍ تجاري مُعترَف به في السوق المصرية.
هوامش
1مقابلة أجرتها المؤلّفة في تموز/يوليو 2023، القاهرة، مصر.
2مقابلة أجرتها المؤلّفة في نيسان/أبريل 2021، القاهرة، مصر.
3مقابلات أجرتها المؤلّفة في آذار/مارس 2023، القاهرة، مصر.
4مقابلة أجرتها المؤلّفة في شباط/فبراير 2023، القاهرة، مصر.
5Amr Adly, Cleft Capitalism: The Social Origins of Failed Market Making in Egypt (Redwood City, CA: Stanford University Press, 2020), 181.
6مقابلة أجرتها المؤلّفة مع رائد الأعمال في آذار/مارس 2023، القاهرة، مصر.
المسارات المتباينة لروّاد الأعمال السودانيين في مصر
منذ اندلاع الحرب في السودان في نيسان/أبريل 2023، لجأ ما يقرب من 1.2 مليون مدني سوداني إلى مصر، لينضمّوا إلى 4 ملايين سوداني يقيمون هناك أساسًا. يدير كثرٌ من أولئك الذين نزحوا مؤخّرًا شركاتهم الخاصة، إلا أن تجاربهم تباينت بشكل ملحوظ، إذ تأثّرت إلى حدٍّ كبير بحجم رأس المال المالي والاجتماعي الذي كانوا يملكونه أصلًا. فقد أظهرت الشركات السودانية الراسخة، المتوسّطة والكبيرة، قدرةً لافتةً على التكيّف، إذ استطاعت نقل أعمالها إلى مصر والتوسّع هناك، بفضل رأس مالها المالي الكبير، وحساباتها المصرفية الخارجية، وشبكات أعمالها العابرة للحدود. قصة هذه الشركات هي قصة استمراريةٍ تُمثّل فرصةً استراتيجيةً طويلة الأجل لتوسيع الأعمال والتنويع الجغرافي. أما الشركات السودانية الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الموارد المالية وشبكات الأعمال المحدودة، والتي ليس لديها حسابات مصرفية في الخارج، فدُفِعَت إلى العمل في القطاع غير الرسمي في مصر، وبالتالي تواجه باستمرار حالةً من انعدام اليقين وتحدّيات تنظيمية. قصة هذه الشركات هي قصة سعيٍ من أجل البقاء، تُمثّل استراتيجيةً قصيرة الأجل للحفاظ على الأعمال، في وقتٍ تتمتّع الشركات الأكبر حجمًا بإمكاناتٍ أكبر لاتّباع مقارباتٍ مُوجَّهةٍ نحو الاستثمار.
وقد تأثّرت مسارات هذه الشركات السودانية إلى حدٍّ كبير أيضًا بالتشديد غير المسبوق في السياسة المصرية تجاه الهجرة من السودان بعد اندلاع الحرب. فالمواطنون السودانيون كانوا حتى ذلك الحين يستطيعون دخول مصر من دون تأشيرة، ويتمتّعون بحقوقٍ متبادلةٍ في الإقامة والعمل والمُلكية، ما كان يدلّ على وجود علاقة فريدة وطويلة الأمد، وإن كانت متقلّبة، بين البلدَين. ولكن بدءًا من العام 2023، شدّدت السلطات المصرية شروط الدخول والإقامة لجميع السودانيين، ووضعت عقبات أمام تسجيل الشركات الجديدة. كان تأثير هذه القرارات قاسيًا بوجه خاص على الشركات الصغيرة، كما يتّضح من مسار كثيرٍ من السودانيين الوافدين حديثًا الذين استقرّوا في حيّ فيصل، وهو حيّ مكتظّ بالسكان في القاهرة يُعَدّ مركز هجرةٍ ونزوحٍ لكلٍّ من الجاليات الأجنبية والمصريين من الأرياف، بفضل موقعه المركزي وتكلفة المعيشة المعقولة نسبيًا فيه. ومع أن السلطات المصرية أعلنت أنها لا تزال ترغب في جذب الاستثمارات السودانية، اتسّمت سياساتها منذ العام 2023 بالتقلّب، وصبّت بصورة رئيسة في صالح روّاد الأعمال المتوسّطين والكبار.
الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر غير الرسمية في حيّ فيصل
يدير الكثير من السودانيين شركاتٍ صغيرة ومتناهية الصغر في حيّ فيصل، حيث استأنف بعض رجال الأعمال الأنشطة التجارية نفسها التي كانوا يضطلعون بها في السودان سابقًا، فيما انتقل البعض الآخر إلى العمل في قطاعات جديدة. ويضطّر جميع هؤلاء إلى مواجهة القيود نفسها التي تعترض العدد الكبير من الشركات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في "السوق البلدية" غير الرسمية، التي قدّرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية أنها شكّلت نحو 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام 2022.1 وتبقى الشركات السودانية الحديثة، مثلها مثل هذه الشركات المصرية والكثير من الشركات السودانية التي استقرّت في حيّ فيصل قبل الحرب، غير مُسجَّلةٍ في الغالب، وهي تعمل خارج الأنظمة الضريبية والأُطُر التنظيمية الرسمية. لكن المدنيين السودانيين النازحين حديثًا يواجهون مكامن ضعفٍ أخرى آخذةً في التزايد، أبرزها تحدّيات الحصول على الإقامة، ما يقيّد حريتهم في التنقّل، ويزيد خطر ترحيلهم؛ والانخفاض الحادّ في قدرتهم الشرائية منذ اندلاع الحرب؛ وقلّة إلمامهم بظروف السوق المصرية.
الواقع أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال السودانيين استقرّوا في حيّ فيصل في العام 2023 نظرًا إلى تكاليف المعيشة المنخفضة فيه، وارتباطاتهم العائدة إلى ما قبل الحرب بالسودانيين المقيمين هناك أساسًا، والذين يملكون شققًا سكنية. وكان الوافدون الأوائل يتمتّعون بالإمكانات المالية لتحمّل تكاليف استئجار المساحات السكنية والتجارية، إلا أن الانخفاض الحادّ في قيمة الجنيه السوداني منذ بداية الحرب قلّص قيمة مدّخراتهم، سواء النقدية أم تلك المودَعة في المصارف السودانية. في الوقت نفسه، أدّى وصول أعداد متزايدة من المدنيين السودانيين إلى القاهرة في غضون بضعة أشهر، وبحثهم عن سكنٍ بشكل عاجل، إلى تضخّمٍ في الإيجارات أثَّرَ بشكل غير متناسب على الوافدين من السودان لاحقًا. ومع ذلك، استطاعت مؤسسات كثيرة يديرها سودانيون، مثل المطاعم والمقاهي، ومحلات البقالة، وصالونات التجميل، مواصلة العمل وتلبية حاجات الزبائن السودانيين بشكل أساسي. وهذه المؤسسات التي تديرها عائلات عمومًا، نادرًا ما توظّف أكثر من عاملَين أو ثلاثة عمّال، وتخزّن منتجات سودانية مستوردة إجمالًا إلى مصر على نحوٍ غير قانوني من تشاد أو السودان أو الإمارات العربية المتحدة. وتُسهِم هذه المؤسسات في توليد شعورٍ بالانتماء والهوية، وبالاستقرار في بيئةٍ أجنبية، وإن كان تركّزُها في حيٍّ واحد يؤجّج أيضًا التنافس في ما بينها.
وتضطّر الشركات السودانية الصغيرة ومتناهية الصغر إلى تخطّي عددٍ من العقبات، أبرزها قدرتها المحدودة على الحصول على السيولة والقروض المصرفية، التي ازدادت صعوبةً بسبب انهيار النظام المصرفي السوداني، وافتقار السودانيين في مصر إلى الحسابات المصرفية على نطاق واسع. أما مَن يمتلكون حساباتٍ في بنك الخرطوم أو بنك فيصل، وهما مؤسّستان سودانيتان، فيحوّلون مدّخراتهم السودانية إلى الجنيه المصري عبر تطبيق "بنكَك"، وهو التطبيق الرقمي السوداني الوحيد الذي لا يزال يعمل. ويُعَدّ تحويل الأموال خارج النظام المصرفي الرسمي غير قانوني، في حين أن التطبيقات الرقمية مثل "فَوري" ليست متاحةً لغير المصريين، ولذا غالبًا ما يجري التحويل من خلال سماسرة سودانيين غير رسميين يعملون من منازلهم أو متاجرهم. وقد يوفّر هؤلاء السماسرة أيضًا خدمات تحويل الأموال بين السودان ومصر بهدف زيادة دخلهم. وفي مقدور الأفراد السودانيين الذي يستطيعون دفع مبلغٍ أوّلي قدره ألف دولار أميركي (50 ألف جنيه مصري) فتح حساب مصرفي استثماري، وهو حساب ضروري لتسجيل الشركات بموجب قانون الاستثمار المصري للعام 2017. ولكن وجدنا من خلال المقابلات التي أجريناها أن الكثيرين يتجنّبون التعامل مع القطاع المالي الرسمي، إما لأنهم لا يثقون في النظام المصرفي، أو لأنهم قد يضطّرون إلى تبرير مصدر الودائع وهدفها للسلطات المصرية
وما يزيد الأمور تعقيدًا للمدنيين السودانيين الوافدين حديثًا هو شرط الحصول على إقامة رسمية في مصر للتأهّل للخدمات المصرفية الرسمية. فالأفراد السودانيون المُسجَّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وهم فئة سكانية نَمَت بنسبة 955 في المئة منذ بداية الحرب، جزئيًا بسبب التشديد الكبير لقواعد الدخول والإقامة بصورة رسمية، مُستبعَدون تمامًا من النظام المصرفي. وتقدّم المفوضية والمنظمات المجتمعية التابعة لها منحًا صغيرةً لمساعدة اللاجئين على إطلاق مشاريعهم التجارية، إلا أن هذه المنح تبقى محدودة المبالِغِ ولا تلبّي حجم الطلب عليها. ولهذا السبب، لا يستطيع السودانيون في مصر الاعتماد على المساعدات الرسمية أو خيارات الاقتراض التقليدية. أما مَن يحمل منهم تأشيرات سياحية، فعليهم تجديدها كل بضعة أشهر، الأمر الذي يصعّب عليهم فتح حسابات مصرفية.2 في موازاة ذلك، فرضت السلطات المصرية ضوابط أكثر صرامةً على الشركات الجديدة، فيما أصبحت إجراءات الحصول على الموافقة الأمنية التي يجب أن يخضع لها أصحاب الشركات أكثر غموضًا وتعقيدًا.
ويُعَدّ روّاد الأعمال السودانيون الذين يعملون بشكل غير رسمي، ويتمتّعون بوضع قانوني هشّ، أكثر عرضةً لقمع الشرطة، وطلب الرشاوى، والإغلاق المفاجئ، وأحيانًا حتى الترحيل من مصر. فضلًا عن ذلك، غالبًا ما يعتمد أصحاب الشركات على الشبكات غير الرسمية من العائلة والأصدقاء والمهاجرين للحصول على القروض والموارد المشتركة واليد العاملة. هذا النوع من رأس المال الاجتماعي يكوّن مجموعةً من المورّدين والعملاء الموثوقين، ما يقلّل الاعتماد على المؤسسات الرسمية. وبالفعل، إن العمل في القطاع غير الرسمي يمكن أن يشكّل بحدّ ذاته استراتيجيةً للبقاء، إذ يتيح لروّاد الأعمال السودانيين اجتياز بيئةٍ تنظيميةٍ هشّة. لكنّ هذه المقاربة، وإن كانت توفّر قدرًا من المرونة، تديم أيضًا مواطن الضعف وانعدام اليقين، إذ تبقى الشركات السودانية الصغيرة ومتناهية الصغر مضطّرةً إلى التفاعل مع سلطات الهجرة المصرية، وأجهزة إنفاذ القانون. هذه التقاطعات المتعدّدة تدفع الشركات السودانية إلى الانخراط أكثر في القطاع غير الرسمي الكبير ضمن الاقتصاد السياسي المصري، حيث تبقى غير مُسجَّلة ولكن تحت أنظار الدولة. يُضاف إلى ذلك أن انعدام الاستقرار في السودان يعقّد أكثر أيّ محاولةٍ للتخطيط على المدى الطويل، إذ لا يزال معظم روّاد الأعمال يأملون في العودة إلى الوطن. هذا ويشعر الكثير من روّاد الأعمال الموجودين في أحياء مثل حيّ فيصل بأنهم عالقون بسبب شبه استحالة السفر، وغياب الفرص المُجدية لتوسيع أنشطتهم، وهشاشة وضعهم القانوني والاقتصادي.
الشركات المتوسّطة والكبيرة ذات الروابط الدولية والمصرية
تختلف شروط العمل بشكل كبير للشركات السودانية المتوسّطة والكبيرة، المُصنَّفة على أنها تضمّ عشرين موظّفًا أو أكثر، التي انتقلت إلى مصر بعد اندلاع الحرب. فقد استطاعت شركاتٌ كثيرة إعادة تأسيس نفسها في مصر من خلال نقل أنشطتها التجارية القائمة في السودان أو توسيعها، بالاعتماد على مدّخراتها وحساباتها التجارية السابقة، وتوظيف الخبرات والروابط التي كانت تمتلكها قبل الحرب في الأسواق المصرية والدولية. وقد استفادت هذه الشركات بصورة أساسية من إطارٍ تنظيميّ مُرحِّب مَنَح أصحابها إقامة استثمارية طويلة الأجل، ما أتاح لهم السفر إلى دول ثالثة والعودة بحرية، وسهَّلَ عقد الشراكات مع نظرائهم المصريين. لكن وفقًا لأحاديث غير رسمية، أوقفت السلطات المصرية فجأةً إصدار الإقامة الاستثمارية للمواطنين السودانيين في مطلع العام 2025، ولا يزال وضع هذا القرار غير واضح منذ نيسان/أبريل.3
وعوضًا عن البدء من جديد، واصل الكثير من هذه الشركات السودانية النازحة العمل في المجال نفسه، إذ نقلت رأس المال والسلع والخبرات إلى مصر، أو فتحت فروعًا محليةً لها في البلاد مُحافِظةً قدر الإمكان على أنشطتها في السودان. فعلى سبيل المثال، قال صاحب شركة كبيرة إن ارتفاع تكاليف الشحن جرّاء الحرب لم يمنعه من استيراد المحاصيل من السودان،4 وإنه استطاع تجاوز الاضطرابات بأقلّ الخسائر الممكنة بفضل استفادته من شبكات الأعمال الواسعة التي بناها قبل الحرب في مصر وخارجها، ومن السمعة الراسخة لشركته العائلية. ومثله مثل آخرين، أتاحت له مدّخراته وشبكاته الاقتصادية الدولية العائدة إلى ما قبل الحرب، بما في ذلك في مصر، الحصول على معلومات متعلّقة بالسوق، والتعرّف إلى الجهات المحلية التي من شأنها تسهيل الإجراءات البيروقراطية مثل تسجيل شركته. وتُظهِر الدراسات الميدانية المكثّفة والمقابلات أن أصحاب الشركات السودانية الكبيرة استثمروا، منذ انتقالهم إلى مصر، في قطاعات متنوّعة، من ضمنها إنتاج الموادّ الغذائية، والتجارة الخارجية في المحاصيل والمواشي، والاستشارات الهندسية، والإنتاج الموسيقي، وخدمات التوصيل عبر الإنترنت، وهم يعملون إجمالًا في أحياء الطبقة المتوسّطة مثل مدينة نصر، وحيّ الدقي، وحيّ المهندسين في القاهرة.
الواقع أن توافر السيولة والحصول على القروض سهّلا بشكل كبير تسجيل الشركات السودانية وإعادة تأسيسها في مصر. فقد سبق لشركات كثيرة أن امتلكت حسابات بالعملات الأجنبية خارج السودان، غالبًا في الإمارات العربية المتحدة، الأمر الذي وفّر لها الحماية من تقلّبات العملة السودانية قبل الحرب، ومن انهيار النظام المصرفي السوداني بعدها. كذلك، سهّل امتلاك الحسابات الخارجية التعاملَ مع تداعيات العقوبات الدولية التي فرضتها الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على السودان في تسعينيات القرن الماضي، والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي شملت تجميد الأصول وحظر السفر. فرجال الأعمال ذوو حسابات مصرفية دولية استطاعوا الحصول على الإقامة في الإمارات، ما أتاح لهم حرية التنقّل، خصوصًا إلى مصر. وكان الكثير منهم يمتلكون أصلًا شققًا سكنيةً (معظمها في القاهرة والإسكندرية)، إضافةً إلى حسابات في المصارف المصرية، وكانوا على درايةٍ بظروف السوق المحلية. ولذا، كان هدف الشركات السودانية المتوسّطة والكبيرة من العمل في مصر الاستمرارية لا البقاء. وما سهّل أيضًا إعادة تأسيس هذه الشركات استمرارُ عمل غرف التجارة في السودان، والسفارة السودانية في القاهرة.
لقد شكّلت حرية السفر عاملًا أساسيًا في نجاح الشركات السودانية الكبيرة التي انتقلت إلى مصر. أما أصحاب الشركات السودانية الصغيرة، فهم عالقون في مصر: يمكن للاجئين وحاملي التأشيرات السياحية قصيرة الأجل المغادرة، ولكن عليهم دفع مبلغ يتراوح بين 2500 و3000 دولار للحصول على تأشيرة سياحية مدّتها شهر واحد تخوّلهم دخول البلاد مجددًا. ويبدو أن السلطات المصرية أوقفت إصدار تأشيرات جديدة للمواطنين السودانيين منذ العام 2023، مع أن هذا القرار ليس إجراءً رسميًا، ما أضرّ بشدّة بأصحاب الشركات الصغيرة. في المقابل، حصل أصحاب الشركات الكبيرة، الذين تمكّنوا من تقديم إثبات بامتلاكهم حدًّا أدنى من رأس المال أو الأسهم، على إقامة استثمارية صالحةٍ لأكثر من خمس سنوات، تتيح لهم مزاولة العمل في مصر، والعودة إلى البلاد بحرية. ولم تكن إجراءات التقدّم للحصول على الإقامة الاستثمارية سهلة، حتى قبل ما أُفيد عن تعليقها في أوائل العام 2025، لكن رجال الأعمال يسعون إلى الحصول عليها لأن حرية التنقّل التي تمنحها إيّاهم تتيح لهم التواصل مع الأسواق العالمية، وتوسيع قاعدة عملائهم، وتسهيل الشراكات مع نظرائهم المصريين والدوليين.
تختلف استراتيجيات الشركات السودانية الكبيرة في مصر اختلافًا ملحوظًا عن استراتيجيات الشركات الصغيرة العاملة في حيّ فيصل. فهي تستثمر بشكل مكثّف في التسويق وبناء العلامات التجارية، مستخدمةً منصّات التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام على نطاق واسع لاستهداف قاعدة عملاء من ذوي الدخل المتوسّط والعالي، لا تقتصر على السودانيين فقط. وتمتلك هذه الشركات مواقع إلكترونية احترافية، وبطاقات عمل أنيقة، وتقدّم خدمات جديدة، مثل الطلب عبر الإنترنت والشحن داخل مصر وخارجها (الأمر الذي لم يكن شائعًا في السودان قبل الحرب). وينظّم بعض هذه الشركات أيضًا أسواقًا تجاريةً ضخمة، وهي ممارسة مستوردة في الغالب من السودان، يشارك فيها البائعون السودانيون لبيع الموادّ الغذائية، ومستحضرات التجميل، وغيرها من المنتجات الاستهلاكية (لزبائن سودانيين بشكل أساسي). فضلًا عن ذلك، تشارك الشركات الكبيرة في الأنشطة التي ترعاها الحكومة، على غرار ملتقى رجال الأعمال السودانيين الذي تستضيفه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والذي يهدف إلى تعزيز التبادلات التجارية، وتحسين شبكة العلاقات.
وتستفيد هذه الشركات أيضًا من شراكاتها مع روّاد الأعمال المصريين، ولا سيما في قطاعَي الموسيقى والمطاعم السودانيَّين المزدهرَين، كما تُظهِر المقابلات التي أجريناها. هذا وتتعاقد شركات أخرى من الباطن مع مصنّعين مصريين أو تؤسّس مشاريع مشتركة معهم، مثلًا لمعالجة الموادّ الخام المستوردة من السودان ثم بيع المنتجات النهائية في مصر والخارج. وتشكّل هذه الشراكات، إلى جانب مساهمتها في تعزيز الجدوى التجارية، إجراءً وقائيًا ضدّ عمليات الإغلاق المُفاجِئة أو العقبات التنظيمية. ومع أن الشركات السودانية الكبيرة لا تعترضها الكثير من العقبات التي تواجه الشركات الصغيرة غير الرسمية، وأن نماذج أعمال الشركات المتوسّطة والكبيرة تتوافق بشكل أوثق مع نموذج التنمية الذي تسعى السلطات المصرية إلى تشجيعه، لا تزال هذه الشركات تواجه تحدّيات أوسع نطاقًا. ومن ضمن هذه القيود التغييرات المُفاجِئة في القواعد التنظيمية والقوانين التجارية؛ والإجراءات البيروقراطية المعقّدة (التي غالبًا ما يقارنها روّاد الأعمال بالإجراءات السهلة جدًّا في الإمارات)؛ والفجوة بين القواعد الرسمية وتطبيقها على أرض الواقع؛ وغموض القرارات، كما يدلّ عليه القرار القاضي مؤخرًا بوقف منح الإقامة الاستثمارية للمواطنين السودانيين، واستمرار تعقيد إجراءات الحصول على الموافقات الأمنية.
المسارات المتباينة للشركات السودانية النازحة إلى مصر
يُظهِر هذا التحليل لبيئتَين مختلفتَين من بيئات الأعمال السودانية، تتّسم علاقتهما بالتفاعل المحدود، أن الشركات السودانية تعمل في ظلّ الكثير من الظروف المشابهة التي تعمل في ظلّها الشركات المصرية، ولكنها تصطدم أيضًا بقيودٍ فريدةٍ من نوعها. فكما هي حال الشركات المصرية الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في السوق البلدية، تعمل الشركات السودانية الصغيرة في ظلّ أُطُرٍ تنظيميةٍ فضفاضة ومُعادية، وهي بيئةٌ تشجّع على العمل غير الرسمي وتثبط الاستثمارات الطويلة الأجل. ولكن على عكس المصريين، يتمتّع السودانيون بوضع قانونيّ هشّ يعرّضهم للترحيل، ناهيك عن أن معرفتهم المحدودة بالسوق تُفاقِم هشاشة أوضاعهم الاقتصادية. ويزداد الوضع سوءًا للنازحين السودانيين الجدد نتيجة تشديد شروط الإقامة أكثر فأكثر، وتراجع القدرة الشرائية في مصر. في المقابل، لا تزال الشركات الكبيرة تستفيد من شراكات مستقرّة، وأصول مضمونة، وشبكات واسعة، تُمكّنُها من التخطيط الاستراتيجي على المدى الطويل، على غرار الشركات المصرية المتوسّطة والكبيرة التي تعتمد على علاقات سياسية قوية. وكان بعض أصحاب الشركات السودانية هذه سبق أن استقرّوا في مصر قبل الحرب، بينما كانت للبعض الآخر شقق سكنية وحسابات مصرفية هناك، ومعرفة بالأسواق المحلية، وعلاقات مع نظرائهم المصريين. مع ذلك، ليست هذه المؤسسات بمنأى عن قوانين الهجرة الآخذة بالتغيّر على الدوام، والتي تؤثّر على المواطنين السودانيين.
بالنظر إلى المستقبل، نرى أن التحوّلات المتسارعة في السياق السوداني، مثل استيلاء القوات المسلحة السودانية على العاصمة الخرطوم في مطلع العام 2025، من المرجّح أن تؤثّر على الشركات الصغيرة والكبيرة بشكل مختلف؛ فبينما قد يعود الكثير من الشركات الصغيرة إلى السودان، من المتوقّع أن تبقى الشركات المتوسّطة والكبيرة في مصر. ويؤدّي كلٌّ من التضخّم وارتفاع أسعار الإيجارات، إلى جانب التنافس بين الشركات الصغيرة، إلى انخفاض هوامش ربح هذه الأخيرة، مع احتمالٍ ضئيلٍ لتحسّن الأوضاع في المستقبل. أما الشركات الكبيرة في مصر، فهي قادرةٌ على الانتظار حتى تستقرّ الأوضاع في السودان، بفضل ما تتمتّع به من مزايا سوقية راسخة، ونجاحها في الحفاظ على حضورٍ عابرٍ للحدود يدعم استثماراتها الطويلة الأجل.
هوامش
1يشير مصطلح "السوق البلدية" إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي لديها قدرة محدودة على الحصول على رأس المال وإنتاجية منخفضة، وغالبًا ما يتداخل مع مصطلح "الاقتصاد غير الرسمي". وأبرز ما يميّز هذا النوع من ريادة الأعمال المتجذّر في المشهد الاقتصادي المصري هو "ضعف الحدود الفاصلة بين الحيّز الاجتماعي والحيّز الاقتصادي". انظر:
Amr Adly, Cleft Capitalism: The Social Origins of Failed Market Making in Egypt (Stanford, CA: Stanford University Press, 2020), p. 177.
2تُمنح تأشيرات سياحية صالحة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر إلى السودانيين الذين دخلوا البلاد بشكل قانوني بعد اندلاع الحرب، بينما يُلزَم السودانيون الذين دخلوا بطريقة غير قانونية على التقدّم بطلبٍ للحصول على صفة لاجئ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
3أحاديث غير رسمية مع سودانيَّين، الأول يعمل محاسبًا والثاني يعمل سمسارًا ويملك شركة سفر في القاهرة في مطلع العام 2025.
4مقابلة أجرتها إحدى المؤلّفتَين مع صاحب شركة كبيرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في القاهرة.
السياق المُتبدّل لمجتمع الأعمال اليمني في مصر
توفّر السوق المصرية فرصًا جذابة لرجال الأعمال اليمنيين، نظرًا إلى القرب الثقافي واللغوي والعلاقات التاريخية السياسية والتجارية بين البلدَين. فكان بوسع اليمنيين طيلة عقود الإقامة في مصر من دون الحاجة إلى تصريح، ما أتاح لروّاد الأعمال اليمنيين تأسيس شركات في قطاعاتٍ مختلفة مثل التجارة الداخلية، والاستيراد والتصدير، والمطاعم، وغيرها. ومع أن مصر أجرت خلال السنوات الأخيرة تعديلات على قانون دخول الأجانب إلى أراضيها والإقامة فيها – وأتى ذلك جزئيًا ردًّا على توافد آلاف اليمنيين إلى مصر هربًا من الحرب الأهلية في بلادهم – فإنها ما زالت تتمتّع بعوامل داعمة للنشاط الاستثماري، منها حجم السوق المحلية الكبير، والاستقرار السياسي، وتسهيلات في إجراءات تسجيل المشروعات طالت فئات معيّنة من الشركات، وقوانين تحمي الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن حوافز ضريبية وإدارية، وإعفاءات جمركية.
يُشار مع ذلك إلى أن الاستفادة من هذه المزايا ليست متاحة لجميع روّاد الأعمال على نحوٍ متكافئ. فقد أثّرت سياسات الهجرة غير المتّسقة في مصر، إلى جانب أوجه التفاوت الهيكلي المتجذّرة في البلاد، بشكلٍ بالغ على تجارب أبناء الجالية اليمنية. والنتيجة كانت انقسام مجتمع الأعمال اليمني في مصر إلى فئتَين: فرجال الأعمال الذين يمتلكون رأس المال المالي ضمن الوافدين اليمنيين الجدد يستطيعون الانضمام بسهولة أكبر إلى شبكات الأعمال اليمنية التي كانت موجودة مسبقًا واقتناص الفرص الاستثمارية، في حين أن ذوي الإمكانات المحدودة، الذين يشكّلون الغالبية العظمى من الجالية اليمنية، يواجهون صعوبةً في الوصول إلى الخدمات الخاصة والعامة، أو تأمين العملة الصعبة، أو الحصول على فرص العمل، في ظلّ تضاؤل مواردهم المالية. لذا يؤدّي رأس المال الاجتماعي، سواء على شكل الشبكات التضامنية أو الهيئات المجتمعية، دورًا حاسمًا في تيسير الفرص الاستثمارية لأصحاب رؤوس الأموال، وضمان مقوّمات البقاء لسائر أفراد الجالية اليمنية.
دور رأس المال الاجتماعي في التغلّب على التحديات
على الرغم من الفرص المتاحة، يواجه المستثمرون اليمنيون في مصر جملةً من التحديات التي تعيق استثماراتهم واستقرارها، وتقوّض أمنهم المالي. وتشير المقابلات التي أُجريت في معرض كتابة هذا المقال إلى أن الإصلاحات القانونية والتنظيمية التي أدخلتها الحكومة منذ العام 2017 بهدف تحسين البيئة الاستثمارية قد زادت عقباتٍ بدورها.1 فما زال صغار المستثمرين اليمنيين يواجهون تحديات مرتبطة بقيود التسجيل واستحصال الموافقة الأمنية والامتثال للإجراءات الإدارية المطوّلة، الأمر الذي يزيد من تكاليف المشاريع ومهل تنفيذها. في هذا الإطار، يجادل رئيس الجالية اليمنية في مصر عمر بابطين قائلًا إن كبار المستثمرين قادرون على توكيل محامين ومحاسبين قانونيين لاستخراج التراخيص من السلطات المعنية والوفاء بالتزامات الإبلاغ المالي، غير أن صغار المستثمرين قد يفتقرون إلى المعرفة الدقيقة بآليات استخراج التراخيص والموافقات الأمنية. ونظرًا إلى التحديات التي تعصف بالنظام المصرفي والسوق المالية في مصر، تواجه الشركات المتوسّطة والصغيرة وكذلك المشاريع الناشئة، صعوبةً في الحصول على التمويل أو القروض المصرفية.
لذا، يؤدّي رأس المال الاجتماعي دورًا أساسيًا في تحديد قرارات الاستثمار للكثير من رجال الأعمال اليمنيين في مصر، كما هي الحال مع نظرائهم في القطاع الخاص المصري. فالروابط والعلاقات الشخصية تسهّل اجتياز الإجراءات الرسمية والممارسات غير الرسمية بنجاح، وبالتالي تدعم الأنشطة التجارية. إذًا، يسهم رأس المال الاجتماعي في بناء الثقة وتسهيل تبادل المعلومات بين رجال الأعمال من القطاع الخاص والموظفين الحكوميين والعملاء. وقد أتاح هذا التبادل للمستثمرين اليمنيين، الذي أتوا إلى مصر بعد اندلاع الحرب الأهلية اليمنية في العام 2014، الاستفادةَ من خبرات رجال الأعمال اليمنيين الذين سبقوهم إلى مصر ومن معرفتهم الدقيقة بالسوق، من أجل تعزيز اندماجهم في السوق المصرية وتوسيع أعمالهم. وهكذا، لا يقتصر تأثير رأس المال الاجتماعي على مجرّد كونه شبكة دعم، بل هو عاملٌ حاسمٌ في تشكيل مسار الاستثمار اليمني في مصر من خلال تحديد القطاعات المستهدفة، وتسهيل العمليات التجارية، وتجاوز العقبات المختلفة.
الشركات الراسخة
ساهمت الروابط التجارية والعلاقات الشخصية القائمة منذ ما قبل اندلاع حرب اليمن في العام 2014 في توجّه المستثمرين اليمنيين نحو السوق المصرية، وفي تكيّفهم مع القوانين واللوائح المحلية وبناء شراكات جديدة موثوقة. وساعد تشكيل مجلس الأعمال اليمني في مصر في أيار/مايو 2021 الشركات اليمنية على استكشاف الفرص للاستثمار أو التوسّع. وساعد هذا المجلس، إلى جانب مجلس أعيان الجالية اليمنية في مصر، على إضفاء صبغة رسمية على الشبكات القائمة في قطاعاتٍ مثل صناعة الأغذية، والمطاعم، والمنسوجات، والعقارات. فقد عمَد بعض المستثمرين إلى توسيع أعمالهم القائمة داخل اليمن عبر إنشاء فروع جديدة في مصر، بينما استفاد مستثمرون آخرون من معرفتهم الدقيقة بالسوق المحلية واحتياجاتها من أجل إقامة شراكات مع شركات في الخارج.
وخلال الفترة الممتدّة بين العامَين 2001 و2021، بلغ حجم الاستثمارات اليمنية 12 مليار دولار أميركي، وفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. وتوزّعت الاستثمارات على قطاعات مختلفة مثل تجارة التجزئة وتجارة الجملة، والاستيراد والتصدير (خاصةً السلع الغذائية والاستهلاكية)، وإنتاج الدواجن، والبرمجة، وصناعة الملابس، وإنتاج الشاي، والشحن الجوي، وصناعة الكرتون، والمطاعم والمقاهي، والمدارس والمراكز الطبية، والعقارات، والإنتاج الإعلامي. وقُدّرت قيمة الاستثمارات اليمنية في قطاع العقارات وحده بأكثر من 4.5 مليارات دولار عن الفترة الممتدّة بين 2014 و2019، وبلغت حصة العاصمة الإدارية الجديدة من هذه الاستثمارات العقارية حوالى 200 مليون دولار حتى منتصف العام 2024. وتجدر الإشارة إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه الأصول مملوكٌ للشركات اليمنية الكبيرة، التي بلغ عددها الإجمالي 45 شركة في العام 2024.2 ومن المرجّح أن تكون بعض الشركات قد نقلت تسجيلها ولوائحها التنظيمية وتراخيص الاستيراد والتصدير من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التي تأسّست بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يقدّم إعفاءات ضريبية ومزايا جمركية متنوعة للشركات غير المصرية العاملة بشكل أساسي في مناطق استثمارية أو مناطق حرة محدّدة.
تزامن تدفّق اليمنيين الأكثر ثراءً منذ العام 2014 مع بروز توجّهات جديدة ضمن الشريحة العليا من الطبقة الوسطى والنخب الثرية في مصر. فقد تمركز مجتمع الأعمال اليمني في مصر تاريخيًا في أحياء الدُقي، وفيصل، والمِنيَل في وسط القاهرة بشكلٍ أساسي، ولكن في السنوات الأخيرة شهدنا انتقالًا ملحوظًا إلى الضواحي الراقية والمدن الجديدة، مثل القاهرة الجديدة، والشيخ زايد، ومدينة السادس من أكتوبر. مع ذلك، ما زالت عائلات كثيرة من الطبقة الوسطى تواجه تحديات في الحصول على الخدمات الخاصة أو حتى العامة، وهي "تكافح للحفاظ على مركزها الاجتماعي، بحيث تقلّصت أموالها مع اغترابها القسري". وفي هذا الإطار، ترى الباحثة في الجامعة الأميركية في القاهرة، علياء محمد المهدي، أن هذه العائلات "قد ينتهي بها المطاف في الفئة الثالثة [من اليمنيين ذوي الخلفيات الاجتماعية والاقتصادية الأدنى] مع تدهور أوضاعها المالية، ما يعني أنها ستحتاج إلى مساعدات مالية خارجية بسبب صعوبة الحصول على فرص العمل والقيود المالية المرتبطة بتصاريح الإقامة". وقد تفاقمت هذه التحديات نتيجة إغلاق السلطات المصرية ثلاث مدارس يمنية خاصة في مطلع العام 2025، كما أكّد السفير اليمني خالد محفوظ بحاح. وتؤرق هذه المسألة على وجه التحديد العائلات المنتمية إلى الطبقة الوسطى، التي ترغب في تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة التي تتقاضى أقساطًا باهظة.
الشركات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر
شكّل اليمنيون من الطبقتَين الوسطى والغنية على الأرجح غالبية الجالية اليمنية في مصر لغاية العام 2014، والتي قُدِّر عدد أفرادها آنذاك بين 70 ألفًا و100 ألف شخص. لكن اليمنيين ذوي الدخل المحدود يشكّلون راهنًا شريحةً أوسع بكثير من هذه الجالية التي ازداد عدد أبنائها أضعافًا بعد العام 2014. وقد تباينت بشكلٍ كبير التقديرات الأخيرة لعدد اليمنيين المقيمين في مصر. ففي مطلع العام 2025، صرّح المستشار الإعلامي للسفارة اليمنية في القاهرة بليغ المخلافي أن عدد المقيمين المسجّلين هو 100 ألف فقط، فيما يشكّل "المتردّدون" على مصر من اليمنيين العدد الأكبر البالغ 150 ألفًا. لكن في العام 2020، لفت هو ومصادر أخرى إلى أن إجمالي عدد اليمنيين المقيمين في مصر يتراوح بين 500 ألف و700 ألف، بينما أعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عددهم أكثر من مليون ونصف المليون شخص. تجدر الإشارة إلى أن عدد اليمنيين المسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ضئيلٌ جدًّا - إذ بلغ 8,255 من أصل 941,625 لاجئًا وطالب لجوء مسجّلًا حتى 31 آذار/مارس 2025 - ما يعني أن السواد الأعظم من اليمنيين المقيمين في مصر هم سيّاح أو طّلاب أو مرضى يتلقّون العلاج، أو غيرهم من الحائزين على تصاريح الإقامة المؤقتة أو ممّن سجّلوا رسميًا شركات صغيرة أو متوسّطة.
تتجنّب الشركات اليمنية المتوسّطة عمومًا تسجيل أعمالها عبر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بسبب التعقيدات البيروقراطية والرسوم والتكاليف المالية المترتّبة عن ذلك، والتي لا يستطيعون تغطيتها. بدلًا من ذلك، تلجأ إلى تسجيل أعمالها ضمن أحد التصنيفات القانونية لتأسيس الشركات الذي يسمح بأن يكون رأس المال المدفوع عند التأسيس أقل بكثير ممّا تفرضه الهيئة العامة للاستثمار. ينطبق ذلك أيضًا على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، التي تواجه تحديات أكبر بكثير. وعلى الرغم من هذه المحاولات، بلغت تكلفة تأسيس شركة، وفقًا للبنك الدولي، ما نسبته 20.3 في المئة من متوسط دخل الفرد السنوي في العام 2020.
من غير المفاجئ إذًا أن قلة رأس المال وصعوبة الحصول على القروض التجارية تشكّلان عائقًا كبيرًا أمام استمرارية المشاريع الاستثمارية واستدامتها. وهنا تؤدّي التحويلات المالية دورًا هامًّا، أسوةً بالاقتصاد المصري عامةً، الذي شكّلت فيه التحويلات من الخارج نسبة 4.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، وفقًا للبنك الدولي. عمومًا، يزيد نقص التمويل من صعوبة الإيفاء بشروط التسجيل الرسمي، ما يحدّ بدوره من إمكانية حصول الشركات المتوسّطة على القروض، ويجعلها أكثر عرضةً للمخاطر القانونية في حال عدم التسجيل. هذا وتميل الشركات متناهية الصغر بشكلٍ كبير إلى عدم التسجيل، وهي التي، بحسب التعريف القانوني، يقلّ رأسُ مالها المدفوع أو رأس مالها المُستثمَر عند التأسيس عن 50 ألف جنيه (حوالى 1000 دولار) وعددُ موظفيها عن الخمسة.
تعكس أوضاع الشركات اليمنية الصغيرة ومتناهية الصغر أوضاع نظيرتها المصرية. ففي الكثير من الأحيان، تتشارك هاتان الفئتان من الشركات الأمكنة نفسها هي ومجموعات أخرى من المهاجرين ذوي الدخل المحدود، ولا سيما في أحياء القاهرة مثل فيصل، والدُقي، والمِنيَل، وأرض اللواء، والبحوث. ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن 89 في المئة من أصل 3.7 ملايين منشأة اقتصادية في مصر في العام 2017 كانت تضم أقلّ من خمسة موظفين، فيما تندرج 10 في المئة أخرى ضمن فئة الشركات الصغيرة. وتشير ورقة بحثية نشرها منتدى البحوث الاقتصادية في مصر في العام 2014 إلى أن الغالبية العظمى من الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر "تعمل خارج الاقتصاد الرسمي، ما يعني في حالة هذه الشركات أن الكثير منها لا يمتثل امتثالًا كاملًا للمتطلّبات القانونية للأعمال، مثل الترخيص والتسجيل ودفع الضرائب". وتضيف الورقة أنّ "العمل خارج الاقتصاد الرسمي أثبت أنّ له أثرًا سلبيًا على إنتاجية الشركات... وأنه يقلّل من احتمالية خروج صاحب الشركة من دائرة الفقر". وقد خلصت دراسة أعدّتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في العام 2025 إلى أن الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر تتمتّع بميزة تجنُّب التكاليف المالية والإدارية التي تُفرَض على الشركات الكبرى المُمتثلة للقواعد التنظيمية. لكن الدراسة لفتت أيضًا إلى استبعاد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من القطاع المصرفي، وأكّدت أن "تأسيس الأعمال الجديدة في مصر يبدو مدفوعًا، في جزءٍ كبير منه، بالضرورة لا بالفرص... بسبب قلّة فرص العمل المتاحة".
يكمُن الحلّ للكثير من الشركات اليمنية، وكذلك نظيرتها المصرية، في اللجوء إلى جهاز تنمية المشروعات المتوسّطة والصغيرة ومتناهية الصغر. أُنشئ هذا الجهاز في العام 2017، ثم توسّع بموجب القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في العام 2021، وهو يضمّ 31 مكتبًا إقليميًا، إضافةً إلى منظومة شراكة وتعاون مع 890 جمعية أهلية و1900 فرع مصرفي، وبالتالي فهو مُتاح لشريحة واسعة من المستفيدين. وقد أصبح هذا الجهاز خيارًا مثاليًا للمستثمرين اليمنيين، إذ يتطلّب رأسَ مال تأسيسيًا أقلّ بكثير، ويتميّز بمتطلّبات تسجيل وإجراءات بيروقراطية أبسط مقارنةً مع تلك التي تفرضها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة على الشركات الكبرى. وتوفّر البرامج المُموَّلة من المانحين دعمًا إضافيًا، مثل مشروع "مسار إيجابي" المموّل من الاتحاد الأوروبي، الذي يساعد روّاد الأعمال اليمنيين (وغيرهم من المهاجرين) على تأسيس شركات خاصة من خلال التدريب على المهارات الحياتية والمهنية وتوفير التمويل الأوّلي.
من المهم إتاحة الفرص لممارسة الأعمال ضمن إطارٍ قانوني وبتكاليف مالية معقولة. لكن المهاجرين "يواجهون صعوبات أكبر بكثير" في التعامل مع الإجراءات البيروقراطية المصرية مقارنةً مع المواطنين المصريين. ونتيجةً لذلك، "في الكثير من الأحيان، يعتمد الحصول على الخدمات الأساسية، من تصاريح الإقامة وجوازات السفر والرعاية الصحية، على القدرة على الاستفادة من العلاقات الاجتماعية". باختصار، يؤدّي رأس المال الاجتماعي دورًا حاسمًا في مساعدة المستثمرين اليمنيين على الامتثال للمتطلّبات الإدارية والقانونية وتجاوز العوائق البيروقراطية، وتيسير دخولهم إلى السوق المصرية، فضلًا عن توفير الموارد المالية والدعم المعنوي لهم.
يزداد اعتماد الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر غير المسجّلة رسميًا على رأس المال الاجتماعي لتعويض نقص التسجيل التجاري والافتقار إلى القنوات الرسمية للحصول على التراخيص أو التمويل، وأيضًا للوصول إلى العملاء. هذا الأمر شائعٌ في المشاريع المنزلية الصغيرة التي كثيرًا ما تديرها نساء يقدّمن خدماتٍ مثل تصفيف الشعر، وإعداد الطعام وتوصيله، ويمتهنّ حرفًا يدوية مثل صياغة المجوهرات وصنع السلال والحقائب الصغيرة، وكذلك تركيب العطور والبخور. وتتلقّى هذه المشاريع أحيانًا طلباتٍ عبر الإنترنت، لكن عملياتها تبقى عمومًا غير منتظمة وعرضةً للانقطاع. حتى الشركات الصغيرة والمتوسّطة تعتمد بشكلٍ كبير على بازارات "الأُسر المنتجة" برعاية السفارة اليمنية أو جمعيات شبابية ونسائية يمنية لبيع منتجاتها. إن الجمعيات التابعة للجالية اليمنية، التي تقدّم خدمات الدعم النفسي الاجتماعي والتدريب المهني - أحيانًا بالتعاون مع المنظمات الإنسانية الدولية – تشكّل عنصرًا مكمّلًا لرأس المال الاجتماعي، إلّا أنها تواجه بدورها تحديات كبيرة، "بما في ذلك إجراءات التسجيل القانوني المعقّدة، وما يترتّب عنها من قيود مالية، وتحديات إدارية وتشغيلية، وتوتّرات مع كلٍّ من المجتمع المضيف والنازحين".
خاتمة
مرّت تجربة المستثمرين اليمنيين في مصر بتحوّلاتٍ متباينة فرضتها الظروف المحلية والإقليمية والدولية، بدءًا من الحرب في اليمن وارتفاع وتيرة هروب رؤوس الأموال منذ العام 2014، ومرورًا بتداعيات جائحة كوفيد-19، ووصولًا إلى الحرب الروسية الأوكرانية. وقد أثّرت هاتان الأزمتان تحديدًا بشدّة على الاقتصاد المصري المضيف، وعلى طبيعة المشاريع اليمنية، وحجم المخاطر التي تتعرّض لها، وأنماط تمويلها، وقدرتها على التوسّع أو حتى الاستمرار. يواجه جميع المستثمرين اليمنيين، صغارًا كانوا أم كبارًا، تحديات جديدة تشمل تزايد كلفة الإقامة القانونية ومتطلّباتها الإدارية، وتقييد فرص التوسّع في السوق، إضافةً إلى تشديد الرقابة على التحويلات المالية، وتراجع القدرة الشرائية للعملاء. ويبدو أن الاعتماد على رأس المال الاجتماعي، سواء من خلال الروابط القائمة داخل الجالية اليمنية أو في أوساط مجتمع الأعمال المصري ومسؤولي الدولة، لم يعد كافيًا لتجاوز العقبات البيروقراطية والقانونية.
إذًا، وعلى الرغم من بقاء جزءٍ كبير من اليمنيين في مصر، شهدت السنوات الأخيرة عودة عددٍ من روّاد الأعمال إلى اليمن، بدافعٍ من الاستقرار النسبي في بعض مناطق البلاد، أو النمو الملحوظ في سوق العقارات داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، نظرًا إلى تقييد حركة تحويل الأموال إلى الخارج بسبب العقوبات الدولية والضوابط المصرفية. وهكذا، سيظلّ مستقبل مجتمع الأعمال اليمني في مصر مرتبطًا بعوامل متشابكة تتمثّل في مدى استقرار الأوضاع السياسية والأمنية في اليمن، وتطوّرات الاقتصاد المصري، ومرونة البيئة التنظيمية في مصر تجاه الأجانب. لكن ما يبدو واضحًا اليوم هو أن الجالية اليمنية لم تعد في وضع الانتظار أو التكيّف فحسب، بل باتت تبحث عن استراتيجيات دائمة للاستقرار أو العودة، تتجاوز مجرّد الإقامة المؤقتة أو المشاريع الاستثمارية الصغيرة.
هوامش
1مقابلات أجرتها المؤلّفة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024 و15 كانون الثاني/يناير 2025 مع يمنيين يملكون شركات عدّة ومدرسة.
2عمر بابطين، رئيس الجالية اليمنية في مصر؛ ومقابلة أجرتها المؤلّفة في 22 تشرين الأول/أكتوبر 2024.
مجتمع الأعمال الليبي في مصر: التغلّب على العقبات الهيكلية واغتنام الفرص العابرة للحدود
صرّح مؤخًّرًا رئيس شركة ليبية متعدّدة الجنسيات تعمل في مصر منذ تسعينيات القرن الماضي، قائلًا: "مصر هي امتداد طبيعي لليبيين، إذ تربطنا علاقات تجارية منذ قرون، ولدينا مصالح مشتركة".1 صحيحٌ أن السوق المصرية تواجه تحدّيات اقتصادية كبيرة، إلا أنها تتمتّع باستقرار نسبي، ما يجعلها جذّابةً للمستثمرين الليبيين بوجه خاص، نظرًا إلى انعدام الاستقرار السياسي والأمني والتفكّك المؤسّسي في بلادهم. ولا يعكس تصريح رجل الأعمال فقط الدور المركزي الذي يؤدّيه مجتمع الأعمال الليبي في مصر في بناء الروابط العابرة للحدود، بل أيضًا الطريقة التي تتشابك بها أنشطته العابرة للحدود مع المصالح الثنائية للدولتَين.
ولكن أكثر ما يلفت الانتباه في المشاريع والاستثمارات التجارية الليبية في مصر هو أنها تنبع في المقام الأول من القطاع العام الليبي، لا من القطاع الخاص. الواقع أن مجتمع الأعمال الليبي في مصر يحافظ على روابط وثيقة بالقطاع العام الليبي لضمان مصالحه الاقتصادية. وترتكز هذه الروابط الوثيقة على علاقات مميّزة مع الهياكل السياسية الحكومية، ما يمكّن أعضاء مجتمع الأعمال من توسيع نفوذهم من خلال الحصول على عقود استراتيجية، وتولّي مناصب مؤسّسية رئيسة، وتسهيل الشراكات بين القطاعَين العام والخاص في ليبيا وخارجها. والجدير بالذكر أيضًا أن مجتمع الأعمال هذا ليس عبارة عن جاليةٍ من روّاد الأعمال في مصر بقدر ما هو مجتمع أعمال عابر للحدود له أنشطة راسخة في السوق في كلٍّ من ليبيا ومصر ودول أخرى في المنطقة. وبالفعل، مقارنةً مع رجال الأعمال الليبيين من القطاع الخاص الذين سعوا إلى العمل في مصر منذ الربيع العربي في العام 2011، وحدها الشركات الليبية الكبرى العابرة للحدود حافظت على دور دائم ومهمّ في السوق المصرية، بفضل قدرتها على التأقلم مع الحضور القوي للشركات المملوكة للدولة المصرية والمنافسين الأجانب.
القطاع الخاص الليبي المتعثّر
ظلّ القطاع الخاص الليبي متخلّفًا عن التطور، على الرغم من سياسة التحرير الاقتصادي النسبي (أو الانفتاح الاقتصادي) التي بدأت في أوائل تسعينيات القرن الماضي. قبل الشروع في عملية التحرير هذه، ساد نموذج اقتصادي تديره الدولة، ويتّسم بهيمنة القطاع العام على غالبية قطاعات الأعمال في البلاد، مع تركيزٍ كبيرٍ على قطاع النفط والغاز. وعلى خلاف معظم الاقتصادات النامية، حيث يمثّل القطاع الخاص عمومًا أكثر من نصف النشاط الاقتصادي الوطني، لم تتجاوز نسبة مساهمته في ليبيا الـ5 في المئة قطّ. ونظرًا إلى حظر النظام الليبي المُلكية الخاصة بدءًا من العام 1978 وحتى الانفتاح التدريجي في أوائل التسعينيات، اضطّر روّاد الأعمال من القطاع الخاص إلى ممارسة أنشطتهم بصورة رئيسة ضمن الاقتصاد غير الرسمي، أو مغادرة البلاد لمزاولة أعمالهم في أماكن أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو أوروبا. فعلى سبيل المثال، أطلق رجل الأعمال الليبي حسن طاطاناكي أنشطته الريادية من الخارج، وخصوصًا من مصر، التي كانت أُسرتُه فرّت إليها في السبعينيات. اشترى طاطاناكي في العام 1991 شركة "تشالنجر" المحدودة (Challenger Limited) المتعدّدة الجنسيات، وأصبح رئيسها، وتخصَّصَ في الخدمات النفطية وحفر آبار النفط، قبل أن يعود في نهاية المطاف إلى ليبيا لتوسيع نطاق أعماله بين البلدَين.
شرع النظام الليبي، إثر العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة على اقتصاده، في الانتقال إلى تحريرٍ اقتصادي جزئي في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات. وهكذا، بدأ بعض رجال الأعمال الليبيين الذين كانوا يديرون أنشطتهم في الخارج بالعودة إلى ليبيا وتطوير أعمالهم في إطارٍ عابرٍ للحدود. وكان أحد الأهداف التي توخّاها النظام الليبي من السماح لبعض رجال الأعمال بالعودة إلى ليبيا لتطوير أعمالهم أكثر استغلالَ شبكاتهم الدولية من أجل الالتفاف على القيود المالية الناجمة عن تجميد الأصول الليبية. وقد استخدم النظام رجال الأعمال هؤلاء كوسطاء، ولا سيما لتسهيل تحويل الأموال إلى الخارج. كذلك، ضَمَنَ التواطؤ بين القطاع الخاص والدولة مزايا اقتصادية للنخب السياسية ونخب الأعمال، ومكَّنَ في الوقت عينه النخب الحاكمة من ترسيخ "اقتصادٍ سياسي قائم على الطاعة". ومن خلال السماح بخصخصة بعض القطاعات وتوفير فرص الاستثمار، عزّز النظام قاعدةَ دعمه في أوساط الجهات الاقتصادية الفاعلة النخبوية، التي أصبحت تعتمد على الحكومة للحفاظ على امتيازاتها في البلاد.
القطاع العام مقابل القطاع الخاص: الاستثمار الليبي في مصر
لا تزال هيمنة القطاع العام على الاقتصاد المحلي في ليبيا تنعكس في الاستثمارات الليبية في الخارج، التي تُدار بصورة رئيسة من خلال المؤسسة الليبية للاستثمار، وهي صندوق الثروة السيادي للبلاد. أُنشِئَت هذه المؤسسة في العام 2006 بهدف الاستفادة من فائض الإيرادات من صادرات الموادّ الهيدروكربونية، نظرًا إلى أن ليبيا تمتلك أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا، والتي شكّلت في العام 2023 نسبة 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و90 في المئة من إيرادات الميزانية، و95 في المئة من قيمة الصادرات. وتضطلع الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية بمعظم أنشطة المؤسسة الليبية للاستثمار في مصر، في شكل مساهمات أو استثمارات. ولكن بينما يبدو أن القطاع العام يحافظ على هيمنته، يبقى من الصعب للغاية تحديد الجهات الفاعلة، لأن استراتيجيات الاستثمار الحكومي التي تديرها طرابلس تُنفَّذ عبر هياكل مؤسّسية متعدّدة تشارك في تمويل عددٍ من الشركات الفرعية المختلفة ذات المُلكية الغامضة والهياكل المالية المعقّدة.
يُقدَّر عدد الشركات المرتبطة بليبيا في مصر على ما أُفيد بـ1165 شركةً متخصّصةً في السياحة، والعقارات، والتمويل، والزراعة، وتمتلك مثلًا بعض المؤسسات الليبية أسهمًا في شركات مصرية. وتُعَدّ حصة ليبيا الاستثمارية في القطاع المصرفي المصري مُربحةً بشكل خاص، إذ يمتلك المصرف الليبي الخارجي حصصًا كبيرةً في المصارف المصرية، أبرزها 38.76 في المئة من المصرف العربي الدولي، و27.71 في المئة من بنك قناة السويس. ومن الأمثلة الأخرى على استراتيجية الاستثمار الحكومية إقامة شراكات بين القطاعَين العام والخاص عن طريق ضخّ التمويل العام الليبي مثلًا في شركات مساهمة ذات أنظمة أساسية مرنة إلى حدٍّ ما، والمشاركة في تمويل المشاريع وإدارتها في مجال التنمية الحضرية أو التطوير العقاري. فقد شمل مشروع "وان ناينتي" One Ninety، الذي أُطلِق في العام 2018 في القاهرة الجديدة، شراكةً بين شركة "لاندمارك صبور" Landmark Sabbour المصرية الخاصة وشركة "لايك سايد" Lakeside للاستثمارات العقارية والسياحية التابعة للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن طبيعة استثمارات الدولة الليبية في السوق المصرية تعقّدت بسبب اختلاس أموال عامة مُخصَّصة لهذا الغرض في ليبيا. فقد اُفيد بأن أفرادًا مقرّبين من الزعيم الليبي معمّر القذافي استخدموا قبل العام 2011 أموالًا عامةً للاستثمار في قطاعَي العقارات والضيافة وغيرهما في مصر، مُنشِئين بذلك نُظمًا ماليةً معقّدةً لإثراء أنفسهم. وقد فرّ بعضهم إلى مصر عَقِب سقوط النظام الليبي في العام 2011، ولا يزالون يمارسون أنشطتهم التجارية هناك. نتيجةً لذلك، أصبح الاستحواذ على استثمار الثروة الوطنية، داخل ليبيا وخارجها، هدفًا رئيسًا للقوى السياسية المتنافسة في البلاد.
وكما هو متوقّع، شهدت الآليات الرئيسة للاستثمار الحكومي الليبي في مصر أيضًا مثل هذا الصراع بين القوى السياسية، ولا سيما بعد نشوء حكومتَين متنافستَين في العام 2014، واحدة في طرابلس (غربًا)، وأخرى في بنغازي (شرقًا). فقد ولّد ذلك تنافسًا على السيطرة على مقرّ المؤسسة الليبية للاستثمار في مصر، وعلى عملية تعيين موظّفيها. يُضاف إلى ذلك أن الخصخصة الكليبتوقراطية للأموال العامة في ليبيا مهّدت الطريق أمام الأفرقاء السياسيين في الحكومة وشبكاتهم لاستخدام الأموال مصدرًا للإثراء والفرص الاقتصادية، عبر استغلال المناصب العامة مثلًا للاستيلاء على أموال الدولة، سواء عن طريق بيع أصول الدولة أم منح عقود تفضيلية.
دفعت أهمية الاستيلاء على أموال الدولة وعقود المشتريات العامة روّادَ الأعمال من القطاع الخاص إلى الانخراط أكثر فأكثر في السياسة الليبية. وقد ترشّح على الأخصّ عددٌ من أعضاء مجتمع الأعمال الليبي العابر للحدود في مصر للانتخابات الرئاسية الليبية، التي كان من المُقرَّر إجراؤها في كانون الأول/ديسمبر 2021، ولكنها أُلغيَت في نهاية المطاف. يوسّع هذا التوجّه نطاق ديناميّات الخصخصة الكليبتوقراطية، إذ تسعى جهاتٌ اقتصادية فاعلة أخرى إلى خوض المعترك السياسي لاكتساب نفوذ استراتيجي في إدارة الأموال والعقود العامة، وبالتالي استثمارات الدولة في الخارج، الأمر الذي يحسّن أنشطتها التجارية العابرة للحدود.
صعوبة تجديد القطاع الخاص الليبي
يُفترَض من الناحية النظرية أن تقدّم مصر المجاورة، بعد العام 2011، للقطاع الخاص الليبي بديلًا عمليًا، نظرًا إلى جهود الحكومة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي، والدعم الذي تحظى به من صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى. فالمشاريع العقارية الضخمة التي أطلقتها إدارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتيح، شأنها شأن قطاعات متنوّعة، بما فيها الخدمات المالية والطاقة والسياحة، فرصًا استثماريةً طويلة الأجل. ومع ذلك، إن تحقيق هذه الإمكانات ليس بالأمر اليسير، إذ تضع السوق المصرية عوائق كبيرة أمام الشركات الليبية الخاصة التي تسعى إلى العمل فيها. فالحضور القوي للشركات المحلية والأجنبية، المتخصّصة والراسخة إلى حدٍّ كبير في مختلف القطاعات الاقتصادية المصرية، يجعل من الصعب على مؤسسات القطاع الخاص الليبي غير المتطوّرة المنافسة. تفتقر الشركات الخاصة الليبية عمومًا إلى الميزة التنافسية مقارنةً مع الشركات المصرية التي تمتلك الخبرات اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية، إلى جانب اليد العاملة الماهرة اللازمة لذلك. وبالفعل، مع أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغت نحو 70 في المئة في العام 2019، لا يزال من الصعب على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تخطّي العقبات التي تنطوي عليها بيئة الأعمال المصرية. ولا يبدو أن بيئة الأعمال هذه، المُشبَعة أو الحصرية للغاية، ملائمةٌ لتجديد القطاع الخاص الليبي على العموم.
ومن الصعب بوجه خاص على رجال الأعمال الليبيين الجدد تأسيس أعمالٍ في مصر. فكما ذكرنا، تسهّل العلاقات الراسخة مع الهيئات الحكومية النافذة وكبار رجال الأعمال معظم أنشطة القطاع الخاص المصري، وكذلك الأنشطة التجارية الليبية الراسخة العابرة للحدود. ويفضّل الجيش المصري، على وجه الخصوص، الشركات المصرية الخاصة لتنفيذ الأشغال العامة الكبرى التي يديرها، مُحافِظًا في الوقت نفسه على أعماله التجارية المهمّة التي تستفيد من الإعفاءات الضريبية، وامتيازات الحصول على العقود العامة، والشراكات مع مستثمرين من القطاع الخاص.
وهكذا، يبدو أن البيئة الاقتصادية في مصر ما بعد العام 2011 تدعم ببساطة استمرارية الماضي، أي بتعبير آخر، لا تزال الجهات الفاعلة الليبية الرئيسة في قطاع الأعمال في مصر تلك التي تشكّل مجتمع الأعمال العابر للحدود الذي يعود تاريخه إلى عقود. في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، عزّزت هذه الجهات نفوذها بنقل أعمالها إلى خارج ليبيا. آنذاك، وفّر نقص الفرص الاقتصادية في ليبيا، إلى جانب عملية التحرير الاقتصادي في مصر التي كانت بدأت في السبعينيات، وتعمّقت بفعل برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيّف الهيكلي الذي أُطلق في العام 1991، بيئةً مؤاتيةً لروّاد الأعمال هؤلاء من أجل تطوير أنشطتهم، أولًا من الخارج ثم بين البلدَين. وقد مكّنهم وجودهم الطويل الأمد في السوق المصرية من توسيع عملياتهم، وتأسيس شركات كبرى وحتى تكتّلات متعدّدة الجنسيات وإدارتها. واليوم، تمتدّ أنشطتهم إلى قطاعاتٍ متنوّعة واستراتيجية مثل قطاع النفط والغاز، والعقارات، والإنشاءات، والخدمات، والسياحة، والصناعات التحويلية.
ويحافظ رجال الأعمال هؤلاء ذوو العلاقات الواسعة على استمرارية مؤسساتهم جزئيًا من خلال تنويع أساليب عملهم، إذ يستثمرون رأس المال من خلال الاستحواذ على الأسهم أو الحصص في المشاريع، فيما يواصلون تطوير شركاتهم الخاصة أو الشركات التابعة لها التي تنتج السلع والخدمات. فعلى سبيل المثال، تمتلك مجموعة غرغار، التي تأسّست في ليبيا في العام 1993، مكتبًا في القاهرة وتعمل في مصر من خلال شركاتها التابعة، مثل غرغار للإنشاءات (Ghrghar Construction) و"ريدي ميكس" Ready Mix. وللمجموعة أيضًا مشاريعها الخاصة في مصر، مثل سلسلة مطاعم أكاكوس Acacus، ومشروع تطوير برج رغد، بما في ذلك بناء مساحات تجارية في حيّ مدينة نصر، تُقدَّر قيمتها بـ41.2 مليون دولار، ومن المُقرَّر الانتهاء منها في العام 2027.
فضلًا عن ذلك، تميل الشركات الليبية الكبرى العاملة في مصر إلى ممارسة أنشطتها الأساسية في سياقٍ عابرٍ للحدود أوسع نطاقًا، حيث تعمل في مصر وليبيا والإمارات العربية المتحدة. يبدو أن رجال الأعمال الليبيين والجهات الاقتصادية الليبية في القطاع الخاص يرَوْن في الإمارات وجهةً للاستثمار أكثر جاذبيةً من مصر.2 فبيئة الأعمال في الإمارات تتميّز ببيروقراطية مبسّطة ومزايا ضريبية كبيرة، ما يوفّر إطارًا تشغيليًا أكثر ملاءمة، ناهيك عن أن الإمارات لا تواجه التحدّيات الاقتصادية نفسها التي تواجهها مصر، وأبرزها النقص المزمن في العملات الأجنبية والتضخّم المتفشّي. وتتّخذ مجموعة غرغار، وتشالنجر المحدودة (Challenger Limited)، و"ألادا" (Alada)، وهي كلّها شركات كبرى، من الإمارات مقرًّا لها، كما تمتلك مكاتب في القاهرة وليبيا. هذا ويحمل أفراد مجتمع الأعمال العابر للحدود جنسياتٍ متعدّدة، ويتنقّلون على نحو منتظم بين هذه الدول الثلاث، حيث يقيمون مؤقّتًا لمزاولة أعمالهم. تتيح هذه الاستراتيجية العابرة للحدود لمجتمع الأعمال الراسخ هذا الاستفادة مما تقدّمه الإمارات من استقرار ومزايا، مع الحفاظ في الوقت عينه على حضوره في مصر.
تأثير العوامل الجيوسياسية على بيئة الأعمال
أصبحت مصر مركزًا استراتيجيًا لرجال الأعمال الليبيين البارزين، ولا سيما أولئك الذين يتبنّون رؤية سياسية-إيديولوجية ليبرالية ويروّجون للإسلام المعتدل. فقد عمَد بعض أفراد مجتمع الأعمال العابر للحدود إلى الاستثمار في قطاعَي الإعلام المصري والليبي من أجل الترويج لهذه الرؤية والتصدّي لنفوذ الإسلام السياسي في المنطقة. وقد استثمر رجل الأعمال الليبي الشهير، حسن طاطاناكي، 15 مليون جنيه مصري (2.73 مليون دولار) في العام 2009 لإطلاق قناة "أزهري" الفضائية في مصر، بهدف نشر رؤية الإسلام المعتدل غير السياسي بما يتماشى مع تعاليم الأزهر، في وجه خطاب جماعة الإخوان المسلمين ووسائل الإعلام التابعة لها، مثل شبكة الجزيرة. وبعد وصول السيسي إلى السلطة، ظلّت مصر بيئةً مؤاتية لأفراد مجتمع الأعمال العابر للحدود المُلتزمين بالتوجّه الإيديولوجي نفسه الذي يتّبعه أصحاب النفوذ المصريون الذين تربطهم بهم علاقات وثيقة.
لجأ بعضٌ من نخبة رجال الأعمال الليبيين إلى الاستثمار في قطاع الإعلام أيضًا من أجل الترويج لموقفهم حيال مسار الصراع في ليبيا. ففي العام 2011، أطلق طاطاناكي قناة "ليبيا أولًا" التي تبثّ من القاهرة وتُعرَف بمعارضتها للإخوان المسلمين وللإسلاميين الناشطين في المشهد السياسي الليبي. وعلى نحو مماثل، أسّس محمود شمّام، وزير الإعلام السابق والمتحدّث باسم المجلس الوطني الانتقالي الليبي، في العام 2013 مجموعة الوسط الإعلامية، التي تمتلك صحيفة مطبوعة، وراديو، ومنصّة رقمية تهدف إلى تغطية أخبار ليبيا، معبّرةً عن وجهة نظر نقدية تجاه القوى الإسلامية المنخرطة في الصراع الليبي. وعلى وجه الخصوص، تبنّى مجتمع الأعمال الليبي هذا المنخرط في قطاع الإعلام التوجّه نفسه الذي اتّبعه المصريون والإماراتيون، من خلال دعم السلطات في شرق لبيبا والقوات المسلّحة بقيادة المشير خليفة حفتر في حربه على الإرهاب ومجموعات الإسلام السياسي؛ وسعى أيضًا إلى إحباط نفوذ حكومة طرابلس التي تدعمها الميليشيات الإسلامية وتساندها تركيا وقطر.
الاصطفافات الجيوسياسية والفرص الاقتصادية الجديدة المتاحة أمام مؤسسات القطاع الخاص الليبي
أسهم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا في العام 2020 في تخفيف حدّة الاختلافات السياسية والجيوسياسية لإفساح المجال أمام تعزيز الفرص الاقتصادية المشتركة مع مصر. وعلى حدّ قول أحد رجال الأعمال المصريين: "لم تعد القضايا السياسية في ليبيا هي محور الاهتمام، بل نتحدّث اليوم عن ممارسة الأعمال في ليبيا".3 وبالفعل، أدّت إعادة تشكيل العلاقات بين البلدَين إلى إبرام شراكةٍ ذات منفعة متبادلة بين السلطات في القاهرة وطرابلس، ما شكّل تحوّلًا عن الشراكة المميزة السابقة بين مصر وسلطات بنغازي. فقد عقدت الغرفة التجارية للقاهرة اجتماعات عدّة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس في إطار اللجنة العليا المشتركة الليبية المصرية أو مجلس أصحاب الأعمال الليبي المصري، أفضت إلى إبرام اتفاقات في العام 2022 من أجل تعزيز العلاقات التجارية وتنويع الاستثمارات وإنشاء مناطق تجارة حرة مشتركة. وقد عمدت مصر إلى توسيع دورها في الأسواق الليبية، في غرب البلاد وشرقها على السواء. ومنذ العام 2021، حصلت الشركات المصرية على عقود إعادة إعمار ضخمة من سلطات طرابلس وبنغازي، تُقدَّر قيمتها بنحو 110 مليارات دولار على مدى عشر سنوات، ويُتوقَّع أن توفّر فرص العمل لما يصل إلى ثلاثة ملايين مصري.
مع ذلك، من المستبعد أن تُحدث العلاقات السياسية المُتبدّلة تغييرًا ملحوظًا في نموذج الأعمال أو تركيبة القطاع الخاص الليبي في مصر. ويُشار إلى أن السلطات الليبية لم تستفِد بعد من الفرص الجديدة المتاحة أمامها لتحسين قدرة المؤسسات الأقل تطوّرًا في القطاع الخاص الليبي على دخول السوق المصرية. وقد أدّى نمو المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدَين إلى تنامي حجم الاستثمارات الحكومية الليبية في مصر، وبالتالي إلى استمرار مساعي الجهات الخاصة إلى الاستفادة من موارد الدولة الليبية. وتَعد هذه الديناميات بالحفاظ على المكانة الراسخة لمجتمع الأعمال الليبي العابر للحدود.
هوامش
1مقابلة أجرتها المؤلّفة في تشرين الأول/أكتوبر 2024، القاهرة، مصر.
2مقابلات أجرتها المؤلّفة مع عددٍ من رجال الأعمال الليبيين الذين يديرون أنشطتهم التجارية بين ليبيا ومصر والإمارات العربية المتحدة.
3مقابلة أجرتها المؤلّفة في أيار/مايو 2023، القاهرة، مصر.